الإمام الحسين عليه السلام في رواية بين القصرين لنجيب محفوظ .. رؤية تحليلية
{ أ. م. د. وسام علي محمد حسين }
المقدّمة[1]
من المعروف لمؤرّخي الأدب العربي ودارسيه أنّ الإمام الحسين عليه السلام، قد احتل مساحة واسعة في خارطة هذا البلد، وكان أحد محاور القصيدة العربية منذ واقعة الطفّ 61هـ إلى يومنا هذا، ولكن من غير المعروف للكثير من المهتمّين بشؤون الأدب ما احتلّه الإمام الحسين عليه السلام في الأجناس الأدبية الأُخرى، لا سيّما الحديثة منها، ألا وهي الرواية.
وممّن أفرد له عليه السلام فضاء واسعاً في رواياته من الروائيين العرب الكبار في القرن العشرين هو الروائي نجيب محفوظ، الذي انساب الإمام الحسين عليه السلام في ثنايا فنّه الروائي انسياب الماء الزلال في سواقي البساتين المزهرة، وقد ارتأيت أن أختار إحدى روايات نجيب محفوظ، وأكشف عن ملامح الإمام الحسين عليه السلام وصورته في تلك الرواية، وهي رواية بين القصرين، وهي واحدة من ثلاثية: قصر الشوق، والسكرية، وروايتنا موضوع البحث والدراسة.
لقد اتخذتُ منهجاً يقوم على مقدّمة وتمهيد ومحورين وخاتمة وقائمة بالمصادر المفهرسة، وقد تناولت في التمهيد تاريخ الدولة الفاطمية في مصر، ودورها في نشر مذهب آل البيت عليهم السلام، والشغف بالإمام الحسين عليه السلام، كما تتبعت الموروث المصري، وتلمست أثر الإمام الحسين عليه السلام فيه.
وفي المحور الأوّل وقفت عند الإمام الحسين عليه السلام في ذاكرة نجيب محفوظ، كما تتبعت شخصية الإمام الحسين عليه السلام في رواية بين القصرين في هذا المحور، واستكملت قسمات وملامح صورة الإمام الحسين عليه السلام في شارع المعزّ أو شارع بين القصرين، حيث يتربع مسجد الحسين شامخاً يطاول الزمن.
كما توقفت متناولة الإمام الحسين عليه السلام في رحاب الأُسرة المصرية المتمثلة في أُسرة أحمد عبد الجواد وأفرادها، لا سيّما زوجته أمينة التي تعلّق قلبها بحب الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك ابنها الصغير كمال الذي كانت له تأملات معبّرة عن ذلك الحب الإلهي الذي يجمعه بالإمام الحسين عليه السلام، لقد تمكّن نجيب محفوظ من تصويرها ورسمها بريشة الفنان الحاذق، وتقديمها للقارئ بأُسلوب مؤثّر للغاية، ثمّ أنهيت الدراسة بخاتمة لخّصت فيها أهم ما توصّلت إليه من نتائج.
التمهيد: الدولة الفاطمية في مصر ودورها في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام
من المعروف لدارسي تأريخ الدولة الفاطمية في مصر، أنّهم قد توجّهوا بأنظارهم من بلاد المغرب التي سادها الاضطراب من حين لآخر إلى مصر؛ لوفرة ثرواتها، وقربها من بلاد المشرق، الأمر الذي جعلها صالحة لإقامة دولة مستقلّة تنافس العباسيين[2].
«ولم تواجه جماهير السنّة في مصر أيّة ضغوط من قبل الدولة الفاطمية؛ لإجبارها على التخلّي عن مذهبها كما أشاع خصوم الفاطميين، وإنّما الجماهير هي التي زحفت طواعية نحو دعوة آل البيت، حتى تحوّل أنصار مذهب السنّة إلى أقلية»[3].
وتذكر المصادر أنّه عندما «وصل الخليفة المعزّ لدين الله الفاطمي إلى القاهرة في سنة 362هـ، ركّز اهتمامه في تحويل المصريين إلى المذهب الشيعي»[4]، وقد كانت القاهرة آنذاك تشكّل مركزاً لحركة التشيع في مصر؛ باعتبارها عاصمة الدولة الفاطمية ومقراً للدعوة، ومنها ينطلق الدعاة إلى أقاليم مصر ونجوعها[5].
ويبدو أنّ «الأساس القوي الذي كانت عليه الدولة الفاطمية، هو انتسابها إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ ولهذا كان السلاح القوي الذي استعمله أعداؤها ومعارضوها هو الطعن في شرعية حكمها»[6].
وقد فضّل الفاطميون الانتماء إلى السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ «لأنّهم يُقيمون حقّهم في الخلافة على أنّهم أسباط النبي عليه السلام، وأنّهم أبناء الوصي علي بن أبي طالب، ولكن العباسيين ينازعونهم دعوى الوصاية وينكرونها، ويقولون: إن الانتساب إلى النبي من جانب عمّه العباس أقرب من جانب علي ابن عمّه أبي طالب، ومن أجل هذا يتسمّى الفاطميون بهذا الاسم؛ لأنّ بنوة الزهراء نسب لا يدعيه العباسيون»[7].
ولعلّ الصبغة الدينية العميقة قد طبعت سياسة الدولة الفاطمية منذ القِدم، وبفضل هذا قامت حكومتهم، وتركّزت في مصر[8].
وتذكر المصادر أنّ الوزير الفاطمي الصالح طلائع بن رزيك، قد لعب دوراً هاماً في حفظ رأس الإمام الحسين عليه السلام مؤقتاً بالسرداب، حيث انتقل من عسقلان إلى القاهرة في 8 جمادى الآخرة عام 548هـ، وبقيت عاماً مدفونة في قصر الزمرد، حتى أُنشئت له خصيصاً قبة هي المشهد الحالي، وكان ذلك عام 549هـ[9]، وقد تمّ «حمل الرأس الشريف من السرداب العظيم إلى هذا القبر، ودُفن به في الثلاثاء الأخير من ربيع الآخر على المشهور من العام التالي، وهو موعد الذكرى السنوية الكبرى بمصر للإمام الحسين»[10]، ويبدو أنّ حضارة مصر الفاطمية «في ظلّ الإسلام الشيعي، كانت نتاج تجربة فريدة من نوعها للدولة الإسلامية الشيعية، وسنجد مؤشرات عظمة هذه الحضارة في المؤسسات التي بناها الخلفاء المصريون، فالمظهر الحضاري المتميّز والمتقدّم هو الذي يدل على عظمة الفكر الذي يحمله أهلها لآل البيت عليهم السلام، الذين أصبحوا نبراساً يُحتذى به في المُثل الإسلامية والإنسانية»[11] على مرّ الأزمان والعصور.
الإمام الحسين عليه السلام في الموروث المصري
لقد تشرّفت مصر بأهل البيت عليهم السلام منذُ أن جاءها محمد بن أبي بكر عاملاً للإمام علي عليه السلام، واستمرت علاقتها بأهل البيت عليهم السلام، وقد زاد من ولائها مجيء عدد من الأعلام، كالإمام الشافعي عندما انتقل إلى مصر، حيث نقل معه هذا الحب، وكذلك وجود بعض من آل البيت كالسيدة نفيسة بنت الحسن التي دُفنت هناك[12]، وما زال مرقدها يؤمّه الزائرون من كلّ حدب وصوب؛ تيمناً بحفيدة الرسول محمد صلى الله عليه وآله.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فكان لقيام دولة كاملة حكمت مصر ـ وعُرفت باسم الفاطميين، وقد رفعت شعاراً عنوانه حب أهل البيت عليهم السلام ـ آثار كبيرة، منها: بناء القاهرة التي أنشأها جوهر الصقلي، وأصبحت مركزاً للإشعاع الحضاري للبلدان المجاورة، وقد تكرّست علاقة مصر بأهل البيت عليهم السلام حتى العصور المتأخرة، ويقال: إنّ مصر سنّية المذهب، شيعية الهوى، وحين يزور الإنسان مقام الحسين عليه السلام، أو السيدة زينب عليها السلام يرى مظاهر التعلّق بأهل البيت واضحة هناك[13].
ويوجد في مصر كثير من الأضرحة والمزارات التي لا حصر لها، والتي يُنسب الكثير منها إلى أهل البيت عليه السلام، ومن المعروف أنّ مصر قديماً قد اشتُهرت بكثرة ما بها من المساجد والقباب والأضرحة، وما ذلك إلّا لطيبة وصلاح يغلبان على أهلها[14].
وقد تنسمت أرض مصر وأهلها «حباً في آل البيت عشقاً وتشيعاً، ولم يكتفوا بتلك الأضرحة والمشاهد الحقيقية، وإنّما بنوا العشرات، بل والمئات من الأضرحة ومشاهد الرؤيا»[15]، ومازالت آثارها باقية ليومنا هذا.
ويبدو أنّ حب المصريين لآل البيت عليهم السلام وتبركهم بهم، دفعهم لبناء تلك الأضرحة التي حملت أسماءهم، وقد أجمع المؤرخون على أنّها تحوي «رفات أصحابها بالفعل، وأضرحة أُخرى يُسمّيها المؤرخون مشاهد الرؤيا، أي: إنّها لا تحوي رفات أصحابها، وإنّما أُقيمت للتبرك بهم فقط»[16]، ويروى أنّ السيدة زينب عليها السلام قد اختارت «مصر لمِا علمت من حب أهلها وواليها لأهل البيت»[17].
وقد دخلتها في «أوائل شعبان سنة 61 من الهجرة، ومعها فاطمة وسكينة وعلي أبناء الحسين، واستقبلها أهل مصر في بلبيس بُكاة معزّين، واحتملها والي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري إلى داره بالحمراء القصوى عند بساتين الزهري حي السيّدة الآن»[18].
وتذكر المصادر أنّ: «السيدة زينب أوّل جوهرة من دوحة النبوّة المباركة ترصّع أرض مصر، بل هي رضي الله عنها ظلّت منذ هذا التأريخ قبساً من أقباس النبوة في مصر»[19].
كما استقبل أهل مصر السيدة نفيسة رضي الله عنها أحسن استقبال، فقد أحبّها الشعب المصري قبل قدومها إليهم[20]. ويبدو أنّ مرونة المصريين في تناول الدين بشكل خاص، قد ساهم في تحديد الملامح الثابتة في الشخصية المصرية[21]، كما ساهم وجود رأس الإمام الحسين عليه السلام في مصر على ربط المصريين بمذهب التشيّع وحبّ آل البيت[22].
ومن بين العادات الشيعية الباقية في مصر ليومنا هذا ذكرى عاشوراء، «وقد كان المصريون يُحيون قديماً ذكرى عاشوراء، حيث كان الموكب يخرج من المسجد ويجوب المدينة رافعاً الأعلام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكان الموكب يتألف من مجموعة خيول يمتطيها الشباب للتذكير بموكب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وبعد أن تجوب الخيول المدينة يتّجه الجميع إلى منازلهم لتناول طبق عاشوراء، وفي المساء يتجمع الناس في بيت كبير في القرية، حيث يستمعون للقرآن الكريم، وتنطلق الأناشيد في حبّ آل البيت»[23]، «وقد استمرت مواكب الشيعة احتفالاً بذكرى عاشوراء حتى فترة قريبة، ويبدو أنّ هذه المواكب من بقايا العهد العثماني الذي أُتيحت في أواخره فرصة لبروز شيعي، وإن كان محدوداً»[24]، «وإنّ وجود مثل هذه العادات والتقاليد حتى اليوم في مصر، ليدل دلالة واضحة على أنّ التشيع استمر وجوده في الواقع المصري»[25].
«وفي شهر رمضان يصبح الضريح والساحة المحيطة به قبلة لسكان القاهرة، ومنهم مَن يتنسم فيه رائحة سليل النبوّة، ومنهم مَن يذهب إلى الإمام الشهيد دون أن يشغل باله بموقع الدفن الحقيقي، فالإمام روح أعلى من أيّ جسد»[26]، «وكما يحمل المصريون الحبّ والتقدير للإمام الحسين عليه السلام، فإنّهم يحملون حبّاً بالقدر نفسه لشقيقته السيدة زينب عليها السلام، التي عانت بعد استشهاده من التضييق بعد أن تخلّى الجميع عمّن بقيَ من آل البيت عليهم السلام وسبوهم، فلم تجد السيدة زينب عليها السلام من كلّ بلاد الله أرضاً تستضيفها وتحميها من بطش يزيد وزبانيته غير أرض مصر، فقرّرت الهجرة إليها»[27].
ولآل البيت في مصر ـ فضلاً عن ذلك ـ مشاهد يأتي إليها الزائرون من أنحاء مصر في مختلف المناسبات الدينية وغيرها، وفي مقدّمتها مشهد رأس الحسين عليه السلام، ويأتي بعده مشهد السيدة زينب عليها السلام، وكلا المشهدين في القاهرة، ومشهد أيضاً باسم الإمام زين العابدين، وهو في الحقيقة مشهد رأس ولده الشهيد زيد صاحب الثورة على هشام بن عبد الملك الأُموي[28]، لقد ترسّخ حب آل البيت عليهم السلام في ضمائر المصريين الذين «مازالوا يحبونهم ويوالونهم، وهي حقيقة لا مراء فيها»[29].
«وقد تجسّدت في الهوية المصرية عبر الأجيال المتوارثة، وقد تجلّى ذلك الحب لآل البيت أن تسموا بمسميات أهل البيت علي والحسن والحسين»[30]. فضلاً عن تسمية بناتهم بنفيسة وأُمّ كلثوم وزينب… من مسمّيات سيدات آل البيت عليهم السلام. كلّ ذلك يؤكّد عمق محبة المصريين لآل البيت، وهذا كلّه قد ألقى بظلاله على نتاج أدب المصريين، لا سيّما الرواية المصرية، وفي مقدّمتها روايات نجيب محفوظ.
المحور الأوّل: الإمام الحسين عليه السلام في ذاكرة نجيب محفوظ
لقد تغلغل الإمام الحسين عليه السلام في الوجدان المصري بكلّ أطيافه، ولا سيّما الكتّاب والروائيين منهم، الذين عبّروا عن «فلسفة وتبحر في مجريات التاريخ، قام به كبار المفكرين مثل عباس محمود العقاد، حين كتب أبو الشهداء، وكان منطلقاً لآخرين»[31]، ومن المعروف أنّ الثقافة العربية كانت منقسمة بين «مدرستين: مدرسة طه حسين، ومدرسة العقاد، فهو صاحب فلسفة في التاريخ، فتناول هذا الجانب الإنساني من ثورة الإمام الحسين، يقول: هذه الإنسانية لا تزال في عطش جديد لدماء الشهداء»[32].
وممّا يُذكر في تأريخ مصر أنّ «القرويين من أرياف مصر لا ينظرون إلى القاهرة، إلّا باعتبارها المكان الذي يوجد فيه مسجد الحسين، ومسجد السيدة زينب عليهما السلام، وقد أشارت رواية الأيام لطه حسين إلى ذلك، حيث حكى عن نظرتهم حول القاهرة أنّها تعني: الحسين، السيدة، الأزهر»[33].
ولم تختلف نظرة نجيب محفوظ عن نظرة مَن سبقه في حبّه للإمام الحسين عليه السلام؛ إذ قال: «لقد ولدتُ في حي الجمالية بجوار الحسين، ثمّ انتقلتُ إلى العباسية، وأنا أحمل لهذه الأحياء ذكريات غالية دافئة ما زلت أحنُّ إليها، وأنا في شيخوختي»[34].
ومن المعلوم أنّ نجيب محفوظ قد أمضى طفولته «وسط الشوارع الفقيرة المؤدية إلى جامع الأزهر، الذي يناهز عمره الألف عام، والتي تؤدي أيضاً إلى مسجد الحسين حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والموجود بداخله ضريح بديع، يحتوي على رأس الإمام الحسين، كما تقود هذه الشوارع الصغيرة أيضاً إلى العديد من الجوامع القديمة الأُخرى التي يتجاوز عمرها مئات الأعوام»[35].
لقد جعل نجيب محفوظ في أوّل حياته الإمام «الحسين مثالاً مع صدمة الحب الهائلة، التي اتضح له في نهايتها أنّه ضحية اعتداء منكر، تآمر به عليه القدر وقانون الوراثة»[36]، وقد كانت أُسرة نجيب محفوظ تملك «بيتاً جديداً في حي العباسية، رغم هذا الانتقال كانت الأُسرة دائمة التردد على حي الحسين، وكان نجيب محفوظ يختلف إلى حي الحسين عادةً، ولم يكن متواجداً لعشق هذا الحي، فقد ورث ذلك عن أُمّه؛ لأنّها كانت كلّ صباح تركب العربة ـ التي تجرّها الخيول وتُسمّى السوارس ـ من العباسية، وتذهب لزيارة الحسين، وزيارة أقاربها وجيرانها القدامى، ثمّ تعود ولم تنقطع عن تلك اليومية طول حياتها»[37].
وممّا يرويه نجيب محفوظ في مذكراته عن والدته وعلاقتها بالإمام الحسين عليه السلام بالقول: «لقد ظلّت أُمّي حتى حدود التسعين من عمرها تزور الحسين»[38]، وقد ظلّ نجيب محفوظ «ملازماً لوالدته باستمرار في زيارتها إلى الحسين»[39].
ويُضيف نجيب محفوظ: «كانت والدتي تُحيطني برعاية كبيرة، وتصحبني معها في كلّ مكان تذهب إليه، سواء في زياراتها للحسين، والمتحف، والأديرة»[40].
إلّا أنّها كانت «تعشق سيدنا الحسين وتزوره باستمرار، وفي الفترة التي عشناها في الجمالية كانت تصحبني معها في زياراتها اليومية، ففي كلّ المرات التي رافقتها فيها إلى سيدنا الحسين، كانت تطلب منّي قراءة الفاتحة عندما ندخل، وأن أُقبّل الضريح، وكانت هذه الأشياء تبعث في نفسي معاني الرهبة والخشوع»[41]، ولم يقتصر ذلك عليه وعلى والدته، بل كان والده عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا أيضاً «يتردد يومياً على حي الحسين بحكم عمله؛ حيث إنّه بعد إحالته للمعاش التحق بعمل في محل تجاري يملكه أحد أصدقائه، فيأتي كلّ يوم في حي الحسين كأنّه لم يغادره»[42].
وقد شكّل حي الحسين بالذات مبتغىً للناس، سواء في مصر أو من خارجها[43].
لقد ظلّ نجيب محفوظ إلى جوار سيدنا الحسين عليه السلام «عهد العشرينات من هذا القرن الذي يرث حصيلات العصر المملوكي»[44]، وبقي مسجد الحسين عليه السلام «في القاهرة الفاطمية أكثر المناطق المحببة إلى قلب الأديب»[45].
وهكذا نشأ نجيب في أُسرة «مكتفية متدينة، وهذا ممّا جعل الطفل نجيب ينعم في جو الدين وبيته غير بعيد عن مقام سيدنا الحسين والتكية، وكل يوم تعرض له الحارة دراويش، ومشايخ، وبعض ما أفرزه الأزهر»[46].
وهذا «ما تلخص في معظم ما كتب من أصداء حي الحسين، وقد كان جار مقامه، وهذا تراه على الأخص في أولاد حارتنا ممثلاً بالجيلاوي، كما نلمحه لدى حديثه عن التكايا والأزقة المظلمة المهجورة، والأفراد الغرباء الغامضين، من دراويش وغجرة وسحرة، وعابرين»[47].
وعندما نتأمل نتاج محفوظ في المرحلة الأُولى سنلحظ الطابع التأريخي في بواكير إنتاجه، ثمّ تلاه الطابع الاجتماعي منذ رواية القاهرة الجديدة، وفيه يعنى بتصوير أحوال أفراد الطبقة المتوسطة، ويتخذ بيئاته من القاهرة القديمة، والحسين، والجمالية، والعباسية[48].
وقد كان نجيب محفوظ في معظم رواياته عندما يصف المظلوم يقول له: مظلوم ظلم الحسن والحسين[49]، وهكذا قد تغلغل الإمام الحسين عليه السلام في أعماق نجيب محفوظ، وظلّ ضريح الإمام الحسين عليه السلام «بتركيبه الوقور المنعزل، وشاهديه الشامخين، وسرّه المنطوي، حباً دائماً، وعشقاً أبدياً في قلب نجيب محفوظ»[50].
فطالما ردد نجيب: «من أشوف ضريح سيدي ومولاي الإمام الحسين أرتاح كثيراً، أُمنيتي زيارة الإمام الحسين»[51]، وقد ظلّت هذه الأُمنية هاجساً يتمناه طوال حياته بزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام في العراق، الذي لم تُتح له هذه الفرصة حتى وافته المنية، وشُيع جثمانه من «مسجد الإمام الحسين بالقاهرة حسب وصيته وسط الآلاف من محبيه البسطاء الذين استلهم منهم شخصياته»[52] في معظم رواياته.
وقد صُلِّي عليه في مسجد الإمام الحسين عليه السلام «والذي طالما أدّى الصلوات فيه، واستلهم منه ومن الأحياء المجاورة له المليئة بعبق التاريخ، وتراث مصر وحضارتها عبر العصور»[53]، وقد سكب هذا الروائي العربي المصري العظيم ذلك الحب في رواياته ومنها بين القصرين.
الإمام الحسين عليه السلام في رواية بين القصرين
شارع المعزّ أو بين القصرين «شارع عمره ألف عام، يقف كشاهد حي على تحوّلات الزمن، منذ فترة حكم الدولة الفاطمية لمصر، مروراً بالمماليك والعثمانيين، والتأريخ الحديث، وما زال قلب القاهرة النابض بالحياة، وأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، إنّه شارع المعزّ لدين الله الفاطمي، الذي كان يُسمّى قديماً بين القصرين»[54]، وقد كان شارع بين القصرين قديماً «تمرّ به مواكب السلطان، وكذلك موكب المحمل، وكسوة الكعبة، وتُقام فيه احتفالات شهر رمضان، ودخول السنة الهجرية»[55].
ويبدو أنّ نجيب محفوظ قد سمح في بعض أعماله الروائية «بجرعة أكبر من سيرته الذاتية بدءاً بـالثلاثية[56]، وقد لجأ نجيب محفوظ في هذه الرواية إلى اتباع الأسلوب الواقعي في وصف بعض مظاهر الحياة في حي الحسين عموماً، وفي بين القصرين خصوصاً»[57].
وبين القصرين هو «الجزء الأوّل من ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة، والتي تشكّل القاهرة ومنطقة الحسين خصيصاً المسرح الأساسي والوحيد لأحداثها، تحكي الرواية قصة أُسرة من الطبقة الوسطى، تعيش في حي شعبي من أحياء القاهرة، أي: فترة ما قبل وأثناء ثورة 1919م»[58].
وقد صور نجيب محفوظ في هذه الرواية حياة أُسرة برجوازية من الطبقة الوسطى، ويقول نجيب: «كمال يعكس أزمتي الفكرية، وكانت أزمة جيل فيما أعتقد، والأزمة التي يقصدها هي مأساة الحرية في المجتمع آنذاك»[59]، ورواية بين القصرين «تحمل في ثناياها قصص عن أُسرة، لكلّ فرد فيها قصة تجعل منه رواية في حدّ ذاته، وفي بين القصرين يقع منزل السيد أحمد عبد الجواد المكوّن من حرمه أمينة، وابنه الأكبر ياسين، وخديجة، وفهمي، وعائشة، وآخر العنقود كمال»[60].
ويمثّل «السيد أحمد عبد الجواد السلطة المطلقة في البيت، فلا رأي فوق رأيه، ولا قول يضاهي قوّته، يطيعه أولاده طاعة عمياء، حتى أنّهم يفضّلون الموت ألف مرّة عند مواجهة أبيهم»[61]، «ويبدو أنّ شخصية أحمد عبد الجواد مأخوذة من قصة حياة جدّ نجيب محفوظ، فوالده كان يعمل بالدائرة التي بها جدّه لوالدته، واسمه محمد عمرو، وكان تاجراً غير متعلّم ومسرفاً، وكثير الزواج، وكانت آخر زيجة له من (عالمة) اسمها زبيدة»[62].
والجدير بالذكر أنّ في القاهرة تجمعات شيعية تقل وتكثر حسب أحوال الزمان في حي الحسين، وكان أغلبها من الشيعة الوافدين إلى مصر بهدف الاستقرار فيها، «والذين كانوا يقدمون من الشام وبلاد فارس والعراق وغيرها… بمعنى عائلة السيد من تلك العائلات، ولا تزال لهذه العائلات بقايا في مصر حتى اليوم»[63].
واسم السيّد هو في الحقيقة «صفة تشريفية خاصّة بالأشراف المنتسبين لآل البيت، فهي لا تُطلق إلّا على الأشراف فقط»[64]، وهكذا يبدو أنّ شارع بين القصرين قد جمع بين العديد من «عوامل الجذب، أوّلها: ديني، يتجلّى في محبي الإمام الحسين والسيدة زينب وكلّ ما يتصل بهما، إذ يروى أنّ المسجد يضمّ رأس الحسين عليه السلام، وثانيهما: تاريخي، ويتجلّى في القبة المعمارية والأثرية للمسجد ومرافقه الأساسية، الحرم والمُصلّى والقبّة والمنارة»[65]، وقد كان المسجد عبارة عن ضريح «متوسط المساحة، بناه الصالح طلائع من الحجر المنحوت، واتخذ له 3 أبواب ومئذنتين وقبة واحدة في أعلى الضريح الذي يقال: إنّه ضمّ رأس الإمام الحسين عليه السلام»[66].
وقد أُعيد تجديد الضريح دون تغيير عمارته في «عهد الصالح نجم الدين أيوب بعد احتراقه؛ بسبب الشموع التي يوقدها داخله الزائرون، وكانت آخر عملية توسعة قامت بها الحكومة المصرية عام 1935م؛ لتصبح مساحة المسجد الكلية 3340م»[67]، ولعلّ هذا الاهتمام يعكس مدى قدسية المكان، ومدى أهميته في نفوس المصريين عامّة، والحكام بخاصّة.
المحور الثاني: الإمام الحسين عليه السلام في رحاب الأُسرة المصرية في رواية بين القصرين
1 ـ الأُمّ أمينة والإمام الحسين عليه السلام
كانت شخصية أمينة ضمن نسيج الرواية شخصية محورية، فقد كانت «شديدة الاعتزاز بثقافتها الشعبية المتوارثة عن أجيال متعاقبة منذ القِدم، ولم تكن تظنُّ أنّها بحاجة إلى مزيد من العلم يُضاف إلى ما لديها من معارف دينية وتاريخية وطبيّة، وممّا ضاعف من إيمانها بعلمها أنّها تلقته عن أبيها الذي كان شيخاً من العلماء»[68]، «وقد ظلّت أمينة طوال عشـرين سنة قضتها في هذا الشارع شديدة الشوق إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا الحبيب المقدّس الذي كان على مقربة من بيتها»[69]، لأنّ زوجها ذلك «الكائن الرهيب كان يحول بينها وبين أُمنيتها في الخروج من البيت»[70].
وقد استمر حب الحسين عليه السلام في صدرها والشوق إليه في ساعات النظر إلى مئذنته التي أحبّتها حبّاً لصاحبها، فكانت تتنهّد وبألم؛ لشعورها بالحرمان من زيارة هذا الصـرح العربي الإسلامي، الذي يربض على مقربة من بيتها، وظلّ هذا الصـرح ـ أي: ضريح الإمام الحسين عليه السلام ـ أكثر تأثيراً في نفس أمينة من أيّة أمكنة دينية أُخرى، فكم كانت «تروعها المآذن التي تنطلق انطلاقاً ذا إيحاء عميق، تارةً عن قرب، حتى لترى مصابيحها وهلالها في وضوح، كمآذن قلاوون وبرقوق، وترف عن بُعد غير بعيد، فتبدو لها جميلة بلا تفضيل، كمآذن الحسين والأزهر، وثالثة من أُفق سحيق، فتراءى أطيافاً كمآذن القلعة والرفاعي، وتقلّب وجهاً فيها بولاء وافتتان، وحب وإيمان، وشكر ورجاء»[71].
لكنّ روح أمينة كانت ترفرف «فوق ذراها أقرب ما تكون إلى السماء، ثمّ تستقر العينان على مئذنة الحسين عليه السلام[72]، أحبّتها ـ لحبّ صاحبها ـ إلى نفسها، فتنفض نظراتها حناناً وأشواقاً، مشوبة بحزن يطوف بها كلّما ذكرت حرمانها من زيارة ابن بنت رسول الله، وهي على مسير دقائق من مثواه، وتنهّدت نهدةً مسموعةً، استردّتها من استغراقها، فثابت إلى نفسها، وراحت تتسلّى بالنظر إلى الأسطح والطرقات، فلم تزايلها الأشواق»[73].
«ويبدو أنّ المعالم الدينية كانت ذات تأثير محدود في نفس أمينة، لا يرتفع إلى مستوى ضريح الإمام الحسين الذي تربع على عرش قلب أمينة»[74].
ومن الواضح في رواية بين القصرين أنّ ربّ الأُسرة السيد أحمد عبد الجواد وما كان يتصف به من «غلظة وتشدد وراء عدم تحقق تلك الأُمنية»[75]، في زيارة أمينة لسيدها الإمام الحسين وهو على قرب منها.
إنّ الأقدار قد شاءت ذات يوم أن يسافر ربّ الأُسرة السيد أحمد عبد الجواد بطل الرواية إلى بور سعيد، فانطلقت في ذهنها فكرة زيارة ضريح الإمام الحسين عليه السلام، وكان لابنها الأكبر ياسين دور في ترسيخ هذه الفكرة، حتى أنّها من فرط خوفها الممزوج بفرحها تمتمت وتنهدت قائلة لابنها ياسين: «سامحك الله.. فقهقه ولدها الشاب، وهو أكبر أبنائها مردفاً القهقهة بالقول: والله، لو كنت مكانك لمضيت من توّي إلى سيدنا الحسين، أَلا تسمعين حبيبك الذي تهيمين به على البعد وهو قريب، قومي إنّه يدعوك إليه»[76].
لقد كانت لحظة اقتناع أمينة بفكرة الزيارة مدهشة، وكأنّها «زلزال قد وقع بأرض لم تعرف الزلازل، فلم تدرِ كيف استجاب قلبها للنداء، ولا كيف تطلّع بصرها إلى ما وراء الحدود المحرّمة، ولا كيف تراءت المغامرة ممكنة، بل مغرية، بل طاغية، أجل بدت زيارة الحسين عذراً قوياً ـ له صفة القداسة ـ للطفرة اليسارية التي نزعت إليها إرادتها، ولكنّها لم تكن وحدها التي تمخّضت عنها نفسها، إذ لبّت دعاءها في الأعماق تيارات حسينية متلهفة على الانطلاق، كما تلبي الغرائز المتعطشة لقتال نداء الدعاء إلى الحرب، بحجّة الدفاع عن الحرية والسلام»[77]، لقد صاحب لحظة اقتناع أمينة بفكرة الزيارة «خفقان لاحت آثاره في احمرار وجهها، فخفضت رأسها؛ لتُخفي تأثرها الشديد، انجذب قلبها إلى الدعاء بقوة تفجرت في نفسها فجأة على غير انتظار، لا منها ولا من أحد ممّن حولها حتى ياسين نفسه»[78].
ولم تدرِ أمينة كيف تعلن استسلامها الخطير، ولكنّها نظرت إلى ياسين وسألته بصوت متهدج: «زيارة الحسين منية قلبي وحياتي.. ولكن أبوك؟ فضحك ياسين قائلاً: أبي في طريقه إلى بور سعيد، ولن يعود قبل ضحى الغد»[79].
لقد انتصر خيار أمينة هذه المرّة بالخروج من المنزل والذهاب إلى سيدها الحسين عليه السلام برفقة ابنها الأصغر كمال، فحثّت بهما الخطى بشوق اللقاء إلى دخول الجامع الذي «يقيد الأبصار حسناً وجمالاً، فيه من أنواع الرخام المجزّع الغريب الصنعة، البديع الترصيع، مما لا يتخيّله المتخيّلون، والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثلها في التأنق والغرابة، وحيطانه كلّها رخام على الصفة المذكورة»[80].
وقد كان مسجد الحسين عليه السلام في الأصل قصر الزمرد، وهو من أهم «قصور دولة الفاطميين، وفي مكان الزمرد ـ كان أشرف مكان بالقصر تقام به الصلاة ـ حتى بالرأس الشريف ليدفن هناك»[81]، ويُعدّ مسجد «الحسين بالقاهرة، وهو مسجد تأريخي تجددت عمارته في مختلف العصور، وهو يضمّ الضريح الذي يقال: إنّ رأس الحسين حُمل إليه من عسقلان سنة ثمانٍ وأربعين وخمسمائة هجرية ـ 1153م ـ ودفن به»[82].
وقد وُضع رأس الإمام الحسين عليه السلام في «تابوت من فضة مدفون تحت الأرض، قد بني عليه شباك جميل، يقصر الوصف عنه، ولا تحيط الإدراك به، مجللاً بأنواع الديباج، محفوفاً بأمثال العمد الكبار شمعاً أبيض، ومنه ما هو دون ذلك، وقد وضع أكثره في أنوار فضة خالصة ومذهبة»[83].
ولم يختلف وصف الكاتب نجيب محفوظ في روايته بين القصرين لجامع الإمام الحسين عليه السلام عن ذلك الوصف، حيث وصف الجامع من الخارج والداخل، لا سيّما حيث همّت أمينة وابنها كمال الخطى إلى جامع الحسين عليه السلام؛ إذ يصف نجيب محفوظ ذلك بالقول: «فلاحَ لهما عن بُعدٍ جانب من المنظر الخارجي لجامع الحسين، يتوسّطه شباك عظيم الرقعة، محلّى بالزخارف العربية، وتعلوه فوق سور السطح شرفات متراصة كأسنة الرماح، فتساءلت والبشر يسجع في صدرها: سيدنا الحسين؟ ولما أجابها بالإيجاب مضت تقارن بين المنظر الذي تقترب منه ـ وقد حثّت خطاها لأوّل مرّة مذُ غادرت البيت ـ
وبين الصورة التي خلقها خيالها له، مستعينة في خلقه بنماذج من الجوامع التي في متناول بصرها، كجامع قلاوون وبرقوق، فوجدت الحقيقة دون الخيال؛ لأنّها كانت تنفخ في الصورة طولاً وعرضاً على قدر يناسب منزلة صاحب الجامع من نفسها»[84].
ويُضيف نجيب محفوظ واصفاً فرحة أمينة حين دخلت جامع الحسين عليه السلام: «بَيْدَ أنّ هذا الاختلاف بين الحقيقة والخيال، لم يكن ليُؤثر شيئاً في فرحة اللقاء التي تمثّلت بها جوانحها، ودارا حول الجامع حتى الباب الأخضر[85]، ودخلا في زحمة الداخلات، ولما وطأت قدما المرأة أرض المسجد شعرت بأنّ بدنها يذوب رقة وعطفاً وحناناً، وأنّها تستحيل روحاً طائراً، يرفرف بجناحيه في سماء يسطع بجنباتها عرف النبوّة والوحي، فاغرورقت عيناها بالدمع الذي أسعفها للترويح عن جيشان صدرها، وحرارة حبّها وإيمانها، وأريحية امتنانها وفرحها»[86]، ويبدو أنّ أمينة قد ذُهلت من فرحة اللقاء، ولم يقف أمامها إلّا «أن تلتهم المكان بأعين شيّقة، متطلّعة جدرانه وسقفه وعمده، وأبسطته ونجفه، ومنبره ومحاريبه»[87].
وقد تزامنت زيارة أمينة وابنها كمال جامع الحسين عليه السلام مع تدفق «تيّار الزائرات الزاحف في بطء، يدفعهما رويداً، حتى وجدا نفسيهما في مثوى الضريح، طالما تلهّفت أشواقها على زيارة هذا المثوى، كما تتلهّف على حلم يستحيل تحقيقه في هذه الدنيا، ها هي تقف بين أركانه، بل ها هي لصق جدران الضريح نفسه، تشرف نفسها عليه خلال الدموع، وتودّ لو تتريّث لتتملّى مذاق السعادة، لولا شدّة ضغط الزحام، ومدّت يدها إلى الجدران الخشبية، واقتدى كمال بها، ثمّ قرءا الفاتحة، ومسحت بالجدران وقبّلتها، ولسانها لايني عن الدعاء والتوسل»[88].
لقد كانت أمينة تودّ وتتمنّى «لو تقف طويلاً، أو تجلس في ركن من الأركان؛ لتُعيد النظر والتأمل، ثمّ لتُعيد الطواف، ولكنّ خادم المسجد وقف للجميع بالمرصاد، لا يسمح للواحدة بالتلكّؤ، ويحثّ المتباطئات، ويلوّح منذراً بعصاه الطويلة، وهو يدعو الجميع إلى إتمام الزيارة قبل حلول ميعاد صلاة الجمعة»[89].
لقد ارتوت أمينة من المنهل العذب، «ولكنّها لم تطفئ ظمأها، وهيهات أن يُروى لها ظمأ، لقد هاج الطواف حنينها، فتفجرت عيونه، وسال وزخر، ولن يزال ينشد المزيد من القرب والابتهاج»[90].
«ولمّا وجدت نفسها مرغمة على مغادرة المسجد انتزعت نفسها منه انتزاعاً، وأودعته قلبها، وهي تولّيه ظهرها، ثمّ مضت حسرى يعذّبها شعورها بأنها تودعه الوداع الأخير»[91]. لكنّ الأُمور سارت عكس ما ابتغت أمينة، التي انطفأت نار أشواقها بزيارة ضريح الإمام الحسين عليه السلام؛ إذ شاء القدر أن تسقط في الشارع، وهي تسير في طريقها من جامع الحسين إلى بيتها، وأن تُكسر ساقها، وهي برفقة ولدها كمال الذي ما برحت يده الصغيرة تفارق يدها المرتجفة؛ خوفاً من عقاب زوجها إن علم بخروجها من البيت دون علمه.
لقد حاول أفراد الأُسرة، ولا سيّما ابنتها خديجة والخادمة أُمّ حنفي، التخفيف عمّا أصاب أمينة، مبرّرين خروجها لزيارة الإمام الحسين عليه السلام دون علم والدهم الصارم بالأمر الهيّن؛ لقدسية المكان الذي قصدته أُمّهم أمينة، حتى «بدا هذا الأثر واضحاً بين الجماعة خارج الحجرة، فتمتمت خديجة: فلتحلّ بها بركة سيّدنا الحسين الذي ما خرجت إلّا لزيارته. وكأنّما تذكر كمال بقولها أمراً هاماً نسيه طويلاً، فقال بدهشه: كيف أمكن أن يقع لها هذا الحادث بعد تبركها بزيارة سيدنا الحسين؟ ولكن أُمّ حنفي قالت ببساطة: وما أدرانا بما كان يحدث لها ـ والعياذ بالله ـ لو لم تتبرك بزيارة سيّدها وسيّدنا»[92].
لقد تزامنت عودة الأب أحمد عبد الجواد وبشكل مفاجئ من سفره مع حادثة خروج أمينة دون علمه وكسر ساقها، ممّا «تضاعف عند ذاك شعورها بفداحة الذنب، وخطورة الاعتراف، فدمعت عيناها، وقالت بصوت لم تعن بإخفاء نبراته الباكية، إمّا لأنّه غلبها على صوتها، أو لأنّها أرادت أن تبذل محاولة يائسة لاستدرار العطف، قائلة: ظننت أن سيّدنا الحسين يدعوني إلى زيارته، فلبيت.. ذهبت للزيارة.. وفي طريق العودة صدمتني سيارة.. قضاء الله يا سيّدي»[93].
«وهتفت خديجة:
ـ أرأيت بركة الحسين؟
وقالت عائشة بخيلاء:
ـ لكل شيء حدود، حتى غضب بابا»[94].
ويبدو أنّ الأُمور سارت عكس التوقعات، فلم يشفع عنده خروج أمينة ولو لغرض زيارة الحسين عليه السلام؛ حيث فـ«الرجل واصل حديثه بهدوئه الرهيب الذي يهون إلى جانبه الزعيق، قائلاً:
ـ كيف اقترفت هذا الخطأ الكبير، ألأنّي ابتعدت عن البلد يوماً واحداً؟
ـ فقالت بصوت متهدج، وشت نبراته بالرجفة التي ملكت جسمها:
أخطأت يا سيدي، وعندك العفو! وكانت نفسي تتوق إلى زيارة سيّدنا الحسين، وحسبت أنّ زيارته المباركة تشفع لي في الخروج، ولو مرّة واحدة»[95].
ويبدو أنّ أمينة كانت امرأة متدينة خاضعة بشكل كلّي للزوج، حالها حال المرأة المصرية آنذاك.
وقد اتخذ أحمد عبد الجواد قراره بطردها إلى بيت أُمّها إلى حين شفاء ساقها، وقد ذهبت أمينة ـ بالفعل ـ إلى بيت أُمّها تملأ جوانحها خيبة أمل من زوجها الذي توقعت أن يسامحها لمجرد سماعه باسم الإمام الحسين عليه السلام، ولكنّه كاد «يطلقها حين علم بفعلتها؛ لأنّها مسّت طاعته المقدّسة»[96].
وقد ملأ الحزن والألم قلب أمينة، وهي تُخبر والدتها بما جرى لها.
«خبريني يا بنيتي!
فقالت أمينة متنهّدة:
زرت سيّدنا الحسين في أثناء سفره إلى بورسعيد، فتفكّرت الأُمّ في حزن وكآبة، ثمّ تساءلت: وكيف علم بأمر الزيارة؟»[97]، وتضيف والدة أمينة متهكّمة ممّا جرى بقولها:«هل من الكفر أن تزور امرأة فاضلة سيّدنا الحسين؟! أَلا يسمح أصدقاؤه، وهم لا يقلّون عنه غيرةً ورجولةً، لزوجاتهم بالخروج لمختلف الأغراض؟ أبوك نفسه الذي كان شيخاً من حملة كتاب الله، كان يأذن لي في الذهاب إلى بيوت الجيران للتفرّج على المحمل»[98].
ولعلّ هذا الأمر كان تعبيراً واضحاً عمّا اختلج في نفس المرأة المصرية ـ أمينة ـ من حبّ صادق للحسين عليه السلام، حتى أنّها دفعت بنفسها إلى تحمّل ما آلت إليه الأُمور من موقف زوجها، وهو الذي تحكمه تقاليد وأعراف مصرية تحول دون خروج المرأة من بيتها، وإن كان لغرض الزيارة، وهذا ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار مع أمينة.
2 ـ الابن الأصغر كمال والإمام الحسين عليه السلام
لقد كان كمال طفلاً «شقياً ذا خيال محلّق، متفوّقاً في دراسته، مهتماً بالدين الذي يمثّل الإمام الحسين ركناً مهماً فيه»[99]. وراح كمال عبد الجواد في الثلاثية عند مواجهة «قناعاته الدينية السابقة، في إيمانه بالأرواح، وأضرحة الأولياء، حين يكتشف في تراجيديا مثيرة أنّ ضريح الإمام الحسين لا يحمل رفاته، وأنّه ضريح رمزي ليس إلّا، وهنا تبدأ رحلة كمال بحثاً عن معرفة جديدة»[100].
لقد كان كمال من محبّي سماع سيرة آل البيت عليهم السلام، «والتزوّد منها بأنبل القصص وأعمق الإيمان، حتى وجدت منه على القرون مستمعاً مشغوفاً، ومحبّاً مؤمناً، وأسيفاً بكّاءً، فلم يُهوّن من بلواه إلّا ما قيل من أنّ رأس الشهيد بعد فصله عن جسده الطاهر، لم يرضَ من الأرض مسكناً إلّا في مصر، فجاءها طاهراً مسبّحاً، ثمّ ثوى حيث يقوم ضريحه»[101].
لقد كانت شخصية كمال وعلاقته بالإمام الحسين عليه السلام واضحة المعالم في هذه الرواية، ونحن لا نستبعد أنّ نجيب محفوظ قد اتخذ من كمال قناعاً، وأسقط عليه ذكريات الطفولة، حين كان يصاحب أُمّه إلى الضريح، فكمال هو نجيب محفوظ دون غيره، ومن تلك المعالم عدم حلف كمال بالإمام الحسين عليه السلام كذباً، فقد: «كان يُدرك خطورة الحلف الكاذب فيما يُثير من سخط الله وأوليائه، ويعزّ عليه جداً أن يحلف كذباً بالحسين خاصّة؛ لولهه به، ولكنّه كثيراً ما وجد نفسه في مأزق حرج ـ كما وجد اليوم ـ لا مخرج منه في نظره إلا بالحلف الكاذب، فينساق وهو لا يدري إلى التورط فيه، بَيْدَ أنّه لم يكن ينجو، خاصة إذا ذكّر بجريرته، من الهم والقلق، ويود لو يقتلع الماضي السيّئ من جذوره، وأن يبدأ صفحة جديدة نظيفة، وذكر الحسين، وموقفه عند أصل مئذنته، حيث تتراءى، وكأنّ هامتها تتصل بالسماء، وسأله في ضراعة أن يعفو عن زلته، وهو يشعر بفضاضة مَن اجترأ على حبيب بإساءة لا تغتفر، وغرق في توسلاته مليّاً، ثمّ أخذ يفيق إلى ما حوله، ويفتح أذنيه إلى ما يدور من حديث، فيه المعاد وفيه الجديد»[102].
ولعل شخصية الحسين عليه السلام في رواية بين القصرين تنساب كالماء الزلال في سواق البستان، ممّا أتاح لكلّ أبطال الرواية أن يأخذوا بما يروي ظمأهم لمعرفة جوهر هذا الشيء، والاقتراب منه من خلال الضريح الذي ينتصب شامخاً في وسط القاهرة، لقد كان جامع الحسين مثار أخيلة وعواطف لا تنضب لشخصيات الرواية، ومنهم كمال الذي كان يقف «حيال الضريح حالماً مفكراً، يود لو ينفذ ببصره إلى الأعماق؛ ليطلع على الوجه الجميل الذي أكّدت له أُمّه أنّه قاوم غير الدهر بسرّه الإلهي، فاحتفظ بنضارته ورونقه، حيث يُضيء ظلمة المثوى بنور غرّته»[103].
وظلّ الإمام الحسين عليه السلام يراود مخيّلة كمال الطفل، حتى أصبحت زيارة الحسين عليه السلام أُمنية من الأماني «ولمّا لم يجد إلى تحقيق أُمنيته سبيلاً، قنع بمناجاته في وقفات طويلة، مفصحاً عن حبّه، شاكياً إليه متاعبه الناشئة من تصوّراته عن العفاريت، وخوفه من تهديد أبيه، مستنجداً به على الامتحانات التي تلاحقه كلّ ثلاثة أشهر، ثمّ خاتماً مناجاته عادة ًبالتوسّل إليه أن يُكرمه بالزيارة في منامه»[104].
ولعلّ اعتياد المرور «بالجامع صباحاً ومساءً خففت بعض الشيء من شدّة تأثره به، إلّا أنّه لم تكن تقع عليه عيناه حتى يقرأ له الفاتحة، ولو تكرّر ذلك منه مرّات في اليوم الواحد، أجل لم تستطع العادة أن تقتلع من صدره بهجة الأحلام، فلم يزل لمنظر الجدران السامقة تجاوبها مع قلبه، ولم يزل لمئذنته العالية نداء ما أسرع أن تلبيه الفاتحة»[105]، ولطالما تمنّى كمال أن يلقى الإمام الحسين عليه السلام وجهاً لوجه، إذ يصف نجيب محفوظ ذلك المشهد الرائع، قائلاً: «وكم تمنّى حالماً لو ينسونه في الجامع بعد أن يغلق أبوابه، فيمكنه أن يلقى الحسين وجهاً لوجه، وأن يمضي في حضرته ليلة كاملة حتى الصباح، وتخيّل ما يخلق به أن يقدّمه له عند اللقاء من آي الحبّ والخضوع، وما يجدر به أن يلقيه عند قدسيه من أمانيه ورغباته، وما يرجوه بعد ذلك عنده من العطف والبركة»[106].
ويُضيف نجيب محفوظ مصوراً المشهد الذي يجمع كمال بالإمام الشهيد قائلاً: «تخيّل نفسه وهو يقترب منه خافض الرأس، فيسأله الشهيد برقة من أنت؟، فيجيبه وهو يقبل يده كمال أحمد عبد الجواد، ويسأله عن عمله، فيقول له: تلميذ ـ ولن ينسى التنويه بتفوّقه ـ بمدرسة خليل آغا، ويسأله عمّا جاء به في هذه الساعة من الليل، فيجيبه بأنّه حبّ آل البيت عامّة والحسين خاصّة، فيبتسم إليه عطفاً، ويدعوه إلى مرافقته في تجواله اللّيلي، وعند ذاك يبوح له بأمانيه جملة قائلاً: اضمن لي أن ألعب كما أشاء داخل البيت وخارجه، وأن تبقى عائشة وخديجة في بيتنا إلى الأبد، وأن تُغيّر طبع أبي، وأن تمدّ في عمر أُمّي إلى ما لا نهاية، وأن آخذ من المصروف قدر كفايتي، وأن ندخل الجنة جميعاً بلا حساب»[107]، وبهذا اتخذ كمال من الإمام الحسين عليه السلام مثلاً وقدوة وشفيعاً له، ومجسّداً عمق الصلة الروحية التي تربطه بملهمه الأبدي الإمام الحسين عليه السلام.
الخاتمة
كثيرة هي البحوث التي أنجزتها أقلامنا، وهي ضمن اختصاصنا الأدبي المعروف، لكن لهذا البحث وقعه الخاص ومذاقه المميّز؛ لمِا فيه من دهشة ممزوجة بالخشوع والتحليق في أجواء روحانية، لم يملك القارئ حتى تترقرق عينه بالدمع فرحاً لهذا السمو وهذا الرقي، رقي نفوس المصريين، ومدى تعلّقهم بشخصية عربية إسلامية تربّعت على قمّة هرم التأريخ منذ أربعة عشر قرناً من الزمن، وستبقى منهلاً عذباً لكلّ الأقلام الإنسانية الرصينة، ملهمة لمواهب وقرائح الشعراء والروائيين والكتّاب، ولكلّ مَن يمتلك ناصية الكلمة واللون.
وعليه فإنّ النتائج المستخلصة من هذه الدراسة قد تبلورت فيما يأتي:
إنّ شخصية الإمام الحسين عليه السلام لم تكن حكراً على الشعر في القصيدة العربية، بل كان للرواية حصة فيها.
إنّ الإمام الحسين عليه السلام لم يكن شخصية خاصّة بشعب أو بلد دون آخر، فهي شخصية عابرة للبلدان والدول والطوائف وحتى الأديان، شخصية إنسانية، ومثل أعلى لكلّ البشر.
إنّ رواية بين القصرين قد جسّدت بفنّية عالية حبّ المصريين للإمام الحسين عليه السلام، ومدّى تعلّقهم به، وقد عبرت عن ذلك الحبّ بلغة روائية ساحرة.
إنّ شخصية أمينة وحبّها للإمام الحسين عليه السلام قد توارثته من عائلتها التي كانت تقطن إلى جوار مسجد الحسين في القاهرة، ممّا يؤكّد أنّ الحبّ يُتوارث كما يُتوارث المال والنسب.
إنّ حبّ الإمام الحسين عليه السلام والتعلّق به متفاوت لدى أفراد العائلة المصرية، إذ كانت أمينة من أقصى اليسار في هذا الحبّ، وكان محمد عبد الجواد من أقصى اليمين، وهذا الصراع أو التضاد قد منح هذا الحبّ حرارة أو لذعة مستطابة، تقرّب المحبين من معاني الحبّ الصوفي، الذي لا يخلو من التضحية من أجل المحبوب.
وفي كلّ محاور الرواية وفصولها يبرز لنا ما يتغلغل في أعماق نجيب محفوظ من حبّ للإمام الحسين عليه السلام، استلهمه وتنامى في داخله من خلال مجاورة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في الجمالية، والنظر إلى قبّته يومياً، وقد جسّد نجيب محفوظ ببراعة الفن الروائي ذلك الحبّ من خلال شخصية كمال، الذي جعله قناعاً عبّر من خلاله عن ذلك الشعور بقداسة الإمام الحسين عليه السلام، ومنزلته وتأثيره في قلوب المصريين.
إنّ هذه الدراسة ربما ستفتح أفقاً جديداً أمام دراسة تخوض غمار البحث عن الإمام الحسين عليه السلام بين ذخائر ونفائس الرواية العربية عامّة والمصرية خاصّة.
فهرست المصادر
1. أهل البيت في مصر، إعداد وتقديم: السيد هادي خسرو شاهر، تي ـ شوني محمد، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، طهران، ط1، 2006م.
2. آل بيت النبيّ في مصر، أحمد أبو كف، دار المعارف، القاهرة.
3. التشيع المصري الفاطمي، د. حسن محمد صالح، دار الحجة، البيضاء.
4. دراسة في أدب نجيب محفوظ تحليل ونقد، د. رجاء عيد، الناشر: منشأة المعارف بالاسكندرية.
5. رواية بين القصرين، نجيب محفوظ، 1973م، دار القلم، بيروت.
6. السيدة نفيسة رضي الله عنها، أ. توفيق أبو علم، القاهرة، 1412هـ ـ 1992م.
7. الشيعة في مصر، جاسم عثمان مرغي، ط1، 1423هـ ـ 2003م، مؤسسة البلاغ، دار سلوني.
8. الشيعة في مصر من الإمام علي إلى الخميني، صالح الورداني، ط1، 1414هـ ـ 1993م، مطبعة ستار برس للطباعة والنشر، القاهرة.
9. العبقريات الإسلامية، فاطمة الزهراء والفاطميون ـ أهل البيت، عباس محمود العقاد، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
10. عيد الغدير في عهد الفاطميين، د. محمد هادي الأميني، ط1، 1417 هـ ـ 1997 م، مؤسسة الآفاق.
11. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ، نبيل راغب، ط2، 1975م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
12. مراقد أهل البيت في القاهرة، السيد محمد زكي إبراهيم، قدّم لها وعلّق عليها: محي الدين حسين يوسف، ط6، 1424هـ ـ 2003م.
13. المصريون والتشيع الممنوع، د. أحمد راسم النميش، دار الحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع.
14. نجيب محفوظ في مجهوله المعلوم، د. علي شلق، دار المسيرة، ط1، 1979م، بيروت.
15. نجيب محفوظ في ضوء نزعاته الأدبية، د. محمد نجم الحق الدوزي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط1، 2011م، أربد ـ الأردن.
16. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته، رجاء النقاش، مركز الأهرام للطباعة والنشر، ط1، 1419هـ ـ 1998م.
17. أهم المجلات
18. الكلية الإسلامية الجامعة، النجف الأشرف تقنيات المكان في رواية بين القصرين رؤية تحليلية، النجف الأشرف، العدد 538ع/2012.
19. مجلة العربي، عدد خاص نجيب محفوظ عروبة القلب الوديع، العدد577ـ ذو القعدة 1437هـ ـ ديسمبر 2006م.
20. مواقع الأنترنت
21. الإمام الحسين عليه السلام في الثقافة المصرية: www.abrar online. net/ar.
22. بعد 60 عاماً على ثلاثية نجيب محفوظ مجلة الشباب: shabab.ahram-org eg.
23. بين القصرين نجيب محفوظ ـ مجلة نور الأدب: www.nooreladab.com.
24. الدولة الفاطمية: www.dorar.net.
25. شيعة مصر: Egyptian shia-added 2new.
26. مسجد الحسيين شهادة حبّ المصريين لآل البيت: www.retagato.com.
27. مصر تبكي محفوظ: www.ana.hura.com.
28. مصر تشيع نجيب محفوظ: www.alittihad-qe-mobile.
29. المصريون بعدسة نجيب محفوظ: m.alwafd.org.
30. مكانة آل البيت عند المصريين. egypthistory.net.
31. نجيب محفوظ هدوء البراكين، د. لنا عبد الرحمن. lanaabd.com www.
32. نجيب محفوظ ورواية بين القصرين.www.m.ahewar-org.s.as.
________________________________________
[1]جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية.
[2] اُنظر: تأسيس الدولة الفاطمية، موقع: www.dovar.net.
[3] الورداني، صالح، الشيعة في مصر من الإمام علي إلى الخميني: ص27.
[4] اُنظر: موسوعة الفرق، الدولة الفاطمية وخيانتها في محو السنّة ونشر التشيع، المبحث الخامس، dorar.net/enc/firq/1843.
[5] اُنظر: مرغي، جاسم عثمان، الشيعة في مصر: ص73.
[6] الأميني، محمد هادي، عيد الغدير في عهد الفاطميين: ص29.
[7] العقاد، عباس محمود، فاطمة الزهراء والفاطميون: ج2، ص346.
[8] اُنظر: الأميني، محمد هادي، عيد الغدير في عهد الفاطميين: ص30.
[9] اُنظر: إبراهيم، محمد زكي، مراقد أهل البيت في القاهرة: ص43.
[10] المصدر السابق: ص48.
[11] صالح، حسن محمد، التشيع المصري الفاطمي: ص9.
[12] اُنظر: الإمام الحسين عليه السلام في الثقافة المصرية، موقع: www.abraronline.net.
[13] اُنظر: المصدر السابق.
[14] اُنظر: شاهر، هادي خسرو، وتي شوني محمد، أهل البيت في مصر: ص63.
[15] المصدر السابق: ص67ـ68.
[16] مكانة أهل البيت عند المصريين، موقع: egypthistory.net/2010.
[17] إبراهيم، محمد زكي، مراقد أهل البيت: ص68.
[18] المصدر السابق.
[19] شاهر، هادي خسرو، وتي ـ شوني محمد، أهل البيت في مصر: ص71.
[20] اُنظر: أبو علم، توفيق، السيدة نفيسة رضي الله عنها: ص80.
[21] اُنظر: الورداني، صالح، الشيعة في مصر من الإمام علي إلى الخميني: ص77.
[22] اُنظر: المصدر السابق: ص112.
[23] مكانة أهل البيت عند المصريين، موقع: egypthistory.net/2010.
[24] الورداني، صالح، الشيعة في مصر من الإمام علي إلى الخميني: ص75.
[25] المصدر السابق.
[26] مكانة آل البيت لدى المصريين، موقع: egypthistory.net.
[27] المصدر السابق.
[28] اُنظر: مرغي، جاسم عثمان، الشيعة في مصر: ص114.
[29] النميش، أحمد راسم، مقدّمة المصريون والتشيع الممنوع: ص8.
[30] الورداني، صالح، الشيعة في مصر من الإمام علي إلى الخميني: ص16.
[31] الإمام الحسين في الثقافة المصرية، موقع: www.abrar online. net/ar .
[32] المصدر السابق.
[33] مرغي، جاسم عثمان، الشيعة في مصر: ص169.
[34] عيد، حسين، نجيب محفوظ رحلة الموت في أدبه: ص292.
[35] نجيب محفوظ الأديب المصري الكبير، موقع: www.m.yalaa.com.
[36] عيد، رجاء، دراسة في أدب نجيب محفوظ: ص63.
[37] الدوزي، محمد نجم الحق، نجيب محفوظ في ضوء نزعاته الأدبية: ص10.
[38] النقاش، رجاء، نجيب محفوظ صفحات من مذكراته: ص15.
[39] المصدر السابق: ص14.
[40] المصدر السابق: ص15.
[41] المصدر السابق: ص13.
[42] الدوزي، محمد نجم الحق، نجيب محفوظ في ضوء نزعاته الأدبية: ص10.
[43] اُنظر: أبو كف، أحمد، آل بيت النبي في مصر: ص118.
[44] شلق، علي، نجيب محفوظ في مجهوله المعلوم: ص54.
[45] مصر تبكي محفوظ، موقع: www.ana.hura.com.
[46] شلق، علي، نجيب محفوظ في مجهوله المعلوم: ص46.
[47] المصدر السابق: ص53.
[48] اُنظر: نوفل، يوسف حسن، القصة والرواية بين جيل طه حسين وجيل نجيب محفوظ: ص131.
[49] اُنظر: شيعة مصر، موقع:egyptian shia –added new.
[50] شلق، علي، نجيب محفوظ في مجهوله المعلوم: ص20.
[51] www.alyayha-ahlalmotada.com.
[52] مصر تشيع نجيب محفوظ، جريدة الاتحاد، موقع: www.alittihad-qe-mobile.
[53] مصر تبكي محفوظ، موقع: www.ana.hura.com.
[54] شارع المعز أو بين القصريين حكاية ألف عام /أنا زهرة، 2014. www.anazahra.com
[55] المصدر السابق.
[56] اُنظر: شارع بين القصرين من محرر القدس إلى حرافيش محفوظ: m.hespress.com.
[57] مجلة العربي، العدد 577، ذو القعدة 1437هـ، 2006: عدد خاص عن نجيب محفوظ.
[58] تقنيات المكان في رواية بين القصرين، رؤية تحليلية، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، النجف الأشرف، العدد 538/2012: ص40.
[59] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين: ar.m.wiktpedia-er.
[60] المنهج الواقعي في رواية بين القصرين نجيب محفوظ: www.al5hahb.com.
[61] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين.
[62] المصدر السابق.
[63] بعد 60 عاماً على ثلاثية نجيب محفوظ مجلة الشباب: shabab.ahram-org –eg.
[64] اُنظر: الورداني، صالح، الشيعة في مصر من الإمام علي إلى الخميني: ص76.
[65] المصدر السابق: ص71.
[66] المصدر السابق.
[67] مرغي، جاسم عثمان، الشيعة في مصر: ص168.
[68] مكانة آل البيت لدى المصريين، موقع: ar.m.wikipedia.org/wiki.
[69] المصدر السابق.
[70] راغب، نبيل، قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ: ص136.
[71] اُنظر: ثلاثية نجيب محفوظ: ص11. ollap.ps/article/tag.
[72] مئذنة الإمام الحسين عليه السلام قد بُنيت على نمط المآذن العثمانية، فهي إسطوانية الشكل، ولها دورتان، وتنتهي بمخروط. اُنظر: مسجد الإمام الحسين القاهرة، موقع: htt://ar.m.wikipedia.or.wiki.
[73] نجيب محفوظ، ورواية بين القصرين، موقع: www.m.ahewar-org.s.as.
[74] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين: ص42.
[75] المصدر السابق.
[76] ثلاثية نجيب محفوظ: ص12. ollap.ps/article/tag
[77] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين: ص175.
[78] المصدر السابق: ص175.
[79] المصدر السابق.
[80] إبراهيم، محمد زكي، مراقد أهل البيت في القاهرة: ص54.
[81] مرغي، جاسم عثمان، الشيعة في مصر: ص47.
[82] إبراهيم، محمد زكي، مراقد أهل البيت في القاهرة: ص54.
[83] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين: ص178.
[84] المصدر السابق.
[85] الباب الأخضر: وقد سُمّيت المنطقة بالباب الأخضر؛ لأنّها في الأصل قصر الزمرد أيام الدولة الفاطمية، وقد دُفن رأس الإمام الحسين عليه السلام فيه؛ ولأنّ الزمرد لونه أخضر، سُمّيت المنطقة بالباب الأخضر. اُنظر: شاهر، هادي خسرو، وتي ـ شوني محمد، أهل البيت في مصر: ص15.
[86] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين: ص178.
[87] المصدر السابق: ص179.
[88] المصدر السابق.
[89] المصدر السابق.
[90] المصدر السابق: ص176ـ177.
[91] المصدر السابق: ص196.
[92] المصدر السابق.
[93] المصدر السابق: ص204.
[94] المصدر السابق.
[95] المصدر السابق.
[96] نجيب محفوظ، هدوء البراكين، موقع: www.danaabd.com.
[97] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين:ص56.
[98] المصدر السابق.
[99] اُنظر: تقنيات المكان في رواية بين القصرين، رؤية تحليلية: 13ـ14.
[100] محفوظ، نجيب، رواية بين القصرين: ص63.
[101] المصدر السابق: ص56.
[102] المصدر السابق: ص65
[103] المصدر السابق: ص56.
[104] المصدر السابق: ص58.
[105] المصدر السابق.
[106] المصدر السابق: ص178ـ179.
[107] المصدر السابق: ص179.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبياء
http://warithanbia.com/?id=1408
لینک کوتاه
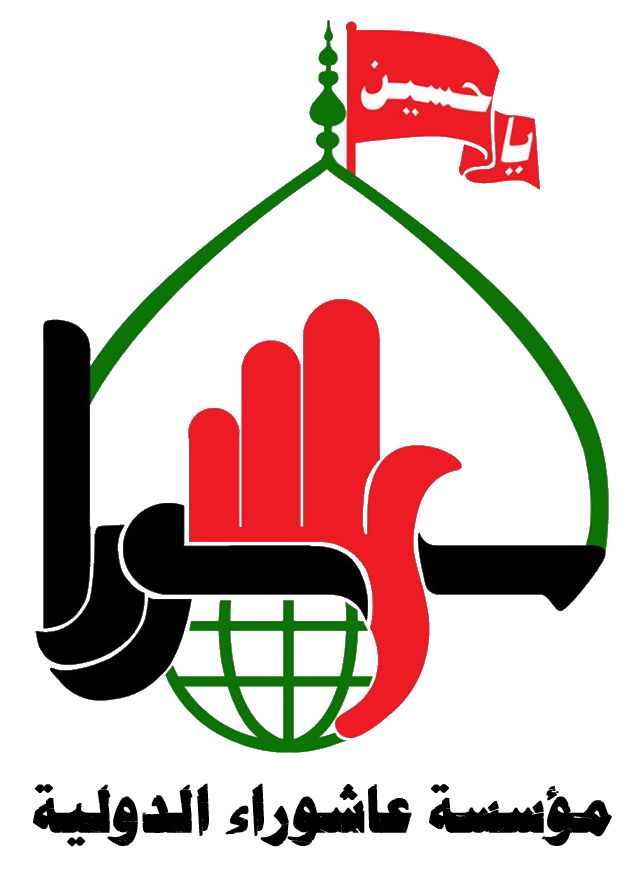
سوالات و نظرات