الأميرة الأسيرة وإنطلاقة العلم من الحجاب
{ م. رنا الخويلدي }
مقدّمة*
إنّ السيّدة زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب(عليهما السلام)، قدوة في الرسوخ، وقمّة في الشموخ، وقلمي أضعف من أن يتسلّق جميع مناقبها، وأقصر من أن يصل إلى كنهها، وهذا ليس مجرّد نسق كلام، بل أنّى لي أن أبلغ معناها والله يُعطيها بغير حساب، حيث يقول(عز وجل): (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) [1]، ويصلّي عليها من غير ذكر عدد، فيقول تعالى: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)[2]، كما أنّها قدوة في الصبر والاسترجاع اللذَين ذُكرا في الآيتين؛ ولذلك تعمّدت أن أحصر بحثي في جانبين من مناقبها، وهما: حجابها وعلمها، وعمدت إلى أن يكون الطرح طرحاً تحليلياً واستنتاجياً لبعض مواقف السيّدة زينب(عليها السلام) وكلماتها، لا طرحاً تاريخياً يسرد الأحداث فقط.
وقد ضمّناه ثلاثة مباحث، وفي كلّ مبحث ثلاثة مطالب، تحدّثنا في المبحث الأول عن شيء من حياتها، وفي المبحث الثاني عن حجابها، وفي المبحث الثالث عن علمها، سائلين الله(عز وجل) أن يضيف هذا البحث شيئاً جديداً لتراث آل محمد(صلى الله عليه واله).
المبحث الأوّل: لمحات من سيرة السيّدة زينب(عليها السلام)
المطلب الأول: ولادتها واسمها
هي: (زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية، سبطة رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم، أُمّها فاطمة الزهراء)[3]، وقد (أدركت النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم، ووُلِدت في حياته… وكانت زينب امرأة عاقلة لبيبة جَزلَة… وكانت مع أخيها الحُسَين ـ (رضي الله عنه) ـ لما قُتل، وحُمِلت إلى دمشق، وحضرت عند يزيد بن معاوية، وكلامها ليزيد ـ حين طلب الشامي أُختها فاطمة بنت علي من يزيد ـ مشهور مذكور في التواريخ، وهو يدلّ على عقل وقوّة جَنان)[4].
واختُلف في تاريخ ولادتها، فـ(قيل: في غرّة شعبان في السنة السادسة)[5]، وقيل: كانت ولادتها في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، في الخامس من جمادى الأُولى[6]، لكنّ الأرجح هو أنّ ولادتها في الخامس من جمادى الأُولى، في السنة الخامسة للهجرة، في المدينة المنوّرة[7].
و(لما وُلِدت السيّدة زينب، مضى عليها عدّة أيام ولم يُعيّن لها اسم، فسألت السيّدة فاطمة من الإمام أمير المؤمنين(عليهما السلام) عن سبب التأخير في التسمية؟ فأجاب الإمام: إنّه ينتظر أن يختار النبي الكريم لها اسماً. فأقبلت السيّدة فاطمة ببنتها إلى النبي(صلى الله عليه واله) وأخبرته بذلك، فهبط الأمين جبرئيل وقال: يا رسول الله، إنّ ربّك يُقرؤك السلام، ويقول: يا حبيبي، اجعل اسمها زينب. ثمّ بكى جبرئيل، فسأله النبيّ عن سبب بكائه؟ فقال: إنّ حياة هذه البنت سوف تكون مقرونة بالمصائب والمتاعب، من بداية عمرها إلى وفاتها)[8].
إنّ تأخّر تسمية السيّدة زينب(عليها السلام) كاشف عن مدى احترام الإمام علي والسيّدة فاطمة الزهراء(عليهما السلام) لمقام النبي(صلى الله عليه واله)، فلم يسبقاه في تسميتها، في حين أنّ والدة مريم العذراء ـ مع ما لها من القدر والإيمان ـ لم تنتظر نبي الله زكريا(عليه السلام) في تسمية ابنتها مريم، قال تعالى ـ حكاية عن قولها ـ: (وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ)[9]، ولا يُمكن أن نتوقّع بأنّ نبي الله عمران هو الذي أوصى زوجته بذلك؛ لأنّها ـ إلى حين ولادتها ـ كانت تظنّ أنّها ستنجب ذكراً. إذاً؛ هناك فارق كبير بينها وبين السيّدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) في احترام مقام النبوّة.
ومن معاني اسم زينب في اللغة: (شجر حسن المنظر، طيّب الرائحة، وبه سُمّيت المرأة زينب بهذه الشجرة)[10]. (وفي كتاب لاروس: الزَينب: نبات عشبي بصلي معمّر، من فصيلة النرجسيات، أزهارهجميلة بيضاء اللون فوّاحة العَرف)[11]. (أو أصلها: (زين أب) حُذفت الألف لكثرة الاستعمال، وزنبة وزينب كلتاهما امرأة)[12].
ونعتقد أنّ السيّدة زينب سُمّيت بهذا الاسم لسببين، هما:
أولاً: لكونها أشبه بالشجرة الحسنة المنظر، الطيّبة الرائحة، المعمّرة؛ لما كان في حياتها ومماتها من الذكر الحسن والسمعة الطيّبة، ولما امتازت به من الخدر والصبر والجزالة والعلم والفصاحة، حتّى أنّ نسلها نُسب إليها، فيقال لذريتها: (زينبيون)، وهم يرون في هذا النسب شرفاً لهم لما لها من الشرف.
ثانياً: (باعتقادنا قد تكون سُمّيت بهذا الاسم لأنّ أباها زين أب، لم يُسبق في سابقة في رحم، أو بسابقة في دين، تشهد له آية التطهير)[13]، وآية المباهلة[14]، وآية الولاية[15]، وغير ذلك من الآيات والسور التي فيها خصوصية للإمام دون الصحابة.
وبكلا المعنيين، فإنّ اسم السيّدة زينب دالٌ على شيء جيد ومنتج، فهو مع السيّدة زينب(عليه السلام) اسمٌ على مسمّى.
المطلب الثاني: كُناها وألقابها
إنّ كنية السيّدة زينب، هي: أُمّ الحسن وأُم كلثوم، ولُقّبت بأُمّ الحسن؛ لأنّها ورثت عن أُمّها ـ فاطمة الزهراء(عليها السلام) أُمّ الحسن ـ صفاتها، من خُلقٍ وعلم وعمل، وأمّا لقب أُمّ كلثوم، فقد ذكر السيّد علي عاشور حديثاً عن النبي(صلى الله عليه واله)، أنّهُ قال: (أوصي الشاهد والغائب من أُمتي، وأخبروهم أن يكرموا هذه الصبية؛ لأنّها تشبه خالتها أُمّ كلثوم)[16]، وبرأيي أنّه لا بدّ لهذا الحديث من تكملة، إلّا أنّها لم تُذكر؛ لأنّه منذ متى كان الإكرام على الشبه فقط؟! وقد قال الله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)[17]، فلم يأمر النبي(صلى الله عليه واله) بإكرام هذه الصبية إلّا لأنّها ذات تقوى وسموّ نفسي، ثمّ ليس هناك ما يؤكّد أنّ النبي(صلى الله عليه واله) يقصد بهذا الحديث السيّدة زينب الكبرى، فلربّما يقصد أُختها الصغرى التي تُلقّب أيضاً بـأُمّ كلثوم، كما أنّها أيضاً وُلدَت في حياة النبي(صلى الله عليه واله)، وقد قال السيّد محمد كاظم القزويني في كتابه: (زينب الكبرى من المهد إلى اللحد) ما نصّه: (يوجد ـ في كتب التراجم ـ اضطراب شديد حول هذا الاسم وهذه الكنية، فالمشهور أنّ السيدتين: زينب وأُمّ كلثوم، بنتان للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من السيّدة فاطمة الزهراء(عليها السلام))[18].
وقد علّق ولده مصطفى القزويني على ذلك بقوله: (لقد جاء التعبير عن السيّدة زينب الكبرى ـ في بعض كتب الحديث والتاريخ ـ بكلمة (أُمّ كلثوم)، وهنا عدّة احتمالات:
الاحتمال الأول: أنّ هذا التعبير هو كنية لها.
الاحتمال الثاني: أنّه اسم ثانٍ لها.
الاحتمال الثالث: أنّه اشتباه وخطأ من بعض المؤرّخين؛ حيث إنّهم عبّروا عنها باسم أُختها، أو بكنية أُختها.
الاحتمال الرابع: وجود سبب آخر خفي علينا، بسبب ظلم التاريخ لترجمة حياة أهل البيت رجالاً ونساءً.
ولكلّ واحدة من هذه الاحتمالات الأربعة قرائن وشواهد تاريخية، يطول الكلام بذكرها، لكنّ الذي يتبادر إلى الذهن بعد الدراسة الموضوعية ـ والله العالم ـ هو أنّ أقوى الاحتمالات هو الاحتمال الأول، خاصّة وأنّ شخصية البنت الثانية للإمام أمير المؤمنين أُحيطت بسحاب كثيف من الغموض والإبهام والتشويش، إلى درجة أنّ بعض المعاصرين أعطى لنفسه الجرأة في أن يُنكر وجود بنت ثانية للإمام من زوجته السيّدة فاطمة الزهراء.. يكون اسمها أُمّ كلثوم!
وعلى كل حال، فقد كان السيّد المؤلّف (يقصد والدَه) يَطمئن، بل ويقطع بأنّ المقصود من (أُمّ كلثوم) ـ في كثير من كتب الحديث والتاريخ ـ هي السيّدة زينب الكبرى، وهذا ما نلاحظه حين الاستماع إلى مجالسه ومحاضراته المسجّلة على أشرطة الكاسيت، ونلاحظه ـ أيضاً ـ حين التدقيق في فصل (حياة السيّدة زينب في عهد والدها الإمام أمير المؤمنين(عليهما السلام))، ففي كثير منالفقرات التاريخية المرتبطة بفاجعة مقتل الإمام علي أمير المؤمنين، يوجد التعبير بجملة: (تقول أُمّ كلثوم)، وقد فهم المؤلّف أنّ المقصود ـ في أكثر تلك المقطوعات ـ هي السيّدة زينب الكبرى، فذكر الكلام ونسبه إلى السيّدة زينب سلام الله عليها)[19].
وكما هو ملحوظ أنّ السيّد مصطفى يؤكّد أنّ هناك بنتاً أُخرى للإمام علي(عليه السلام) من فاطمة الزهراء(عليها السلام)، تُدعى أُمّ كلثوم، لكنّ أُمّ كلثوم المذكورة في مقتل الإمام علي(عليه السلام) يؤكّد بأنّها السيّدة زينب(عليها السلام)، وعلى كلّ حال، باعتقادي أنّ هناك بنتاً أُخرى لعلي والزهراء(عليهما السلام)، تُكنّى بأُم كلثوم، خطبها عمر، وألَحّ في خطبتها حتّى أنّه هدّد على ذلك؛ ما جعل الإمام علي(عليه السلام) يحجبها عن الأنظار، فكان ذلك سبباً لعدم روايتها الحديث[20]، والإبهام والتشويش على شخصيتها، وانتقال كنيتها لأُختها زينب الكبرى.
أمّا ألقاب السيّدة زينب(عليها السلام) فهي: (الصدّيقة الصغرى، العقيلة، عقيلة بني هاشم، عقيلة الطالبيين، العارفة، العالمة، الفاضلة، الكاملة، عابدة آل علي)[21].
المطلب الثالث: حياتها
إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) (أدركت النبي(صلى الله عليه واله) ووُلدت في حياته)[22]، وقد أُخبر النبي(صلى الله عليه واله) من قِبَل جبرئيل(عليه السلام) بأنّ حياتها ستكون مليئة بالمصائب والمآسي، فقال: إنّ حياة هذه البنت ستكون مقرونة بالمصائب والمتاعب، من بداية عمرها إلى وفاتها[23]. وقد رُوي أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) رأت في عمر الطفولة رؤيا مهولة، فقصّتها على جدّها رسول الله(صلى الله عليه واله) بقولها:(يا جداه، رأيتُ البارحة أنّ ريحاً عاصفة قد انبعثت، فأظلمت الدنيا وما فيها، وأظلمت السماء، وحركتني الرياح من جانب إلى جانب، فرأيتُ شجرةً عظيمة فتمسكتُ بها؛ لكي أسلم من شدّة الريح العاصفة، وإذا بالرياح قد قلعت الشجرة من مكانها وألقتها على الأرض، ثمّ تمسكتُ بغصنٍ قوي من أغصان تلك الشجرة، فكسرتها الرياح، فتعلّقتُ بغصنٍ آخر فكسرته الريح العاصفة، ثمّ تمسكتُ بغصنٍ آخر وغصن رابع حتّى استيقظتُ من نومي. وحينما سمع رسول الله منها هذه الرؤيا بكى، وقال: فأمّا الشجرة فهو جدّك، وأمّا الغصنان الكبيران فهما أُمّك وأباك[24]، والغصنان الآخران فأخواكِ الحسنان تسودّ الدنيا لفقدهم، وتلبسين لباس المصيبة والحداد في رزيتهم)[25].
وفعلاً هذا الذي حصل، فقد (عاصرت السيّدة زينب(عليها السلام) الحوادث المؤلمة التي عَصفت بأُمّها البتول بعد وفاة أبيها الرسول، وما تعرّضت له من الضرب والأذى)[26]، حينما غصبوا إرثها، وكذلك هبتها (فدك)[27]، وهجموا على دارها [28]، وأسقطوا جنينها[29]، حتّى ماتت وهي غاضبة عليهم[30]. فلم تكن السيّدة زينب(عليها السلام) بمعزل عن هذه المآسي، فهي التي (رافقت أُمّها الزهراء(عليها السلام) إلى مسجد رسول الله(صلى الله عليه واله) حين إلقاء الخطبة)[31]، وقد كان عمرها آنذاك خمس سنوات.
والذي لفت نظرنا هو أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) في أغلب أيام حياتها لم تفارق أئمة زمانها أبداً، فحريّ بها أن تكون بهذا المستوى من السموّ النفسي بشتّى المناقب التي لم تسبقها إليها غيرها عدا أُمّها الزهراء(عليها السلام)، فهي بعد شهادة أُمّها(عليها السلام) بقيت في كنف أبيها علي أمير المؤمنين(عليه السلام)، حتّى (زوَّجها أبوها علي من عَبد الله ابن أخيه جعفر، فولدت له عليّاً، وعوناً الأكبر، وعبّاساً، ومحمّداً، وأُمّ كُلثُوم)[32]، إلّا أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لم تبتعد كثيراً عن أبيها علي(عليه السلام) بهذا الزواج، بل بقيت قريبة منه، ولمّا انتقلت الخلافة الظاهرية إليه (ووصل من البصرة إلى الكوفة واستقرّ به المكان، التحقت بهِ العوائل من المدينة إلى الكوفة، ومن جملة السيدات اللواتي هاجرن من المدينة إلى الكوفة، هي السيّدة زينب(عليها السلام)، وقد سبقها زوجها عبد الله بن جعفر، حيث كان في جيش الإمام لدى وصوله للبصرة)[33]، فعاشت هي وزوجها في بيت أبيها الإمام علي(عليه السلام)، إذ (كان كلٌّ من البنات والأولاد المتزوّجين يسكنون في حجرة من تلك الحجرات، والسيّدة زينب(عليها السلام) كانت تسكن مع زوجها في حجرة أو غرفة من غرف دار الإمارة)[34].
فالسيّدة زينب(عليها السلام) (عاصرت بل عاشت الاضطرابات والأحداث الداخلية التي حدثت من واقعة صفين إلى النهروان، إلى الغارات التي شنّها عملاء معاوية على بلاد أمير المؤمنين(عليه السلام))[35]، (حتى فُجِعَت بهذا الوالد الحنون، وقد رأته مضرّجاً بالدماء بسيف ابن ملجم المرادي، وكان قد بات عندها ليلة استشهاده، وقد نعى نفسه أمامها، إذ ذكر السيّد مصطفى القزويني بأنّ المقصودة بكنية أُمّ كلثوم في تلك القصة هي السيّدة زينب)[36]. ولم تزل السيّدة زينب(عليها السلام) من معاناة إلى معاناة، مروراً بالظروف القاسية التي عاشها الإمام الحسن(عليه السلام)، حتّى قضى مسموماً بأمـر مِن معاوية [37]؛ لأنّها ـ أيضاً ـ كانت معه في الكوفة، ولمّا انتقل إلى المدينة(عليه السلام) انتقلت معه.
ورُويَ أنّه لما استُشهد الإمام الحسن(عليه السلام): (صاحت زينب وا أخاه، وا حسناه، وا قلّة ناصراه، يا أخي مَن ألوذ به بعدك؟! وحزني عليك لا ينقطع طول عمري. ثمّ إنَّها بكت على أخيها وهي تلثمخديه وتتمرّغ عليه، وتبكي عليه طويلاً)[38]، وقد استظهرنا أنّ قولها(عليها السلام) لأخيها الإمام الحسن(عليه السلام): (مَن ألوذ به بعدك)، لا يعني أنّها لا تعتبر زوجها عبد الله أو أخاها الإمام الحسين(عليه السلام) ملاذاً، بل قصدها أنّ الجميع ـ وعلى رأسهم الإمام الحسين(عليه السلام) ـ صاروا مفجوعين بمصاب الإمام الحسن(عليه السلام)، فبمَن تلوذ بهذه المصيبة والكلّ مفجوع، أو أنّ قصدها ـ أيضاً ـ وجود خصوصية للإمام الحسن(عليه السلام) لا يعوضها غيره، قال الإمام الصادق(عليه السلام): (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء)[39]، (هذا وهو فقيه كغيره من الفقهاء يخلفه المئات من أهل الفقه، فكيف إذا كان إماماً، بالتأكيد ستكون له خلّة، حتّى وإن كان يخلفه إمام بعده، فالخصوصية له محفوظة، كما أنّ للإمام الذي يخلفه خصوصية أُخرى خاصّة به، كخصوصية الإمام علي(عليه السلام) بولادته في الكعبة، وكخصوصية الزهراء(عليها السلام) التي هي حجّة على الأئمة(عليهم السلام) بتكوينها من ثمر الجنة، ولم تنتقل من صلب إلى صلب، وإلّا فالسيّدة زينب(عليها السلام) كانت متعلقة بالإمام الحسين(عليه السلام) إلى درجةٍ وصفته في خطبتها في الكوفة بهذه الصفة: (يا شقيق فؤادي))[40].
وقد كان الإمام الحسين(عليه السلام) يكنّ لها كلّ المحبة والاحترام، حتّى روي: (أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) كان يقرأ القرآن الكريم ذات يوم، فدخلت السيّدة زينب(عليها السلام)، فقام من مكانه والقرآن بيده، كلّ ذلك احتراماً لها).
كما أنّنا نرى أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) كانت برفقة زوجها عندما أراد الالتحاق بأبيها الإمام علي(عليه السلام) حين استقراره في الكوفة، وكذلك حين مكوثها مع الإمام الحسن(عليه السلام) في الكوفة، ورجوعها حين رجع إلى المدينة، لكن مع الإمام الحسين(عليه السلام) نجدها تركت زوجها عبد الله في المدينة؛ إذ لم يخرج مع الإمام الحسين(عليه السلام)؛ لأسباب يذكرها المحققون، ورافقت أخاها الإمام الحسين(عليه السلام) هي وأولادها إلى كربلاء، وهنا تتجلّى أهمّية دور السيّدة زينب(عليها السلام) في كربلاء، بمعنى أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لو كان زوجها معها في رحلتها إلى كربلاء مع قافلة الإمام الحسين(عليه السلام) لَظن البعض أنّ مجيء زوجها هو الذي دفعها لمرافقة أخيها الإمام الحسين(عليه السلام)، لكن لمّا لم يخرج زوجها مع الإمام الحسين(عليه السلام) تجلّت بكلّ وضوح أهمّية دورها إلى حدٍّ تترك زوجها في المدينة، وتذهب برفقة ولدَيها وبنتها مع أخيها الإمام الحسين(عليه السلام)؛ لِنفهم أنّ دورها لم يكن عشوائياً في كفالة العيال بعد شهادة إخوتها، وفضح بني أُمية بمواقفها وخُطَبِها، إنّما هذا الدور جاء عن تخطيطٍ إلهي سابق، حتّى وجدنا الإمام علي(عليه السلام) يختبرها كيف تُلقي الخطبة، كما ويزوّدها بالعلوم الغيبية والمستقبلية؛ كي ترد بها على أعداء الله، كما سنذكر لاحقاً.
بل رويَ أنّها كانت موصاة بهذا الدور العظيم لحكمةٍ بالغة؛ من خلال رواية طويلة سأذكر منها ما نصّه: (والحسين بن علي(عليه السلام) أوصى إلى أُخته زينب بنت علي في الظاهر، وكان ما يخرج عن علي بنالحسين(عليه السلام) من علم يُنسب إلى زينب، ستراً على علي ابن الحسين(عليه السلام))[41].
بل إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) كأنّها وُلدت لأجل كربلاء ونصرة القضية الحسينية، فبمجرد أن انتهت واقعة الطف، وأدّت ما عليها من كفالة العيال، وفضح بني أُمية، وتهييج الدمعة على مصاب أبي عبد الله في الكوفة والشام والمدينة، رحلت عن هذه الدنيا وهي صابرة محتسبة، وقد (قيل: إنّها توفّيت بعد ورود المدينة بثمانين يوماً، وفي كتاب السيّدة زينب: أنّها توفّيت في يوم الأحد، (15) شهر رجب، سنة (62) من الهجرة… فهي أصغر من أخيها الحسين(عليه السلام) بعامين، فلمّا توفّيت كان لها (56) سنة)[42]. وهنالك اختلاف في مكان قبرها، قيل: إنّه في المدينة، وقيل: في الشام، وقيل: في مصر[43].
المبحث الثاني: الحجاب في فكر السيّدة زينب(عليها السلام) وكلماتها
المطلب الأول: حجاب السيّدة زينب(عليها السلام)
إنّ السيّدة زينب بنت الإمام علي(عليهما السلام)، هي المصداق الأعظم للمرأة المحجوبة، (فالحجاب الستر… وامرأة محجوبةٌ قد سُتِرت بسترٍ وحجاب)[44].
والحجاب ينقسم إلى قسمين: حجابٌ ظاهري، وحجابٌ باطني، فأمّا الحجاب الظاهري، فهو الملموس المرئي، وهو المذكور في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ)[45]، وأيضاً في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) [46]. أمّا الحجاب الباطني، فهو حجاب غير مرئي؛ لأنّه صفة تحجب الإنسان ـ سواء كان رجلاً أو امرأة ـ عن المعصية، وهو المذكور في قوله تعالى: (وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ)[47] وكان العرب يُطلقون صفة التحجّب حتّى على الرجال، كقول عمر بن سعد (لعنه الله):[48]
أوقر ركابي فضة وذهبا أنا قتلت الملك المحجّبا
وقصد بعبارة: (الملك المحجّب) الإمام الحسين(عليه السلام)؛ لأنّ نفسه تحجّبت عن الذنب، سواء كان كبيراً أو صغيراً، وكان يُشير بذلك إلى الحجاب الباطني.
إنّ الحجاب الباطني أساسٌ للحجاب المادي، لكنّ الحجاب المادي دالٌ عليه، فلا يُقبل من المرأة أن تترك الحجاب المادي الظاهري تحت شعار: (إنّ الإيمان في القلب)، كما لا يُقبل منها أن تتحجّب بالحجاب الظاهري، وهي مبتذلة نفسياً، فلا تتورّع من النظرة الحرام والكلام المائع، وما شابه ذلك.
إنّ السيّدة زينب الكبرى(عليها السلام) كانت المصداق الأسمى لهذين الحجابين، فهي تمسّكت بالحجاب الباطن وهو التقوى، وبالحجاب الظاهر وهو الحجاب المادي، وهو البيت والخمار، وما شابه ذلك، وحتّى لمّا جرت المشيئة الإلهية بأن تُسبى وتَخرج من خدرها، ظلّت متمسّكة بالحجابين الظاهري والباطني، فأمّا حجابها الباطني في أسرها، فمن مصاديقه ما قاله بشير بن خزيم الأسدي عن خطبتها في الكوفة، حين قال: (ونظرتُ إلى زينب بنت علي(عليهما السلام) يومئذٍ، فلم أرَ خفرة والله أنطق منها)[49]. ومن المؤكّد قال ذلك؛ لأنّ عليها علامات المرأة الملتزمة، وكأنّي بها تتكلم وهي مطرقة إلى الأرض، أو تنظر إلى النساء دون الرجال؛ تطبيقاً لقوله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) [50]، أو تحاول أن تضع الستر على وجهها وهي تخطب، فوصفها إثر ذلك بالخفرة، كما أنّه وصفها بأنّها تُفرغ عن لسان أبيها، أي: إنّها في منطقها ذات صلابة وبلاغة تُذكّر بصلابة علي بن أبي طالب(عليه السلام) وبلاغته، أي: إنّ منطقها بليغ وليس فيه ميوعة، وهذا من التقوى، وهي الحجاب الباطن؛ لأنّ عكسه يكون الخضوع من قِبل المرأة، وقد قال تعالى: (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)[51].
وأمّا حجابها المادي في الأسر، فمن مصاديقه قولها ليزيد في مجلسه: (أَمِن العَدل يابن الطلقاء تَخديرك حرائرك وإماءك، وسَوقك بنات رسول الله، قد هتكت ستورهنَّ، وأبديت وجوههنَّ، تحدو بِهنَّ مِنبلدٍ إلى بلد، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمعاقل، ويتصفّح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف؟!)[52]. إنّ تركيز السيّدة زينب على إبراز وجوههنَّ يدلُّ على مدى لوعتها على هتك هذا الحجاب، ومدى أهمّيته عندها، كما يدلّ على أنّ الذي بدا منهنّ بالأسر هو الوجوه فقط، بمعنى أنهنَّ لم يُهتك منهنّ شيء ظاهري سوى الوجوه.
أمّا ما قاله ابن الأثير في تاريخه عن يوم الطف بعد شهادة الإمام الحسين(عليه السلام) ـ (ونهبوا ثقله ومتاعه وما على النساء، حتّى إن كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها، فيؤخذ منها)[53]ـ فبرأينا أنّ هذا أوشك أن يحدث، لكنّه من المؤكّد لم يحدث، أو المقصود به: أنّ ما سُلِبَ منهنّ هو النقاب أو الإزار، وليس الثوب الذي يستر بدنهنّ؛ لذلك نقول: إنّ الله تعالى صرف عنهن طمع الدناة من الجيش، كما صرف عن يوسف(عليه السلام) كيد النسوة، فقال الله تعالى في محكم كتابه: (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)[54].
ويؤكّد ذلك ما حدثَ في مجلس يزيد، حيث نصّ الرواية: (قال رجل منهم أزرق أحمر، ونظر إلى وصيفة من بناتهم، فقال يا أمير المؤمنين: هب لي هذه. فقالت زينب: لا والله، ولا كرامة لك ولا له إلّا أن يخرج من دين الله)[55]. أي: إنّه سوف لا يتيسرّ له بحكم دين الله والطبيعة التي خُلق الناس عليها، فكما أنّ الصدقات حُرّمت على آل محمد(صلى الله عليه واله)، فقد صرف الله عنهم كيد الفاسقين، كما صرفه عن يوسف(عليه السلام)، أمّا الستور التي هُتِكَت والتي ذكرتها السيّدة زينب(عليها السلام) بقولها: (وهتكت ستورهنّ)، إنّما هي الخيام والهوادج والنُّقب، أو الأُزر التي تختفي خلفها وجوههنّ، ويتأكّد فيها سترهنَّ، ولو كان مقصدها بهتك الستور هو تجريدهنَّ من المَلبس، لما ذكرت السيّدة زينب إبداء الوجوه بعد ذلك؛ لأنّ التجرّد يفي بالإبداء كلياً حتّى الوجوه، وعندها ستكون عبارتها التالية: (وأبديت وجوههنّ) زائدة؛ فمن هنا قد اتّضح أنّ قولها: (وهتكت ستورهنّ وأبديت وجوههنّ)، بمعنى أنّك حرقت خيامهنّ، وأذهبت نقاب وجوههنّ، وسقتهنّ سبايا من غير هوادج، ويؤكّد هذا المعنى كذلك قولها:(أَمِن العدل يابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك؟!) ليتأكّد أنّ لوعتها هي خروجها من الخِدر وانكشاف وجهها، أي: المساكن التي تسترها، وليس كما ذكر ابن الأثير من تجريدهنّ الثوب الذي يستر الجسد.
المطلب الثاني: سبب اهتمام أهل البيت(عليهم السلام) بالحجاب
إنّ أهل البيت(عليهم السلام) اهتمّوا كثيراً بحجاب نسائِهم وخِدرهِنّ، وركّزوا على حجاب المرأة وخدرها، حتّى أنّ السيّدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) حينما سُئلت:(أيّ شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل)[56]. كما ذكر الشيخ جعفر النقدي في كتابه (زينب الكبرى) أنّ السيّدة زينب كانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول الله(صلى الله عليه واله)، تخرج ليلاً وتُطفئ القناديل؛ كي لا يُرى خيالها، ويكون الحسن(عليه السلام) عن يمينها والحسين(عليه السلام) عن شمالها. من هنا ينشأ السؤال التالي: لماذا كلّ هذا الاهتمام من قِبل أهل البيت(عليهم السلام) بحجاب المرأة؟
والجواب عن ذلك هو: أنّ أهل البيت(عليهم السلام) اهتمّوا كثيراً بالحجاب بالنسبة للمرأة؛ لأنّه يسمو بالمرأة نفسياً وفكرياً، وكلّما اهتمّت المرأة بالحجاب اهتماماً بالغاً كانت منتجة في مجال عملها، ولقد ثبت عقلاً ـ من خلال التجربة التي استنتجتها ـ أنّ الحجاب هو أمرٌ عقلي؛ إذ إنّ التجربة تقول: إنّ الأشياء ـ حتّى إذا كانت من جماليات الإنسان ـ إذا أُسرف في صرفها المادي، ستكون نتيجتها بالضدّ، فمثلاً: الإنسان اللبق إذا تكلّم مع أيّ أحد يراه في البيت أو الشارع، فلا يقال: إنّه بليغ، بل يُقال: إنّه ثرثار، والإنسان البشوش إذا ابتسم أو ضحك بوجه أيّ أحد كان في البيت أو الشارع، فعندها لا يُقال: إنّه بشوش، بل يقال: إنّه مجنون، والإنسان الغني إذا وزّع أمواله لأيّ أحد يلقاه في البيت أو الشارع، فسيقع في حرج مادي محتمل يؤدّي إلى افتقاره وعوزه، وكذلك المرأة إذا تبرّجت وأظهرت مفاتنها لأيِّ أحد في البيت أو الشارع، سيُقال عنها: إنّها مبتذلة، وعندها ستتعرّض لكلمات الغزل والإعجاب من كثيرٍ من الرجال، والمرأة بطبيعتها تنجرّ مشاعرها للكلام المعسول، فعندها تفسد ويفسد بها المجتمع، فالمرأة كشعلة النار تُدفئ وتُنير وتُحرق في نفس الوقت، وذلك حسب مكانها الذي توضع فيه، وحسب استعمال مَن يستعملها، وهذا هو السرّ في اهتمام أهل البيت(عليهم السلام) بحجاب المرأة؛ لأنّه يحفظ لها كرامتها، ويجعلها ناجحة في حياتها.
ولعلّه يقول قائل في هذا السياق: إنّ النساء في المناطق الريفية أكثر التزاماً بالحجاب من النساء في المدن؛ إلّا أنّ النساء في المدينة أكثر نجاحاً من نساء الأرياف، كنجاحهنَّ بالدراسة، وإظهار المواهب، بالرغم من أنّهنّ أقلّ التزاماً بالحجاب. إذاً؛ أين صحّة القول: بأنّ المرأة كلّما التزمت بالحجاب أكثر نجحت أكثر؟
والجواب عن ذلك هو: أنّنا نجد أنّ المرأة الريفية ناجحة، وسرّ نجاحها هو في أُسرتها، فنجدها متحمّلة لأعباء المسؤولية والعمل في البيت أكثر من المرأة المدنية، وهي صبورة ومطيعة لزوجها أكثر من أغلب النساء المدنيات، وبهذا التحمّل للأعباء والصبر، نجدها تربّي جيلاً صالحاً، وهذا هو أصل النجاح؛ لأنّ دور المرأة الأساس هو في بيتها، بينما تجد بعض النساء المدنيات، ربّما هنّ ناجحات بالدراسة وإظهار الموهبة، إلّا أنّ لديهنّ فشل في الحياة الزوجية والأُسرية؛ لأنّ التمدّن لمّا قلّل من التزامهنّ بقوانين الدين، ومن ضمنها الحجاب، قلّل أيضاً من تحمّلهنّ للمسؤولية، وطاعتهنّ للأزواج؛ ما جعل الطلاق يرتفع بدرجة عالية في المجتمعات المتمدّنة.
إذاً؛ فالحجاب هو سرّ نجاح المرأة أينما كانت؛ وهذا ما جعل السيّدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) وابنتها السيّدة زينب(عليها السلام) أكثر النساء إنجازاً؛ لأنهنّ أعظم النساء في الخدر والحجاب، وقد ركّز أهل البيت(عليهم السلام) على الحجاب من أجل ذلك، أي: من أجل إنجاح المرأة في دورها الأساس وهو البيت، وباقي الأدوار التي تُناط بها حسب موقعها في هذه الحياة، كدور نصرة الإمامة وأهدافها الذي أُنيط بالسيّدة فاطمة الزهراء والسيّدة زينب(عليهما السلام)، فكانت انطلاقتهما من الحجاب انطلاقة عظيمة، بل أعظم انطلاقة؛ ليكون ذلك ردّاً على مَن يقول: إنّ الحجاب يقيّد المرأة عن التعليم وعن أداء دورها.
المطلب الثالث: يزيد وعدم غيرته
كما هو معروف أنّ يزيد بن معاوية هو رجل معدوم الغيرة إلى أعلى المستويات، وهذا وصف مفروغ منه، لكنْ ثمّة كلام في قول السيّدة زينب(عليها السلام) ليزيد عن هذا الموضوع في مجلسه، وذلك حينما قالت له: (أَمِنَ العَدل يابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهنَّ، وأبديت وجوههنَّ، تحدو بِهنَّ الأعداء مِن بلدٍ إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوههنَّ القريب والبعيد، والدني والشريف؟!)[57].
فهذه العبارات ربّما يتصوّر من خلالها البعض أنّ يزيد كان صاحب غيرة على نسائه، إلّا أنّ هذا الأمر ليس صحيحاً، أي: إنّ يزيد كان معدوم الغيرة إلى أبعد الحدود، وبذلك فهو ليس أفضل ممّن يُظهرون نساءهم متزينات للرجال الأجانب، وسنشرح ذلك في ثلاثة موارد:
المورد الأول
إنّ يزيد لم يحجب حرائره وإماءه لغيرتهِ عليهنَّ، بل لأنّه أراد بذلك صدع قلوب سبايا آل محمد(صلى الله عليه واله)؛ لأنّه كان يعاني من عقدة نفسية؛ للفارق الكبير بين البيت العلوي والبيت الأُموي، فهو كان يعلم بانحداره من بيت سيّئ الصيت برجاله ونسائه، بينما البيت العلوي معروف بشرف رجاله وخدر نسائه، فأمر يزيد بتخدير نسائه، وسوق بنات رسول الله سبايا؛ حسداً وتشفّياً. ويؤكّد هذا المعنى قول السيّدة زينب(عليها السلام) له: (تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا…)، وكأنّ تخدير حرائره وإماءه صار على يد يزيد، وليس على يد معاوية، أي: في أيام سوق العلويات سبايا، ومن قبلُ لم تكن نساؤه مخدّرات، أي: إنّ هذا الفعل مقصود لأذية السبايا من آل محمد(صلى الله عليه واله)، لا لغيرته على نسائه.
المورد الثاني
إنّ غيرة الرجل المحمودة لا بدّ أن تكون على كلّ امرأة، وأن لا تكون محصورة على النساء من خاصّته فقط؛ لذلك قال الإمام علي(عليه السلام): (ما زَنى غيورٌ قط)[58]، أي: إنّ الغيور ـ لغيرته على جميع النساء ـ لا يزني، لأنّه يحسب كلّ امرأة هي من خاصّته؛ لذلك فهو لا يهتك حجاباً لأيّ امرأة غيرةً على كلّ النساء، وبذلك لو كان يزيد ذا غيرةٍ لهزّته الغيرة على بنات رسول الله(صلى الله عليه واله)، ولما أبدى وجوههنّ وساقهنّ سبايا، يتصفّح وجوههنَّ القريب والبعيد، والدني والشريف، باعتبار أنّ الغيور هو الغيور على كلّ النساء كما أسلفنا.
المورد الثالث
إنّ تخدير يزيد لحرائره وإمائه، وسوقه بنات رسول الله(صلى الله عليه واله) سبايا، لا يُعدّ غيرةً، بل هو فسق وضلالة؛ لأنّ مَن يُفضّل أهله وخاصّته على حساب دين الله ورسوله يكون من أهل الفسق والضلالة، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)[59]، وهذا ما فعله يزيد بن معاوية، فقد خدّر النساء من خاصّته، وساق بنات النبي(صلى الله عليه واله) أُسارى، مستهيناً بدين الله ودين رسوله(صلى الله عليه واله)، ليثبت عليه الفسق بذلك، بالإضافة إلى الأُمور التي ثبت فيها فسقه كشرب الخمر، وغير ذلك.
إذاً؛ من خلال كلّ هذا التوضيح يتبيّن أنّ قول السيّدة زينب(عليها السلام) ليزيد:(أمِنَ العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقُك بنات رسول سبايا؟!) إنّما هو ذمّ ليزيد، ووصفه بالفسق وعدم الغيرة، وبالظلم أيضاً، وهو عدم العدل الذي ذكرته السيّدة زينب(عليها السلام) أول كلامها، لمّا قالت: (أمِنَ العدل يابن الطلقاء).
المبحث الثالث: العلم الذي نطقت به السيّدة زينب(عليها السلام) في خُطَبها
المطلب الأول: انكشاف الغطاء عن عينيها
هنالك مَن يعتقد أنّ الحجاب يُقيّد المرأة عن التعليم وأداء دورها فيه، وينسون أنّ سيّدات النساء كنّ محجبات بأفضل وأكمل حجاب عند تعليم وأداء دورهنّ المنوط بهنّ، فلم يُقيّدهنّ الحجاب عن تحصيل علمٍ أو أداء دور، بل على العكس نجد أنّ المرأة إذا كانت ذات طُهر وعفاف وتديّن وصبر على المصاعب، ولها قابلية لطلب العلم وتحمّله؛ سيفتح الله تعالى لها آفاقاً غيبية من العلم والفيوضات، فالإسلام قد اهتمّ بالمرأة وحافظ على كرامتها عموماً بلا استثناء، وخصّ بعض النساء بالكرامات العلمية والأدبية وغيرها؛ لأنّهنّ وصلن إلى مراتب عليا في التقوى والالتزام والصبر الذي يساعد على دوام كلّ فضيلة، وهو مفتاح للعطاءات الإلهية، قال تعالى:
(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)[60].
ومن النساء اللّاتي برزنَ بالصبر والعفة والحجاب، هي السيّدة زينب بنت علي بن أبي طالب(عليهما السلام)، بل فاقت جميع النساء بصبرها.
ومن مواقف السيّدة زينب(عليها السلام) التي أذهلت العقول، لمّا قال لها ابن زياد: (كيف رأيت صُنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلّا جميلاً)[61]، فهذه العبارة انبهرت بها الألباب، واقشعرّت لها الأبدان، فهي تدلّ على صبرها العظيم، إلى درجة أنّها رأت في مقتل أحبّتها الذين قُطّعوا تقطيعاً، الشيء الجميل؛ لأنّه كان في سبيل الله، وهذه هي حقيقة واضحة في عبارة السيّدة زينب(عليها السلام)، إلّا أنّه برأينا كما أنّ لهذه العبارة معنىً ظاهرياً، فإنّ لها معنىً باطنياً، فأمّا المعنى الظاهري، فهو المعنى السابق الذي قال به العلماء: بأنّها من كثرة تسليمها لأوامر الله تعالى، صارت ترى من مقتل إخوتها وأهل بيتها في سبيل دين الله أمراً جميلاً، وهذا من باب قوله تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)[62]، فلماّ شاء الله تعالى أن يرى الحسين وأهل بيته مقتولين؛ لعلمه بأنّ الدين لا يستقيم إلّا بنهضة الإمام وشهادته، شاءت السيّدة زينب ذلك، ورأته جميلاً.
أمّا المعنى الباطني الذي استظهرناه من هذه العبارة ولعلّه الأرجح، فهو أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لمّا سألها ابن زياد: (كيف رأيت صُنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلّا جميلاً)، فهو قد سألها عن رؤيتها بعينها الطبيعية لما جرى على إخوتها وأهل بيتها، أي: كرؤية الناس العاديين، فأجابته عن رؤيتها المكشوف عنها الغطاء، فقالت: ما رأيت إلّا جميلاً، تعني بذلك رؤيتها لما وراء الحجب، كأن تكون رأت من الملائكة مَن يظلّلهم، ومنهم مَن يحملهم، ومنهم مَن يستقبلهم، ورأت جدّها رسول الله(صلى الله عليه واله)، وأباها علياً(عليه السلام)، وأُمّها الزهراء(عليها السلام)، وأخاها الحسن(عليه السلام)، وهم يسقون الشهداء الماء، ويعدون الإمام الحسين(عليه السلام) بأنّ الله سيأخذ بثأره في آخر الزمان؛ لذلك قالت عن هذه الأحداث وما شابهها من الأحداث الغيبية: (ما رأيت إلّا جميلاً).
وبكلا المعنيين ـ الظاهري والباطني ـ قد اتّضح مقام السيّدة زينب(عليها السلام)، ومدى صبرها، إلّا أنّه في المعنى الثاني الباطني اتّضحت حقيقة أُخرى ـ كما أسلفنا ـ وهي أنّ السيّدة زينب كُشف عنها الغطاء يوم عاشوراء، ولعلّها استمدّت صبرها وتحمّلت الصعاب مما رأت وسمعت من الأُمور الغيبية التي هي مكمّلة لليقين بلا شك؛ إذ قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)[63].
المطلب الثاني: علمها بمراتب الموت والحياة
إنّ القرآن الكريم بظاهره الأنيق وباطنه العميق، يحتوي على جميع العلوم بمختلف أنواعها وأهدافها، قال الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) [64]، والسيّدة زينب(عليها السلام) هي بنت الإمام علي(عليه السلام)، وهي أعلم النساء بكتاب الله في زمانها؛ لأنّ القرآن الكريم نزل في بيوتهم، ولأنّ لها قابلية لتعلّم تأويل القرآن وتفسيره، بل وتعليمه أيضاً، حتّى أنّها كانت تعلّم نساء الكوفة القرآن[65].
ومن العلوم التي كانت السيّدة زينب(عليها السلام) تُحيط بها، هي مراتب الموت والحياة للإنسان، وقد لمسنا بعض ذلك من خلال خطبتها في مجلس يزيد حين قالت له: (وتهتف بأشياخك، زعمتَ أنّك تناديهم)[66]، فهي بهذا المقطع تُبيّن أنّ أشياخ يزيد لا يسمعون النداء ولا يشهدون مجلس يزيد؛ لأنّهم موتى، وهو بذلك زعم يناديهم. وهنا يرد إشكال، وهو: أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) أشارت إلى أنّ الموتى لا يسمعون، وشبه هذا القول يقوله الوهابية ضدّنا ـ نحن الشيعة ـ بندائنا للأئمة(عليهم السلام) وبزيارتنا لقبورهم، فكيف نُفرّق بين قول السيّدة زينب(عليها السلام)، وبين بدعة الوهابية؟ طبعاً الجواب عن هذا الإشكال، هو: أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لمّا أشارت إلى أشياخ يزيد بأنّهم لا يسمعون نداءه، أو يشهدون حديثه؛ ذلك لأنّها تعلم بدرجات الموتى وصفات كلّ منهم، وهي كما يلي:
الصنف الأدنى: هم الكفّار والمنافقون، وهؤلاء لا يسمعون النداء، ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ)[67]، وكذلك قوله تعالى: (وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ)[68]، ويشمل ذلك: أنّهم لا تصل إليهم الصلاة، أو قراءة القرآن؛ بدلالة قوله تعالى: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ)[69]، وأيضاً: لا يصلهم الاستغفار؛ بدلالة قوله تعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)[70]؛ لذلك نرى أنّ هناك عدم دقّة في نقل هذا الحديث الذي نصّه: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: إلّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)[71]؛ لأنّ كلمة (ابن آدم) وكلمة (إنسان) تشملان الكفار والمشركين والمنافقين، بينما الآيات الكريمة ـ كما استعرضناها ـ قد أكّدت بأنّ الكفار والمشركين والمنافقين لا يسمعون، ولا تصلهم أعمال البرّ.
ثمّ إنّ هؤلاء إن كان لا ينفعهم استغفار النبي(صلى الله عليه واله) وصلاته كما صرّحت الآيات، فهل ـ بعد ذلك ـ ينفعهم دعاء أولادهم إذا كانوا صلحاء؟! بل الأكثر من ذلك، إنّ أولادهم ممنوعون من الاستغفار لهم أصلاً، قال الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ)[72]؛ لذلك فالحديث الأدقّ معنًى في هذا السياق، هو هذا الحديث الوارد عن رسول الله(صلى الله عليه واله): (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّامن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)[73]؛ لأنّ هذا الحديث يخصّ بذلك المؤمنين، دون غيرهم من الكافرين والمنافقين والمشركين، الذين لا يسمعون ولا تصلهم أعمال البرّ، والذين قصدتهم السيّدة زينب(عليها السلام) بقولها ليزيد: (وهتفت بأشياخك، زعمت أنّك تناديهم).
الصنف الأوسط: هم المؤمنون من أصحاب اليمين، أي: دون المقرّبين بالفضل، وهؤلاء إذا ماتوا سيسمعون، لكن سيكون لهم سمع محدود، كأن يسمعون قراءة القرآن والكلام عند قبورهم، كما أنّهم يصل لهم ثواب الفاتحة وأعمال البرّ من بعيد، بدلالة قوله تعالى فيهم: (وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ)[74]، فإرسال السلام من قِبل أهل اليمين للنبي(صلى الله عليه واله) في حياته أثناء نزول الآية، دليلٌ على أنّ لهم صلة أو شيء من هذا القبيل مع سكّان الدنيا، كما وأنّ النبي(صلى الله عليه واله) من المؤكّد سيردّ عليهم السلام، فيسمعونه أو يُبلَّغ لهم؛ لنعلم من خلال ذلك أنّ الدعاء والفاتحة وجميع أعمال البرّ المهداة إليهم تصلهم أيضاً، أي: إنّهم بعكس الصنف الأدنى الذين ذكرناهم، وهم الكفار والمنافقون الموتى، الذين قلنا: بأنّهم ممنوع عليهم الثواب من جميع أعمال البرّ.
الصنف الأعلى: وهم الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله، فهؤلاء يسمعون النداء، ويشهدون الأحداث أو بعضها، كلّ حسب درجته، ويدلَّ على ذلك ما يلي:
أولاً: إنّ الله تعالى أنزل آيات صريحة بأنّ هنالك أمواتاً من أبرز صفاتهم أنّهم لا يسمعون، ومنها الآيات المتقدّم ذكرها: (وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ)[75]، وقوله: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) [76]، إلّا أنّ الشهداء نفى الله عنهم صفة الموت الروحي تماماً بقوله: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [77]، وهذا يعني أنّهم يسمعون.
ثانياً: إنّ الله تعالى قال عن حياة الشهداء الروحية: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ)[78]، فقد بيّن الله تعالى بأنّ حياة هؤلاء الشهداء الروحية قريبة منَّا وفي عالمنا، إلّا أنّنا لا نشعر بها، ولو انكشف عن عيوننا الغطاء لشعرنا بها؛ بدلالة قوله: (وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ) ، ولا نعرف ما حدود هذه الحياة التي اختصّوا بها، هل هو السمع فقط؟ لكن على الأرجح أنّ من خواصّ هذه الحياة، هو اطّلاعهم على أهمّ الأحداث التي تخصّ الدين، وعلى رأسها سوح القتال في سبيل الله؛ بدليل قوله تعالى عن الشهداء: (فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)[79].
والجدير بالذكر أنّ هنالك شهداء مرتبتهم أعلى،وميزتهم ليس السمع فقط،بل إلقاء السمع،وهي مرتبة أعلى مما قبلها،قال الله تعالى:(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)[80]، وإلقاء السمع هو الشهادة على أعمال الخَلق، بدلالة أنّ سبب تسمية الذين يُقتلون في سبيل الله بالشهداء، هو القتل في سبيل الله، وكأنّهم يكونون شهداء على الحدث الذي قُتلوا فيه، وهناك شهداء بدرجة أعلى تكون شهادتهم بسبب اطّلاعهم على الأعمال، والذي عبّرت عنه الآية بإلقاء السمع.
وهؤلاء الشهداء هم محمد(صلى الله عليه واله) والأئمة من أهل بيته(عليهم السلام)، وهم أنفسهم الأُمّة الوسط، والشهداء الذين أشار إليهم المفسّرون في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)[81]، وبيّنوا أنّ كلمة: (أُمّة) تُطلق على الفرد الفعّال، قال تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً) [82]، وتُطلق على المجموعة الصغيرة من الناس أيضاً، ففي قوله تعالى عن موسى(عليه السلام): (وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ)[83]، وبالتالي فليس ضرورياً أن تكون الأُمّة الواردة في الآية المتقدّمة هي جميع الأمّة الإسلامية. وأضف إلى قول أُولئك المفسّرين: أنّ هذه الآية واضحة الدلالة بأنّها لا تقصد بكلمة الشهداء جميع أفراد الأُمة الإسلامية؛ في حين أنّ واحدهم لا يعلم بأعمال الآخر، فربُّ العزّة لا يُشهد أحداً على ما لا يعلم، فالأُمّة الشهداء على الناس هم الذين يُلقون السمع، المطّلعون على أعمال الناس، والمقصودون في قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) وهم النبي(صلى الله عليه واله) والأئمة من أهل بيته(عليهم السلام).
ومن خلال كلّ هذا الشرح اتّضح أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لعلمها بأصناف الموتى، فقد نفت عن أشياخ يزيد أن يسمعوه أو يشهدوا مجلسه؛ إذ إنّهم من الصنف الأدنى من الموتى.
وبناءً على ما تقدّم؛ نعلم أنّ ما تقوله الوهابية من استنكارهم النداء للأئمة وزيارتهم، بعيد كلّ البُعد عمّا قالته السيّدة زينب(عليها السلام). ومن هنا؛ يتجلّى لنا مدى أعلمية السيّدة زينب بكتاب الله الذي جعله الله تعالى تبياناً لكلّ شيء، وكيف أنّ المرأة المحجّبة والمخدّرة تستطيع أن تجعل من الحجاب أُفقاً يُحلّق به فكرها إلى كلّ رفعة وسموّ.
المطلب الثالث: السيّدة زينب(عليها السلام) والإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)
كما هو معلوم أنّ الناس الإلهيين على قدر ما يؤمنون بيوم القيامة التي يأخذ فيها الصالح ثوابه، والظالم عقابه، أيضاً يتمنّون أن يأخذ الظالم عقابه في الدنيا، ويأخذ الصالح ثوابه فيها، فمثلاً: نوح(عليه السلام) دعا على قومه بالفناء عَدا المؤمنين منهم، قال تعالى: (وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا * رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا)[84]، وكذلك موسى(عليه السلام)، حيث قال الله تعالى: (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ)[85]، وهكذا الحال في كلّ رسول، أو أغلبية الرسل، قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)[86].
والسيّدة زينب(عليها السلام) باعتبارها إنسانة إلهية، قد رأت أعظم المصائب وأقساها، كان لا بدّ أن تُروى لها أخبار الجزاء لآل محمد(عليهم السلام)، والعقاب لأعدائهم في الدنيا، والتي تتحقّق بقيام الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، بل لا شك في أنّ أخبار الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)أشبه بالجُرَع التي تأخذها كي تتصبّر بها على مآسيها، وهذا ما رأيناه بيّناً جليّاً ومستتراً في خطبها، فركّزت فيها على الجزاء لهم، والعقاب لعدوِّهم، ومن نماذج ذلك: قولها عن عذاب أهل الكوفة: (أفعجبتم أن مطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تُنصرون)[87]، وقولها لابن زياد، حاكية عن إخوتها وأهل بيتها:(هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتُحاجّ وتُخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذٍ، ثكلتك أُمّك يابن مرجانة)[88]، وقولها ليزيد: (صدق الله سبحانه، كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)[89]، وقولهـا ليزيـد أيضاً: (وتهتفُ بأشياخك، زعمتَ أنّك تناديهم، فلتردنّ وشيكاً موردهم، ولتودنّ أنّك شللت وبكمت، ولم يكن قلت ما قلت، وفعلت ما فعلت)[90]، (فمهلاً مهلاً، لا تطش جهلاً، أنسيت قول الله: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؟![91])[92]، (حَسبك بالله حاكماً، وبمحمدٍ خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم مَن سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلاً، وأيّكم شرٌّ مكاناً وأضعف جُنداً … ولئن اتّخذتنا مَغنماً،لَتجدنا وشيكاً مَغرماً، حين لا تجدُ إلّا ما قدَّمت، وما ربُّك بظلامٍ للعبيد) [93]، (ولَتردنّ على رسول الله بما تحمّلت مِن سَفك دماء ذريّته، وانتهكت مِن حرمته في عترته ولُحمته، حيث يجمع الله شملهم،ويلمّ شعَثهم، ويأخذ بحقّهم، (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)[94])[95]. ففي هذه العبارات نجد السيّدة زينب(عليها السلام) تعد بالعقاب لأعداء آل محمد في الدنيا والآخرة، أمّا قولها عن القصاص الدنيوي، فهو إشارات وتلميحٌ، تؤكّد من خلاله قيام الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) آخر الزمان، وسنشرح ذلك في ثلاثة موارد:
المورد الأول: إنّ السيّدة زينب كانت كأمِّها الزهراء(عليها السلام) متألّمة لِما لاقته الإمامة من غصبٍ
وتهميشٍ، وقد لمسنا ذلك من خلال ما قالته ليزيد: (وسيعلم مَن سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين،بئس للظالمين بدلاً، وأيُّكم شرٌّ مكاناً وأضعَف جُنداً)[96]. كما كانت السيّدة زينب(عليها السلام) تتتوّق إلى أن تكون الإمامة ذات خلافة وحاكمية على الناس؛ بحيث يتضح ذلك من خلال قولها ليزيد: (وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا)[97]، فهي بيّنت ليزيد أنّ الإمامة لا يمكن أن تصفو له، ولكن الذي صفا له هو ملك هذه الإمامة وسلطانها، وهي على حزن من ذلك، بِمعنى أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لم تكن نظرتها إلى السلطان والملك كنظرة أبي سفيان حينما قال للعباس بن عبد المطلب: (لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. (فقال له العباس:) ويحك إنّها النبوّة)[98]، أو كنظرة يزيد حين قال:[99]
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل
فهذان المنافقان ينظران إلى الملك والسلطان بتجرّدٍ من النبوّة والإمامة، أي: برأيهما ليس هناك نبوّة ولا إمامة، إنّما هو ملك وسلطان فقط، بينما كان مراد السيّدة زينب(عليها السلام) ـ في المقام ـ هو كون الإمامة حاكمة كما كانت النبوّة لجدّها رسول الله(صلى الله عليه واله)، وهو مراد إلهي من خلال قوله تعالى: ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) [100]، وقوله تعالى لمّا حسد الناس آل محمد(عليهم السلام): (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا)[101]، وطالما أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) تحزّ في نفسها رؤية الإمامة مغصوباً حقّها وغير حاكمة، فكان لا بدّ من أحد يخفّف همّها بالوعد الإلهي، بأنّه سيأتي يوم من الأيام يحكم فيه الإمام الشرعي كلّ العالم، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وهذا الأمر ليس مفترضاً فقط، بل لمَسناه في عبارات تبيّن أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) كانت مطّلعة على أحداثٍ في الأزمنة اللاحقة، من ذلك قولها ليزيد: (فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فو الله، لا تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحينا، ولا تُدرك أمَدنا، ولا ترحض عنك عارها)[102].
وفعلاً هذا الذي حصل، فإقبال يزيد على قتل الإمام الحسين(عليه السلام)، هي انتكاسة بني أُميّة على مرّ التأريخ، ولم يمت وحي النبي(صلى الله عليه واله)، ولم يُمح ذكر آله(عليهم السلام)، وكان أمدهم مما لم يتوقّعه يزيد، كما أخبرت السيّدة زينب(عليها السلام) بذلك، وهو ما يؤكّد أنّها كانت تتلقّى علوم الأُمم اللاحقة من قِبل مَن عاصرها من الأئمة(عليهم السلام)، وأنّ قولها ليزيد: (وجمعك إلّا بَدَد، يوم ينادي المنادي:أَلا لعنة الله على الظالمين)[103]، فلربّما تقصد بذلك ظهور الإمام المهدي(عليه السلام)؛ لأنّ أكبر معركة سيخوضها(عجل الله فرجه الشريف) هي مع السفياني، أي: من نسل آل أبي سفيان جدّ يزيد، وسينتصر الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، فلعلّ السيّدة زينب خاطبت يزيد بهذا القول: (وجمعك إلّا بدد)؛ لأنّ السفياني من نسله وحامل فكره، فيزيد سيُهزم به، كما أنّ من الصيحات التي ستُسمع قُبيل الظهور هي هذه الصيحة: (أَلا لعنة الله على الظالمين)[104]، فلعلّ النداء الذي ذكرته السيّدة زينب بقولها: (يوم ينادي المنادي: أَلا لعنة الله على الظالمين)، كانت تقصد به هذه الصيحة قُبيل الظهور.
المورد الثاني: ذكرت السيّدة زينب(عليها السلام) في خطبتها في أهل الكوفة وتوبيخهم هاتين العبارتين: (فإنّه لا تحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثأر، وإنّ ربَّك لبالمرصاد)[105]. وقد بيّن السيّد القزويني في كتابه (زينب الكبرى من المهد إلى اللحد) في شرحه للخطبة، بأنّ هذه العبارة تُشير إلى المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، ولكن لم يشرح سبب ذهابه إلى هذا التفسير، إلّا أنّ المعنى يكاد يكون واضحاً في هذه العبارة، فإنّ الثأر إنّما يُطلق على القصاص في الدنيا وليس في الآخرة. وأيضاً قالت ليزيد: (ونسأل الله أن يُكمل لهم الثواب، ويُوجب لهم المزيد، ويُحسن علينا الخلافة)[106]، فكلمة الخلافة أيضاً تُطلق على مَن في الأرض وليس على مَن في الجنّة، وأنّنا لم نجد لذلك جواباً سوى أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) تُشير بذلك إلى الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)؛ لأنّه هو الذي سيأخذ لهم الثأر ويحسن لهم الخلافة، ولا يُمكن أن نقول: إنّها تقصد بالثأر ثورة المختار؛ لأنّ ثورة المختار لم تأخذ الثأر من بني أُميّة رأس الظلم، في حين أنّ السيّدة زينب قالت: (لا يخاف فوت الثأر)، أي: إنّها تُبشّر بمَن سيأخذ الثأر كاملاً، فهو إذاً ليس المختار، كما وأنّ حُسن الخلافة الذي ذكرته السيّدة زينب(عليها السلام) لم يتحقّق على مدى إمامة الأئمة بعد الإمام الحسين(عليه السلام)، فكلّهم مضوا مظلومين ومضطهدين؛ ليتجلّى بكلّ وضوح عندنا، أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) بقولها تُشير إلى الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)؛ لأنّه سيأخذ الثأر كاملاً، حتّى قال الإمام الحسين(عليه السلام) لبني أُميّة: (أَما والله، لا تذهب الدنيا حتّى يبعث الله منّي رجلاً، يقتل منكم ألفاً، ومع الألف ألفاً، ومع الألف ألفاً)[107]. كما وأنّ الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) ستكون له الخلافة التي هي إحسان إلهي، أي: الخلافة التي تأخذ حقّها الشرعي في مقامي الحكم والملك، وبالتالي يكون الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) هو الخلف الصالح لآبائه(عليهم السلام)، والذي ستكون إمامته خلافة على هذه الأرض.
إذاً؛ فالسيّدة زينب(عليها السلام)على بيّنة من أمرها فيما يخصّ هذا الإمام، حتّى أنّها في خطبتها في أهل الكوفة بمجرّد أن قالت: (فإنّه لا تحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثأر)، قال الإمام السجاد(عليه السلام) لها: (يا عمّة، اسكتي… وأنت بحمد الله عالمة غير معلّمة، فهمة غير مفهّمة… إنّ البكاء والحنين لا يردّان مَن قد أباده الدهر) [108]، ولعلّ الإمام لم يرِد أن تسترسل السيّدة زينب(عليها السلام) بالحديث عن الثأر ـ ثمّ أثبت بأنّها عالمة بهذا الأمر، فاهمة له ـ لأمرين:
الأمر الأول: كي لا يتّضح حديثها بأنّه عن الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، فيشتبه الناس بعد ذلك بأنّ المختار الثقفي هو المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، لكونه خرج أيضاً بشعار: (يا لَثارات الحسين)، بغض النظر عن نسبه، وهذا ما جعل السيّدة زينب(عليها السلام) تتكلّم فقط بالإشارات عن الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) بعد ذلك في خطبتها في الشام.
الأمر الثاني: يُحتمل أن يكون مراد الإمام زين العابدين(عليه السلام) أنّ أهل الكوفة وإن ندموا على غدرهم بالحسين(عليه السلام)، وأرادوا أن يُصلحوا ذلك في معركة التوابين ضدّ يزيد، والتي قُتل فيها جميعهم، إلّا أنّ غدرهم بالإمام الحسين(عليه السلام) سوف يترتّب عليه الأثر الوضعي، وهو دخول السفياني إلى الكوفة قُبيل الظهور، والفتك بأهلها، فلم يرد الإمام أن تسترسل عمّته(عليها السلام) في ذلك فتذكره؛ لأنّ هذا الأمر يؤذي أهل البيت(عليهم السلام)؛ لأنّ في الكوفة ضريح علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وأنّ أهل الكوفة في زمن الظهور سوف يكونون من الشيعة المخلصين لأهل البيت(عليهم السلام)، فكلّ ما يجري عليهم سيؤذي أهل البيت بلا شكّ.
أمّا العبارة المنسوبة للإمام السجاد(عليه السلام) في الرواية المتقدّمة، وهي قوله لعمته زينب(عليها السلام): (إنّ البكاء والحنين لا يردّان مَن أباده الدهر)، فنحن نضعها في محلّ إشكال؛ لأنّ الإمام السجاد(عليه السلام) كيف يقول ذلك، وهو الذي لم تهدأ عبرته، وكان يعمل على تهييج الحسرة والعبرة على أبيه الحسين(عليه السلام)، فكيف يُنكر على السيّدة زينب بكاءها وأنينها؟! ثمّ إنّ الإمام الحسين(عليه السلام) لم يُبده الدهر، بل قتله الناس ظلماً وعدواناً، وعبارة: (قتله الناس) هي عبارة الإمام السجاد(عليه السلام) لابن زياد؛ لرفع التشويش عن الأفكار، فكيف له أن يستسيغ ذلك بعبارة: (أباده الدهر)؛ لنفهم أنّ هذه العبارة دخيلة على الرواية.
إذاً؛ الإمام السجاد(عليه السلام) قال للسيّدة زينب(عليها السلام): (اسكتي… يا عمّة)، إمّا خوفاً عليها من شرطة الوالي، كما قال السيّد القزويني، أو كي لا تسترسل في الكلام عن الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، فيضع الناس الكلام في غير موضعه، ويطبّقونه على المختار فيما بعد.
النتيجة
لقد أكملنا بحثنا بحمد الله، مع أملنا بأنّه قد ارتقى إلى مستوى الخدمة للسيّدة زينب(عليها السلام)، وقد وصلنا فيه إلى عدّة نتائج، أهمّها:
1ـ إنّ تأخّر تسمية السيّدة زينب (عليها السلام) ، وانتظار الإمام علي والسيّدة الزهراء (عليهما السلام) لأمر رسول الله (صلى الله عليه واله) فيها؛ يدلّ على مدى احترامهما (عليهما السلام) لمقام النبوّة، فأمّ مريم العذراء ـ على الرغم من إيمانها ـ لم تصل إلى هذه المرتبة في احترامها لمقام النبوة، فهي التي أسمت ابنتها مريم، وقالت: (وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ) ، ولم تنتظر في تسميتها رأي نبي الله زكريا (عليه السلام). كما ويدلّ خبر تأخّر تسميتها على أنّ الإمام علياً والسيّدة الزهراء(عليهما السلام) على علمٍ بأنّ ذريتهما كلّها طاهرة، فينتظرون في تسميتهم أمر النبي(صلى الله عليه واله)، والنبي ـ كما أخبر تعالى ـ (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).
2ـ إنّ من ألقاب السيّدة زينب الكبرى أُمّ الحسن، ولعلّها لُقّبت بهذا اللقب؛ لأنّها ورثت عن أُمّها فاطمة الزهراء أُم الحسن (عليها السلام) مكارمها وعلمها.
3ـ إنّ البنت الثانية لعليّ والزهراء (عليهما السلام) ، والتي تُلقّب بأُمّ كلثوم ـ والتي نعتقد أنّه لمّا حجبها الإمام علي (عليه السلام) عن الأنظار بشكلِ طبيعي وغيبي ـ قد انتقل لقبها لأُختها السيّدة زينب الكبرى (عليها السلام) ، فلمّا أظهرها الإمام علي (عليه السلام) بعد مقتل عمر، أصبحتا مشتركتين بهذا اللقب.
4ـ إنّ حديث النبيّ (صلى الله عليه واله): (أوصي الشاهد والغائب من أُمّتي، وأخبروهم أن يُكرموا هذه الصبية؛ لأنّها تشبه خالتها أُمّ كلثوم) ـ الذي لا نعلم أنّه (صلى الله عليه واله) هل يقصد واحدة من بنات الزهراء (عليها السلام) ، الكبرى أو الصغرى؟ ـ نرى أنّه بحاجة إلى تكملة لم تُذكر؛ لأنّ الإكرام في الإسلام مقياسه التقوى وليس الشبه، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) ،وبذلك فالنبي(صلى الله عليه واله) إذا أمر بإكرامها فقد أمر بذلك لأجل تقواها وسموّها الذاتي، وليس للشبه فقط، وهذه هي العبارة المفقودة في الحديث على فرض صحّة السند.
5ـ إنّ من خلال مرافقة السيّدة زينب(عليها السلام) لأخيها الإمام الحسين(عليه السلام)، من دون زوجها، يتّضح لنا مدى أهمّية دورها في قضية الإمام الحسين(عليه السلام)؛ لأنّها لو كان معها زوجها لقيل: إنّ الدافع من مجيئها مع أخيها الإمام الحسين(عليه السلام)، هو مرافقة زوجها، كما كانت مع الإمام علي والإمام الحسن(عليهما السلام)، لكن لمّا لم يرافق زوجها الإمام الحسين(عليه السلام)، ورافقته هي وأولادها، تجلّت بكلّ وضوح أهمّية دورها في كفالة العيال وقيادتهم، وفضح بني أُميّة، وتهييج العَبرة على الإمام الحسين(عليه السلام)، واتّضح أنّ دورها هذا لم يأتِ عشوائياً، بل جاء عن تخطيطٍ إلهي مسبق.
6ـ إنّ السيّدة زينب (عليها السلام) كانت ملتزمة بالحجابين: الظاهري، وهو الملبس الساتر لجسدها، والباطني، وهو التقوى، ومن دلالات ذلك هو قول بشير بن خزيم الأسدي عن خطبتها في الكوفة: (ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذٍ، فلم أرَ خفرة والله أنطق منها). والخفرة: هي المرأة الشديدة الحياء، ومن المؤكّد قال ذلك؛ لأنّ عليها علامات المرأة المستحية، كأن تكون تتكلّم وهي مطرقة إلى الأرض، أو تنظر للنساء دون الرجال؛ تطبيقاً لقوله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) ، أو تكون محاولة لوضع الستر على وجهها وهي تخطب، فوصفها إثر ذلك بالخفرة، كما أنّه وصفها بأنّها تُفرغ عن لسان أبيها، أي: إنّها في منطقها ذات صلابة وبلاغة تُذكّر بصلابة وبلاغة علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وهذا من التقوى وهي الحجاب الباطن، لأنّ عكسه يكون الخضوع من قبل المرأة، وقد قال تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا).
7ـ إنّ ابن الأثير في (الكامل في التاريخ)، يتحدّث عن سلب النساء، قال: (ونهبوا ثقله ومتاعه وما على النساء، حتّى إن كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها، فيؤخذ منها)، ولعلّه يقصد في ذلك: سلبهنّ الإزار والنقاب، وليس الثوب الذي يستر أبدانهنّ؛ لأنّ سمعة وكرامة بنات محمد(صلى الله عليه واله) لا تسمح بهذا الشيء، والذي يتقرّر أنّ الله تعالى صرف عن نساء آل محمد كيد الأنذال، ولم يعرَّضن للسوء والفحشاء، كما صرف عن يوسف كيد النسوة، فقال: (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ) ، وقال: (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء).
8 ـ اهتمّ أهل البيت (عليهم السلام) بالحجاب؛ لأنّه انطلاقة المرأة نحو النجاح، سواء نجاحها في أُسرتها، أو في تحصيل العلم النافع، أو التعليم، فالالتزام بالحجاب سرّ من أسرار نجاحات السيّدة الزهراء (عليها السلام) ، وفضلها على جميع نساء الأوّلين والآخرين، كما وأنّه من أسرار نجاحات السيّدة زينب (عليها السلام) ، وفضلها على جميع نساء الأُمّة الإسلامية عدا أُمّها الزهراء (عليها السلام).
9ـ لقد استنتجنا أنّ الحجاب قد أثبتته التجربة؛ وذلك لأنّ الأشياء إذا أُسرف في صرفها المادي انقلبت إلى الضدّ، فمثلاً: الأنسان اللبق إذا تكلّم مع أيّ أحد يلقاه في البيت أو خارجه، فلا يقال عنه: إنّه لبق بعد ذلك، بل يقال عنه: إنّه ثرثار، والإنسان البشوش إذا تبسّم أو ضحك بوجه أيّ أحد يلقاه في البيت وخارجه، فلا يقال عنه: إنّه بشوش، بل يقال عنه: إنّه مجنون، وهكذا، وحتى المرأة إذا أظهرت مفاتنها لجميع مَن في البيت وخارجه، سيقال عنها: إنّها مبتذلة، وعندها تواجَه بالكلام المعسول ممّن في قلوبهم مرض، فتفسد ويفسد بها المجتمع، وهذا من أسباب تركيز أهل البيت(عليهم السلام) على الحجاب.
10ـ إنّ السيّدة زينب الكبرى لما قالت ليزيد في مجلسه: (أمِنَ العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقكَ بنات رسول الله سبايا؟!)، لا يعني ذلك أنّ يزيد ذو غيرة على نسائه، بل ـ وكما أثبتنا بالدليل ـ أنّه:
أولاً: حجب نساءه وخدّرهن؛ ليغيض الإمام زين العابدين(عليه السلام)، وبنات رسول الله(صلى الله عليه واله)، الذين ساقهم أُسارى.
ثانياً: إنّ الغيور هو الذي يغار على كلّ امرأة ، ويعتبر كلّ امرأة تخصّه، وبذلك فإنّ يزيد ليس بصاحب غيرة طالما سبى النساء، كيف وهؤلاء النساء هنّ بنات رسول الله(صلى الله عليه واله).
ثالثاً: إنّ الله تعالى قال: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)، وهذا الذي فعله يزيد، فقد خدّر نساءه، وسبى بنات رسول الله(صلى الله عليه واله)، مستهيناً بدين الله ورسوله؛ ليثبتَ بذلك عدم غيرته وفسقه وظلمه.
11ـ إنّ السيّدة زينب (عليها السلام) لما خاطبها ابن زياد بقوله: (كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت(عليهما السلام): ما رأيتُ إلّا جميلاً)، وهذا القول ـ حسب ما نعتقد ـ له ظاهرٌ وباطن، فأمّا ظاهره، فهو أنّها كانت ترى مصرع إخوتها وأهل بيتها بأنّه شيء جميل؛ لأنّه في سبيل الله تعالى، وأمّا باطنه، فإنّ ابن زياد سأل السيّدة زينب(عليها السلام) عن رؤيتها بالعين الطبيعية، فأجابته هي عن رؤيتها المكشوف عنها الحجاب، وكأنّها رأت الملائكة تُظلّلهم وأشياء من هذا القبيل؛ لأنّها فعلاً لم ترَ آنذاك إلّا الجمال الإلهي والرحمة الربانية بهم.
12ـ إنّ من العلوم التي تعلمها السيّدة زينب (عليها السلام) ، والتي استنتجناها من خطبتها في بحثنا، هي علمها بمراتب الموتى، وذلك من خلال قولها ليزيد: (وتهتف بأشياخك، زعمت أنّك تناديهم). فاتّضح من خلال قولها أنّها تعلم بأنّ أشياخ يزيد بين كافر ومنافق، لا يسمعون النداء، أو يشهدون الحدث؛ لأنّهم في المرتبة السفلى بسبب كفرهم ونفاقهم، ولأنّ الأموات درجات، وأعلى مرتبة هي درجة إلقاء السمع، وهي الشهادة على أعمال الخلق من خلالها، وهذه الصفة هي خاصّة بمحمد(صلى الله عليه واله) وأهل بيته والأئمة من ولده(عليهم السلام)، وهي المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ).
13ـ إنّ السيّدة زينب الكبرى(عليها السلام) في بعض العبارات التي في خُطبها أشارت إلى الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، وبشّرت بظهوره، وهذا ليس استنتاجاً خاصّاً بنا، فقد أشار السيّد محمد كاظم القزويني في كتابه (زينب الكبرى من المهد إلى اللحد) إلى ذلك في إحدى عبارات خطبها، وأضفنا على إشارته سبب ذهابنا إلى تطبيق هذه العبارات على الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، من ذلك توضيحنا بأنّ السيّدة كانت تتتوّق إلى أن ترى الإمامة حاكمة، فكان لا بدّ أن تُروى لها أخبار الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) الذي ستكون فيه الخلافة حاكمة، وهنالك كثير من العبارات تبيّن أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) عالمة بأخبار الأُمم السابقة ومطّلعة عليها، ولعلّ قولها ليزيد: (وجمعك إلّا بدد، يوم ينادي المنادي أَلا لعنة الله على الظالمين)، تقصد به يوم ظهور الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)؛ لأنّ أكبر معركة سيخوضها الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، هي مع السفياني، أي: من نسل آل أبي سفيان جدّ يزيد، وسينتصر الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، فلعلّ السيّدة زينب(عليها السلام) خاطبت يزيد بهذا القول لأنّ السفياني من نسله وحامل فكره، فيزيد سيُهزم به. كما أنّ من الصيحات التي ستُسمع قُبيل الظهور هي: (أَلا لعنة الله على الظالمين)، فلعلّ النداء الذي ذكرتهُ السيّدة زينب(عليها السلام) تقصد به هذه الصيحة قُبيل الظهور؛ كما أنّنا دلّلنا على ذلك بكلمة (ثأر) التي لا تُطلق إلّا على شيءٍ في الدنيا، وقد قالت السيّدة زينب(عليها السلام) لأهل الكوفة متوعّدة بعذاب الله: (ولا يخاف فوت الثأر)، وشرحنا مدى انطباق هذه العبارة على الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، وقد كان ذلك المطلب الأخير من بحثنا.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، 1970م.
2. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
3. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت279هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأُولى.
4. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، مؤسّسة الوفاء، الطبعة الثانية، بيروت ـ لبنان.
5. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أحمد بن محمد بن عجيبة (ت1224هـ)، القاهرة، 1419هـ.
6. البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774هـ)، مكتبة المعارف، بيروت، 1413هـ/1992م.
7. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي (ت1205هـ)، الطبعة الثانية، الكويت.
8. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 1407هـ/1987م.
9. تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة (بريل)، في مدينة ليدن، في سنة 1879م، موقع يعسوب.
10. تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت571هـ)، دراسة وتحقيق: علي شيري، دار الفكر، 1415هـ/1995م.
11. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ)، تحقيق: د. بشّار عوّاد معروف، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1406هـ/1985م.
12. تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري (ت370هـ)، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب.
13. خلاصة الأحكام في مهمّات السنن وقواعد الإسلام، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأُولى، لبنان ـ بيروت، 1418هـ/1997م.
14. الدر المنثور والتفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، مركز هجر للدراسات والبحوث العربية والإسلامية، الطبعة الأُولى، القاهرة.
15. روضة الواعظين، محمد بن الحسن الفتال النيسابوري (ت508هـ)، منشورات الرضي، طبعة المكتبة الحيدرية، قم ـ إيران.
16. زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد، السيّد محمد كاظم القزويني، تحقيق وتعليق: ولده مصطفى القزويني، دار المرتضى، بيروت.
17. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
18. سير أعلام النبلاء، حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 1412هـ/1993م.
19. شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي (ت656هـ)، الطبعة الأُولى، دار الكتاب العربي.
20. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، دار الفكر، طبعة بالأوفست على طبعة دار الطباعة العامرة باسطنبول، 1401هـ/1981م.
21. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت ـ لبنان.
22. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد (ت230هـ)، دار صادر، الطبعة الأُولى، بيروت، 1968م.
23. غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري (ت850هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأُولى، بيروت ـ لبنان، 1416هـ/1996م.
24. الغيبة، محمد بن إبراهيم النعماني (ت حدود 360هـ)، تحقيق: فارس حسّون كريم، أنوار الهدى، قم المقدّسة، الأُولى، 1422هـ.
25. الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، الطبعة الأُولى، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
26. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (ت711هـ)، دار صادر، الطبعة الأُولى بيروت.
27. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن طاووس، أنوار الهدى، الطبعة الأُولى، قم ـ إيران، 1417هـ.
28. المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ.
29. مفاتيح الغيب، محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي (ت606هـ)، دار الفكر، الطبعة الأُولى، 1041هـ.
30. موسوعة زينب الكبرى، السيّد علي عاشور، الطبعة الأُولى، بيروت ـ لبنان.
31. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت748هـ)، تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأُولى، 1382هـ/1963م.
32. الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك الصفدي (ت764هـ)، تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420هـ/2000م.
________________________________________
* العتبة العلوية المقدّسة/النجف الأشرف/ العراق.
[1] الزمر: آية10.
[2] البقرة: آية156ـ157.
[3] ابن حجر العسـقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج8، ص166.
[4] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج6، ص132ـ133. اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد ابن علي، الإصابة: ج8، ص166، ونقل السيّد علي عاشور تعليقاً على كلام ابن الأثير، فقال: (قيل: وقد سَهَا؛ فإنّ فاطمة التي طلبها الشامي بنت الحسين، لا بنت علي(عليه السلام)). عاشور، علي، موسوعة زينب الكبرى: ج1، ص16.
[5] عاشور، علي، موسوعة زينب الكبرى: ج1، ص33.
[6] اُنظر: المصدر السابق.
[7] اُنظر:المصدر السابق: ص11. القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص36.
[8] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص36 (الهامش)، نقلاً عن ناسخ التواريخ.
[9] آل عمران: آية36.
[10] الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة: ج13، ص230.
[11] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص37 (الهامش).
[12] الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج3، ص26.
[13] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص130. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج2، ص419 وغيرهما.
[14] اُنظر: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص120. النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي: ج5، ص122وغيرهم.
[15] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج6، ص218. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور: ج5، ص360. ابن عجيبة، أحمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ج2، ص52.
[16] عاشور، علي، موسوعة زينب الكبرى: ج2، ص62.
[17] الحجرات: آية13.
[18] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص38.
[19] المصدر السابق: ص38ـ 39 (الهامش).
[20] ذكرها ابن سعد في طبقاته ضمن النساء اللاتي لم يروين الحديث. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج8، ص463.
[21] عاشور، علي، موسوعة زينب الكبرى: ج1، ص11.
[22] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج6، ص132ـ133. اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد، الإصابة في تمييز الصحابة: ج8، ص166، نقلاً عن ابن الأثير.
[23] اُنظر: القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص36 (الهامش)، نقلاً عن ناسخ التواريخ.
[24] هكذا في المصدر، والصحيح: (أبوك).
[25] المصدر السابق: ص52، نقلاً ـ بتصرّف ـ عن كتاب زينب الكبرى للنقدي.
[26] المصدر السابق: ص49.
[27] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج5، ص25. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج2، ص297.
[28] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج30، ص18. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج3، ص117ـ 118.
[29] اُنظر: الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج6، ص15. الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص139.
[30] اُنظر: البخاري والبيهقي بالأرقام المتقدمة، وغيرهما من أصحاب السنن والصحاح.
[31] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص52.
[32] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج6، ص133.
[33] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص53.
[34] المصدر السابق: ص54.
[35] المصدر السابق: ص55.
[36] المصدر السابق: ص39 (الهامش).
[37] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص253. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص274.
[38] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص68، نقلاً عن: معالي السبطين للمازندراني: ج1، المجلس التاسع.
[39] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1، ص220.
[40] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص336.
[41] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج46، ص20.
[42] عاشور، علي، موسوعة زينب الكبرى: ج1، ص17.
[43] اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص58ـ60.
[44] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص298.
[45] الأحزاب: آية53.
[46] الأحزاب: آية59.
[47] الأعراف: آية29.
[48] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص335.
[49] (والخفرة: المرأة الشديدة الحياء). القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص28.
[50] النور: آية31.
[51] الأحزاب: آية32.
[52] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[53] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص183.
[54] يوسف: آية34.
[55] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص293.
[56] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج42، ص84. وذُكر هذا الحديث في بعض كتب أبناء العامة أيضاً بصيغ مختلفة.
[57] المصدر السابق: ج45، ص134.
[58] ابن أبي الحديد المعتزلي، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج20، ص116.
[59] التوبة: آية24.
[60] الزمر: آية10.
[61] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص115ـ 116.
[62] الإنسان: آية30.
[63] الأنعام: آية75.
[64] النحل: آية89.
[65] اُنظر: القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص54 (الهامش).
[66] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[67] النمل: آية80.
[68] فاطر: آية22.
[69] التوبة: آية84.
[70] التوبة: آية80.
[71] أبو زكريا، يحيى بن شرف، خلاصة الأحكام: ج2، ص1037، ورواه مسلم بلفظ: (إذا مات الإنسان). النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج5، ص73.
[72] التوبة: آية113ـ114.
[73] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج2، ص22.
[74] الواقعة: آية90ـ91.
[75] فاطر: آية22.
[76] النمل: آية80.
[77] آل عمران: آية169.
[78] البقرة: آية154.
[79] آل عمران: آية170.
[80] ق: آية37.
[81] البقرة: آية143.
[82] النحل: آية120.
[83] القصص: آية128.
[84] نوح: آية26ـ 28.
[85] يونس: آية88.
[86] البقرة: آية214.
[87] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد: ص285.
[88] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص116.
[89] المصدر السابق: ص157.
[90] المصدر السابق: ص134.
[91] آل عمران: آية178.
[92] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص158.
[93] المصدر السابق: ص134ـ135.
[94] آل عمران: آية169.
[95] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[96] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[97] المصدر السابق: ص105.
[98] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج21، ص104.
[99] النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص192.
[100] البقرة: آية30.
[101] النساء: آية54.
[102] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[103] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[104] النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة: ص181.
[105] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص109.
[106] المصدر السابق: ص135.
[107] المصدر السابق: ج51، ص134.
[108] المصدر السابق: ج45، ص164.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبياء
http://warithanbia.com/?id=2147
لینک کوتاه
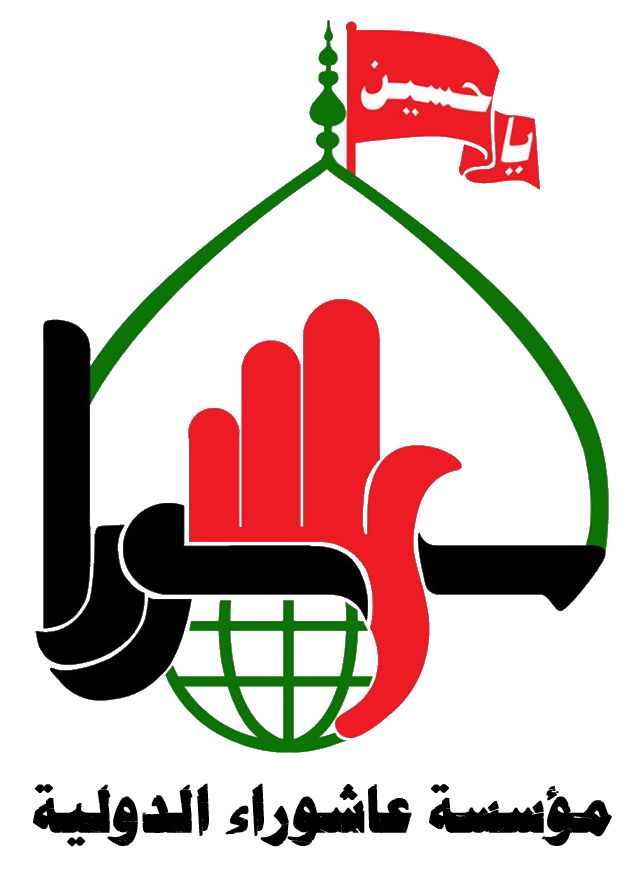
سوالات و نظرات