الآثار المعنوية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام في ضوء الآيات القرآنية – دراسة وصفية تحليلية – القسم الأول
{ د. الشيخ أسعد علي السلمان – باحث إسلامي وأُستاذ في جامعة المصطفى(صلى الله عليه واله) العالمية، من العراق. }
مقدّمة
إنّ الدارس والمتابع لمجريات واقعة عاشوراء يجد بأنّها امتلكت مقوّمات عديدة:
منها شخصية قائدها وحامل لوائها الإمام الحسين(عليه السلام)، فهو سبط النبي الأكرم(صلى الله عليه واله)، الذي شهد القاصي والداني بأنّه(عليه السلام) من خيرة الناس.
ومنها ـ أيضاً ـ أهداف النهضة الواضحة والجلية التي تصبّ في الصالح العام للأُمّة الإسلامية.
ومنها ـ كذلك ـ نوع المحاربين المشاركين في صفّ الإمام الحسين(عليه السلام)، فقد كان جلّهم من الأفذاذ المعروفين بالورع والتقوى والشجاعة والبسالة، سواء أكانوا من أهل بيته(عليه السلام) أم من أنصاره وأصحابه (رضوان الله تعالى عليهم).
ومن تلك المقوّمات ـ أيضاً ـ الصفات التي اتّصف بها الطرف المقابل، فقد كان رأس الهرم فيه هو يزيد الفاسد الفاجر، الذي أخذ له أبوه معاوية البيعة إمّا بالإكراه أو بالإغراء، والذي ـ لشدّة فسقه ـ لم يدافع عنه حتّى أميره والي المدينة عندما قال له الإمام الحسين(عليه السلام) قولته المشهورة: «يزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله»[1]، ومن تلك الصفات الأفعال الحقيرة والخسيسة التي قام بها الجيش السفياني في هذه المواجهة التي مارسوا فيها أشدّ أنواع التنكيل، من قبيل: حرمان الإمام الحسين(عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه من الماء، هذا السلاح المحظور دينياً وإنسانياً على مرّ العصور والأزمان، وكذلك قتل الأطفال الرضّع والنساء، وهتك الحرمات الدينية من خلال قطع الرؤوس والطواف بها في المدن والأمصار، والتمثيل بالجثث، وغير ذلك من الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية.
إنّ جميع ما ذُكر من هذه المقوّمات، كان هو السبب الرئيس وراء الانتصار المعنوي الذي حصل لجبهة الحقّ الممثّلة بالإمام الحسين(عليه السلام) ومَن معه، وفي ذات الوقت الذي كان يعيش فيه قادة الطرف المقابل زهو الغلبة الظاهرية من الناحية العسكرية، وقد استمرّ هذا الانتصار إلى يومنا هذا، وسيستمرّ بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة، هذا الانتصار الذي جعل من هذه الواقعة نهضة معطاء تزخر بالآثار المهمّة والحيوية على الصعيدين المادّي والمعنوي، فهي بحقّ مدرسة في الدين، والأخلاق، والعلم، والثورة، والحبّ، والتضحية، مدرسة تصلح لكلّ زمان ومكان.
ثمّ إنّه ونظراً لكثرة الآثار الناتجة عن هذه الدراسة التي تُضاف إلى جملة الدراسات الساعية إلى تبيين قرآنية النهضة الحسينية على مستوى الأهداف والمنطلقات، أو الأفعال والسلوكيات، أو الآثار والمخرجات، فقد ارتأينا تحديد دائرة البحث في المقام بعرضٍ وتبيينٍ لخصوص الآثار المعنوية التي ذكرها القرآن الكريم في آياته المباركة. فعلى الرغم من أنّ «الهيكل العظمي ـ إذا صحّ التعبير ـ للثورة هو أحداثها المادّية التي تقع في الزمان والمكان… ولكنّ هذه الأحداث وحدها، مجرّدة عن علاقاتها بالذهنية العامة للأُمّة، ومجرّدة عن انفعال الأُمّة بها ونوع استيعابها لها، لا معنى لها ولا دلالة… إنّ لحم الأحداث وعصبها ودمها هو مظاهر انعكاساتها في الذهنية العامّة للأُمّة، وردود الفعل التي بعثها في نفوس مختلف الفئات توقع الثورة. ثمّ ردود الفعل التي بعثتها الثورة بعد أن وقعت. إنّ الثورة بهذا الاعتبار… تكون مؤثّرة وفاعلة في محيطها البشري، وبهذا الاعتبار تأخذ مكانها في التاريخ الحيّ للأُمّة»[2].
وحتّى يكون طرحنا في هذا المقال منظّماً وسلساً سوف نوزّع الحديث عن الآثار المعنوية المشار إليها على أربعة محاور، هي:
المحور الأوّل: الآثار المرتبطة بالجانب العقدي.
المحور الثاني: الآثار المرتبطة بالجانب الأخلاقي.
المحور الثالث: الآثار التي تعدّ مسائل حيوية في المنظومة الدينية.
المحور الرابع: الآثار المرتبطة بالجانب الحماسي والثوري.
هذا، وإننا لا ندّعي القدرة على استيعاب جميع الآثار المشار إليها في هذا المقال؛ وذلك للبركات غير المحدودة المترتّبة على هذه النهضة الخالدة؛ ومن هنا كان بناؤنا في المقام على القيام بعرض جملة من الآثار المهمّة والحيوية في كلّ محور من المحاور المذكورة، متّبعين بذلك المنهج الوصفي التحليلي الذي نسعى فيه إلى تبيين ظاهرة التماهي الحاصلة بين القرآن الكريم والنهضة الحسينية، هذا التماهي الذي يجعل من النهضة المباركة مصداقاً للمعية التي أقرّها الرسول الكريم(صلى الله عليه واله) في حديث الثقلين المتواتر.
المحور الأوّل: الآثار المعنوية المرتبطة بالجانب العقدي
إنّ الذي يستذكر أحداث واقعة الطفّ وما رافقها من كلمات وسلوكيات قائدها الإمام الحسين(عليه السلام) يجد أنّها مدرسة عقائدية، ثمرتها صقل عقيدة الفرد المسلم وتعميقها في مجال العقائد المرتبطة بالمبدأ والمعاد؛ فإنّ الدمج بين بُعدي العقيدة والتضحية له دلالات عميقة وآثار راسخة، خصوصاً إذا صدر هذا الفعل من شخصيةٍ كشخصية الإمام الحسين(عليه السلام)، التي لاقت بسبب منزلتها من رسول الله(صلى الله عليه واله)، وعدم مفارقتها للقرآن، والمظلومية التي وقعت عليها، مقبولية واسعة عند الجميع.
هذا، وأنّ الآثار والثمار المعنوية المرتبطة بهذا المجال نجدها كالآتي:
1ـ ترسيخ عقيدة التوحيد
إنّ توحيد الباري(عز وجل) هو من أكثر العقائد التي وجدت رواجاً في الآيات القرآنية، وقد تنوّع الحديث القرآني عن هذه العقيدة من أبعادٍ شتّى، فمن تلك الآيات ما تطرّقت إلى التوحيد في مقام الذات، كقوله تعالى: (وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) [3]، وقوله تعالى: (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) [4]. ومنها ما يدلّ على التوحيد في مقام الصفات، كقوله تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)[5]، وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا)[6]، ومنها ما يدلّ على التوحيد في الخالقية، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله)[7]، أو على التوحيد في التدبير والربوبية، كقوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ)[8].
والنوع الأخير من التوحيد الذي يعتبره القرآن الأصل المشترك بين جميع الشرائع السماوية هو التوحيد في العبادة، قال تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا)[9]. ومن أجل هذا النوع من التوحيد الإلهي فقد دفع الأنبياء(عليهم السلام) أثماناً باهظة، من مضايقات وإبعاد وتشريد، بل وإلى إزهاق أرواحهم في أحيان كثيرة. خذ مثلاً ما جرى للنبي إبراهيم(عليه السلام)، الذي عرّض نفسه للهلاك من أجل الدفاع عن هذا المبدأ، قال تعالى حكاية عمّا جرى بعد قيامه(عليه السلام) بتكسير الأصنام: (قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ * قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ)[10].
هذا، ونجد أنّ توحيد الباري قد تجلّى بأنواعه العديدة في نهضة الإمام الحسين(عليه السلام)، فهو قبل أن يكون إماماً في السلوك والأخلاق والفضائل، كان إماماً في التوحيد والعقيدة والإيمان، فقد علّمنا (صلوات الله عليه) أدب التكلّم مع الله تعالى، يكفيك من ذلك دعاؤه(عليه السلام) المعروف يوم عرفة، الذي جاء في بعض فصوله: «كيف يستدلّ عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظّهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليلٍ يدلّ عليك؟ ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي الّتي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً…»[11]. فإنّ هذا الكلام يدلّ ـ بأروع ما يمكن ـ على التوحيد الذاتي (نفي المثل والشريك عن الذات المقدّسة)، وهو البرهان نفسه الذي تجلّى في قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)[12].
وأمّا فيما يخصّ أنواع التوحيد الأُخرى، فقد ورد عنه(عليه السلام) في مقام التوحيد الصفاتي ما نصّه: «يا مَن لا يعلم كيف هو إلاّ هو، يا مَن لا يعلم ما هو إلاّ هو، يا مَن لا يعلمه إلاّ هو، يا مَن كبس الأرض على الماء وسدّ الهواء بالسّماء، يا مَن له أكرم الأسماء…»[13]. وفي مقام التوحيد في الخالقية والمدبّرية، فقد ورد عنه(عليه السلام) في الدعاء ذاته: «اللّهمّ لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعاً بصيراً، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقاً سويّاً رحمةً بي، وقد كنت عن خلقي غنيّاً، بما برأتني فعدّلت فطرتي. ربِّ بما أنشأتني فأحسنت صورتي، ربِّ بما أحسنت إليّ وفي نفسي عافيتني…»[14]، إلى غير ذلك من المفاهيم التوحيدية التي وردت في هذا الدعاء القيّم، والتي تحتاج إلى عمل مستقل من أجل استجلائها والوقوف على آحادها.
كان ما مضى من الحديث متعلّقاً بشخصية الإمام الحسين(عليه السلام) العامّة، أمّا فيما يرتبط بنهضته المباركة، فإنّ الذي يرصد كلماته وتحرّكاته(عليه السلام) بعد رفضه لبيعة يزيد وإلى يوم شهادته على صعيد كربلاء، يجد أنّها مفعمة بالإقرار بالتوحيد، فمنها ما جاء في بداية الكتاب الذي كتبه(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية، الذي جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية: أنّ الحسين(عليه السلام) يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله»[15]. ومنها قوله(عليه السلام) يوم عاشوراء: «صبراً على قضائك يا رب، لا إله سواك، يا غياث المستغيثين، ما لي ربّ سواك، ولا معبود غيرك»[16].
ولم يقف هذا المدد التوحيدي النابع من نهضة الحسين(عليه السلام) على حدود المواجهة المباشرة بينه(عليه السلام) وبين خصومه، بل استمرّ حتّى في أحداث السبي المروّعة؛ إذ نطالع في هذا المجال ما جرى بين الإمام زين العابدين(عليه السلام) وبين عبيد الله بن زياد (لعنه الله)؛ وذلك عندما: «التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين(عليهما السلام)، فقال: مَن هذا؟ فقيل: علي بن الحسين. فقال: أليس قد قتل اللهُ علي بن الحسين(عليه السلام)؟ فقال علي(عليه السلام): قد كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، قتله الناس. فقال: بل الله قتله. فقال علي(عليه السلام): (الله يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)»[17]. فقد عمد(عليه السلام) في كلامه هذا إلى إثبات أمرين، أوّلهما: إرجاع جميع الأفعال إلى الله(عز وجل)، وأنّ أيّ مخلوقٍ لا يمكنه الاستقلال بشيء من الفعل من دون إذن الله ومنحه القدرة على الإتيان به؛ وهذا هو التوحيد الأفعالي[18].
ثانيهما: هو نفي عقيدة الجبر التي ذهب إليها الأشاعرة، وكان لبني أُمّية سعياً حثيثاً من أجل ترسيخها في عقول الناس؛ إذ كانوا يوهمون الناس بأنّ جميع الأفعال التي تصدر من الناس هي صادرة من الله تعالى وليس لأحد دور في تغييرها[19]؛ ومن هنا فإنّ مقصود الإمام(عليه السلام) من دمجه بين هذين البُعدين هو تصحيح فكرة التوحيد الأفعالي بما ينسجم مع عدل الله(عز وجل) في إثابة المطيعين ومعاقبة العاصين بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنهم بإرادتهم واختيارهم؛ وتقديم هذه العقيدة خالية ومنزّهة من كلّ شائبة من شوائب الجبر الأشعري.
فما نريد قوله ـ في هذه النقطة ـ هو: إنّ النهضة الحسينية في سعيها الحثيث لتركيز هذه المفاهيم التوحيدية في نفوس الناس، تُحقّق الغاية نفسها التي أشار إليها القرآن وجعلها هدفاً لكلّ الرسالات السماوية، خصوصاً مقام التوحيد في العبادة الذي سعت رسالات الأنبياء(عليهم السلام) إلى ترسيخه في نفوس الناس.
هذا، ويُضاف إلى هذا الترسيخ النظري لعقيدة التوحيد، السلوك الخارجي له(عليه السلام) ولصحبه، والذي كان له الأثر المعنوي الأعظم في ذلك، فقد نُقل أنّه(عليه السلام)بعث أخاه أبا الفضل العباس(عليه السلام) إلى القوم ليطلب منهم أن يمهلوه إلى صبيحة يوم العاشر لكي يصلّي ويدعو الله في هذه الليلة، فلمّا وافقوا على الطلب، بات(عليه السلام) هو وأصحابه تلك الليلة بين راكع وساجد، وكان لهم دويّ كدوي النحل[20]؛ وهذا الفعل هو قمّة العبادة الخالصة والانقطاع الكامل لله(عز وجل).
2ـ ترسيخ الاعتقاد باليوم الآخر
إنّ التدليل العقلي على مسألة المعاد واليوم الآخر وإن كان له الأثر الكبير جدّاً في إثبات هذه العقيدة ودحض الشبهات التي يمكن أن تُثار حولها، إلّا أنّه غير كافٍ في جعلها تجسيداً حيّاً يعيش في ضمير الفرد وروحه، فإنّنا نحتاج علاوةً على البُعد العقلي إلى بُعد آخر، وهو عبارة عن المشاهدة الحسّية، كما جرى في حادثة ذبح الطيور من قِبل إبراهيم الخليل(عليه السلام) الذي لم يكن يعوزه الدليل العقلي، فقد كان واصلاً إلى درجة اليقين، لكن هذا اليقين لم يكن كافياً في حصول الاطمئنان القلبي والروحي لديه؛ لذلك احتاج إلى ضميمةٍ لهذا اليقين العقلي، قال تعالى حكاية عنه(عليه السلام): (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)[21]. لكنّ هذه المشاهدة الحسّية لا تتأتّى لكلّ أحد؛ ومن هنا جاء دور التأثير المعنوي والروحي في هذا المجال، وقد كان من تجلّياته الواضحة نهضة الإمام الحسين(عليه السلام) التي تُعدّ تجسيداً واقعياً للاعتقاد الخالص بالمعاد، فقد عاش الإمام(عليه السلام) وأهل بيته وصحبه أروع صور هذا الاعتقاد؛ وأقوالهم وتضحياتهم خير شاهد على هذا الانصهار بهذه العقيدة، ممّا يجعل استحضار مجريات واقعة الطفّ الأليمة ذا دورٍ كبيرٍ في جعل هذه العقيدة تعيش في وجدان الفرد والمجتمع باستمرار.
ومن الكلمات التي قيلت في هذا الصدد، ما جاء في الوصية التي كتبها الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية، التي جاء فيها بعد الإقرار بالوحدانية ونبوّة النبي محمد(صلى الله عليه واله): «… وأنّ الجنّة والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور»[22]. ومنها ما جاء عنه(عليه السلام) في معرض حديثه عند سماعه خبر استشهاد سفيره إلى أهل الكوفة مسلم بن عقيل: «رحم الله مسلماً، فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنّته ورضوانه»[23]. كما نُقل عنه(عليه السلام) أنّه كان يُكثر من قول: (إنّا لله وإنّا إليه راجعون)، ففي مجلس الوليد والي المدينة بعدما أخبره الأخير بموت معاوية، قال(عليه السلام) هذه العبارة[24]، وقالها أيضاً في طريقه إلى الكوفة بعد تجاوزه لقصر بني مقاتل، فبعد أن خفق الإمام(عليه السلام) برأسه خفقةً انتبه وهو يقول: «إِنّا للهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُون، وَالْحمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ»[25]. كما أنّه(عليه السلام) ذكّر بهذه العقيدة عندما خاطب الأعداء الذين حالوا بينه وبين رحله يوم عاشوراء، فقد قال: «ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً»[26].
والمعنى نفسه نجده في كلام السيّدة زينب(عليها السلام) عندما ردّت على اللعين عبيد الله ابن زياد الذي أظهر الشماتة لأخيها الإمام الحسين(عليه السلام) بسبب ما جرى في كربلاء، وأراد أن يوهم الجميع بأنّ العمل الذي قام به من الأفعال الحسنة الحاصلة على التأييد الإلهي، فقد قال: «كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قوم كُتِبَ عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاجّ وتخاصم، فاُنظر لـمَن الفلج، هبلتك أُمّك يا بن مرجانة…»[27]. إلى غير ذلك من الأقوال التي أكّدت محورية هذه العقيدة في واقعة الطف الخالدة.
وهذا التأكيد كان نابعاً في حقيقته من سنّة قرآنية كانت تسعى دوماً إلى ربط الإنسان في هذه الدنيا الفانية بموقف عصيب سوف يتحقّق في نشأة أُخرى، تتجلّى فيه عدالة الله(عز وجل) ورحمته على العباد. فإنّ مَن يطالع الآيات المباركة في القرآن الكريم يجد أنّ الإيمان باليوم الآخر حاضر ومركّز عليه فيها، وأنّ هذا الكتاب العظيم قد أولاها اهتماماً واسعاً، وذِكراً متكرّراً؛ وذلك لما تُشكّله من أهمّية كبرى، ووجود عظيم، في العقيدة الإسلامية، بل في حياة البشرية منذ بدء خلقها وحتّى يوم الحساب. ولشدّة التركيز عليها وتكرارها في القرآن نراها تُشكّل الاهتمام الثاني له بعد عقيدة التوحيد، وبالشكل الذي لا يضاهيه ولا ينافسه أيّ شيء آخر؛ ففي حدود (1400) آية مباركة من القرآن الكريم ورد الحديث والاشارة إلى المعاد والأُمور المرتبطة به[28]، بل إنّه ورد في الآيات الشريفة ما يقارب السبعين اسماً أو وصفاً له، «إنّ كلّ ذلك يبيّن بجلاء ما لهذا الأمر من الأهمّية القصوى والعظمى في نظر الشريعة؛ وبالتالي ما يلفت نظر الإنسان في هذه الأرض إلى حقيقة وأبعاد هذا الأمر، ومن ثَمَّ ما يترتب عليه ـ أي: الإنسان ـ من مسؤوليات جسام، والتزامات عظام؛ للفوز والنجاة من حساب هذا اليوم، والتنعّم بالحياة الخالدة من بعده في جنات النعيم»[29].
ففي أوّل سورة من القرآن نجد الإشارة الواضحة إلى هذه العقيدة، فقد ذُكرت ضمن مجموعة من صفات الباري جلّ شأنه، قال تعالى: (مـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)[30]، ثمّ توالت الآيات القرآنية التي أكّدت هذه الحقيقة؛ فمن صفات المتّقين التي تمّ التطرّق إليها في بداية سورة البقرة هو الإيمان باليوم الآخر، قال تعالى: (والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)[31]. ثمّ الآيات التي وصفت يوم القيامة وذكرت شيئاً من أحواله وأهواله، قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا…) [32]، وقال تعالى أيضاً: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ)[33]. وهكذا تتوالى الآيات الكثيرة وصولاً إلى الوعيد والتهديد بالعذاب والويل بحقّ منكر هذه العقيدة، قال تعالى: (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ)[34]، وقال أيضاً: (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ)[35]. وما هذه التأكيدات الكثيرة الواردة في القرآن إلّا من أجل الإجابة عن سؤال فطري، وهو: ما هو مصير الإنسان بعد هذه الحياة؟ فإنّ الإنسان جُبل على حبّ البقاء وكراهة الزوال والفناء، وهذا الميل أوضح دليل على أنّ الموت ليس فناء للإنسان، فلو كان الموت مؤدّياً إلى ذلك للزم منه عبثية هذا الميل المشاهد عند كلّ إنسان، وبالنظر إلى ذلك نجد أنّ الشرائع السماوية جاءت تُفسِّر هذا الميل الفطري ببيان أنّ الموت هو انتقال من دار إلى دار، ومن نشأة إلى نشأة أُخرى، وأنّ الإيمان هو الركن الركين في العقائد على وجه لو طُرح انهارت الشرائع قاطبة[36].
ومن هنا؛ فإنّ هذا الأثر المعنوي المهمّ الذي تركته النهضة الحسينية بخطاباتها وبسلوكيّاتها التي عبّرت عنها التضحيات الجسام، هو أثر قرآني يصبّ في مصلحة بقاء الشرائع الدينية، وهو أثر يتوقّف عليه ـ من هذا المنظار ـ مصير الدعوة الإسلامية، ولعلّ هذا الأمر هو أحد الأسرار التي تُشير إليه العبارة المشهورة: (الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء)، فإنّ رسوخ هذا الأثر في نفوس المؤمنين الشيعة المتأثّرين بمفاهيم النهضة الحسينية، هو الذي جعلهم يتهافتون إلى تقديم أروع صور التضحية والشهادة من أجل نصرة دين الحقّ، والذبّ عن أعراض المسلمين وأموالهم. وليس ببعيد عنّا ما قدّمه الشباب الحسيني المخلص في المواجهة المعاصرة ضدّ فلول داعش الأرجاس، فإنّ استجابتهم المذهلة لفتوى الجهاد الكفائي لسماحة آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه)، هو في الحقيقة ناشئ من العلاقة الكبيرة بينهم وبين واقعة الطفّ، وأنّهم بمشاركتهم في الجهاد واستشهادهم في سوح القتال، سوف يحقّقون نوعاً من السنخية مع شهداء هذه الواقعة الخالدة، فيحصلون على الدرجات العالية في ذلك اليوم الآخر.
3ـ ترسيخ العقائد الأُخرى
نستمرّ مع العطاء المعنوي العقائدي للنهضة الحسينية، إلّا أنّه نظراً لضيق المجال فإنّنا سوف نُجمل الحديث عن العقائد الأُخرى التي كانت هذه النهضة المعطاء سبباً في تدعيمها وتقويتها في نفوس الناس، سواء كان ذلك على مستوى إثبات النبوّة أو إثبات الإمامة، فمن تلك الإيحاءات العاشورائية التي تُرسّخ في النفوس هذه الأمور المهمّة في عقيدة الفرد المسلم نجد أنّه(عليه السلام) قد صدرت منه تأكيدات كثيرة، ربطت نهضة عاشوراء بإحياء سنّة النبي(صلى الله عليه واله) ومواجهة البدع التي أُوجدت في الدين الإسلامي، ومن هذه التأكيدات ما صدر عنه(عليه السلام) في مجلس الوليد بن عتبة والي المدينة، فقد قال له(عليه السلام): «أيّها الأمير، إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، مُعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله…»[37]. فهذا الكلام الذي يُتلى في كلّ موسم عاشورائي فيه تأكيد واضح على مسألة النبوّة، وأنّها أحد الأسباب التي جعلت الإمام(عليه السلام) يرفض مبايعة يزيد، فإنّ خلافة هذا الفاسق كانت تؤدّي إلى طمس معالم السنّة، وتغييب مفهوم النبوّة في المجتمع الإسلامي؛ كيف لا؟ ونحن نجد أنّ الطاغية المتهتّك عندما وصله خبر قتل الإمام(عليه السلام) ومَن معه استشهد بأبيات ابن الزِّبَعْرَى التي منها::[38]
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل
ومن تلك الإيحاءات ما ذكره(عليه السلام) في وصيّته لأخيه محمد بن الحنفية، «وأنّي لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا مُفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي، أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب(عليهما السلام)»[39]. فإنّ السير على سيرة الرسول الكريم محمد(صلى الله عليه واله) دليل على أنّ الطرف المقابل كان يحرف مسار الأُمّة الإسلامية على عكس ذلك، هذا الفعل الذي يُفضي في نهاية المطاف إلى إلغاء كلّ الجهود التي بذلها النبي(صلى الله عليه واله) في تبليغ الدين والتعاليم الإسلامية إلى الناس، وبالنتيجة تغييب عقيدة النبوّة تماماً عن النفوس، أو جعلها هامشية خالية من كلّ أثر.
ولشدّة اهتمامه(عليه السلام) بهذا الأمر نجده يُضمّنه في رجزه الذي أنشده عندما حمل على القوم ظهر يوم عاشوراء: [40]
أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني
أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي
وهذا الأثر المهمّ المترتب على نهضته(عليه السلام) قد تمّ التأكيد عليه قرآنياً بشكل كبير جدّاً، ففي مجال أنّ النبوّة والرسالة هي حقّ ثابت للرسول الكريم محمد(صلى الله عليه واله)، يقول تعالى: (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)[41]. وأمّا في مجال مواقف النبيّ الرافضة لكلّ الأطروحات الهدّامة، والساعية إلى نقض الهدف من الرسالة يقول تعالى: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ)[42]. وفي مجال ضرورة التأسّي بالنبيّ(صلى الله عليه واله)، والاستنان بسيرته وسنّته يقول(عز وجل): (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ…)[43].
أمّا فيما يتعلّق بمنصب الإمامة لأهل البيت(عليهم السلام) بعد النبي(صلى الله عليه واله)، فقد كانت نهضة عاشوراء تجسيداً واضحاً لإثبات هذا الحقّ لهم(عليهم السلام)، فإنّ رفض الإمام لبيعة يزيد كان سببها هو رؤيته(عليه السلام) بأحقّيته لتولّي زمام هذا الأمر، وقد صرّح بذلك عندما لقي جيش الحرّ في الطريق، فكان فيما قال في تلك الأثناء: «أمّا بعدُ، أيّها الناس، فإنّكم إن تتّقوا الله تعالى، وتعرفوا الحقّ لأهله، يكن رضاء الله عنكم، وإنّا أهل بيت نبيِّكم محمد(صلى الله عليه واله) أولى بولاية هذه الأُمور عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالظلم والجور والعدوان»[44]. كما أنّ هذا المعنى نفسه قد ورد في رسالته(عليه السلام) التي كتبها إلى بعض أشراف الكوفة في أحد المواضع القريبة من كربلاء، وقد ورد في بعضها قوله(عليه السلام): «وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولّوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا في الأرض الفساد، وعطّلوا الحدود والأحكام، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وإنّي أحقّ بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله(صلى الله عليه واله)»[45].
ولم يتوقّف هذا المعنى عند شخص الإمام(عليه السلام) وحده، بل إنّه ترسّخ في نفوس أصحابه(عليه السلام)، فنُقل عن بعضهم، وهو يزيد بن المهاجر الكندي، أنّه خاطب رسول عبيد الله بن زياد الذي جاء برسالة إلى الحرّ الرياحي يأمره فيها أن يُجعجع برحل الإمام(عليه السلام)، فخاطبه قائلاً: «ثكلتك أُمّك، ماذا جئت فيه؟ قال: أطعت إمامي ووفيت ببيعتي. فقال له ابن المهاجر: بل عصيت ربّك، وأطعت إمامك في هلاك نفسك، كسبت العار والنار، وبئس الإمام إمامك، قال الله عزّ من قائل: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ)[46]، فإمامك منهم»[47]. بل حتّى أعداؤه يقرّون بهذا الحقّ لهم(عليهم السلام)، لكنّ سوء العاقبة منعهم من مناصرة هذا الحقّ واتّباع المنهج الحسيني؛ إذ تذكر بعض المصادر أنّ برير بن خضير الهمداني قد استأذن الإمام(عليه السلام) قبل المعركة بأن يتكلّم مع عمر بن سعد، فأذن له، ولما وصل إلى عمر بن سعد، لم يُسلّم عليه، فبادره عمر بقوله: «يا أخا همدان، ما منعك من السلام عليّ؟ أَلستُ مسلماً أعرفُ الله ورسوله، وأشهدُ بشهادة الحقّ؟ فقال له برير: لو كنتَ عرفتَ الله ورسوله كما تقول، لما خرجتَ إلى عترة رسول الله تُريد قتلهم؟… فأطرق عمر بن سعد ساعة إلى الأرض، ثمّ رفع رأسه، وقال: والله يا برير، إنّي لأعلم يقيناً أنّ كلّ مَن قاتلهم وغصبهم حقّهم هو في النار لا محالة، ولكن يا برير، أَتشير عليّ أن أترك ولاية الري فتكون لغيري؟ فوالله، ما أجد نفسي تُجيبني لذلك»[48].
وهذا هو المفهوم الذي سعى الإمام(عليه السلام) وأصحابه إلى ترسيخه في نفوس الناس من خلال أقوالهم وسلوكيّاتهم وتضحياتهم، وهو مفهوم حياتي يرتبط بجانب عقدي، يتعلّق بضرورة تنفيذ وصيّة رسول الله(صلى الله عليه واله) بالرجوع إلى ولاة أمره من بعده، ويرتبط بجانب عملي مؤدّاه أنّ الحافظ لهذا الدين الذي فيه سعادة الدارين هو الرجوع إلى أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) الذين منهم الحسين(عليه السلام)، فهم السبيل الوحيد لعدم تحقّق الخلاف والفرقة بين الناس، وكذلك هم السبيل للنجاة يوم القيامة.
هذا المفهوم على الرغم من أنّ القرآن لم يتعرّض إلى تفاصيله، ولم يُعيّن مصاديقه، حاله حال النبوّة والكثير من الضروريات الدينية، أمثال: الصلاة، والحج، والزكاة، وغير ذلك؛ إلّا أنّ التأكيد نجده واضحاً في جملة من الآيات الشريفة على أنّ الطاعة التي هي من شؤون القيادة وإدارة شؤون الأُمّة، تلزم على جميع المسلمين تجاه فئة خاصّة من المجتمع، قال تعالى: (أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ…)[49]، فبالنظر إلى دمج إطاعة النبي(صلى الله عليه واله) بإطاعة أُولي الأمر، وبملاحظة القاعدة القرآنية التي ساقتها الآية الشريفة: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [50]، من لزوم الأخذ بكلّ ما يقوله الرسول(صلى الله عليه واله)، يتّضح لنا أنّ المراد بأُولي الأمر هم طبقة من الناس يتّصفون بعدم الوقوع بالخطأ حالهم حال رسول الله(صلى الله عليه واله). وطبيعي أنّ الاستدلال لا يكتمل ولا يثبّت إمامة أهل البيت(عليهم السلام) إلّا بالرجوع إلى جميع الأدلّة الروائية والمواقف الصادرة عن الرسول(صلى الله عليه واله)، التي تُثبت أنّ الإمامة هي منصب إلهي لهم(عليهم السلام). وبما أنّ الخوض في تفاصيل هذا المطلب يؤدّي إلى خروجنا عن موضوع البحث، فنكتفي بما ذكرناه؛ لأنّه يؤدّي الغرض المطلوب في المقام، وهو معرفة أنّ القرآن يؤكّد على حقيقة الإمامة وضرورتها بعد الرسول(صلى الله عليه واله).
وهذا البيان القرآني يحثّ الفرد المسلم على عدم الرضا بالسطحية الموجودة في مقام تشخيص مَن هم ولاة الأمر بعد الرسول(صلى الله عليه واله)، وهل هم جميع مَن وصلوا إلى سدّة الحكم على الرغم من الملاحظات الكثيرة على الأعمّ الأغلب منهم، حتّى وصل الأمر ببعضهم إلى الفسق والفجور، والتجاهر بشرب الخمر أمّ أنّهم أشخاص معينون يتّصفون بصفات خاصّة تؤهّلهم لتولي منصب خلافة الرسول(صلى الله عليه واله)؟
ومن هنا؛ فدور القرآن في تأكيده على هذا المفهوم عندما يجتمع مع ما تقدّم بهذا الشأن في نهضة الحسين(عليه السلام) يكون حافزاً وأثراً معنوياً يدفع بالإنسان إلى اتّباع الأئمّة الواقعيين ومَن يسيرون على نهجهم. ولا شكّ في أنّ هذا الأثر المعنوي إذا اجتمع مع شجاعةٍ وإقدامٍ، فإنّه لا ينفكّ عن الرفض والمقاومة لجميع المخالفين لخطّ الإمامة من أصحاب السلوكيات المنحرفة والمطامع الشخصية.
المحور الثاني: الآثار المعنوية المرتبطة بالجانب الأخلاقي والتربوي
إنّ المجتمع البشري كلّما انغمس في الحياة المادّية، وأصبح يحسب لكلّ شيء حساباً مادّياً يستند إلى منطق الربح والخسارة، نراه يبتعد شيئاً فشيئاً عن القيم الأخلاقية والتربوية، ويتعامل معها بشكل نفعي شخصي؛ ومن هنا فهو بحاجة إلى هزّة تؤثّر على كيانه الروحي وتُرجعه بين الفينة والأُخرى إلى صوابه، وقد كانت بحقّ نهضة الإمام الحسين(عليه السلام)، تلك الثورة العظيمة المليئة بتلك القيم التي تجعل الإنسان يثور على نفسه وواقعه من حيث لا يشعر؛ والسبب في هذا التأثير الخالد هو أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) وأهل بيته وصحبه قدّموا كلّ هذه القيم السامية ولم يطلبوا عليها أجراً أو منفعة شخصية، بل ختموها بالشهادة والتضحية في سبيل الله تعالى.ولذا فإنّ الكاتب سوف يقع في حيرة إذا أراد أن يكتب في هذا المضمار، فهو مضمار يصلح لأن يكون منهاجاً دراسياً يُدرَّس للتلاميذ والطلّاب بشتّى مراحلهم العمرية. لكنّنا سوف نختصر في المقام مسلّطين الضوء على القيم التي جاءت في القرآن بشكل مباشر، وهي:
1ـ العزّة والكرامة
يُعدّ هذا المبدأ الذي وُجد مع خلقة الإنسان من المبادئ الأخلاقية السامية على الصعيد الفردي والاجتماعي، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [51]، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن اكتساب كلّ ما يؤدّي إلى ذلّته ومهانته، ومن أبرز ما يوجب ذلك هو ابتعاد الإنسان عن الله تعالى وانصياعه إلى مغريات الشيطان وأهواء النفس الأمّارة، فالعزّة والكرامة تكون مع الله تعالى، قال(عز وجل): (فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا)[52]، وهذه المعية لا تكون إلّا من خلال الإيمان به والعمل بما أمر به، قال تعالى: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)[53]. ومن هذا المنطلق؛ فإنّنا نجد أنّ رفض الإمام الحسين(عليه السلام) لبيعة يزيد كان أحد أسبابه هو الحفاظ على هذا المبدأ السامي، فإنّ قوله(عليه السلام) جواباً على طلب البيعة منه ليزيد: «ومثلي لا يبايع مثله»[54]، دليل واضح على مقصود الإمام بأنّ البيعة لو تحقّقت منه لهذا الشخص الفاجر، فإنّها بمنزلة الانتقاص من مكانته السامية، والأكثر من ذلك فقد صرّح في نصّ آخر بأنّ البيعة كانت بمنزلة وقوعه في معرض المذلّة؛ إذ قال(عليه السلام) يوم العاشر من المحرّم في بعض خطبه: «لا والله، لا أعطي بيدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد»[55]، وقال أيضاً: «موت في عزّ خير من حياة في ذلّ»[56]، وقال(عليه السلام) كذلك: «أَلا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنين»[57]؛ وعليه فإنّه نتيجة لهذه الجهود العظيمة والتضحيات الجسام التي بذلها أبو عبد الله(عليه السلام) في أعظم واقعة شهدها التاريخ البشري نجد أنّ كلّ مَن ركب سفينته(عليه السلام) يسعى دوماً إلى التخلّق بهذا الخلق القرآني السامي، بل إنّنا نجد أنّ عبارة (هيهات منّا الذلّة) أصبحت شعاراً يرفعه الشيعة في كلّ موقف فيه رفض للظلم والذلّة من قِبل حكّام الجور والجبابرة.
2ـ الصبر
من القيم الأخلاقية الأُخرى التي تجسّدت بأبهى صورها في نهضة الحسين(عليه السلام)، هو الصبر على كلّ المآسي والآلام المروّعة التي حصلت في واقعة عاشوراء، سواء التي عانى منها الحسين(عليه السلام) وأصحابه والرجال من أهل بيته البررة من ألم العطش وضرب السيوف انتهاءً بالقتل، أم التي واجهت رحله(عليه السلام) بعد استشهاده في مسيرة السبي إلى الكوفة والشام، فكلّ هذه الآلام قد واجهها جميع مَن حضر وشارك في هذه الواقعة بالصبر والثبات على المبدأ الحقّ الذي من أجله نهض(عليه السلام) وثار بوجه الظلم والاضطهاد، وبمجرّد مطالعة القارئ العزيز لما كُتب في مقتله(عليه السلام) ومسير السبايا، يجد أنّ هذه القيمة الأخلاقية حاضرة بشكل لا يقبل الشكّ والريب، فالأُمّ كانت تُقدّم ولدها الشاب الجديد عهد بالزواج من أجل أن يُستَشهَد بين يدي أبي عبد الله(عليه السلام)[58]، وفي موقف مماثل نجد أنّ إحدى النساء التي فجعت بزوجها في المعركة تُقدّم ولدها الصغير لكي يبذل دمه من أجل سبط
رسول الله(صلى الله عليه واله)[59].
وأمّا من جانب الإمام الحسين(عليه السلام) وأهل بيته البررة، فنجد المواقف العديدة التي تنمّ عن الصبر والثبات، منها على سبيل المثال: بروز القاسم بن الحسن(عليه السلام) وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم[60]، وقد عكس استشهاده مدى صبر عمّه الحسين(عليه السلام)، وصبر أُمّه رملة، ومن تلك المواقف الكاشفة عن قوّة الصبر على المصيبة هي مقتل عبد الله الرضيع وهو في حجر أبيه الحسين(عليه السلام)[61]. هذه المواقف المذكورة وغيرها الكثير كلّها تنمّ عن أنّ هذه النهضة الجليلة لم تصل إلينا بهذا الشكل لولا مقدار الصبر الكبير الذي كان يحمله الحسين(عليه السلام) والثلّة الصالحة من أهل بيته وصحبه.
ومن هنا؛ فلا عجب من اشتراطه(عليه السلام) بأن يتحلّى كلّ مَن يلحق به بهذه الفضيلة الأخلاقية، فقد خطب(عليه السلام) في موضع يُقال له: (زبالة) قائلاً: «أيّها الناس، فمَن كان منكم يصبر على حدّ السيف وطعن الأسنّة، فليقم معنا، وإلّا فلينصرف عنّا»[62]، وممّا رُوي عنه أنّه خاطب أصحابه يوم عاشوراء بقوله: «صبراً بني الكرام، فما الموت إلّا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة…»[63]، كما أنّ وصيّته لأُخته زينب(عليها السلام) ومَن معها من النساء على ما سوف يشاهدنه ويلاقينه، كانت عبارة عن ضرورة التحلّي بالصبر وتقوى الله تعالى، فقد قال(عليه السلام) في هذا الشأن: «ولا بدّ أن تروني على الثرى جديلاً، ولكن أوصيكنّ بتقوى الله ربّ البريّة، والصبر على البليّة، وكظم نزول الرزيّة، وبهذا وعد جدّكم، ولا خلف لما أوعد، ودّعتكم إلهي الفرد الصّمد»[64]. إذاً؛ في كلّ مقام تُحيى به هذه النهضة فإنّ ذلك سوف يكون مدعاة لتعزيز هذه القيمة الأخلاقية، فتكون حافزاً للمتلقّي على تحمّل المصائب التي تحلّ به في حياته، من هنا يقول أحد شعراء الطفّ:[65]
أنستْ رزيتكم رزايانا التي سلفت وهوّنت الرزايا الآتية
ويقول شاعر آخر: [66]
أيّها اللائمون كفّوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكّروني
تلك ذكرى بها تهون الرزايا وهي من أُمّهات ريب المنون
وأنّ هذا الأثر المعنوي الذي تركته نهضة الحسين(عليه السلام) في نفوس الناس لهو من الآثار التي أكّد عليها القرآن كثيراً، فقد وردت مادة (صبر) باشتقاقاتها المختلفة في الآيات القرآنية، فقد ورد فيها أنّ الصبر من عزائم الأُمور، أي: من أعظم الفضائل، قال تعالى: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[67]، وقال(عز وجل): (وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[68]؛ كما أنّ هذه الخصلة الحميدة جُعلت أحد المعيارين اللذين في ضوئهما حصل بعضٌ على منصب الإمامة وهداية الناس، قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)[69]، إلى غير ذلك من الموارد.
إذن؛ فالصبر الذي هو من أعظم الملكات والأحوال التي مدحها القرآن وكرّر ذكرها كثيراً، يُعدّ أحد أهمّ الآثار المعنوية لنهضة الحسين(عليه السلام)، فمِن صبره(عليه السلام) وصبر أهل بيته وصحبه نستلهم هذه الفضيلة، وتكون حيّة في نفوسنا، نستمدّ منها القوّة والصلابة في مواجهة الظروف العصيبة، والثبات على الحقّ، وأَلّا نخاف في سبيل إحقاقه لومة لائم.
3ـ الإيثار
الإيثار في اللغة هو مصدر آثر يُـؤْثِر إيثَاراً، وقد عُرِّف بأنّه: التّقديم والاختيار والتفضيل[70]، وعُرِّف أيضاً بأنّه: «تفضيل المرء غيرَه على نفسه»[71].
أمّا اصطلاحاً فهو: «أن يُقدّم غيره على نفسه في النفع له، والدفع عنه، وهو النهاية في الأُخوّة»[72]. وقال آخرون في تعريفه بأنّه: «فضيلة للنّفس، بها يكفُّ الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصُّه، حتّى يبذله لـمَن يستحقُّه»[73].
والإيثار بهذا المعنى يحتلّ مكانة خاصّة في منظومة القيم الأخلاقية بوجه عامّ، وفي منظومة التشريعات الإسلامية بوجه خاصّ، فهو يمتلك أهمّية كبرى في حياة المسلم، فعلاوة على ما يترتّب عليه من الأجر والثواب الكبيرين، فإنّه توجد جملة من الفوائد المعنوية تترتّب على انتعاش هذه الخصلة الحميدة في نفس الإنسان، منها: إنّها تطرد عنه الحرص والطمع وشحّ النفس، فقد رُوي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّ: «الإيثار أعلى مراتب الكرم، وأفضل الشيم»[74]، وقال(عليه السلام) أيضاً: «أفضل السخاء الإيثار»[75].
وقد تجلّت هذه الفضيلة المهمّة جدّاً في نهضة عاشوراء في أعلى درجاتها، كيف لا؟ وأنّ مرتبة بذل النفوس في سبيل نصرة المظلومين، وإصلاح ما فسد من أُمور المسلمين، وإحياء سنّة الرسول(صلى الله عليه واله) هي من الأهداف المهمّة التي قامت عليها نهضة الإمام الحسين(عليه السلام)، والتي كانت حاضرة لدى المقاتلين المشاركين في هذه النهضة الخالدة، وقد تجلّت علاوة على ذلك في كلماتهم، فخذ ـ مثلاً ـ موقف الطالبيين عندما عرض عليهم الإمام الحسين(عليه السلام)، وعلى سائر الأصحاب في ليلة العاشر من المحرم أن يتركوه وينجوا بأنفسهم، فقد رفضوا هذا العرض أشدّ الرفض، وقالوا: «ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ونقاتل معك حتّى نرد موردك»[76]. أمّا أصحابه(عليهم السلام) فقد ورد هذا المعنى في كلماتهم التي منها ما قاله مسلم بن عوسجة في الموقف ذاته: «أنحن نخلّي عنك، بما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟… أما والله لو [قد] علمت أنّي أُقتل، ثمّ أحيا، ثمّ أُحرق، ثمّ أُحيا، ثمّ أُذرّى، يُفعل بي ذلك سبعين مرّة، ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك»[77]، ومنها ما قاله زهير بن القين: «[والله] لوددت أنّي قُتلت، ثمّ نُشرت، ثمّ قُتلت، حتّى أُقتل هكذا ألف مرّة، وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك»[78]. هذا، وأنّ الكلمات كثيرة في هذا المجال، وهي لا تزيد على الواقع الخارجي الذي جسّدته هذه النهضة، المتمثِّل بالمواقف البطولية والتضحيات الجسام، فكلّ مقاتل عندما يدخل معركة جهادية يضع أمامه احتمالين، أحدهما: الظفر والنجاة، والآخر: نيل مرتبة الشهادة، إلّا المشاركين في واقعة كربلاء، فهؤلاء لم يكن أمامهم إلّا طريق الشهادة، فتضحيتهم هذه تُعدّ من أعظم أنواع العطاء، قال الشاعر:
يجود بالنفس إن ضنّ الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود
وهذه الصفة الأخلاقية تطرّق إليها القرآن في مواطن عديدة، تارةً تكون في موضع اللوم والعتاب، وأُخرى في موضع المدح، فممّا جاء في المورد الأوّل قوله تعالى: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)[79]. فقد ذكر العلّامة الطباطبائي بأنّ الخطاب في هذه الآية مسوق للعتاب، سواء كان مقصوداً به عامّة الناس، نظراً إلى كون طبعهم البشري هو التعلّق التامّ بالدنيا والاشتغال بتعميرها، أم أنّه قد تعلّق بخصوص الكفار[80]. وهذا النصّ القرآني يمكن تطبيقه على الطرف المقابل لجبهة الحقّ في واقعة كربلاء، فإنّ جيش عمر بن سعد أيضاً كان عندهم إيثار، لكنّه من نوع آخر (النوع السلبي)، فقد آثروا الحياة الدنيا الزائلة على نصرة الحقّ المتمثِّل بنهضة سبط رسول الله(صلى الله عليه واله)، وخير شاهد على هذا الأمر ما جرى على لسان قائد هذا الجيش العرمرم، الذي هرع للتنكيل بمَن طالب بإنقاذ هذه الأُمّة من حيرة الضلالة، فقد ورد عنه أنّه كان يُخيّر نفسه بين قتل الإمام الحسين(عليه السلام) وبين الحصول على مُلك الري، وقد اختار الأخير وأصبح مصداقاً لـمَن يُؤثر الحياة الدنيا[81].
وقد سُمع هذا اللعين يُنشد الشعر قائلاً:[82]
دعاني عبيد الله من دون قومه إلى خطّة فيها خرجت لحيني
فو الله لا أدري وأنّي لواقف أُفكّر في أمري على خطرينِ
أَأترك ملك الري والري رغبة أم أرجع مذموماً بقتل حسينِ
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرّة عينِ
أمّا النوع الإيجابي من الإيثار فقد ورد في قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون: (قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)[83]. فصحيح أنّ السحرة في المقام قد رفضوا القسم الأوّل من الإيثار بحسب ما جاء في نصّ الآية، إلّا أنّ النتيجة النهائية التي وصلوا إليها هي إيثار ما ظهرت لهم من البينات على جميع ما عند فرعون من زخارف الدنيا وزينتها، وهو من الإيثار الإيجابي.
والمورد الآخر الذي أشار إليه القرآن هو ما جاء في قوله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[84]. فالكلام في هذه الآية مسوق لمدح الأنصار الذين آووا الرسول(صلى الله عليه واله) والمهاجرين ونصروهم، وقدّموهم على أنفسهم رغم ما يعانونه من فقر وحاجة.
وعليه؛ فالإيثار بأيّ شيء إذا كان من أجل غرض إلهي يكون إيثاراً ممدوحاً، فكيف إذا كان ذاك الشيء هو حياة الإنسان، فمن المؤكّد أنّه يكون أشدّ محبوبية له(عز وجل)؛ ومن هنا فلا غرابة إذا وجدنا أنّ المولى يذكر مفردة (الشراء) في قوله تعالى: (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله…)[85]. فإنّ الأنفس والأموال وإن كانت كلّها مملوكة للمولى بنحو الأصالة وما ملكيّتنا لها إلّا بنحو التبع، لكنّه(عز وجل) لعظم مقام التضحية بها في سبيله يُنزّل نفسه منزلة غير المالك ويشتريها من أصحابها مقابل الجنّة في النشأة الأُخرى.
ومن الآثار البارزة للعيان المترتبة على النهضة الحسينية في جميع الأعصار، هو ما نشاهده من حالة الإيثار المنقطع النظير لأتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، في كلّ ما يتعلّق بإحياء شعائر هذه النهضة المعطاء، ففي كلّ مورد يكون فيه اسم الحسين(عليه السلام) حاضراً نجد أنّ الشيعة يبذلون فيه الغالي والنفيس، سواء على مستوى الأرواح، أم الأموال، أم الراحة، وما هذا العطاء والبذل إلّا رشحة من معين ذاك العطاء الذي قدّمه المولى أبو عبد الله الحسين(عليه السلام) في سبيل إنقاذ البشرية وإحياء السنن الإلهية.
4 ـ الشجاعة
ورد في معنى الشجاعة لغة، أنّها: «شدّة القلب عند البأس»[86]، وورد أيضاً أنّ: «… الرجل الشجاع وهو المقدام»[87].
أمّا الشجاعة بحسب العرف والاصطلاح، فهي لا تختلف عن المعنى اللغوي، فقد ورد في تعريفها أنّها: «الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف، والاستهانة بالموت»[88].
هذا، وتحتلّ هذه الخصلة الحميدة منزلة كبيرة في منظومة الفضائل الأخلاقية؛ وذلك لكونها تدخل في مجالات حياتية عديدة على الصعيد الفردي والاجتماعي كالمجال الديني، والجهادي، والعلمي، والسياسي، ونحو ذلك، فإنّ الخوف المفضي إلى الجبن: «قوّة تقيّد المرء، وقد يكون لها تأثير كبير في حياتنا، حيث تمنعنا عمّا نرغبه، وتجبرنا على ما لا نرغبه، كما تعوق تقدّمنا، وتمنعنا من تطوير إمكانياتنا»[89].
وهذه الخصلة وإن لم ترد بمادّتها في القرآن، إلّا أنّه(عز وجل) أشار إلى بعض الأفعال الشجاعة التي قام بها بعضٌ، من قبيل قصّة تحطيم الأصنام من قِبل بطل التوحيد نبي الله إبراهيم(عليه السلام)؛ إذ يقول تعالى بعد سرده للمحاورة التي جرت بين إبراهيم(عليه السلام) وبين قومه على لسانه(عليه السلام): (وَتَالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ)[90]. فهذا الموقف الشجاع والبطولي له(عليه السلام) لم يصدر منه إذا لم يكن يتحلّى بهذه الفضيلة، خصوصاً مع علمه بالنتيجة الوخيمة التي تنتظره جرّاء هذا الفعل، وهذا ممّا لا غرابة فيه بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين، فهم نتيجة للمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم في تبليغ كلمة الحقّ إلى الخلق، كانوا أصحاب جرأة وبأس، لا ينفذ الخوف المفضي إلى الجبن إلى نفوسهم، قال تعالى: (يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ)[91]. وقال أيضاً: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا الله وَكَفَى بِالله حَسِيبًا)[92].
ومن صور الشجاعة الأُخرى التي مدحها القرآن، الموقف الشجاع الذي أبداه جماعة من المسلمين إبّان وقعة بدر الصغرى، قال تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ الله وَالله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)[93]. فإنّ هذه الحالة المعنوية العالية تنهزم أمامها كلّ أساليب الترهيب والتخويف التي يعمد الخصوم إلى ترويجها والعمل بها.
وقد تجلّت هذه الخصلة الحميدة في نهضة الحسين(عليه السلام) من خلال عدّة صور، أبرزت جملة من المواقف ذات الجرأة والبأس والإقدام لأعمدة هذه النهضة المعطاء، منها على سبيل المثال: الشجاعة والبسالة التي أبداها سفير الإمام الحسين(عليه السلام)في الكوفة، فقد واجه بمفرده الكتيبة التي أرسلها ابن زياد لاعتقاله بقيادة عمرو بن حريث المخزومي، ومحمد بن الأشعث، والتي عجزت عن مواجهة رجل لا يملك سوى سيفه، ممّا دعا ابن زياد أن يرسل إلى محمد بن الأشعث موبِّخاً له بقوله: «بعثناك إلى رجل واحد لتأتينا به، فثلم في أصحابك ثلمةً عظيمةً، فكيف إذا أرسلناك إلى غيره»[94]. والأدلّ من ذلك على شجاعة هذا البطل المغوار الردّ الذي أرسله ابن الأشعث إلى ابن زياد، والذي يقول فيه: «أيّها الأمير، أتظنّ أنّك بعثتني إلى بقّال من بقّالي الكوفة، أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة؟! أَوَ لم تعلم أيّها الأمير أنّك بعثتني إلى أسد ضرغام، وسيف حسام، في كفّ بطل همام، من آل خير الأنام»[95].
ومن المواقف الشجاعة الأُخرى لواقعة الطفّ وعدم الاكتراث بالموت ـ وكلّ مواقفها على هذه الشاكلة ـ اللهجة الشديدة في خطاب الإمام الحسين(عليه السلام) للحرّ بن يزيد الرياحي، فإنّه من جملة الخطاب الذي دار بينهما، بعد تغيير الحرّ لمسار الإمام(عليه السلام) ومنعه من مواصلة طريقه إلى الكوفة أو الرجوع إلى المدينة، قال له الحرّ: «يا حسين، إنّي أذكِّرك الله في نفسك، فإنّي أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال له الحسين(عليه السلام): أفبالموت تخوّفني؟!»[96]. فردُّ الإمام بأُسلوب الاستفهام الاستنكاري ذي دلالة قوية على رباطة جأش الإمام(عليه السلام)، وعزمه على مواصلة ما بدأه وإن وصلت الحال إلى استشهاده، وهذا العزم قد تجلّى بصورة أوضح في الشعار المدوّي الذي رفعه(عليه السلام) يوم عاشوراء، والذي هزّ به عروش الظالمين، وأصبح شعاراً لكلّ أحرار الشيعة في العالم، وهو قوله(عليه السلام): «أَلا وإنّ الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلّة والذلّة، وهيهات له ذلك، هيهات منّي الذلّة»[97].
وهذه الفضيلة القرآنية لم تنتهِ بأحداث واقعة الطف يوم عاشوراء، بل استمرّت فيما بعد ذلك، فنجد المواقف الصلبة والقوية التي أبداها الموكَل إليهم قضية استمرار النهضة المباركة بارزة دائماً، فهذا الإمام السجاد(عليه السلام) لم يأبَ مواجهة عبيد الله بن زياد في مجلسه، فبعد المشادّة الكلامية بينه(عليه السلام) وبين هذا الطاغية، وأمر الأخير بضرب عنق الإمام(عليه السلام) لولا ما قامت به عمّته زينب(عليها السلام) من فعل أدّى إلى انصراف هذا الملعون عن نيّته المشؤومة، أقبل الإمام(عليه السلام) عليه بعد أن طلب من عمّته السكوت قائلاً: «أَبالقتل تهدّدني يابن زياد؟! أَما علمت أنّ القتل لنا عادة، وكرامتنا الشهادة؟!»[98].
أمّا المواقف الشجاعة للعقيلة زينب(عليها السلام) في مسيرة السبي فهي كثيرة، فقد كانت بحقّ بطلة كربلاء، ومن أبرز تلك المواقف البطولية ردّها الصارخ على ما تلفّظ به هذا الطاغية من كلمات الكفر فيما تلاه من شعر لابن الزِّبَعْرَى ـ والذي تقدّم ذكره ـ فقد ردّت عليه الحوراء زينب(عليها السلام) كاسرة جدار الخوف منه ومن زبانيّته الملعونين: «الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)[99]، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نُساق كما تُساق الأسراء، أنّ بنا هواناً على الله وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك، جذلان مسروراً… فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)[100] أَمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول لله(صلى الله عليه واله) سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، تحدو بهنّ الأعداء من بلد إلى بلد، ثمّ تقول غير متأثّم ولا مستعظم:[101]
لأهلّوا واستهلّوا فرحاً ثمّ قالوا يا يزيد لا تُشل»
فهذه الكلمات ما كانت لتصدر أمام أعلى سلطة متجبّرة في الدولة آنذاك، لو لم تتحلّى العقيلة زينب(عليها السلام) بالشجاعة الفائقة، وعدم الاكتراث بأيّ نتيجة قد تصدر من قِبل هذا الطاغية المتهتّك.
ثمّ إنّه من خلال ما تلوناه من مصاديق قرآنية لهذه الخصلة الحميدة، وما أبرزناه من مواقف بطولية شجاعة لأعمدة واقعة الطف الخالدة، نجد أنّ القاسم المشترك هو أنّ اتّخاذهم للموقف الشجاع لم يكن لحَميّة أو عصبيّة، وإنّما كان من أجل إحياء دين الله تعالى ونصرة المظلومين، وهذا الهدف في حقيقته وماهيّته هدف رسالي سار عليه الأنبياء(عليهم السلام) من آدم(عليه السلام) وصولاً إلى نبيّنا الخاتم(صلى الله عليه واله)؛ ومن هنا قيل ـ وما أصدقه من قول ـ: (الإسلام محمّديّ الوجود حسينيّ البقاء).
4ـ التوكّل
إنّ الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأنّه مدبّر هذا الكون ومنظّم جميع شؤونه، إذا كان حقيقياً وصادقاً، فإنّه يُثمر بلا أدنى شكّ خصلةَ التوكّل عليه(عز وجل) في جميع الأُمور والأعمال، والتسليم بأنّ جميع القدرات والقوى الأُخرى لا شيء إزاء قدرته وقوّته، فنثق بعونه وفضله وعدله؛ ولعلّه لهذه العلاقة الوثيقة بين هذين الأمرين نجد أنّ القرآن قد قرن بين الإيمان بالله والتوكّل عليه، فقد قال في محكم آياته: (…وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)[102]. (….وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)[103]. (قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا) [104].
هذا فيما يتعلّق بالبُعد المعنوي والاعتقادي، أمّا بالنسبة إلى البُعد السلوكي والعبادي، فهو أيضاً لم ينفكّ عن اقترانه بفضيلة التوكّل على الله، قال تعالى: (وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)[105].
والتقوى التي هي الورع عن محارم الله، قد اقترنت هي الأُخرى بالتوكّل عليه والاعتماد على مقاديره، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفَى بِالله وَكِيلًا)[106].
إذاً؛ التوكّل على الله هو حالة ينبغي أن تكون حاضرة في كلّ أنواع العلاقة معه(عز وجل)، ومن المفترض أن يكون المؤمن متصفاً بهذه الخصلة الحميدة في جميع أُموره، وهذا ما نستفيده من قوله تعالى: (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)[107].
ثمّ إنّه مع هذا الحثّ الكبير على هذه الفضيلة، إلّا أنّه من الضروري أَلّا يُسيء الإنسان الفهمَ تجاهها، فيهمل ما أمر الله به من الأسباب والوسائل، فيكون كسولاً يتطلّع إلى الحياة الطيّبة دون جهد أو عمل، قال رسول الله(صلى الله عليه واله): «أكيس الكيّسين مَن حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، وأحمق الحمقى مَن اتّبع نفسه هواها، وتمنّى على الله الأماني»[108].
هذا، وأنّ الإنسان وهو يعيش في خضم هذه البهرجة الدنيوية التي زاغت لها الأبصار، وتعلّقت بها القلوب، يحتاج دوماً إلى مَن يذكّره بفناء هذه المغريات واللذائذ، وعدم فائدتها إلّا بالنحو الذي تمكّنه من السير على جادّة الحقّ؛ وأحد مصاديق هذا التذكير هو إحياء فضيلة التوكّل في نفسه، فإنّه من خلالها يتخلّص من سطوة هذه المغريات وعدم الانجرار وراء متعتها الموهومة.
ولو جئنا إلى الأُمور التي تُحيي هذه الفضيلة في نفوس الناس، لوجدنا أنّ النهضة الحسينية تمتلك دوراً كبيراً جدّاً في هذا المجال، فإنّ التماهي بين الإرادة الإلهية والإرادة الحسينية، هو من أروع الأُمور التي سجّلتها هذه النهضة المباركة، وهذا التماهي هو عين الثقة بالله(عز وجل)، هذه الثقة بالنصر الإلهي هي مَن جعلت الإمام الحسين(عليه السلام) يُقدِم على هذه الحركة التغييرية، رغم كلّ المحاولات التي كانت تمنع من النصر الظاهري، والتي استند إليها جميع مَن نصحه(عليه السلام) بعدم الخروج إلى الكوفة سواء من الأصدقاء أم الأعداء.
وعلى الرغم من أنّ مآلات الفعل الذي قام به الإمام(عليه السلام) ومَن معه، كافية في الدلالة على أنّ هذه الفضيلة كانت مترسخة في نفوسهم، إلّا أنّ الأقوال ـ أيضاً ـ لم تخلُ منها، فقد ورد في خاتمة الوصية التي كتبها الإمام(عليه السلام) إلى أخيه محمد بن الحنفية أثناء خروجه من مكّة المكرّمة ما هذا نصّه: «… وهذه وصيّتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت وإليه أُنيب»[109]. ومن تلك الأقوال أيضاً ما جاء في ردّه على الضحّاك ابن عبد الله المشرقي، ومالك بن النظر الأرحبي، اللذين أخبرا الإمام(عليه السلام) بحال أهل الكوفة، وأنّهم قد أجمعوا على حربه، فقد كان ردّه(عليه السلام) على ذلك: «حسبي الله ونعم الوكيل»[110]. فالإمام(عليه السلام) كان يرى بأنّ إيكاله الأمر إلى الله(عز وجل) هو المبتغى، وأنّ أيّ كثرةٍ بشريةٍ لم تكن تحمل هذه الروح الإيمانية المجاهدة، لا حاجة له(عليه السلام) بها. وهذا المعنى قد ظهر في كلماته بشكل أكثر وضوحاً وهو في منزل (البيضة)، عندما خطب في أصحابه وأصحاب الحرّ بن يزيد الرياحي، فقد تطرّق إلى خذلان أهل الكوفة له ولأبيه وأخيه(عليهم السلام)، وكذلك ابن عمّه مسلم بن عقيل، وقال في نهاية حديثه عن ذلك: «وسيُغنِي الله عنكم» [111].
أمّا دعوات الإمام(عليه السلام) ومناجاته يوم الواقعة، فهي مليئة بعبارات التوكّل على الله تعالى والثقة به، ومنها قوله(عليه السلام) صبيحة يوم العاشر: «اللّهمّ أنتَ ثقتي في كلّ كربٍ، ورجائي في كلّ شدّةٍ، وأنتَ لي في كلّ أمرٍ نزل بي ثقةٌ وعدّةٌ…»[112]. أمّا مناجاته(عليه السلام) وهو في لحظاته الأخيرة، فهي الأُخرى لم تنفكّ أيضاً عن ذكر هذه الفضيلة السامية، فقد جاء فيها: «اللّهمّ أنتَ متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غنيّ عن الخلائق، عريض الكبرياء… أدعوك محتاجاً، وأرغب إليك فقيراً، وأفزع إليك خائفاً، وأبكي إليك مكروباً، وأستعين بك ضعيفاً، وأتوكّل عليك كافياً، احكم بيننا وبين قومنا، فإنّهم غرّونا، وخدعونا، وخذلونا، وغدروا بنا، وقتلونا…»[113].
وممّا تقدّم تبيّن وبوضوح تامّ مدى ملازمة هذه الخصلة الأخلاقية للإمام الحسين(عليه السلام) في كلّ مفاصل هذه النهضة المباركة. وهنا يأتي السؤال: بأنّ صفة التوكّل لديه(عليه السلام) هل حالت دون قيامه بالتخطيط الدقيق، وتهيئة الأسباب الظاهرية للتعامل مع الأحداث المستجدّة، انتهاءً بالمواجهة الشرسة التي وقعت يوم العاشر من المحرّم؟ الجواب: كلّا، إنّه(عليه السلام) مع كامل توكّله على الله وثقته به، لكنّه لم يترك استخدام الأساليب الصحيحة والمشروعة في نهضته المباركة، ومن تلك الأساليب على سبيل المثال تركه لأخيه محمد بن الحنفية في المدينة؛ ليكون عيناً له يُخبره بمجريات الأُمور ومآلاتها[114]، فقد أراده أن يبقى متواصلاً مع قاعدته، غير منقطع عمّا يُخطط له الأعداء في المدينة المنوّرة التي لها ثقلها ومكانتها في نفوس المسلمين، ومنها أيضاً إرساله لمسلم بن عقيل (رضوان الله تعالى عليه) إلى الكوفة؛ ليُهيّئ له الأرضية المناسبة لقدومه وإمساكه بزمام الأُمور في هذه المدينة المنتفضة على السلطة الظالمة، ومنها ـ كذلك ـ مفاوضاته مع عمر ابن سعد قائد الجيش الأُموي الرامية إلى إيجاد انشقاق كبير بين صفوف الأعداء فيما لو استجاب لدعوة الإمام(عليه السلام)، هذا الانشقاق الذي كان من الممكن أن يعكس المعادلة في تلك المواجهة. إلى غير ذلك من الأساليب التي بيّنت بأنّه(عليه السلام) في عين توكّله الشديد على الله تعالى، إلّا أنّه لم يترك تهيئة الأسباب الظاهرية المشروعة، فلم يكن تواكلاً وتكاسلاً منه(عليه السلام)، بل كان توكّلاً حقيقياً.
وبناءً على هذا؛ فإنّ إشاعة مفاهيم النهضة الحسينية بين الناس في كلّ زمان ومكان، من ثمراته هو إيجاد هذه الصفة القرآنية الرائعة التي بإمكانها أن تخلق جيلاً ثورياً واعياً، يتحرّك على وفق الضوابط الشرعية ويؤدّي تكاليفه، وهو في الوقت نفسه يعيش حالة التوكّل على الله والثقة به. ولعمري إنّ الأسباب الظاهرية التي قد تُتراءى للبعض بأنّها ضعيفة لو عشنا معها ونحن متّصفين بهذه الصفة، لوجدنا بأنّها قد توصلنا إلى نتائج مذهلة، لا تخطر على الصديق فضلاً عن العدو، بينما لو تجرّدنا من هذه الصفة فإنّنا سوف نُمنى بالهزيمة من دون أدنى شكّ، قال الإمام الخميني(قدس سره): «إذا تخلّينا يوماً ما عن اعتمادنا على الله واعتمدنا على النفط، أو على السلاح، فاعلموا أنّ ذلك اليوم هو اليوم الذي سنواجه فيه هزيمتنا»[115].
5ـ جهاد النفس
من الضروري على مَن يعيش في دائرة العبودية لله(عز وجل) أَلّا يكتفي بالإصلاح الشكلي والظاهري، والالتزام السطحي بالشريعة الإسلامية، وإنّما ينبغي له أن يسعى بكلّ ما أُوتي من قوّة إلى إيجاد حالة من التغيير الجذري في داخله؛ من أجل أن يكون مؤدّياً ما عليه من تكاليف، وهو يعيش حالة الرضا التامّ تجاه كلّ ما يواجهه، ويسير في طريق العبودية والتسليم المطلق لله(عز وجل). وهذا التغيير الجذري لا يتحقق إلّا بكبح جماح النفس، والسيطرة على قواها، وجعلها طَيِّعة لمتطلّبات الشريعة الإلهية، فإنّ الناس جميعاً ـ إلّا مَن عصم الله ـ تكون غرائزهم محتاجة إلى رقابة مستمرّة، مضافاً إلى ما يكتسبونه من عادات بيئية ومجتمعية ضارّة تحتاج إلى محاربة وإقصاء؛ ولصعوبة هذه المهمّة وخطورتها، فقد عبّر عنها الرسول(صلى الله عليه واله) بالجهاد الأكبر، فقد رُوي عن أبي عبد الله(عليه السلام) «أنّ النبي(صلى الله عليه واله) بعث سريّة، فلمّا رجعوا، قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقيَ عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، ما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس»[116]. وعنه(صلى الله عليه واله) أيضاً: «الشديد مَن غلب نفسه»[117]. وكذلك روى الإمام موسى بن جعفر،
عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين(عليهم السلام)، عن النبي(صلى الله عليه واله) أنّه قال: «إنّ أفضل الجهاد مَن جاهد نفسه التي بين جنبيه»[118].
ونحن إذ نقدّم دراسة قرآنية حول الآثار المعنوية للنهضة الحسينية، تستوقفنا جملة من الآيات التي حثّت على ضرورة مجاهدة النفس، والوقوف أمام تطلّعاتها التي لا تعرف القيود والضوابط، قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)[119]. فإنّ الفوز بالجنّة واتّخاذها مأوى وملجأ يحتاج إلى تحقّق شرطين، أوّلهما: الخوف من الله المفضي إلى عدم التمرّد عليه وعصيان أوامره، وثانيهما: هو السيطرة على هوى النفس وكبح جماحها، فإنّ هذا الأمر هو المنفذ الرئيس لدخول الإنسان إلى معترك الذنوب والمفاسد. كما أنّ الشيطان الخارجي لا يتمكّن من النفوذ إلى داخل الإنسان ما لم يوافقه الشيطان الداخلي في منحاه، ويفتح له أبواب الدخول، كما يُشير إلى ذلك قوله تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)[120] [121].
وهناك آيات أُخر تحذّر الإنسان من مغبّة الانصياع لهوى النفس؛ وتبيّن أنّ عاقبة ذلك هي الخيبة، كما في قوله تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)[122]. أو الوقوع في الضلال عن سبيل الله الموجب للعذاب الشديد، كما قال تعالى: (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ الله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)[123]. أو حصول الفساد في السماوات والأرض، قال تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ)[124].
أمّا ما هو المراد من هوى النفس الذي تُحذّر الآيات منه؟ فعلى الرغم من وضوحه في الوسط الديني والاجتماعي إلّا أنّه لا بأس بذكر بعض الكلمات الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة(عليهم السلام) في مقام توضيحه وبيان مصاديقه، ومنها ما ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «مَن ملك نفسه إذا رغب، وإذا رهب، وإذا اشتهى، وإذا غضب، وإذا رضي، حرّم الله جسده على النار»[125]. ومنها ما ورد عنه(عليه السلام) أيضاً: «مَن علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول، ويعلم ما يعمله من خير أو شرّ، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى)»[126].
وفي الصدد نفسه ذكر القمّي(رحمه الله) في تفسيره لهذه الآية: «هوى العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها، ثمّ تركها مخافة الله، ونهى النّفس عنها، فمكافأته الجنّة»[127].
ومع هذه الفضيلة الأخلاقية (مجاهدة النفس) ودورها في صنع الإنسان، بل المجتمع المسيطر على قواه البهيمية المتمثّلة برغبات النفس وشهواتها، وقواه السبعية المتمثّلة بانفعالات النفس وردّة فعلها العدوانية تجاه ما تواجهه من أحداث، فإنّنا سوف نُحقق الغاية التي سعى إليها جميع أنبياء الله ورسله وأوصيائه(عليهم السلام)، والتي هي عبارة عن انتشال البشرية من حضيض الرذائل والسلوكيات المنحرفة، وإيصالها إلى حضرة الربوبية واتّصافها بمقام الخلافة الإلهية.
وهذه الفضيلة الأخلاقية يمكن أن تكون النهضة الحسينية من منابعها الرئيسة، فإنّ الحالة التي عاشها الإمام الحسين(عليه السلام) وأهل بيته وصحبه من العزوف عن هوى النفس وشهواتها، وكلّ إغراءات المال والمنصب والعافية والرفاه والحياة والبقاء، كان لها الأثر البالغ في صمودهم في هذه المواجهة الصعبة، مما أفضى إلى انتصارهم المعنوي رغم انتهاء المعركة بحسب الظاهر لصالح بني أُميّة، ورغم كلّ التحشيدات الإعلامية والأساليب القسرية التي اتّبعها بنو أُميّة ومَن جاء بعدهم من الطغاة والظلمة إلى يومنا هذا.
ومن المشاهد الرائعة للانتصار الذي حقّقه أبطال كربلاء في ميادين نفوسهم قبل دخولهم لساحة النزال ومواجهة الموت، ما جاء في المصادر التاريخية بشأن نافع ابن هلال الذي كان شابّاً جميلاً، وكان حديث عهد بالزواج، وقد حضرت زوجته معه إلى كربلاء، فعندما همّ نافع بالبراز «تعلّقت بأذياله وبكت بكاءً شديداً، وقالت: إلى أين تمضي، وعلى مَن أعتمد بعدك»[128]. فهذا الموقف يهزّ كيان الإنسان، خصوصاً الشاب في بداية زواجه، فإنّ نفسه تكون توّاقة للالتقاء بالمحبوب، إلّا أنّ نافعاً لمّا رأى مزاحمة هذا الأمر المشروع لنصرة الدين الحقّ المتمثِّل بأبي عبد الله(عليه السلام)، فإنّه جاهد نفسه وأرغمها على عدم الانصياع لهذه الرغبة، وقد أبدى ذلك بصورة واضحة في جوابه للإمام الحسين(عليه السلام)، الذي خاطبه قائلاً بعد سماع كلام زوجته: «يا نافع، إنّ أهلك لا يطيب لها فراقك، فلو رأيت أن تختار سرورها على البراز. فقال: يابن رسول الله، لو لم أنصرك اليوم، فبماذا أجيب غداً رسول الله؟»[129].
والمشهد الآخر لمجاهدة النفس هو الوقوف بوجه غريزة حبّ البقاء والحياة، فإنّها من أعظم الغرائز التي تسعى النفس دوماً إلى تحصيلها بشتّى الطرق، إلّا أنّ هذه الغريزة لم تقف بوجه أبطال كربلاء، فإنّهم أقدموا يتهافتون على الموت والانسلاخ عن هذه الحياة الفانية، غير مبالين برغبات نفوسهم في هذا المجال، بل نجد أنّ بعضهم قد حصل على أمان يضمن لهم عدم ملاحقة السلطات لهم إذا تركوا المعركة، إلّا أنّهم لم يعيروا هذا الأمان أيّ اهتمام، بل وأهانوا مَن جاء به إليهم، فقد ورد في المصادر بأنّ اللعين شمر بن ذي الجوشن «دعا العباس بن علي وإخوته، فخرجوا إليه، فقال: أنتم يا بني أختي آمنون. فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك، لئن كنت خالنا، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟!»[130].
ومن المشاهد الأُخرى كذلك حجم مجاهدة النفس الذي تحلّت به بطلة كربلاء العقيلة، فإنّ طبيعة المرأة العاطفية تتفاعل مع المصائب دائماً بطريقة عفوية، فيصدر منها بعض الأفعال كضرب الوجه وشقّ الجيب على الفقيد، كما أنّ بعض النساء قد تسوقهنّ نفوسهنّ إلى الإتيان بأفعال قد حرّمها الشرع، كجزِّ الشعر أو نتفه، إلّا أنّ العقيلة لم تنسقْ وراء هذه الرغبات النفسية العاطفية، بل تحلّت بأعلى درجات الصبر والجلادة، ولم تبرز ما يضعف القضية التي سعى الإمام الحسين(عليه السلام) إلى تحقيقها من خلال نهضته المباركة، فهي رغم رؤيتها لأخيها(عليه السلام) وسائر أهل بيتها مجزّرين كالأضاحي يوم العاشر من المحرّم، ورغم ما عانت منه طيلة أيام السبي، ومواجهة أعتى طغاة العصر، إلّا أنّها لم تضعف وتركن إلى نفسها، بل إنّها كانت ترى أنّ كلّ ذلك في عين الله تعالى، وهو(عز وجل) لا يصدر منه إلّا الجمال، وقد تجلّى هذا المبدأ في جوابها لابن زياد الذي خاطبها بالقول: «كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلّا جميلاً»[131]. فهل يمكن أن يصدر هذا المنطق من امرأة يمكن أن تنساق وراء طبيعتها الغريزية وهي تواجه تلك المآسي التي تهتزّ لها الجبال الرواسي، لو لم تكن قد صرعت نفسها وانتصرت عليها في ميدان الجهاد الأكبر الذي أشار إليه رسول الله(صلى الله عليه واله)، فيما تقدّم ذكره.
هذا وأنّ المشاهد كثيرة جدّاً، فإذا أردنا سردها قد نحتاج إلى مقال مستقلّ، فإنّ النهضة الحسينية برمّتها قد اشتملت على نوعي الجهاد: الأصغر والأكبر.
محصّلة البحث
إنّ النهضة الحسينية بما حقّقته من انتصار معنوي جعل منها نهضة معطاء تزخر بالآثار المهمّة والحيوية على الصعيدين المادّي والمعنوي، أصبحت جديرة بالبحث والتحقيق من أجل استقصاء هذه الآثار وتبيينها للقارئ العزيز؛ لكي يجعلها مشعلاً يسير في ضوئه ويهتدي به فيما يمرّ به من مواقف مظلمة في هذه الحياة الدنيا. وبما أنّ هذه النهضة كلّها بركات وثمار لا يمكن الإلمام بها في هذه المقالة؛ لذلك فقد بنينا على تخصيص عرضنا لهذه الثمرات والآثار بالمعنوية فقط، وقيّدنا دراستنا أيضاً بأن تكون في ضوء الآيات القرآنية، قاصدين من ذلك بيان قرآنية النهضة الحسينية على مستوى نتائجها ومخرجاتها.
ونحن إذ نقدّم هذه الدراسة فإنّنا نكون قد قمنا بترسيخ مفهوم المعية التي أقرّها الرسول الأعظم(صلى الله عليه واله) في حديث الثقلين، فعدم الافتراق بين القرآن وأهل البيت(عليهم السلام) ينبغي أن يكون حاضراً في حياة المسلمين، يستشعرونه في كلّ حركاتهم وسكناتهم، فهو المؤمِّن لهم من الوقوع في الضلال كما نصّ على ذلك(صلى الله عليه واله).
هذا، وأنّنا قد صنّفنا الآثار المعنوية القرآنية المترتبة على هذه النهضة المباركة إلى أربعة محاور، تناولنا في المحورين الأوّل والثاني منها جملة من الآثار العقدية والأخلاقية والتربوية المنبثقة من أقوال وسلوكيات الإمام الحسين(عليه السلام) ومَن معه، في مجمل هذه الحركة التغييرية وما تلاها من أحداث السبي. ففي الجانب العقائدي كانت نهضته(عليه السلام) ترسيخاً واضحاً وجلياً لما اصطلح عليه بالأُصول الخمسة (التوحيد، العدل، النبوّة، الإمامة، والمعاد). أمّا في الجانب الأخلاقي والتربوي فكانت مفاهيم من قبيل: (العزّة والكرامة، الصبر، الإيثار، الشجاعة، التوكّل، ومجاهدة النفس)؛ عناوين مهمّة ورئيسة ذكرناها لهذه النهضة، يستلهمها الفرد الشيعي خصوصاً أو المحبّ لهم(عليهم السلام) عموماً في كلّ موسم تُحيا فيه ذكرى أبي عبد الله(عليه السلام)، وقد استنرنا في عرضنا لهذه الآثار بنور الآيات القرآنية المباركة بُغية تحقيق الهدف المشار إليه أعلاه.
ونظراً لضيق المجال ومحدودية الصفحات المسموح بها في هذا المقال؛ لذلك أرجأنا الحديث عن بقيّة المحاور إلى قسم ثانٍ لهذا المقال.
والحمد لله ربّ العالمين.
________________________________________
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد (ت413هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1414هـ/1993م.
2. أعيان الشيعة، محسن الأمين، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
3. الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل (تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكّي)، جعفر السبحاني، الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1409هـ/1989م.
4. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي وآخرون، ترجمة وتلخيص: محمد علي آذرشب، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1421هـ.
5. أنصار الحسين(عليه السلام)، محمد مهدي شمس الدين (ت2001م)، الدار الإسلامية، الطبعة الثانية، 1401هـ/1981م.
6. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، تحقيق: محمد باقر البهبودي، مؤسّسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1402هـ/1983م.
7. بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخزّازي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الخامسة، 1418هـ.
8. تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلّاء، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
9. التعريفات، علي بن محمد الجرجاني (ت816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1405هـ.
10. تفسير القمّي، علي بن إبراهيم القمّي (ت نحو329هـ)، صححه وعلّق عليه وقدّم له:
العلّامة طيّب الموسوي الجزائري، دار الكتاب، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
11. تهذيب الأخلاق في التربية، أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه (ت421هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1405هـ/1985م.
12. تهذيب الأخلاق، عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ (ت255هـ)، قرأه وعلّق عليه: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد، دار الصحابة للتراث، طنطا ـ مصر، الطبعة الأُولى، 1410هـ/1989م.
13. ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، محمد مهدي شمس الدين (ت2001هـ)، الدار الإسلامية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1400هـ/1980م.
14. الشجاعة الإيجابية، فيرا بيفر، مكتبة جرير، الطبعة الأُولى، 2006م.
15. الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد، الشيخ محمد السند، تحقيق: رياض الموسوي، دار الغدير للطباعة والنشر، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1424هـ/2003م.
16. الصحاح، إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطّار، دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 1407هـ/1987م.
17. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال (الإمام الحسين(عليه السلام))، عبد الله البحراني (ت1130هـ)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) بالحوزة العلمية، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1407هـ/1365ش.
18. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت329)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفّاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الثالثة، 1367ش.
19. الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم الشيباني، المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1385هـ/1965م.
20. الكلّيات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، أيّوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت1094هـ)، مؤسّسة الرسالة (ناشرون)، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1419هـ/1998م.
21. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، أنوار الهدى، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
22. لواعج الأشجان، محسن الأمين (ت1371هـ)، منشورات مكتبة بصيرتي، طبع سنة 1331ش.
23. مثير الأحزان، جعفر بن محمد بن نما الحلّي (ت645هـ)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1369هـ/1950م.
24. المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة، عبد الحسين شرف الدين الموسوي (ت1377هـ)، مراجعة وتحقيق: محمود بدري، مؤسّسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1421هـ.
25. معاني الأخبار، محمد بن علي بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المقدّسة ـ إيران، 1379هـ/1338ش.
26. المعجم الوسيط، مجموعة مؤلّفين، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 1425هـ/2004م.
27. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404هـ.
28. معين الخطباء، كاظم البهادلي، نشر مركز الدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدّسة، الطبعة الأُولى، 1435هـ /2014م.
29. مفاتيح الجنان، عبّاس القمّي (ت1359هـ)، تعريب: محمد رضا النوري النجفي، منشورات العزيزي، الطبعة الثالثة، 1385ش/2006م.
30. مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني، مؤسّسة الإمام الصادق(عليه السلام)، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الرابعة، 1421هـ.
31. مقتل الحسين(عليه السلام)، الموفّق محمد بن أحمد المكّي الخوارزمي (ت568هـ)، تحقيق: محمد السماوي، تصحيح ونشر: أنوار الهدى، الطبعة الأُولى، 1418هـ.
32. مقتل الحسين(عليه السلام)، عبد الرزّاق الموسوي المقرّم (ت1391هـ)، انتشارات الشريف الرضي.
33. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهر آشوب (ت588هـ)، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1376هـ/1956م.
34. موسوعة شهادة المعصومين(عليهم السلام)، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، انتشارات نور السجّاد، قمّ، الطبعة الأُولى، 1381ش.
35. موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام)، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، دار المعروف للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1416هـ/1995م.
36. ميزان الحكمة، محمد الريشهري، تحقيق ونشر: دار الحديث، الطبعة الأُولى.
37. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي (ت1402هـ)، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1390هـ.
38. وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت1104هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1414هـ.
39. ينابيع المودّة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم، القندوزي الحنفي (ت1294هـ)، تحقيق: سيّد علي جمال أشرف الحسيني، دار الأسوة للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، 1416هـ.
الصحف
1. صحيفه امام (فارسي)، روح الله الخميني (ت1409هـ).
المواقع الإلكترونية
1. المعاد في القرآن الكريم والروايات الشريفة، أبو القاسم الديباجي:
2. https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=c363cd2b-9c4c-481a-a157-8492eebfcafb.
________________________________________
[1] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[2] شمس الدين، محمد مهدي، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي: ص13ـ14.
[3] البقرة: آية163.
[4] الإخلاص: آية1.
[5] الملك: آية14.
[6] فاطر: آية44.
[7] فاطر: آية3.
[8] يونس: آية3.
[9] آل عمران: آية64.
[10] الأنبياء: آية66ـ70.
[11]القمي، عباس، مفاتيح الجنان: ص426.
[12] فصّلت: آية53.
[13] القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: ص416.
[14] المصدر السابق: ص413ـ414.
[15] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص179.
[16] المقرّم، عبد الرزاق، مقتل الحسين(عليه السلام): ص283.
[17] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص94.
[18] اُنظر: الخرازي، محسن، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية: ج1، ص53.
[19] اُنظر: السبحاني، جعفر، الإلهيات (تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكّي): ص611ـ612.
[20] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص57.
[21] البقرة: آية260.
[22] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص179.
[23] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص45.
[24] اُنظر: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص343.
[25] المصدر السابق: ص446.
[26] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص293.
[27] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص71.
[28] اُنظر: السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن: ج8، ص6.
[29] الديباجي، أبو القاسم، المعاد يوم القيامة دراسة معاصرة: ص45.
[30] الفاتحة: آية4.
[31] البقرة: آية4.
[32] آل عمران: آية30.
[33] آل عمران: آية106.
[34] المؤمنون: آية74.
[35] المطففين: آية10ـ12.
[36] اُنظر: السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن: ج8، ص5ـ6.
[37] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص174.
[38] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105.
[39] المصدر السابق: ص179.
[40] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص184.
[41] الأحزاب: آية40.
[42] الفتح: آية29.
[43] الأحزاب: آية21.
[44] الخوارزمي، الموفّق محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص331ـ332.
[45] المصدر السابق: ج1، ص335.
[46] القصص: آية41.
[47] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص83ـ 84.
[48] الخوارزمي، الموفق محمد بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج1، ص351.
[49] النساء: آية59.
[50] الحشر: آية7.
[51] الإسراء: آية7.
[52] النساء: آية139.
[53] المنافقون: آية8.
[54] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[55] ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص37.
[56] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224.
[57] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص59.
[58] اُنظر: قصّة وهب بن حباب الكلبي: الخوارزمي، الموفق محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ج2، ص15ـ 16.
[59] راجع قصّة الشاب الذي قدمته أُمّه بعد استشهاد أبيه في واقعة الطفّ، الذي رجّح الشيخ محمد مهدي شمس الدين بأن يكون اسمه عمرو بن جنادة بن الحارث الأنصاري. اُنظر: شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين(عليه السلام): ص101.
[60] اُنظر: الخوارزمي، الموفق محمد بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج2، ص31ـ32.
[61] اُنظر: الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص181.
[62] القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص62.
[63] الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص289.
[64] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص484.
[65] شرف الدين الموسوي، عبد الحسين، المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة: ص137.
[66] البهادلي، كاظم، معين الخطباء: ج1، ص55.
[67] الشورى: آية43.
[68] لقمان: آية17.
[69] السجدة: آية24.
[70] اُنظر: الحسيني الكفوي، أيوب بن موسى، الكلّيات(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): ص40.
[71] أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط: ص6.
[72] الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات: ص59.
[73] ابن مسكويه، أحمد بن محمد، تهذيب الأخلاق: ص19.
[74] الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج1، ص16.
[75] المصدر السابق.
[76] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص244.
[77] المصدر السابق.
[78] المصدر السابق.
[79] الأعلى: آية16.
[80] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص269ـ270.
[81] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص306ـ 308.
[82] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص598.
[83] طه: آية72.
[84] الحشر: آية9.
[85] التوبة: آية111.
[86] الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج3، ص1235.
[87] ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص247.
[88] الجاحظ، عمرو بن بحر، تهذيب الأخلاق: ص27.
[89] بيفر، فيرا، الشجاعة الإيجابية: ص6.
[90] الأنبياء: آية57ـ 58.
[91] النمل: آية10.
[92] الأحزاب: آية39.
[93] آل عمران: آية173ـ175.
[94] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص203.
[95] المصدر السابق.
[96] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص378.
[97] المصدر السابق: ج45، ص83.
[98]المصدر السابق: ج45، ص118.
[99] الروم: آية10.
[100] آل عمران: آية178.
[101] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105ـ106.
[102] آل عمران: آية122 و160. المائدة: آية11. التوبة: آية51. إبراهيم: آية11. المجادلة: آية10. التغابن: آية13.
[103] المائدة: آية23.
[104] الملك: آية29.
[105] هود: آية123.
[106] الأحزاب: آية1 ـ 3.
[107] الطلاق: آية3.
[108] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج89، ص250.
[109] المصدر السابق: ج44، ص330.
[110] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص317.
[111] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص438.
[112] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص96.
[113] القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: ص271ـ272.
[114] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[115] الخميني، روح الله، صحيفه إمام: ج20، ص77. (ترجمة الباحث).
[116] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج15، ص161.
[117] المصدر السابق.
[118] المصدر السابق: ص163.
[119] النازعات: آية40ـ41.
[120] الحجر: آية42.
[121] اُنظر: مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج19، ص398.
[122] الشمس: آية7ـ10.
[123] ص: آية26.
[124] المؤمنون: آية71.
[125] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج15، ص162.
[126] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص71.
[127] القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمّي: ج2، ص404.
[128] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص539.
[129] المصدر السابق.
[130] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص56. واُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص315.
[131] البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص383.
المصدر: موقع مؤسسة وارث الأنبياء
https://warithanbia.com/?id=2689
لینک کوتاه
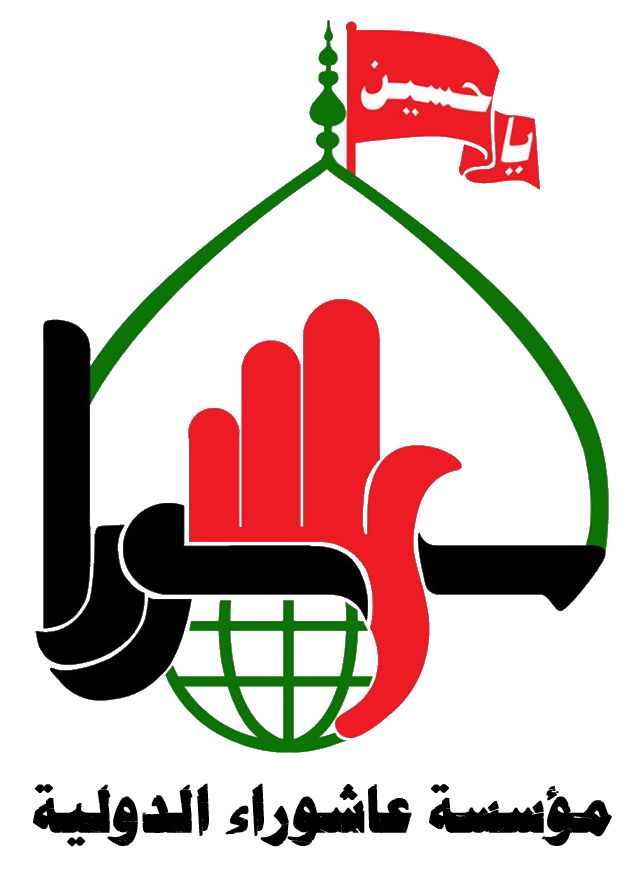
سوالات و نظرات