الآثار المعنوية لنهضة الإمام الحسين (عليه السلام) في ضوء الآيات القرآنية … دراسة وصفية تحليلية.. القسم الثاني
{ د. الشيخ أسعد علي السلمان – باحث إسلامي وأُستاذ في جامعة المصطفى(صلى الله عليه واله) العالمية، من العراق }
مقدّمة
بعد أن قمنا في القسم الأوّل من هذا المقال بعرضٍ لجملةٍ من الآثار المعنوية، المستوحاة من نهضة أبي عبد الله الحسين(عليه السلام) في واقعة الطفّ الخالدة، ودراستها في ضوء الآيات القرآنية المباركة، فها نحن في هذا القسم بصدد إكمال الحديث عن هذا الموضوع، ونوّد في بداية الحديث أن نذكِّر القارئ الكريم بأنّنا قد قسّمنا الآثار المشار إليها على محاور أربعة، وقد تقدّم الحديث فيما سبق عن الآثار المتعلّقة بالمحورين الأوّل والثاني، وفي هذه الأوراق المتواضعة سوف نتحدّث عمّا هو متعلِّق بالمحورين الثالث والرابع. أمّا المحاور الأربعة بشكل كلّي فهي عبارة عن:
المحور الأوّل: الآثار المرتبطة بالجانب العقدي.
المحور الثاني: الآثار المرتبطة بالجانب الأخلاقي.
المحور الثالث: الآثار التي تُعدّ مسائل حيوية في المنظومة الدينية.
المحور الرابع: الآثار المرتبطة بالجانب الحماسي والثوري.
هذا، وإنّنا ـ كما نوّهنا في القسم الأوّل ـ لا ندّعي القدرة على استيعاب جميع الآثار المتعلّقة بالجانبين المتبقيين؛ وذلك للبركات غير المحدودة المترتّبة على هذه النهضة الخالدة؛ ومن هنا كان بناؤنا ـ في هذا القسم أيضاً ـ على القيام بعرض للآثار المهمّة والحيوية في كلّ واحد من المحورين المذكورين، تاركين استيعاب الحديث في جميع جوانب الموضوع، والتشقيق في أبحاثه إلى دراسات أُخرى مستقبلية إن شاء الله تعالى.
أمّا المنهج المتّبع في المقام فهو كالسابق عبارة عن المنهج الوصفي التحليلي، الذي نسعى فيه إلى تبيين ظاهرة التماهي الحاصلة بين القرآن الكريم والنهضة الحسينية على مستوى الآثار والثمرات المعنوية، هذا التماهي الذي يجعل من النهضة المباركة مصداقاً للمعية التي أقرّها الرسول الكريم(صلى الله عليه واله) بين القرآن وأهل البيت(عليهم السلام) في حديث الثقلين المتواتر[1].
المحور الثالث: الآثار المعنوية التي تُعدّ مسائل حيوية في المنظومة الدينية
1ـ إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تحتلّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة مهمّة في منظومة التشريعات الإسلامية؛ وذلك لما تمثّله من كونها صمّام أمانٍ لتطبيق جميع هذه التشريعات وعلى شتّى المستويات، فقد رُوي عن النبي(صلى الله عليه واله) أنّه قال: «لا تزال أُمتي بخيرٍ ما أَمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرّ والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات، وسُلِّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصرٌ في الأرض ولا في السماء»[2].
وفي الصدد نفسه رُوي عن الإمام الباقر(عليه السلام) أنّه قال: «… إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة، بها تُقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتُردّ المظالم، وتعمر الأرض، ويُنتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر…»[3].
ونظراً لأهمّية هذه الفريضة وعظم فائدتها في الحياة الاجتماعية، فقد تناولتها الآيات القرآنية من زوايا متعدّدة، وهذه الآيات عبارة عن: قوله تعالى: ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )[4]. فإنّه وبالنظر إلى السياق الذي وردت فيه هذه الآية الشريفة، والذي تحدّثت فيه الآيات السابقة واللاحقة على هذه الآية عن ضرورة الاعتصام بحبل الله تعالى وتوحيد الصفّ[5]. يترتّب هذا الأثر بشكل واضح على إعمال هذه الفريضة في المجتمع، فإنّه مع الأمر بإشاعة النقاط الإيجابية والتشجيع عليها في المجتمع، ونبذ الأُمور السلبية واستهجانها سوف نحقّق مجتمعاً متماسكاً قوياً، يمتلك خاصية العلاج الذاتي، فهو يعالج نفسه بنفسه؛ وعليه فإنّ فرصة تدخّل العامل الخارجي المؤدّي إلى الفرقة والانشقاق ستكون ضئيلة.
ومن هنا؛ نجد أنّ القرآن يصف المؤمنين المتّحدين المشمولين برحمته(عز وجل) بصفات عديدة، وعلى رأسها الاتّصاف بهذه الفريضة المهمّة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[6].
كما تُخبرنا الآيات القرآنية في موضع آخر بأنّ إشاعة هذه الفريضة في الأُمّة الإسلامية هو السبب في كونها من أفضل الأُمم التي مرّت في تاريخ البشرية، قال تعالى: ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله….)[7]، فإنّ «الدليل على أنّ هذه الأُمّة خير أُمّة رُشّحت لهذه المهمّة الكبرى [خدمة المجتمع الإنساني] هو قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيمانها بالله، وهذا يفيد أنّ إصلاح المجتمع البشري لا يمكن بدون الإيمان بالله والدعوة إلى الحقّ، ومكافحة الفساد، كما ويستفاد من ذلك أنّ هاتين الوظيفتين ـ مع ما هما عليه من السعة في الإسلام ـ ممّا تفرد بهما هذا الدين من دون بقية الشرائع السابقة»[8].
ولم تقف الآيات على مدح المسلمين؛ لكونهم قد اتّصفوا بهذه الفريضة، بل إنّها قد مدحت مَن اتّصف بها من أهل الكتاب أيضاً، قال تعالى: (لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)[9]، أي: «ليس أهل الكتاب سواء، فهناك جماعة تُطيع الله وتخافه، وتؤمن به وتهابه، وتؤمن بالآخرة وتعمل لها، وتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»[10].
وفي مقابل جعل القيام بهذه الفريضة من صفات المؤمنين، نجد أنّه في محلّ آخر من القرآن جُعل ترك هذه الفريضة من صفات المنافقين، قال تعالى: ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )[11].
ومن المعلوم أنّ شيوع ظاهرة النفاق في أيّ مجتمع، معناه شيوع جملة من الصفات الأخلاقية الذميمة[12]: كالكذب (الذي هو مفتاح الذنوب)[13]، والخيانة، وخُلف الوعد، هذه الصفات التي تُعدّ مدعاة لفقدان الأمان في المجتمع.
ونحن إذ نتحدّث في المقام عن الآثار المعنوية للنهضة الحسينية، نقف أمام هذه الفريضة الإلهية وقفة خاصّة، فإنّه(عليه السلام) قد أخرج العمل بهذه الفريضة من دائرة التعامل الفردي والجماعي المحدود إلى مستوى التغيير الثوري، وبذل الدماء الزاكية من أجل تحقيق هذا المبدأ السامي، فهو(عليه السلام) علاوة على ميله القلبي إلى ذلك ـ كما ورد عنه(عليه السلام) عند وداعه لقبر جدّه(صلى الله عليه واله) قُبيل خروجه من المدينة: «اللهمّ، وإنّي أُحبّ المعروف وأكره المنكر»[14] ـ فقد صدرت منه تصريحات نهى عن أُمور منكرة، فضح من خلالها ما عليه السلطة الحاكمة من الفساد والظلم والطغيان، وخذ ـ مثلاً ـ ما صدر عنه(عليه السلام) عندما طلب منه معاوية البيعة ليزيد بعدما ذكر أهليته لتولّي هذا المنصب من بعده، فقد قال(عليه السلام) في هذا الصدد: «وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لأُمّة محمد (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم)، تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنّك تصف محجوباً أو تنعت غائباً، أو تخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلم خاصّ، وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المتهارشة عند التحارش، والحمام السبق لأترابهن، والقينات ذوات المعازف، وضروب الملاهي، تجده ناصراً، ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق أكثر ممّا أنت لاقيه»[15].
ومن هذه التصريحات أيضاً ما قاله(عليه السلام) جواباً عن رسالة كتبها له معاوية يعاتبه فيها على بعض الأُمور التي ادّعي أنّها صدرت منه(عليه السلام): «واعلم، أنّ الله ليس بناسٍ لك قتلك بالظّنّة، وأخذك بالتّهمة، وإمارتك صبيّاً يشرب الشراب، ويلعب بالكلاب، ما أراك إلّا قد أوبقت نفسك، وأهلكت دينك، وأضعت الرعيّة، والسلام»[16].
ومن تصريحاته الأُخرى التي شخّصت أنّ المدّة التي يعيشها(عليه السلام) هي مدّة تطبيق هذه الفريضة مهما كلّف الأمر، ما تضمّنته خطبته(عليه السلام) في أصحابه قُبيل وصوله إلى كربلاء، وقد جاء فيها: «إنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، واستمرّت حذاء، ولم تبق منه إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، أَلا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً»[17]. فإنّه مع هذا التغيّر الحاصل في المفاهيم الدينية، فإنّ صورة المجتمع ستكون حينها صورة إسلامية، بينما روحه ومحتواه سيكونان على خلاف ذلك، وعليه سوف تسود المجتمع حالة النفاق، وهذا بعينه المعنى الذي أشارت إليه الآية القرآنية المتقدّمة: ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ…)[18].
كما يرى(عليه السلام) في كلام آخر له عدم صحّة السكوت عن تفشّي المنكر وغياب المعروف في المجتمع الإسلامي، حيث يقول: «أيّها الناس، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال: مَن رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يُغير عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدخله مدخله، أَلا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر»[19].
وكنتيجة لجميع هذه التصريحات والمواقف وغيرها نجد أنّ الشعار الذي رفعه(عليه السلام) في بداية حركته ـ: «وأنّي لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا مُفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر…»[20] ـ أصبح مناراً للعديد من المواقف الواعية في المجتمع الشيعي، وما هذه الحركة التثقيفية والتوعوية التي يقوم بها المنبر الحسيني إلّا أحد الوجوه الناصعة من أجل ترسيخ هذه الفريضة القرآنية بين الناس، فالخطباء في جميع الأزمنة والأمكنة يسعون ـ من خلال كلماتهم وأحاديثهم ـ إلى تشخيص مواطن الفساد في المجتمع، والحثّ على ضرورة الوقوف بوجهه، وطالما عرّضهم هذا الأمر إلى دفع أثمان باهضة، من قبيل التهديد، والتعذيب، والتشريد، وصولاً إلى التصفية الجسدية في أحيان كثيرة.
إنّ هذا الطريق مليء بالأشواك ويحتاج إلى صبر وثبات من قِبل السائرين فيه؛ ومن هنا نجد أنّ القرآن يقرن بين هذه الفريضة وبين الصبر على ما سوف يحصل من جرّاء ذلك، قال تعالى حكاية عن لسان لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[21]. فهذا الأمر الصعب الذي يعيشه كلّ مَن يسير على النهج الحسيني ويسعى إلى تثبيت أركانه في المجتمع، يحتاج إلى عزيمة قويّة لا يمكن أن تحصل إلّا من خلال استلهام العون والقوّة ممّا قام به صاحب هذه النهضة المباركة وأهل بيته وصحبه من تجسيد واقعي لهذه الفريضة السامية.
2ـ ترسيخ حالة الصراع بين الحقّ والباطل
إنّ الصراع بين الحقّ والباطل يُعدّ واحداً من أكثر السنن الكونية شيوعاً واطّراداً في الحياة البشرية على مستوى المجتمعات والأفراد، وهو قديم بقدم خلق الإنسان، قد لازمه منذ اللحظات الأُولى لصيرورته خليفة الله على هذه الأرض، فهذا إبليس بعد عصيانه للأمر الإلهي وتحوّله إلى مخلوق منبوذٍ مطرودٍ من الحضرة الإلهية قرّر الانتقام من آدم وذريته؛ وذلك بسلوکه طريق الإغواء لهم وإبعادهم عن جادّة الحقّ، قال تعالى حكاية عن لسان هذا العدو اللدود للبشر: ( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)[22]؛ فبعد هذه المقاسمة يبدأ الصراع بين آدم وذريته المؤمنة من جهة وبين الشيطان وأتباعه من جهة أُخرى، فأتباع الحقّ هم جميع الأنبياء والرسل، والسائرون على نهجهم، قال تعالى حكاية عن لسان أهل الجنّة: (لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)[23]، وأمّا أتباع الباطل فهم المخالفون لهم والساعون إلى إبطال المشروع الإلهي الذي ينادون به، قال تعالى: ( وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا)[24].
ثمّ إنّ هذا الصراع لا يتوقّف وسوف يستمرّ إلى قيام الساعة، ويعود السبب في ذلك إلى أنّه لا يخلو مجتمع إنساني مهما كانت درجة تطوّره من علاقات تنافسية، أساسها التدافع والتسابق على الموارد والخيرات، والمال، والقوّة، والمنصب، والجاه، والنفوذ، ونتائج هذه المنافسات لا تتحقّق بشكل عادي وعفوي، وإنّما تأتي في سياق معارك تأخذ أشكالاً وأنواعاً متعدّدة: ناعمة أو دامية، شريفة أو خبيثة، وذات مظاهر فكرية، أو عقائدية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو أمنية.
والعامل الرئيس في هذه المنافسات والصراعات هو الانصياع وراء المصالح الشخصية الضيّقة، أو الجماعية المحدودة على حساب المصلحة المجتمعية النوعية، فعندما تكون روح الأنانية هذه هي المعيار لأيِّ سلوك أو موقف، فإنّ الأشخاص أو الجماعات الحاملين لها يصبحون على استعداد للوقوف إلى جانب الباطل ضدّ الحقّ مهما كانت درجة وضوحه عندهم، وعلى استعداد أيضاً لتغليب الظلم على العدل، أو الكره والتعصّب على الحبّ والتعاون والتسامح، وعندها يستشري الفساد، ويتحكّم الظلم والاستكبار بحياة المجتمع ويعمّ الخراب فيه.
والإنسانية إذ تعيش أجواء هذا الصراع المحتدم، فلا بدّ لها من هزّات نوعية توقظها من سبات الغفلة، وتوقف الأفراد والجماعات ـ خصوصاً الذين يحاولون الالتحاق بركب الهداية الإلهية، إلّا أنّهم بين الفينة والأُخرى تجتذبهم أنانيّتهم المدعومة بالمغريات والملذّات الدنيوية ـ على حقيقة أنّهم يعيشون في دوّامة صراع بين الحقّ والباطل، مع تشخيصٍ للحقّ والباطل وأتباع كلّ منهما.
وفي هذا الصدد نرى أنّ النهضة الحسينية قد قامت بهذه الهزّة العنيفة في المجتمع الإسلامي آنذاك، واستمرّ عطاؤها في هذا المجال إلى يومنا هذا وإلى مستقبل الأيام القابلة، ولا نكون مغالين إذا قلنا: بأنّها أثّرت حتّى في الفكر غير الإسلامي[25].
أمّا كيف مثّلت هذه الحركة التي قام بها سيّد الشهداء أبو عبد الله(عليه السلام) صراعاً بين الحقّ والباطل؟ فالجواب في المقام يمكن أن ينطلق من مبدأين:
أحدهما: نظرية مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) التي تذهب إلى عصمة الإمام(عليه السلام)، فإنّه بناءً على هذا المبنى المتسالم عليه عند جميع الطوائف الشيعية، يكون تصرّف الإمام الحسين(عليه السلام) من دون أدنى شك تصرّفاً متوافقاً مع التشريعات الصادرة عن الحقّ سبحانه وتعالى، قال(عز وجل): ( فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)[26]؛ فيكون حينها الطرف المقابل له هو الممثّل لجبهة الباطل، قال تعالى: ( ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ….) [27]. هذا باختصار طريق الباحث الذي يؤمن بمدرسة أهل البيت(عليهم السلام).
أمّا مَن ينطلق من مبدأ مدرسة الصحابة، فمن الضروري أن يذهب إلى النتيجة نفسها؛ وذلك لأنّ وثيقة الصلح المبرمة بين الإمام الحسن(عليه السلام) ـ الخليفة الشرعي ـ وبين معاوية، قد اشتُرط فيها عدم تعيين الأخير خليفة من بعده، وإنّما يكون الأمر لشورى المسلمين[28]، أو يكون الأمر له(عليه السلام)[29]، وهذا الأمر يدلّ على حقيقة لا تقبل الشكّ والترديد، وهي أنّ قبول الإمام الحسن(عليه السلام) بالصلح كان مشروطاً بعدم امتداد الخلافة في أُسرة معاوية، في حين أنّ ما تمّ هو على خلاف ذلك، فالأخير عهد بالأمر من بعده إلى ابنه يزيد ، وهو عهد باطل وعليه فحركة الإمام الحسين(عليه السلام) الرافضة للبيعة كانت حقّة، وهي محاولة لإرجاع الحقّ إلى أصحابه، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الإمام الحسن(عليه السلام) عندما صالح معاوية لم يكن في مقام التنازل عن حقّ الخلافة له ولأخيه من بعده، وإنّما كان حقناً للدماء في تلك المدّة؛ ومن هنا عدّ بعضٌ أنّ اشتراط الإمام الحسن(عليه السلام) بأن تكون الخلافة له بعد معاوية، وإذا حدث به حادث تكون لأخيه الإمام الحسين(عليه السلام)، منسجمٌ «مع إيمان الإمام الحسن(عليه السلام) بالنصّ النبوي على إمامته وإمامة أخيه بأنّهما إمامان وسيّدا شباب أهل الجنّة، ويؤيّده شرط ينصّ أَلّا يبغي معاوية غائلة للحسن والحسين(عليهما السلام)، مضافاً إلى أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) مشمول بشرط عدم الاعتداء على حياة أهل البيت عامّة، فتخصيصه بالشرط يُشير إلى ارتباط حياته بمستقبل الخلافة»[30].
ومن هنا؛ فإنّ ما حصل في نهضة الإمام الحسين(عليه السلام) هو رفض للباطل المتمثّل بتولّي يزيد الطاغية زمام رقاب المسلمين من دون أدنى وجه حقّ، بينما الممثّل الحقيقي لخلافة رسول الله(صلى الله عليه واله) موجود، ومطالب برجوع هذا الحقّ إلى أصحابه، قال(عليه السلام) عند مجيء معاوية إلى المدينة وطلبه من أهلها مبايعة يزيد: «أنا والله أحقّ بها منه، فإنّ أبي خير من أبيه، وجدّي خير من جدّه، وأُمّي خير من أُمّه، وأنا خير منه»[31].
كما نُقل عنه(عليه السلام) أنّه قال في تفسير قوله تعالى: ( هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ)[32]: «نحن وبنو أُميّة اختصمنا في الله(عز وجل) قلنا: صدق الله، وقالوا: كذب الله. فنحن وإيّاهم الخصمان يوم القيامة»[33]. أضف إلى ذلك ما ذكره(عليه السلام) في خطبته التي كانت على مشارف كربلاء: «أَلا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حقّاً حقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً»[34]، حيث بيّن في كلامه هذا أنّ الصراع بين الحقّ والباطل يُعدّ من الدواعي الرئيسة لنهضته المباركة.
وكذلك ما قاله في خطبته في منزل (البيضة): «مَن رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يُغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدخله مدخله، أَلا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر»[35].
إذاً؛ فمن الثمرات المهمّة التي تعطيها هذه النهضة لكلّ المهتمّين بها، هي عدم نسيانهم أبداً أنّهم يعيشون حالة صراع بين الحقّ والباطل على جميع الأصعدة، فلا يطمئنّوا إلى حالة رخاء أو هدوء تضمر تحتها مساعي حثيثة من أجل تحطيم الوجود الديني بين الناس، وحرف عقولهم إلى المادّية العمياء التي تتحكّم بمستقبل الناس بعد أن ألهتهم ببعض النعم الزائفة، فأبعدتهم عن القيم الدينية على حساب أرواحهم وأعراضهم، بل والغاية من خلقهم من كونهم خلفاء الله في أرضه. فالنهضة الحسينية تبرّز حالة الصراع وتبقي جذوته مستعرة في النفوس، فالإنسان المتماهي مع هذه النهضة يبدأ بتشخيص حالة الصراع هذه في نفسه أوّلاً؛ إذ يزن الإنسان الحسيني رغبات نفسه، ويسعى جاهداً إلى محاربة ما كان باطلاً منها، ثمّ ينطلق شيئاً فشيئاً ليصل إلى أعلى مراتب الصراع حتّى يتشكّل جيل حسيني رافض للظلم والباطل في جميع المناطق التي تعيش أجواء هذه النهضة المباركة.
3ـ ترسيخ مبدأ الأُسوة والقدوة
يُعدّ مبدأ الاقتداء والتأسّي أساساً مهمّاً في حياة الإنسان؛ إذ يرافقه في جميع مراحله العمرية، فالشخص في بداية عمره، وبسبب عدم خوضه للكثير من التجارب، وعدم دخوله إلى معترك الحياة وصعوباتها ومشاكلها، نجده يسعى إلى اتّخاذ قدوة تساعده على اتّباع الطريق القويم، وتمدّه بالتجارب والخبرات التي تصقل شخصيته وتساعد في تكوينها، فالقدوة حاجة فطرية نشأت بفعل عدم الكمال الذي يعاني منه الإنسان؛ ومن هنا نجد أنّ القرآن قد شدّد على ضرورة التحلّي بهذا، قال تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا )[36]، وقال أيضاً: ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله…)[37].
بل أكثر من ذلك إنّ الله(عز وجل) يأمر الرسول(صلى الله عليه واله) الذي هو أكمل الأنبياء والمرسلين بأن يقتدي بالهدى الذي تحلّى به مَن سبقه من الأنبياء، قال تعالى: (الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)[38].
نعم، القرآن الكريم كان متوجّهاً إلى أنّ الإنسان قد يُشبع هذه الحاجة الفطرية بطريقة خاطئة، فبدلاً من أن يتّخذ قدوةً حسنةً تمنحه الهداية والنجاة والفوز، نجده يتّخذ قدوةً موهومةً تُبعده عن ذلك كلّه وتُلحق به الضلال والخسران، قال تعالى في معرض ذمّه للمنحرفين عن الجادّة الحقّة: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ)[39]؛ إذاً، فهؤلاء المترفون يقومون بمواجهة جهود الأنبياء والرسل في كلّ أُمّة من خلال تحريك هذا المبدأ لدى الناس، مشخِّصين لهم مَن يقتدون به، وأنّ هؤلاء الآباء هم الأَوْلى بالاقتداء من أُناس غرباء عنهم.
وقد قارن المولى(عز وجل) بين قدوتين، إحداهما سيئة ابتعدت عن خطّ الأنبياء(عليهم السلام)، والأُخرى قدوة حسنة سارت على النهج الذي رسمه الله تعالى للبشرية، وذلك في قوله تعالى: ( ضَرَبَ الله مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ * وَضَرَبَ الله مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ)[40].
ونظراً لهذه الأهمّية التي يحظى بها هذا المبدأ الفطري، ولضمان عدم الانحراف في تطبيقه عن جادّة الشريعة؛ نجد أنّ الأنبياء جميعهم وكذلك أوصياؤهم قد تحمّلوا شتّى أنواع المصاعب والشدائد من أجل أن يكونوا قدوةً للناس في زمانهم، حتّى يصلوا من خلال اتّباعهم والسير على هديهم إلى السعادة والنجاة.
ومن هؤلاء الأشخاص نجد أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) في نهضته المباركة ـ التي هي مورد بحثنا ـ سعى إلى أن تكون نهضته معلماً وشاخصاً بارزاً في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية، فهي ـ بعبارة جامعة ـ سلوك رافض لتغييب دور الدين الإسلامي في المجتمع، ففي كلّ زمان هُدد فيه الكيان الديني، ينبغي الاقتداء والسير على نهج الحسين(عليه السلام) من أجل استئصال هذا التهديد واجتثاثه من جذوره. أضف إلى ذلك أنّ التأثير الذي يتركه السلوك الخارجي للقدوة أقوى بكثير من أقواله؛ ومن هنا فإنّ الإمام في فعله الذي قام به في هذه النهضة المباركة جعل نفسه قدوةً لجميع الثائرين من أجل العزّة والكرامة، ولجميع الحريصين على بيضة الإسلام وغير الخاضعين للمستبدّين مهما كان توجّههم وانتماؤهم.
ومع هذا الوضوح في هذا الجانب إلّا أنّنا يمكن أن نتلمّس هذا المبدأ من كلمات الإمام(عليه السلام) ومواقفه في حركته التغييرية هذه، تلك الكلمات التي تكون ثمرة ترديدها المتواصل من قِبل خَدَمة المنبر الحسيني في مواسم التبليغ وغيرها مدعاة لجذب الناس نحو الاقتداء بهذا الإمام الطاهر ـ وكلّهم(عليهم السلام) قدوة وأُسوة ـ والتمثّل بمواقفه، فإنّه وبناءً على مبدأ التمثّل والاستيعاب، فإنّ المتلقّين لمفاهيم النهضة الحسينية من خلال تكرار هذه المواقف عليهم وترسيخ هذا المبدأ في أذهانهم، سوف يسعون إلى التمثّل بهذه المواقف ومحاكاتها في الموارد المشابهة، وهذا الأمر يكبر شيئاً فشيئاً إلى أنّ يصل إلى حالة استيعاب هذه المبادئ بشكل كامل، فيوجد لدينا حينها جيل حسيني يسعى إلى الشهادة من أجل تحقيق المبادئ السامية، وهذا بالفعل ما حصل عندما لبّى الشباب الحسيني في العراق فتوى المرجعية في الجهاد ضدّ فلول داعش الإرهابية، فبمحض سماع نداء المرجعية سارع المؤمنون الحسينيون إلى تسجيل أسمائهم والإلحاح على المسؤولين بإرسالهم إلى جبهات الكرامة بأسرع وقت.
إنّ هذا المبدأ يجلّيه الإمام الحسين(عليه السلام) بشكل واضح في نهضته المباركة، فهو على الرغم من كونه إماماً مفترض الطاعة بنصّ رسول الله(صلى الله عليه واله)[41]، إلّا أنّه(عليه السلام) يوقفنا بشكل واضح على أنّه أراد من حركته هذه التأسّي برسول الله(صلى الله عليه واله) والسير على نهجه، فقد قال(عليه السلام) في بداية حركته: «… وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب(عليه السلام)»[42]، وقال أيضاً ليلة العاشر من المحرّم مخاطباً أُخته زينب(عليها السلام): «أبي خير منّي، وأُمّي خير منّي، وأخي خير منّي، ولي ولكلّ مسلم برسول الله(صلى الله عليه واله) أُسوة»[43]. فإنّ هذه الكلمات ما هي إلّا تجسيد للمفهوم القرآني الذي أبانته الآية الشريفة التي طلبت من المسلمين التأسّي برسول الله(صلى الله عليه واله).
أضف إلى ذلك فهو(عليه السلام) عندما خرج من المدينة كان يردّد قوله تعالى: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)[44] [45]، وهذا تأسٍّ واضح بأحد أنبياء أُولي العزم وهو موسى(عليه السلام)، فالإمام(عليه السلام) بتلاوته هذه الآية وكذلك تلاوة قوله تعالى: ( وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ)[46] عند دخوله إلى مكّة المكرّمة[47]، كان يهدف من وراء ذلك إلى ربط حركته بحركة الأنبياء الذين كانوا يسعون إلى نجاة الإنسانية وإخراجها من الظلمات إلى النور مقابل مَن يريد عكس ذلك، ولعلّه من أجل هذا الهدف جاء التأكيد في زيارته(عليه السلام) على مسألة وراثته(عليه السلام) لجملة من الأنبياء الذين كان لهم أثر في ترسيخ الدين الإلهي في حياة البشر، فقد جاء في زيارة وارث المروية عن الإمام الصادق(عليه السلام): «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين(عليه السلام) وليّ الله»[48]. ومن هنا ونتيجة لهذا الربط نجد أنّ الزائر يعلن اقتداءه واتّباعه للأمر الذي سار عليه الإمام الحسين(عليه السلام) وعموم أهل البيت(عليهم السلام)، فقد ورد في مفردات الزيارة ذاتها: «وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متّبع»[49]، وجاء أيضاً هذا التأسّي والاتّباع في زيارة أنصار المولى أبي عبد الله(عليه السلام) وهم شهداء واقعة الطفّ (رضوان الله تعالى عليهم)، فقد رُوي عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «ثمّ أومِ إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء(عليهم السلام)، فهم هناك وقل: السلام عليكم أيّها الربانيون ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وأنصار…»[50].
وأمّا سلوك الإمام الحسين(عليه السلام) في هذه النهضة المباركة فهو أُسوة وقدوة على جميع المقاييس، كيف لا! وقد كان مخيّراً بين أن يعيش حياة هادئة بمجرّد بيعته للطاغية يزيد، وبين أن يلاقي السيوف البواتر وأسنّة الرماح والتنكيل به وبأُسرته وصحبه، فاختار الطريق الثاني من أجل أن يبقى الدين ويبقى الخطّ الإلهي الذي به يخرج الناس من الظلمات إلى النور مقابل مَن يريد عكس ذلك، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: (الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)[51].
فالإمام(عليه السلام) كان يُطالب بالحق كما تقدّم، وقد تحرّك في ضوء طلبات وكتب أعلنت الولاء له والطاعة، وبعد خذلان مَن كتبوا له نجده قد بالغ في إلقاء الحجّة على القوم، وأمّا في ميدان الحرب، فقد كان تخطيطه وإدارته للمعركة فذّة للغاية، فهذه المنازلات والأراجيز والخطب الرنّانة لصحبه وأهل بيته، التي نقلتها لنا كتب التواريخ والسير والمقاتل، هي في الحقيقة دروس وعبر لكلّ ثائر مضحّي من أجل مبادئ الإسلام السامية، أضف إلى ذلك بعض السلوكيات الأُخرى من قبيل تقديم الإمام(عليه السلام) ولده علي الأكبر للنزول إلى الميدان قبل بني هاشم، فكان أوّل شهيد من بني هاشم، وغيرها من السلوكيات الرفيعة.
كلّ هذه الأفعال وما تقدّم عليها من أقوال له(عليه السلام)، وكلمات الأئمّة التي قرّرت كيفية التعامل مع الأمكنة الطاهرة له(عليه السلام) ولـمَن معه من البررة، هي مَن جعلت الشيعي دائماً يلهج بعبارة: (يا ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً عظيماً)، ولذا فمن المفترض عليه إذا كان مخلصاً وصادقاً في أُمنيته أن يسير على ما ساروا، فإنّه بذلك سوف يحقّق الكون معهم والفوز بقربهم في جنّات الخلد.
4ـ إتمام ا لحجّة
من الأُسس الموضوعة التي تمّ التسالم عليها بين أفراد الإنسانية، هو أنّ المتبنّي لأيّ دعوى طالباً من الآخرين الاقتناع بمضمونها ومتابعتها على صعيد الاعتقاد القلبي أو السلوك الخارجي، ينبغي له إقامة البرهان والحجّة على صحّة دعواه، وهذا الأمر سرى إلى دعوى النبوّة من قِبل الأنبياء؛ وذلك لكون الطرف الجائي بها هو من البشر، وهو غير معصوم في نظر أغلب البشر، فتكون نسبة الخطأ والاشتباه بنظرهم واردة؛ ومن هنا نجد أنّ الله(عز وجل) يسدّد رسله وأنبياءه بالحجج الدامغة التي وصلت إلى درجة عجز البشر عن مجاراتها والإتيان بمثلها، فمعجزات الأنبياء أوضح من أن نسردها في هذه المقالة، فهي متنوّعة بحسب مقتضيات كلّ زمان ومكان. نعم، علاوة على ذلك فإنّه(عز وجل) قد أرشد العقل إلى كيفية الاستدلال على وجوده تعالى ووحدانيّته، فقد قال عزّ من قائل: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)[52]، وقال أيضاً: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتَا…)[53]. وقال كذلك: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)[54]، إلى غير ذلك من البراهين[55]، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، فإنّ هذه المعاجز والبراهين والحجج الإلهية علاوة على إثباتها المدّعى الذي جاء به الرسل والأنبياء، فهي تكون بمنزلة الإدانة القانونية لكلّ المخالفين والسائرين على غير النهج الإلهي؛ وعليه فإنّ كلّ ما سوف يُصيبهم من عذاب أُخروي يكون مبرّراً ولا يحقّ لهم الاعتراض عليه، قال تعالى: (…وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)[56]، وقال أيضاً: (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ…)[57]، فعلى الرغم من كونه(عز وجل): (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[58]، إلّا أنّ حكمته اقتضت أن تكون حجّته بالغة، فلا تُبقي أيّ عذرٍ لمعتذر، قال تعالى: (قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)[59]. أي: إنّ المشيئة الإلهية اقتضت اختيار الخلق وعدم إجبارهم على الإيمان والانصياع لأوامر الله تعالى، والدليل على هذا الاختيار هو أنّ الآية الأخيرة جاءت ردّاً على الاعتراض الوارد في الآية السابقة عليها: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا…)[60]، وعليه يكون المعنى المقصود منها هو أنّ جميع الحجج سواء كانت من النوع الباطن الذي تحكم به العقول البشرية، أم من النوع الظاهر الذي جاءت به الرسل والأنبياء[61]، كلّها تفنّد هذه الدعوى؛ وذلك لأنّه لو كانت المسألة جبرية فلا حاجة إلى كلّ هذه الأدلّة والحجج[62].
والنتيجة؛ إنّنا في أيّ دعوى نروم إشاعتها بين الناس لا بدّ أن نكون متسلّحين بالحجج الكافية التي نستطيع من خلالها إفحام الخصم، وإخلاء سبيلنا تجاه أيّ تبعةٍ سوف تواجهه جرّاء مخالفته للدعوى التي نحن بصددها.
هذا، وإنّنا لو نقلنا الحديث في هذا الموضوع إلى حركة أبي عبد الله(عليه السلام) ضدّ بني أُميّة، لوجدنا أنّه(عليه السلام) على الرغم من كونه هو الحجّة على الخلق كما نصّت عليه بعض الروايات[63]، إلّا أنّه في حركته وما حصل فيها من مواقف سعى حثيثاً إلى إقناع الطرف المقابل بمواقفه، وأنّ همّه الوحيد هو إرساء المفاهيم الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبذ الظلم، فهو سليل الدوحة المحمدية التي أخرج الله بها الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الحقّ والإيمان؛ ومع هذا فكيف يرى الإمام الحسين(عليه السلام) ـ وهو
سبط رسـول الله(صلى الله عليه واله) ـ أنّ الجاهلية العمياء تعود من جديد ولا يُحرّك ساكناً؟! هيهات من ذلك. ابتدأ الإمام الحسين(عليه السلام) معارضته للسلطة بإقناع أجهزتها الحاكمة بعدم صلاحية يزيد للخلافة، وذلك بذكر جملة من الأُمور المسلّمة ـ كما أشرنا في القسم الأول من هذا المقال ـ التي يتّصف بها يزيد والتي لم ينفها الوليد نفسه، فمع إقرار هذا الوالي بهذه الأُمور كيف سوّغ لنفسه القبول بحكومته، أَلا يدخل هذا الأمر ضمن دائرة العناد والانحراف الواضح عن الحقّ؟! هذا الانحراف الذي يكون سبباً للاستهتار بكلّ القيم الدينية، ويكون مثل المتلبّسين به كمَن ذكره الله تعالى بقوله: (وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)[64]. فقد أُعدم هؤلاء الحجّة على صحّة منحاهم ولم يبقَ أمامهم إلّا التشبث بالعناد وتضليل العامّة؛ ومن هنا كانت حركة الإمام(عليه السلام) من أجل كشف هذا التزييف والتضليل وإتمام الحجّة على جميع مَن سيخنع ويرضى بتسلّط هذه الشرذمة على رقاب المسلمين. نعم، إنّ مشروعه ودمه الطاهر سوف لا ينحسر بانتهاء هذه المعركة والانتصار الظاهري لبني أُميّة، فإنّه وإن أتمّ الحجّة على أولئك القوم، وألحق بهم العار والشنار إلى أبد الآبدين، إلّا أنّه(عليه السلام) منح هذه النهضة المباركة بُعداً معنوياً، وهو صيرورتها ـ من خلال الذكر المتواصل لها ـ بمنزلة إقامة متواصلة للحجّة على الناس أن يبحثوا ويسألوا ويستقصوا الحقائق، وأَلّا يكتفوا بالتقليد ومحاكاة الآخرين.
وعلى الرغم من وضوح هذا البُعد في نهضة الحسين(عليه السلام)، إلّا أنّنا نشير إلى بعض المواقف التي أقام فيها(عليه السلام) الحجة على خصومه، ومنها: مفاوضاته مع ابن سعد، وذلك أثناء اللقاء به قبل يوم العاشر، فقال(عليه السلام) له في تلك الجلسة: «ويلك يا بن سعد، أَما تتّقي الله الذي إليه معادك؟ أَتقاتلني وأنا ابن مَن علمت؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي، فإنّه أقرب لك إلى الله تعالى. فقال عمر بن سعد: أخاف أن يُهدم داري. فقال (له) الحسين(عليه السلام): أنا أبنيها لك. فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي. فقال الحسين(عليه السلام): أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز. فقال: لي عيال وأخاف عليهم. ثمّ سكت ولم يجبه إلى شيء»[65].
فإنّ هذا إذعان من ابن سعد بحقّانية الإمام الحسين(عليه السلام) في دعوته، فهو لم يرد عليه ويبيّن بأنّه على باطل، وأنّ الحقّ مع أسياده، وإنّما تذرّع ببعض الأعذار الواهية التي لا تتناسب مع شأن قادة الجيوش؛ إذاً، فهذه الكلمات التي قالها(عليه السلام) هي بمنزلة تذكير هذا العلج بأنّ ما يتشبّث به هي في الحقيقة أُمور سخيفة قياساً بما سوف يلحقه من منزلة عظيمة في حال أنّه انضمّ إلى صفوف جيش المولى أبي عبد الله الحسين(عليه السلام)، فهو ابن بنت رسول الله(صلى الله عليه واله) وريحانته، لكن هيهات هيهات فهؤلاء القوم هم مصداق لقوله تعالى: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)[66].
أمّا في صبيحة اليوم العاشر من المحرّم عندما اصطفّ الجيشان للمناجزة، فقد كان(عليه السلام) غير راغب بوقوع الحرب ولم يبادر القوم بالقتال[67]؛ وحاول جاهداً أن يثني القوم عن عزيمتهم بالتورّط بسفك دمه الطاهر، فقد خطب فيهم في ذلك اليوم محذِّراً إيّاهم من مغبّة فعلهم هذا ومقيماً الحجّة عليهم، قائلاً: «أيّها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتّى أعظكم بما يحقّ لكم عليَّ، وحتّى أُعذر إليكم، فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا رأيكم، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة، ثمّ اقضوا إليّ ولا تنظرون، (إِنَّ وَلِيِّـيَ الله الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)… أمّا بعدُ: فانسبوني فانظروا مَن أنا، ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟! أَلست ابن بنت نبيّكم، وابن وصيه، وابن عمّه، وأوّل المؤمنين المصدِّق لرسول الله بما جاء به من عند ربّه، أَوَليس حمزة سيّد الشهداء عمّي، أَوَليس جعفر الطيار في الجنّة بجناحين عمّي، أَوَلم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي: هذان سيدا شباب أهل الجنّة؟! فإن صدقتموني بما أقول وهو الحقّ، والله ما تعمّدت كذباً منذُ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، وإن كذبتموني فإنّ فيكم (مَن لو) سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يُخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله(صلى الله عليه واله) لي ولأخي، أَما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟!»[68].
فهذا التذكير منه(عليه السلام) هو من أجل إقامة الحجّة بالشكل الذي لا يدخل معه شكّ ولا ريب، وكان من المفترض على الشخص غير الجاحد أن يُذعن لهذا النداء، إلّا أنّه قد اكتسى الرين تلك القلوب وأصبحت أقسى من الحجارة الصمّاء، قال تعالى: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ)[69]، وقال أيضاً: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)[70]؛ فيأتيه جواب اللعين شمر بن ذي الجوشن وقيس ابن الأشعث بأنّهما لا يدريان ما يقول(عليه السلام)، بينما سكت بعضٌ آخر من الذين سمّاهم الحسين(عليه السلام) في خطبته أمثال: شبث بن ربعي، حجّار بن أبجر، زيد بن الحارث، ودفنوا رؤوسهم في الرمل كالنعامة. نعم، القلوب الطاهرة النظيفة عندما تسمع هذه الكلمات ترى بأنّها أمام حجّة تامّة لا يمكن تجاوزها وغمض البصر عنها، وهذا ما حصل للحرّ بن يزيد الرياحي، فهو عندما سمع هذه الكلمات ووقف على عناد القوم وجحودهم للحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، قرّر ترك جبهة الكفر والالتحاق بقافلة الشهادة، بعد أن أعلن توبته وندمه عمّا فعله من جعجعته برحل الحسين(عليه السلام) ومنعهم من دخول الكوفة[71].
والنتيجة التي نقف عليها هي أنّ هذه النهضة الحسينية التي لم تفارق القرآن بكلّ مواقفها، تضع بين أيدينا هذه الثمرة المعنوية، وهي أنّه من المفترض علينا في جميع مواقفنا التي نسعى فيها إلى رضا الله أن نكون متسلّحين بالحجّة التامّة، وأن نكون قادرين على إيصالها إلى الناس، من خلال امتلاكنا وسائل الإقناع الكافية، قال تعالى: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[72].
المحور الرابع: الآثار المعنوية المرتبطة بالجانب الحماسي والثوري
إنّ إرادة التغيير وعدم الانكفاء على نمط حياتي محدّد يُعدّ من المميّزات المفصلية التي يتمتّع بها الإنسان، هذه الإرادة التي من المفترض أن تقوده إلى تحقيق النمط الأفضل في حياته على شتّى الأصعدة: كالسياسي، والاجتماعي، والعمراني، والأخلاق العملية. ونحن في المقام نظراً لتخصّص المقال بالجانب المعنوي نوّد تسليط الضوء على الصّعيدين السياسي والاجتماعي، مضافاً إلى الأهمّية البارزة التي يحظى بها هذان البُعدان وأثرهما الواضح في سائر الأبعاد الأُخرى.
وعلى كلّ حال فالتغيير السياسي والاجتماعي نحو نمط يُحقق السعادة والحياة الهادئة هو من المتطلّبات البشرية في كلّ زمان ومكان، إلّا أنّه ممّا يؤسف له قد يقف في وجه هذه الرغبة معوّقات تمنع من ذلك، وتحاول إيقاف الإنسان على ما يريده مثيرو هذه الموانع من أنماط، محقّقين من وراء ذلك رغباتهم في التسلّط على رقاب الناس ونهب ثرواتهم؛ لذلك فلا بدّ من حركة ثورية تكون دائماً في معرض إثارة هذا الجانب في النفوس، من أجل أن لا تنطفئ هذه الجذوة مهما كانت درجة التسلّط والعنجهية التي يمارسها بعضٌ في هذا المضمار. وقد كانت النهضة القرآنية التي بزغ نورها على يد النبي الخاتم(صلى الله عليه واله) مشعلاً منيراً أضاء الدرب لـمَن كان يعيش في عصر ظلمات الجهل والانحطاط، وأوقفهم على ضرورة مواصلة الطريق من أجل تحقيق الدولة العادلة بقيادة خلفاء الرسول الشرعيين، لكن بسبب عوامل عديدة حصل تقهقر من قِبل المسلمين ورجوع تدريجي إلى وحل الظلمات، وصل إلى ذروته في عصر الطاغية يزيد ابن معاوية، فاستدعى حينها من إمام تلك المدّة القيام بواجبه المقدّس من أجل شحذ الهمم والثورة ضدّ هذا الواقع المزري، وقد نتج عن عمله جملة من الآثار المهمّة في هذا الجانب نستعرض اثنين منها بما يناسب المقام.
1ـ تدعيم مبدأ الولاية والقيادة
لا شك في أنّ مَن يشغل منصب قيادة المجتمعات البشرية ـ سواء كانت مدنية أم قبلية ـ يمتلك دوراً حسّاساً في تحديد مصير هذه المجتمعات نحو الأفضل أو الأسوأ، وبغضّ النظر عن المجتمعات الأُخرى، فإنّنا كمسلمين عانينا الكثير من تسلّط الجبابرة الذين كانوا مصداقاً لقوله تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)[73]. وأمام هذا العتو والتجبّر فإنّ الشعوب إذا كانت خانعة راضية بذلك غير مبدية لأيّة ردّة فعل، فإنّ هذا التجبّر سوف يصل إلى أُمور لا تُحمد عقباها، من قبيل ادّعاء الربوبية والقدرة اللامتناهية، قال تعالى عن لسان فرعون بعد أن تمادى في غروره وجبروته: (… أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)[74]، وقد سبقه إلى هذا الادّعاء النمرود في قصّة إبراهيم(عليه السلام)، قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ الله الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ)[75]. فإنّ الشعوب إذا رضيت بالهوان وغلب عليها الخوف؛ أعطت الطاغية فرصة وشجّعته على الاستمرار والزيادة في البغي، ولنلاحظ مثال على ذلك ما ذكره القرآن الكريم بشأن قوم موسى(عليه السلام)، فإنّ غفلتهم وسكوتهم عن أعمال فرعون وقبولهم استبداده هو ما جرّأه عليهم، قال تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)[76]، وفي الوقت الذي كان موسى(عليه السلام) يقوّي فيهم حالة الصبر والاستعانة بالله على فرعون وجنوده، كانوا يواجهونه بالاستكانة والإحباط والذلّ والهوان: (وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ)[77].
إذاً؛ فالشعوب بحاجة إلى أن تكون واعية ويقظة دائماً في مقام تحديد الشخص الذي يتولّى زمام الحكم فيها، وفي مقابل هذه الحاجة نجد أنّ القرآن الكريم قد تدخّل وكانت له كلمته الفصل في المقام، وذلك من خلال تبنّيه نظرية سياسية مؤدّاها أنّ مَن يتصدّى لإدارة شؤون المسلمين ينبغي أن يكون قد أخذ الشرعية من الله تعالى، فقال(عز وجل): (قُلْ أَطِيعُواْ الله وَالرَّسُولَ)[78]، وقال أيضاً: (…وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ)[79]. وعلى الرغم من الخلاف الذي دار بين أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) ومدرسة الصحابة حول تحديد شكل القيادة للعالم الإسلامي ـ هل تكون بالتنصيب الإلهي، أو تكون بترشيح أهل الحلّ والعقد في الأُمّة الإسلامية؟ ـ إلّا أنّه لم يغب عن الذهنية المسلمة اشتراط سير شخص خليفة رسول الله(عليه السلام) على وفق كتاب الله وسنّة نبيه(صلى الله عليه واله) وعدم مخالفتهما[80]، كيف لا! والآيات تؤكّد بشكل لا يقبل الشكّ ضرورة عدم خروج الحكم مهما
كان نوعه عن محورية الله تعالى، فقد قال(عز وجل): (…وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)[81]، وقال أيضاً: (…لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [82]، وقال كذلك: (…وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[83].
وفي مقابل هذا التشخيص لسلوك الحاكم الماسك بزمام الأمر، يوجد هناك حثّ كبير على الثورة ومواجهة المستبدّين والظالمين، قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا)[84]، كما أنّ هناك مدحاً للمجتمع الثائر غير الساكت على الظلم؛ وذلك لكونه من جملة المصاديق التي تدخل تحت قول تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ)[85]. ومن الموارد الأُخرى للمدح هي أنّ الكلام بالأُمور السيّئة مذموم في القرآن، إلّا في مورد حصول الظلم، قال تعالى: (لاَّ يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا)[86]. وعليه؛ ففي مورد تحقّق الظلم الذي من أبرز مصاديقه ظلم الحاكم لرعيته والسير فيهم على ما لا يُرضي الله ورسوله، سوف يكون مباحاً للناس التحدّث بصوت عالٍ بهذا الظلم، وجَوب الشوارع والخروج بالتظاهرات المندّدة بهذا الحاكم، والمطالبة بالإصلاح أو العزل إن كان الإصلاح متعسِّراً، وهذا الفعل لا يمكن أن يُلام عليه هؤلاء، وهو القائل في كتابه: (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ)[87].
إذاً؛ فالمسلم الذي يحمل هذه الثقافة القرآنية، ينبغي له أَلّا يقبل بالظلم والجور الممارس من قِبل السلاطين والحكّام، وأن يكون موطِّناً نفسه على التضحية، فحتى لو لم نعشْ ظرف الأُطروحة الإلهية لشكل الحكومة، فمن المفترض أن تكون عدالة الحاكم تجاه رعيته، وتحصيل العيش الرغيد والآمن، واحترامه لدينهم ومشاعرهم من الأُمور المطلوبة التي لا محيص عنها.
هذا، وإنّنا إذا جئنا إلى نهضة الإمام الحسين(عليه السلام) في واقعة الطفّ الخالدة، لوجدنا أنّها كانت تحمل هذا المسعى القرآني نفسه، فهي كانت خروجاً على الحاكم الظالم الجائر، وكذلك تحديداً في الوقت نفسه لـمَن هو أوْلى بأن يقود هذه الأُمّة إلى برّ الأمان، وكيف لا تكون كذلك، وقد كان السبب لحصولها هو رفض البيعة من قبله(عليه السلام) ليزيد الطاغية، فقد قال أبو عبد الله(عليه السلام) في مقام تعليل رفضه لبيعة يزيد مخاطباً مروان بن الحكم: «فإنّ مَن لعنه رسول الله(صلى الله عليه واله) لا يمكن له ولا منه [إلّا] أن يدعو إلى بيعة يزيد. ثمّ قال: إليك عنّي يا عدّو الله! فإنّا أهل بيت رسول الله(صلى الله عليه واله)، والحقّ فينا وبالحقّ تنطق ألسنتنا، وقد سمعت رسول الله(صلى الله عليه واله) يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان…»[88]، فإنّ كلامه(عليه السلام) هذا فيه دلالة واضحة على تدخّله في مقام تحديد الشخص الذي يتولّى زمام الحكم في الدولة الإسلامية، بل الأكثر من ذلك فهو(عليه السلام) في كلام آخر يرى أنّ هذا الحقّ منحصر بأهل البيت(عليهم السلام) دون غيرهم، فقد قال: «أمّا بعدُ، أيّها الناس فإنّكم إن تتقوا وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أوْلى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان»[89]. وقد سبق هذا الكلام ما ورد في كتاب وجّهه(عليه السلام) إلى أشراف البصرة، قال فيه: «أمّا بعدُ، فإنّ الله اصطفى محمداً(صلى الله عليه واله) على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثمّ قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلّغ ما أُرسل به(صلى الله عليه واله)، وكنّا أهله وأوليائه[90] وأوصياءه وورثته، وأحقّ الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنّا أحقّ بذلك الحقّ المستحقّ علينا ممّن تولّاه، وقد أحسنوا وأصلحوا وتحرّوا الحقّ، فرحمهم الله وغفر لنا ولهم، وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه(صلى الله عليه واله)؛ فإنّ السنّة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أُحييت»[91].
فإنّ الحركة التغييرية التي يكون هذا المفهوم حاضراً لديها، من المؤكّد أن تترك ذلك كأثر في نفوس السائرين خلفها، حيث لم يألوا جهداً في إشاعتها بين الناس من خلال إصرارهم على إقامة المراسم المتعلِّقة بهذه المناسبة على طول أيام السنّة. ففي ذهن المسلم الشيعي وكلّ مَن يعايش في وجدانه هذه الحركة المعطاء نجد أنّ لمفهوم القيادة والولاية شكلاً خاصّاً، قد يختلف تحديده بين زمن حضور الأئمّة(عليهم السلام) وزمن غيبتهم، وكذلك يختلف الأمر في زمن الغيبة في مسألة تولّي الفقهاء لزمام الأمر أو عدم تولّيهم، وعلى الرغم من كلّ التشقيقات إلّا أنّ القاسم المشترك لشكل الحكومة التي انبثقت من حركة أبي عبد الله(عليه السلام) يستند إلى أمرين مهمّين، هما: إقامة العدل، وحفظ الهوية الدينية للمجتمع الإسلامي، فإنّ الخطابات الواضحة والمتكرّرة من الإمام الحسين(عليه السلام)، التي يصف بها يزيد بانتهاك الحرمات الإسلامية وارتكابه لجرائم القتل، وكذلك كلامه في كتابه إلى أهل البصرة المتقدّم (بأنّ السنّة قد أُميتت والبدعة قد أُحييت)، كلّ هذه الأُمور يتبيّن منها بشكل واضح لا يقبل الشكّ بأنّ نظام بني أُميّة في عهد هذا الفاجر كان يسعى إلى إذابة المفاهيم الإسلامية في المجتمع، وإرجاع الناس إلى جاهليّتهم الأُولى وإلى زمن العبودية والرقّية للأسياد وزعماء البيوتات الذين يتحكّمون بمصائر العباد والبلاد، قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)[92].
والمحصّلة التي نخرج بها من هذه النقطة هي أنّ السائرين على نهج القرآن الكريم والرسول الكريم والمكملين هذا السير بتماهيهم مع النهضة الحسينية قلباً وقالباً، سوف يكونون رافضين لشتّى الحكومات التي ابتعدت عن الأمرين المهمّين المبيّنين أعلاه، فإنّ شعارهم دوماً هو مؤدّى قوله تعالى: (إِنَّ وَلِيِّـيَ الله الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)[93]، وقوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)[94]. وعليه؛ فإنّ هذا الرفض الذي يعيشه الشيعة في كلّ مكان ما هو إلّا مصداق لهذا التقولب بهذه المفاهيم القرآنية والحسينية؛ ممّا حدا ببعضٍ أن يُطلق عليهم الرافضة، وفي الحقيقة هذا اللقب الذي سعى من خلاله الطغاة إلى التنكيل بهم هو شرف لهم، فهم رافضة لكلّ أنواع الظلم والاضطهاد الذي مارسه الظلمة على طول مسار التاريخ، وبشتّى الصور والعناوين التي تلبّسوا بها، موهمين السذّج بأنّهم المحافظون على الرسالة الإسلامية، وأنّهم الأصلح من غيرهم في إدارة شؤون البلاد والعباد.
2ـ التضحية في سبيل اللّه
إنّ من أجمل النِّعم التي يلتذّ بها الإنسان ويحرص عليها هي نعمة الوجود والحياة، فهو يسعى جاهداً إلى البقاء أطول مدّة ممكنة في هذه النشأة، ولو تمكّن من الخلود لمَا آلى جهداً في تحصيله وإبعاد شبح الموت عنه، وهذا الأمر لا يختصّ بالمنغمسين بالمادّيات البعيدين عن النور الإلهي كما ورد في قوله تعالى: (قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ الله خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ) [95]؛ وإنّما نجد هذه النعمة محبّبة ومرغوباً فيها حتّى عند المؤمنين، قال تعالى في قصّة إخراج آدم من الجنّة: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ)[96]، لكن الفارق بين الصنفين هو أنّ المؤمنين يسعون إلى البقاء في هذه الدنيا مستثمرين ذلك في اكتساب مرضاة الله، والحصول على درجات القرب الإلهي العليا؛ وعليه فهذه النعمة ثمينة عند الجميع إلّا مَن شذّ.
ومن الأُمور الأُخرى التي يسعى الإنسان إلى تحصيلها في هذه الحياة الدنيا هي الأموال والأبناء والنساء، قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالله عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)[97]، بل عدّ الأمران الأوّلان من مظاهر الجمال لهذه الحياة الدنيا، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…)[98].
فهذه الأُمور رغم أهمّيتها البالغة والألم الشديد الذي يصاحب فقدانها، خصوصاً في مسألة الأنفس، إلّا أنّنا نجد أنّ الإنسان قد يجعلها في مواضع العطب والتلف أو يتخلّى عنها ويضحّي بها في لحظة من لحظات حياته لقيمة أعلى وغاية أسمى، وهي إعلاء كلمة الحقّ ونصرة الدين والدفاع عن المظلومين، وكلّ ما يكون في سبيل الله(عز وجل)، وهذا الجهاد والتضحية كانا مورداً للمدح والثناء في القرآن وفي موارد عديدة، منها:
قوله تعالى: (لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ الله الْحُسْنَى وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)[99].
وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ..)[100].
وقوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)[101].
وقـوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)[102].
إلى غير ذلك من الآيات التي تصوّر لنا المنزلة العظيمة التي يحظى بها مَن يضع أعزّ ما يملك على كفّه ويقدّمه فداءً لله تعالى، كيف لا! إذ لولا جهود هؤلاء البواسل لكان المجتمع معرّضاً للوقوع في الفتنة[103]، ولضاعت جميع جهود النبي(صلى الله عليه واله) في تبليغ الدين الحقّ، قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)[104]، ولحلّ الفساد في الأرض، قال تعالى: (…وَلَوْلاَ دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)[105]. ونظراً لهذه الأهمّية البالغة نجد أنّ المولى(عز وجل) قد صوّر عملية التضحية هذه بصورة في غاية الروعة، فإنّه تعالى هو المالك المطلق لكلّ شيء في هذا الوجود، إلّا أنّه يجعل ذاته المقدّسة في موضع المشتري لما يريد أن يضحّي به المجاهد في سبيله، قال تعالى: (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)[106]. فـ«إذا أمعنا النظر في قوله: فِي سَبِيلِ الله، يتّضح جلياً أنّ الله تعالى يشتري الأرواح والجهود والمساعي التي تُبذل وتُصرف في سبيله، أي: سبيل إحقاق الحقّ والعدالة، والحريّة والخلاص لجميع البشر من قبضة الكفر والظلم والفساد»[107]. هذا، وإنّ هذه التضحية هي علامة صدق واضحة للإنسان في حبّه لله تعالى، فالشوق للقاء المحبوب هو من صفات المتّقين، قال أمير البيان(عليه السلام): «ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين؛ شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من العقاب»[108]؛ ومن هنا يكون لقاؤهم بالحقّ بعد تضحيتهم بأنفسهم واستشهادهم في سبيله من دواعي الفرحة والبهجة، قال تعالى: (فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)[109].
وهذا المبدأ القرآني السامي نراه تجلّى بأروع صوره في واقعة الطفّ الخالدة، فالإمام الحسين(عليه السلام) وجميع مَن معه ـ سواء الذين نالوا شرف الشهادة أم الذين تحمّلوا أعباء الأسر والسبي ـ قد ضحّوا في سبيل كلمة الحقّ، فهو(عليه السلام) وضع نفسه الشريفة ونفوس جميع أهل بيته وأصحابه فداءً لهذا الدين الحنيف، ومن أجل إنقاذ الناس من عمى الجهالة التي كان من المقرّر إرجاعهم إليها من قِبل بني أُميّة، نقرأ في زيارة الأربعين: «وبذل مهجته فيك؛ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة»[110]، فهو(عليه السلام) صرّح في المراحل الأُولى لهذه النهضة المباركة بأنّ منهاجه هو التضحية في سبيل الله والرغبة في لقائه؛ ومن هنا فهو(عليه السلام) كان يوطِّن مَن معه على أن يكونوا على استعداد كامل لهذا الأمر، فقد ورد في خطبته عند خروجه(عليه السلام) إلى العراق: «مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطِّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله»[111].
هذا المفهوم الذي أبانه الإمام(عليه السلام) في بداية حركته كان له الأثر البالغ في نفوس الخلّص الذين بقوا معه ونالوا شرف الشهادة في سبيل الله، فهذا علي الأكبر (سلام الله عليه) عندما رأى أنّ والده الحسين(عليه السلام) ـ في طريق كربلاء ـ يسترجع ويحمد الله بعد أن هوّمت عيناه وهو على فرسه، أقبل عليه متسائلاً: «ممَّ حمدت الله واسترجعت؟ فقال[(عليه السلام)]:يا بُني، إنّي خفقت خفقةً فعنّ لي فارس على فرس وهو يقول: القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنّها أنفسنا نُعيت إلينا. فقال له: يا أبت، لا أراك الله سوءاً، أَلسنا على الحقّ؟ قال[(عليه السلام)]:بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: فإنّنا ـ إذاً ـ لا نبالي أن نموت محقّين»[112].
وهو المنطق ذاته الذي عبّر عنه أصحابه ليلة العاشر من المحرّم عندما جعلهم الإمام(عليه السلام) في حلّ من بيعته وسمح لهم بالانصراف عنه، فقد كان جوابهم بلسان واحد: «الحمد لله الذي شرّفنا بالقتل معك»[113].
وبالفعل فقد بقيَ هؤلاء إلى آخر رمق من حياتهم، وهم يستبشرون بالمصير الذي سيُلاقيهم، فهم فرحون قبل مفارقة أرواحهم لأبدانهم، وهذه الحالة كانت من دواعي البشرى للإمام(عليه السلام) نفسه، فإنّ صمود هؤلاء الخلّص وثباتهم كان له الدور الكبير في تحقيق الانتصار المعنوي لهذه النهضة المباركة، ودوام عطائها في كلّ زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ ومن هنا نجد أنّ التوجّس الذي كانت تعيشه العقيلة زينب(عليها السلام) هو ما يفرضه الموقف وطبيعة المواجهة، فقد قالت متسائلة: «أخي، هل استعلمت من أصحابك نيّاتهم، فإنّي أخشى أن يسلّموك عند الوثبة واصطكاك الأسنّة؟»[114]، وهنا يأتي جواب الإمام الحسين(عليه السلام) للعقيلة زينب(عليها السلام) جواباً مطمئناً، ومعبِّراً عن حالة الفرح والسرور الذي يعيشه هؤلاء الأفذاذ، وهم يقدّمون أنفسهم قرابين فداءً في سبيل الله تعالى ونصرة لإمامهم، فقد قال(عليه السلام) في هذا الصدد: «أَما والله، لقد نهرتهم وبلوتهم وليس فيهم [إلّا] الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفل بلبن أُمّه»[115].
هذا جانب جزئي من الأقوال والتصريحات التي قيلت في هذه الواقعة الخالدة، والمفعمة بمعاني التضحية والفداء. أمّا التجسيد الواقعي لهذه المفاهيم، فهو ممّا لا يكاد يخفى على كلّ مَن أنصف نفسه وجرّدها عن اتّباع الهوى والشيطان، فالمصير الذي انتهى إليه المقاتلون المشاركون في هذه الواقعة لم يكن لشيء من حطام الدنيا، بل كان لغاية سامية تتماهى مع الغاية التي استُشهد من أجلها أبو عبد الله(عليه السلام)، والتي هي عبارة عن إحياء الدين الإسلامي، وزعزعة عروش الطغاة والجبابرة، فهي ـ إذاً ـ
تضحية في سبيل الله ومرضاته، وقد تجلّت صورة هذه التضحية في الموقف الشجاع للحوراء زينب(عليها السلام)، ذلك الموقف الذي واجهت به طاغية الكوفة عبيد الله بن زياد عندما سألها متهكِّماً وشامتاً: «كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟» فقد أجابته بقلب ملؤه الثقة بالله: «ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قوم كُتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتُحاجّ وتُخاصم، فاُنظر لـمَن الفلج، هبلتك أُمك يابن مرجانة»[116]. وهذه العبارة تحمل المدلول نفسه الذي حملته العبارة المشهورة عنها(عليها السلام) يوم عاشوراء، عندما وقفت على مصرع أخيها الحسين(عليه السلام) قائلة: «اللّهمّ تقبّل منّا هذا القربان»[117].
وبالنتيجة؛ فإنّ مَن يعيش هذه النهضة بروحه وكيانه ويتفاعل معها، وتكون منهاجاً له يُضيء دربه، سوف يكون مستعدّاً للتضحية بكلّ ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله، ولا يكون أداةً طيِّعةً بيد طغاة العصر مهما بلغت أساليبهم الظالمة في إسكات صوت الحقّ.
وهذا الاستعداد للتضحية إذا ما ترسّخ واستحكم في النفوس بفعل تعميق العطاء الحسيني القرآني في هذا الجانب، فإنّه يمكن أن يخلق وعياً ثورياً لا على الواقع السياسي فحسب، بل على مستوى الواقع المجتمعي أيضاً، فسوف يولِّد جيلاً يحمل همّ الثورة والاستعداد للتضحية بالمال والوجاهة والنفس أحياناً في سبيل تقويم مسار المجتمع أمام موجات الانحراف التي يقودها روّاد الحرب الناعمة، فخطر هؤلاء لا يقلّ خطورةً عن الطواغيت والجبابرة.
إنّ ضياع الشباب وانصياعهم أمام موجات الإلحاد التي تقودها دوائر المخابرات والشركات الساعية إلى إشاعة الانحلال والميوعة، يجعلنا بحاجة ماسّة إلى موقف جادٍ لجيل واعٍ يجمع بين قوّة الفكر وحسن العمل والانصياع الكامل لمرجعية عالمة واعية تتابع عمله باستمرار، وهذا التمازج لا يمكن أن يتحقّق إلّا في جيل تشبّع بمفاهيم النهضة الحسينية وسرت في دمائه، فهو مَن يكون مستعدّاً للتضحية بروحه وراحته خدمةً لمجتمعه وحفاظاً على هويّته الدينية.
الخاتمة
إنّ الانتصار المعنوي الذي تحقّق للنهضة الحسينية جعلها جديرة بالبحث والتحقيق من زوايا عديدة، ومن دون أدنى شكّ فإنّ الحديث عن البُعد القرآني في حركة التغيير هذه يحتلّ درجة عليا من الأهمّية، فإنّ القرآن الكريم هو الدستور الخالد للرسالة الإسلامية، وهو المنبع المصان من التحريف والتزييف؛ وعليه فإنّ الاندكاك بين مفاهيم هذه النهضة المباركة ومعطياتها وبين القرآن الكريم، سيمنحها مقوِّماً مهمّاً آخر يُضاف إلى المقوّمات الأُخرى التي تقدّم الحديث عنها في بداية القسم الأوّل من هذا المقال. ونحن عندما حاولنا الحديث عن هذا التمازج بين القرآن وبين حركة أبي عبد الله(عليه السلام) في واقعة الطفّ الخالدة، قد حدّدنا منذ البدء بأنّنا بصدد بيان قرآنية هذه النهضة على صعيد مخرجاتها والثمرات التي انبثقت منها وحسب.
ثمّ إنّ هذه الآثار التي نحن بصددها هي خصوص الآثار المعنوية. ونتيجة لسعة هذه الثمرات والبركات التي هي كالبحر المتلاطم، والتي لو أراد الباحث الخوض في جزئياتها وتفاصيلها لأحوجه ذلك إلى وضع خطة لتأليف كتاب مستقلّ؛ ومن هنا صار بناؤنا على الاختصار والاقتصار على عرض توصيفي تحليلي لبعض الآثار بشكل كلّي.
وقد تمّت دراسة جميع هذه الآثار في ضوء الآيات القرآنية وكلمات المولى أبي عبد الله(عليه السلام) ومواقفه، ومواقف الأفذاذ الذين كانوا معه سواء من أهل بيته الطاهرين أم صحبه البررة.
ونحن ـ وكما أشرنا في القسم الأوّل من هذا المقال ـ سعينا في هذه الدراسة إلى ترسيخ مفهوم المعيّة التي أقرّها الرسول الأعظم(صلى الله عليه واله) في حديث الثقلين، فعدم الافتراق بين القرآن وأهل البيت(عليهم السلام) ينبغي أن يكون حاضراً في حياة المسلمين، يستشعرونه في كلّ حركاتهم وسكناتهم، فهو المؤمِّن لهم من الوقوع في الضلال كما نصّ على ذلك(صلى الله عليه واله).
والحمد لله ربِّ العالمين.
________________________________________
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد(ت413هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1414هـ/1993م.
2. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت463هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجبل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1412هـ/1992م.
3. الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء)، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ)، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني، مؤسّسة الحلبي وشركائه للنشر والتوزيع.
4. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي، ترجمة وتلخيص: محمد علي آذرشب، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1421هـ.
5. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري(ت279هـ)، حقّقه وعلّق عليه: الشيخ محمد باقر المحمودي، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1397هـ/1977م.
6. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، تحقيق: محمد باقر البهبودي، مؤسّسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1402هـ/1983م.
7. البرهان في تفسير القرآن، هاشم بن سليمان البحراني (ت1107هـ)، تحقيق وتصحيح: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، نشر مؤسّسة البعثة، قم المقدسة ـ إيران، 1416هـ.
8. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفّار (ت290هـ)، تحقيق وتصحيح: ميرزا محسن كوجه باغي التبريزي، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم المقدسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1404هـ.
9. تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلّاء، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
10. تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت571هـ)، دراسة وتحقيق: علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1415هـ/1995م.
11. تفسير العيّاشي، محمد بن مسعود العيّاشي (ت320هـ)، تحقيق: هاشم رسولي محلّاتي، المطبعة الحيدرية، الطبعة الأُولى، طهران، 1422هـ.
12. تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، حقّقه وعلّق عليه: السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1365ش.
13. جواهر التاريخ، علي الكوراني، دار الهدى، الطبعة الأُولى، 1426هـ.
14. حياة الإمام الحسين بن علي(عليهما السلام)، باقر شريف القرشي (ت1433هـ)، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، الطبعة الأُولى، 1394/1974م.
15. الصحاح، إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطّار، دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 1407هـ/1987م.
16. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال (الإمام الحسين(عليه السلام))، عبد الله البحراني (ت1130هـ)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) بالحوزة العلمية، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1407هـ/1365ش.
17. الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (ت1392هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1397هـ/1977م.
18. الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي (ت926هـ)، تحقيق: علي شيري، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1411هـ/1991م.
19. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت328/329هـ)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفّاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1367ش.
20. الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1385هـ/1965م.
21. كتاب الخصال، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، حقّقه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1403هـ/1362ش.
22. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، أنوار الهدى، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
23. مثير الأحزان، جعفر بن محمد بن نما الحلّي (ت645هـ)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1369هـ/1950م.
24. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، حسين بن محمد تقي النوري (ت1320هـ)، تحقيق وتصحيح ونشر: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، قم المقدّسة ـ إيران، 1408هـ.
25. مصباح المتهجّد، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1411هـ/1991م.
26. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404هـ.
27. مفاتيح الجنان، عبّاس القمّي (ت1359هـ)، تعريب: محمد رضا النوري النجفي، منشورات العزيزي، الطبعة الثالثة، 1385ش/2006م.
28. مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني، مؤسّسة الإمام الصادق(عليه السلام)، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الرابعة، 1421هـ.
29. مقتل الحسين، لوط بن يحيى بن سليم الأزدي (ت157هـ)، تحقيق: حسين الغفاري، مطبعة العلمية، قمّ المقدّسة ـ إيران.
30. المقنعة، محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (ت413هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1410هـ.
31. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهر آشوب (ت588هـ)، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1376هـ/1956م.
32. موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام)، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، دار المعروف للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1416هـ/1995م.
33. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحسين بن محمد الحلواني (من أعلام القرن الخامس)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي(عليه السلام)، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى المحقّقة، 1408هـ.
34. نهج البلاغة، خطب الإمام علي(عليه السلام)، تحقيق: صبحي صالح، الطبعة الأُولى، 1387هـ/1967م.
35. وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت1104هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، قمّ المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1414هـ.
المواقع الإلكترونية
36. مأساة واقعة كربلاء في كتابات المستشرقين الغربيين، جعفر رمضان.
37. https://uowa.edu.iq/arabic.
________________________________________
[1] قال الحرّ العاملي(رحمه الله(: «أقول: وقد تواتر بين العامّة والخاصّة عن النبي(صلى الله عليه واله) أنّه قال: إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض».الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج27، ص33ـ34.
[2] المصدر السابق: ج16، ص123.والحديث نفسه أورده الشيخ المفيد مع اختلاف في بعض الألفاظ.اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، المقنعة: ص808.
[3] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص181.
[4] آل عمران: آية104.
[5] فالآية السابقة على هذه الآية هي قوله تعالى:(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ((آل عمران: آية103)، والآية اللاحقة هي قوله تعالى:(وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ((آل عمران: آية105).
[6] التوبة: آية71.
[7] آل عمران: آية110.
[8] الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص644ـ645.
[9] آل عمران: آية113ـ114.
[10] الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص654.
[11] التوبة: آية67.
[12] فقد رُوي عن الرسول(صلى الله عليه واله) أنّه قال: «ثلاث خصال من علامات المنافق: إذا حدّث كذب، وإذا ائتُمن خان، وإذا وعد أخلف».النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج9، ص85.
[13] هذا الأمر إشارة إلى ما ورد في مجموعة روايات، منها ما رُوي عن الإمام العسكري(عليه السلام): «جُعلت الخبائث في بيت وجُعل مفتاحه الكذب».المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج69، ص263.
[14] الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج5، ص19.
[15] الأميني، عبد الحسين، الغدير: ج10، ص162.
[16] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص314.
[17] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص48.
[18] التوبة: آية67.
[19] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص304.
[20] البحراني، عبد الله، العوالم(الإمام الحسين(عليه السلام)(: ص179.
[21] لقمان: آية17.
[22] ص: آية82 ـ83.
[23] الأعراف: آية43.
[24] الكهف: آية56.
[25] اُنظر: رمضان، جعفر، مقال بعنوان: مأساة واقعة كربلاء في كتابات المستشرقين الغربيين، على الموقع: https://uowa.edu.iq/arabic/ .
[26] المؤمنون: آية116.
[27] الحج: آية62.
[28] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص42.وأيضاً: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص195.وأيضاً: الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج4، ص291.
[29] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص42.وأيضاً: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص385.وأيضاً: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص261.وأيضاً: ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص140.
[30] الكوراني، علي، جواهر التاريخ: ج3، ص70.
[31] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص325.
[32] الحج: آية19.
[33] الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص43.
[34] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[35] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص304.
[36] الأحزاب: آية21.
[37] الممتحنة: آية4.
[38] الأنعام: آية90.
[39] الزخرف: آية23.
[40] التحريم: آية10 ـ 12.
[41] فقد قال(صلى الله عليه واله) في حقّ الحسن والحسين(عليهما السلام(: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا».المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص30.
[42] البحراني، عبد الله، العوالم(الإمام الحسين(عليه السلام)(: ص179.
[43] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص94.
[44] القصص: آية21.
[45] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص35.الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص254.وأيضاً: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص17.
[46] القصص: آية22.
[47] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص35.وأيضاً: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص17.
[48] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص720.
[49] المصدر السابق: ص721.
[50] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص65.
[51] البقرة: آية257.
[52] فصلت: آية53.
[53] الأنبياء: آية22.
[54] فاطر: آية15ـ 16.
[55] للاطّلاع أكثر على هذه البراهين اُنظر: السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن: ج1، ص111ـ 226.
[56] الإسراء: آية15.
[57] النساء: آية165.
[58] الأنبياء: آية23.
[59] الأنعام: آية149.
[60] الأنعام: آية148.
[61] هذا التقسيم ناظر إلى ما رُوي عن الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام): «إنّ لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة: فالرسل والأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)…».الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص16.
[62] اُنظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج4، ص503.
[63] فقد روى سدير عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال: «…نحن الحجّة البالغة على مَن دون السماء وفوق الأرض».العيّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج1، ص383.وروى عبد الله بن أبي يعفور عنه(عليه السلام) أيضاً قوله: «…فنحن حجج الله في عباده، وخزّانه على علمه، والقائمون بذلك».الصفّار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات: ج1، ص104ـ105.ورُوي عن الإمام الرضا(عليه السلام) ـ في رواية طويلة تحدّث فيها عن الإمامة ـ قوله: «الإمام يُحلّ حلال الله، ويُحرّم حرام الله، ويُقيم حدود الله، ويذبّ عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة، الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم».البحراني، هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن: ج4، ص283.
[64] المؤمنون: آية117.
[65] البحراني، عبد الله، العوالم(الإمام الحسين(عليه السلام)(: ص239.واُنظر: الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج5، ص92ـ93.
[66] النمل: آية14.
[67] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص96.وأيضاً: الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص602.
[68] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص97 ـ 98.
[69] المطففين: آية14.
[70] البقرة: آية74.
[71] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2 ص99 ـ 100.
[72] النحل: آية125.
[73] القصص: آية4.
[74] النازعات: آية24.
[75] البقرة: آية258.
[76] الزخرف: آية54.
[77] الأعراف: آية127ـ 129.
[78] آل عمران: آية32.
[79] الحشر: آية7.
[80] خذ مثلاً ما قاله أبو بكر عندما وصل إلى هذا المنصب، فقد خطب بالمسلمين وكان ممّا قاله: «أيّها الناس، فإنّي قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم».الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج2، ص450.
[81] المائدة: آية44.
[82] المائدة: آية45.
[83] المائدة: آية47.
[84] النساء: آية75.
[85] الشورى: آية39.
[86] النساء: آية148.
[87] الشورى: آية41.
[88] الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج5، ص17.
[89] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص303.وأيضاً: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص47.
[90] هكذا وردت في المصدر والصحيح:(أولياءه).
[91] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين(عليه السلام): ص25ـ 26.
[92] المائدة: آية50.
[93] الأعراف: آية196.
[94] المائدة: آية55.
[95] البقرة: آية94ـ95.
[96] الأعراف: آية20.
[97] آل عمران: آية14.
[98] الكهف: آية46.
[99] النساء: آية95.
[100] الأنفال: آية72.
[101] الحجرات: آية15.
[102] الصف: آية11.
[103] بيّن بعضٌ بأنّ الفتنة: «ذات معنى واسع تشمل كلّ أنواع الضغوط، فتارةً يستعملها القرآن بمعنى عبادة الأصنام والشرك الذي يشمل كلّ أنواع التحجّر والجمود واضطهاد أفراد المجتمع؛ وتُطلق الفتنة أيضاً على الضغوط التي يفرضها الأعداء، للوقوف بوجه اتّساع دعوة الإسلام، ولإسكات صوت أهل الحق، بل حتّى إرجاع المؤمنين نحو الكفر».الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج5، ص425 ـ 426.
[104] الأنفال: آية39.
[105] البقرة: آية251.
[106] التوبة: آية111.
[107] الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص228.
[108] نهج البلاغة: ص303، خطبة 193.
[109] آل عمران: آية170.
[110] القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: ص682.
[111] الحلواني، الحسين بن محمد، نزهة الناظر وتنبيه الخواطر: ص86.
[112] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82.
[113] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص298.
[114] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين(عليه السلام): ص493.
[115] المصدر السابق: ص493.
[116] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص71.
[117] القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين(عليه السلام): ج2، ص301.
https://warithanbia.com/?id=2753
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة وارث الأنبيا
لینک کوتاه
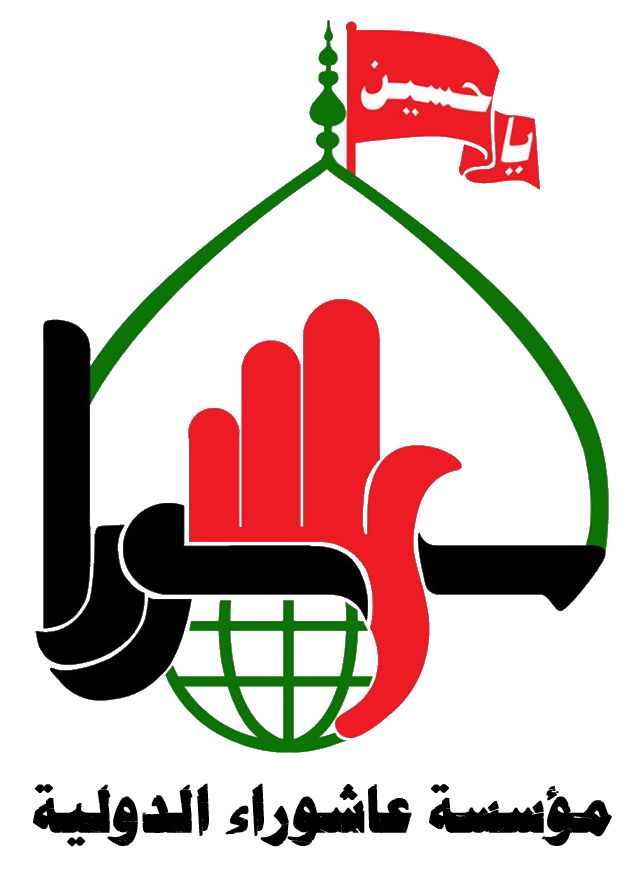
سوالات و نظرات