أثر القرآن الكريم في خطب السيدة زينب (عليها السلام)
{ م. م. إيناس محمد العبادي/كلّية الكفيل الجامعة/العتبة العباسية المقدسة/العراق }
مقدّمة
استطاعت المرأة العربية أن تُثبت نفسها في فنّ الخطابة، ولا سيّما بعد مجيء الإسلام، فقد انتقلت المرأة إلى مرحلةٍ جديدة تميّزت عن سابقتها، إذ خرجت إلى ميدان الخطابة؛ لأنّ الدين الإسلامي قد منحها حريةً مكّنتها من الدفاع عن حقوقها، وقد تضمّنت هذه الخطب المعاني الإسلامية، والحذو حذوَ القرآن الكريم، واتِّباعها منهج الحجج وإيراد البراهين؛ لإخضاع الخصم، وفي طليعة هؤلاء النسوة السيّدة زينب(عليها السلام)، التي اقتبست الآيات القرآنية والألفاظ في كلّ خطبها، موظفةً إيّاها خير توظيف؛ لإيضاح الفكرة وإفحام الخصوم.
الخطابة
للخطابة تعريفات كثيرة ، ( وأوضح وأدقّ ما عُرِّفت به الخطابة أنّها هي : فنّ مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناء و الاستمالة )[1]، وهي إحدى الفنون النثرية، وظيفتها الإقناع، وتختلف عن غيرها بحضور المتلقّي، فهي نصّ مُشافَه به، ولذلك لا بدّ من توفّر مواصفات في النصّ وفي مؤدّيه؛ ليتحقّق الإقناع والتأثير في الجمهور المتلقّي، وقد اهتمّ النقّاد العرب بمواصفات المؤدّي وهو الخطيب، ومواصفات الأداء، أي: الإلقاء، ومواصفات النصّ الُملقى، فاشترطوا في الخطيب سلامة جهاز النطق من العيوب، كما أوصَوا المؤدِّي بحُسن الإلقاء، وتوزيع مواضع الوقف توزيعاً جيّداً، فهي قدرة أو كفاءة أو مَلَكة[2].
وتتنوّع الخطابة بتنوّع موضوعاتها؛ فهناك الخطابة الدينية، والخطابة السياسية، والخطابة الاحتفالية، والخطابة القضائية[3]. ويُشتَرط في الخطبة الإسلامية أن تبدأ بالبسملة والتحميد والتمجيد لله سبحانه، والصلاة على النبي محمد وآله، وأن تتزيّن بالقرآن الكريم والحديث النبوي[4]، وأحياناً يلجأ الخطيب إلى الأمثال والأبيات الشعرية، فالخطابة هي: (صياغة الكلام بأُسلوب يمكِّن الخطيب من التأثير على نفس المخاطب)[5].
مفهوم التناصّ
التناص مصطلحٌ وفد إلينا من الغرب، وفرض حضوره على الدراسات النقدية العربية مؤخّراً، وقد اختلفت النظريات والتفسيرات حوله باختلاف التيارات الفكرية والمدارس النقدية، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى مرجعه اللغوي قبل الحديث عن دلالة التناصّ في بُعده الأدبي.
يرجع التناصّ إلى الجذر اللغوي (نصَصَ)، وقد أورد له أصحاب (المعاجم اللغوية) مجموعة من المعاني، منها: (النصُّ: رفعُك الشيء. نصّ الحديث ينُصُّه نصّاً: رفعَهُ، وكلُّ ما أُظهِرَ فقد نُصَّ… ونصّ المتاع نصّاً: جعل بعضَه على بعض… النصّ: الإسناد إلى الرئيس الأكبر، والنصّ التوقيف، والنصّ التعيين على شيء ما)[6].
من هنا؛ يتّضح أنّ لمفهوم التناصّ جذوراً لُغوية، وإن لم يرد هذا المفهوم بجذوره الأصلية.
أمّا التناص في البُعد النقدي، فقد ظهر في الدراسات الأدبية على يد الباحثة الفرنسية (جوليا كرستيفا)، إذ عرّفته بقولها: (هو ذاك التقاطع داخل التعبير، مأخوذ من نصوص أُخرى)[7].
والتناصّ أساسه التفاعل والتشارك بين النصوص، وهذا يقتضي الحفظ والمعرفة السابقة؛ لأنّ النصّ (يعتمد على تحويل النصوص السابقة وتمثيلها في نصٍّ مركزي، يجمع بين الحاضر والغائب في نسيج متناغم مفتوح)[8].
خطب السيّدة زينب(عليها السلام)
لسنا بحاجة إلى التعريف بالسيّدة زينب(عليها السلام)، فالتعريف بالمعروف بخسٌ لحقّه؛ فهي سليلة البيت العلوي، وعقيلة بني هاشم، وابنة حيدر وفاطمة(عليهما السلام)، وقد انبرت لإفشال مخطّط جيش الشام الخبيث، فتقدّمت بحجابها وبلاغتها لتَقِف أمام أعتى الظالمين في عصرها، فكأنّ علياً قام خطيباً في القوم، فتمثّلت بالقرآن الكريم في خطبها، ونمّ هذا الاستعمال عن فهم عميق للنصّ القرآني، وكأنّه خالط لحمها ودمها، وهي الطريقة ذاتها التي نجدها عند الإمام علي(عليه السلام)، فقد استعمل الشاهد القرآني في نهج البلاغة من أجل عدّة وظائف، أهمّها:
(1ـ إصلاح الذات وتهذيب النفس.
2ـ الترغيب والترهيب.
3ـ الوظيفة العبادية والعقائدية.
4ـ الاحتجاج.
5ـ الوظيفة العقلية)[9].
وتميّزت خطب السيّدة زينب(عليها السلام) بكثرة الاقتباس من آيات القرآن الكريم بما يناسب المقام، فتارةً نجده مباشراً من غير فصلٍ بين نصّ الخطبة والآية؛ إذ يرتبطان بوشائج متينة بحيث لا يحسُّ القارئ بالانتقال من الخطبة إلى الآية؛ وهذا ينمُّ عن استيعاب كامل من السيّدة زينب(عليها السلام) للنصّ القرآني، فهي تستحضره بسرعة كلّما احتاجت إليه للاستشهاد على قضيةٍ ما، وتارةً يكون الاقتباس غير مباشر، من دون أن تلتزم بلفظ الآية وتركيبها، ولكنّ المتلقّي لا يجد صعوبة في تشخيص الآيات القرآنية من نصّ الخطبة، والخطيبة في كلتا الحالتين توظّف الاقتباس توظيفاً دقيقاً؛ لذا سينتظم البحث في مطلبين لرصد أثر القرآن الكريم في خطب السيّدة زينب(عليها السلام)، وهما:
المطلب الأوّل: الاقتباس المباشر من القرآن الكريم.
أمّا المطلب الثاني: الاقتباس غير المباشر من القرآن الكريم.
المطلب الأوّل: الاقتباس المباشر من القرآن الكريم
تميّز اقتباس السيّدة للآيات المباركة بدقّة اختيار الآيات وتوظيفها في خطبها(عليها السلام) توظيفاً ينسجم مع الهدف المراد إيصاله إلى المتلقّين، كما سيتّضح من خلال الأمثلة الآتية:
1ـ بعد حمد الله سبحانه والثناء عليه، والصلاة على النبيّ محمد(صلى الله عليه واله)، تبدأ السيّدة زينب(عليها السلام) خطبتها في الكوفة مستشهدة بالآية الكريمة التي تتضمّن تشبيهاً تمثيلياً، قالت(عليها السلام): (إنما مَثَلُكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم)[10]، وهو اختيارٌ دقيق يُناسب المقام تماماً؛ لأنّها بصدد تقريعهم وتحقيرهم؛ لأنّهم دعوا ابن بنت رسول الله(صلى الله عليه واله)، وأعطوه العهود المغلّظة، ثمّ نكثوا عهودهم وغدروا به، ومثل هذا الفعل ليس من الإسلام في شيء.
ومن جانبٍ آخر تذكّرهم بأنّ العرب مدينون لمحمد وذرّيته، فقد وحّدهم بعدما كانوا طرائق قدداً، يغيرُ بعضُهم على بعض، ويسلب بعضهم بعضاً، وكانوا مشتّتين متفرّقين، فجعل لهم ذِكْراً بين الأُمم، فبعد أن قويت شوكتهم وارتفع شأنهم، أصبح مثَلهم كمثَل التي تنقض غزلها من بعد قوّة أنكاثاً.
وقد ذكّرتهم(عليها السلام) بماضيهم المُخزي؛ إذ دأبوا على نقض العهود، والتخاذل والغدر، كيوم صفّين عند تحكيم الحكمين، وبعد استشهاد أمير المؤمنين(عليه السلام) تهافتوا على مبايعة الإمام الحسن(عليه السلام)، ثمّ خرجوا مع معاوية لقتاله، ثمّ بعد استشهاد الإمام الحسن(عليه السلام) أرسلوا اثني عشر ألف رسالة إلى الإمام الحسين(عليه السلام)، يطلبون منه التوجّه إلى العراق؛ لينقذهم من السلطة الأُموية الغاشمة، فبعث إليهم سفيره مسلم بن عقيل(عليه السلام)، فغدروا به، وتفرّقوا عنه، ثمّ لبّى الإمام الحسين(عليه السلام) النداء، وجاء إلى العراق، ووصل إلى أرض كربلاء، ومعه الصفوة من أهل بيته وأصحابه(عليهم السلام)، فقتلوه، ولم يرعَوا فيه إلّاً ولا ذمّة، وهذا دأبهم[11]، فوبّختهم(عليها السلام) قائلةً: (أتبكون أخي؟! أجل والله، فابكوا، فإنّكم أحرى بالبكاء…)[12]، فمَثَلُهم مثَلُ العبيد والإماء، فالبكاء أليق بهم، وهو يناسب ضعفهم وهوانهم.
نلاحظ أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) قد وظّفت الآية الكريمة توظيفاً رائعاً يُناسب سياق الكلام، ولا نجد أيّ انفصالٍ بين الآية الكريمة وما يجاورها من عبارات الخطبة.
2ـ قولها(عليها السلام): (ألا بئس ما قدّمتْ لكم أنفسُكُم، أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْكمْ وَفِي الْعَذابِ أنتم خالِدُون)[13]، وهو اقتباسٌ من قوله تعالى: (تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ)[14]. وعند تحليل سياق الآية في القرآن الكريم نلاحظ أنّها جاءت بعد الحديث عن بني إسرائيل الذين اشتهروا بنقض العهود والمواثيق، وتكذيب الأنبياء والرسل وقتلهم، وهذا يلائم ما فعله بنو أُمية وأتباعهم مع الحسين وآل بيته(عليهم السلام). ثمّ إنّها استعملت عبارة (ألا ساءَ ما قدّمت أنفسكم) وقد وردت في القرآن الكريم أكثر من مرّة في قوله تعالى: (أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ)[15]، و (أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ)[16]، (والوِزر: الحِمْل الثقيل. والوِزْرُ: الذّنب العظيم لثِقْلِه، وجمعهما: أوزار)[17]، ومعناه: ساء ما ينالهم جزاءً لهذا الذنب العظيم، وهو قتلهم الحسين(عليه السلام).
3ـ (الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على جدّي سيد المرسلين، صدق الله سبحانه كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)[18])[19]، هنا استهلّت السيّدة زينب(عليها السلام) خطبتها بالآية الكريمة، فاختزلت مضمون الخطبة بأكملها، وفي هذه البداية مقاصد ومعانٍ لا تتوقّف عند حدِّ إثارة المتلقّين أو شدّ انتباههم، وضمان إصغائهم، بل هي ردٌّ على أبيات يزيد التي تمثّل بها:
لعبت هاشم بالملك فلا خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل
وهو بهذا الاستشهاد قد أنكر نزول الوحي؛ لذلك ردّت عليه بالآية الكريمة: (أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)، لأجل أن تُفحمه وتُبدّد فرحه وافتخاره، وتُخبره بأنّ مصيره بئس المصير، وعاقبته الهوان والعذاب الأليم، فكان اقتباساً موفّقاً من حيث المعنى؛ لتفنيد هذا الادّعاء الباطل.
وممّا يُلاحَظ هنا براعة الخطيبة؛ إذ أحسنت التعامل مع هذا الموقف الذي قد يعجز عن تحمّله الرجال الأشداء، مع أنّها أسيرة، وقد قُتل إخوتها وأهل بيتها، وسُبيَت من العراق إلى الشام، وأُدخلت في مجلس يزيد الذي يعجُّ بالأعداء، أو الذين يجهلون قدرها بسبب التعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطة الأُموية آنذاك.
ثمّ تقتبس آيةً تعضد وتقوّي ما تقدّم، إذ تقول(عليها السلام): (فمهلاً مهلاً، لا تطِش جهلاً، أنسيت قول الله(عز وجل): (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)[20])[21].
المطلب الثاني: الاقتباس غير المباشر من القرآن الكريم
أوّلاً: اقتباس التركيب من القرآن
إنّ تأثير التركيب القرآني في خُطب السيّدة زينب(عليها السلام) واضحٌ جداً، وسنلاحظ في المقتطفات التالية كيف تأثّرت تلك الخُطب بأُسلوب القرآن الكريم.
• (اللّهم خُذْ بحقّنا، وانتقم ممّن ظلمنا، وأحلل غضبك على مَن سفك دماءنا، ونقض ذمارنا)[22].
• (الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه محمّد(صلى الله عليه واله)، وطهّرنا من الرجس تطهيراً)[23].
• (… فقالت: ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قومٌ كتبَ الله عليهم القتلَ، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتُحاجون إليه، وتختصمون عنده)[24].
وظّفت السيّدة زينب(عليها السلام) هذا الاقتباس لبيان تسليمها الكامل لإرادة الله؛ لأنّ نفس المؤمن مطمئنة، وإنّ أجل الإنسان لا يتقدّم ولا يتأخّر، وقد استعمل القرآن الكريم هذا المفهوم في قوله تعالى: (….قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)[25].
وهذا (يعني: مَن علم الله منه أنّه يُقتل ويُصرع في هذه المصارع، وكتب ذلك في اللوح، لم يكن بدّ من وجوده، فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بينكم الذين علم الله أنّهم يُقتلون إلى مضاجعهم، وهي مصارعهم؛ ليكون ما علم الله أنّه يكون، والمعنى: أنّ الله كتب في اللوح قتل مَن يُقتَل من المؤمنين، وكتب مع ذلك أنّهم الغالبون؛ لعلمه أنّ العاقبة في الغلبة لهم، وأنّ دين الإسلام يظهر على الدين كلّه، وأنّ ما يُنْكَبُون به في بعض الأوقات تمحيصٌ لهم، وترغيب في الشهادة، وحرصهم على الشهادة، ممّا يحرّضهم على الجهاد، فتحصل الغلبة)[26]. فهذا الدين لا يستقيم إلّا بسفك تلك الدماء الزكية المقدّسة.
ثمّ تُخاطبهم(عليها السلام) موبّخةً لهم: (أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيراً، واضحَكوا قليلاً)[27]، فهي تُخبرهم بالعاقبة المخزية التي تنتظرهم، فماذا يرتجي مَن قتل سبط رسول الله(صلى الله عليه واله) مظلوماً عطشاناً، ورضَّ جسده الطاهر بحوافر الخيول، وحرق خيامه، وسبى حرمه، وساقهم من بلدٍ إلى بلد؟!
وقد استقت السيّدة زينب هذا التركيب من قوله تعالى: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ…. فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)[28]، استعملت المعنى لتنذرهم بأنّ فرحهم زائل، وعذابهم مُقيم.
ثانياً: اقتباس اللفظة القرآنية
اللفظة القرآنية هي اللفظة التي نقل القرآن الكريم دلالتها من الجاهلية إلى دلالة جديدة اختصّ بها وحده، وهي موجودة في خُطب السيّدة زينب(عليها السلام)، وقد جاءت اللفظة القرآنية متمكّنة في خطبها، ممّا يدلّ على شدّة امتزاج ذات السيّدة زينب(عليها السلام) بثقافة القرآن الكريم، فلا تجد مشقّة عند استلال اللفظة القرآنية من مخزونها الذهني؛ لأنّها حاضرة دائماً باللفظ والمعنى في ذهنها كلّما أرادت التعبير عن معنىً ما، بل قد تنتزع اللفظة من سياق وموقف مشابه لموقفها، فكأنّها تُذكِّر الناس بالمواقف المتشابهة التي واجهها رسول الله(صلى الله عليه واله) مع المشركين والمنافقين، فتُعيدها إلى الأذهان، لتبيّن لهم أنّ القوم عادوا إلى شركهم وضلالهم بقتلهم الإمام الحسين(عليه السلام) وهذه الثُلّة الطاهرة معه، وأنّه(عليه السلام) امتدادٌ للرسول الأعظم(صلى الله عليه واله).
والألفاظ المُقتبَسة شديدة الاندماج في نصّ الخطبة، بحيث لا يوجد نفور ولا انفصال بين اللفظة القرآنية والخطبة، وتلك سِمة فنّية تُضاف إلى طبيعة اقتباسات السيّدة زينب(عليها السلام) للّفظة القرآنية، فهي اقتباسات فاعلة تُضيف مزيداً من المعاني داخل النصّ الجديد الذي حلّت فيه، وتمتزج معه بعلاقات غاية في التمكّن، وسأحاول تسليط الضوء على الاقتباسات التي تكشف عن عمق فهم المفردة المقتبسة داخل النصّ القرآني، وذلك من خلال قول السيّدة زينب(عليها السلام): (… وبُعداً لكم وسُحقاً، فلقد خاب السعي، وتبّت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضُربتْ عليكم الذلّة والمسكنة)[29].
نلاحظ أنّها(عليها السلام) اقتبست الألفاظ القرآنية، وذكرتها بتسلسلٍ يخدم المعنى الذي تريده، فتبّتْ الأيدي: أي: خسرت، وهذا يترتّب عليه غضب الله عليهم، وضُربتْ عليهم الذلّة لقتلهم سبط الرسول(صلى الله عليه واله)، فهم يشبهون بذلك عمل اليهود.
وإليكم نماذج من المفردات القرآنية في خطب السيّدة زينب(عليها السلام):
1ـ (بُعداً، سُحقاً)
بُعداً لكم وسُحقاً كلاهما بمعنىً واحد، وهو دعاءٌ عليهم. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ)[30]، أنّ (السُّحق: البُعد، وانتصابه على المصدر، أي: سحقهم الله سحقاً… وقال الزجاج: أي: أسحقهم الله سحقاً، أي: باعدهم بُعداً)[31].
وهذه الألفاظ موجودة في آيات أُخرى، كما في قوله تعالى: (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)[32]، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ لفظة (بُعداً) ترد غالباً في سياق الدعاء على الأقوام الذين عذّبهم الله(عز وجل) بالإبادة، كعاد، وثمود، ومدين، وغيرهم.
2ـ تبَّتْ الأيدي
تبَّتْ، أي: خسِرت، والتباب: الهلاك، والمعنى: هلكت الأيدي، فهي تدعو عليهم بالهلاك والخسران، وهو كقولهم لشخصٍ ما: (قاتلهُ الله)، (ومعنى تبّت يداه، أي: تبَّ هو؛ لأنّ العرب تنسب الشدّة والقوّة والأفعال إلى اليدين؛ إذ كان بهما يقع كلّ الأفعال)[33].
لقد كشفت السيّدة زينب(عليها السلام) كلّ الأباطيل التي نشرتها السلطة الغاشمة، من أنّ الحسين(عليه السلام) خرج على أُولي الأمر، وأنّه يجب أن يُقتَل، فبيّنت أنّ الفريقين أحدهما على باطل، وهو يزيد وحاشيته وجيشه، وهو يقابل كفّار قريش في هذه المعادلة، ومنهم أبو لهب الذي أكّد خُسرانه القرآن الكريم، فوقفت أمامهم هذه الثلّة المؤمنة التي هي امتداد للرسول الأعظم(صلى الله عليه واله) قولاً وفعلاً، فأراقوا دماءهم المقدّسة.
وكان هذا الدور من السيّدة زينب(عليها السلام) مكمِّلاً لهذه الثورة؛ إذ لا بدّ لكلّ قضية عادلة من جانب إعلامي يُساندها ويوضّح الأُمور.
3ـ بُؤتم بغضبٍ من الله
اقتبست السيّدة زينب(عليها السلام) الفعل (باءَ) من القرآن الكريم، وهو يصف أفعال اليهود، قال تعالى: (…فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ)[34]، فذمّت السيّدة زينب(عليها السلام) فعلهم، فهو يشبه فعل اليهود الذين فضّلهم الله بكثرة إرسال الرسل، وإغداق النِّعَم؛ فكذّبوا بعض الأنبياء، وقتّلوا بعضهم، وكفروا بالتوراة، وحرّفوا كلام الله وفق أهوائهم، وعبدوا العجل، فكانت النتيجة أنّهم استحقّوا غضب الله، فكأنّ الذين قتلوا الحسين(عليه السلام) كمَن أُشربوا عبادة العجل في قلوبهم.
ثمّ اقتبست اللفظ (ضُرِبَتْ) من قوله تعالى: (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ) [35]. وذلك إشارة منها(عليها السلام) إلى تقتيل اليهود لأنبيائهم.
وهكذا اضطلعت السيّدة زينب(عليها السلام) بهذه المهمّة العظيمة التي اختارها الله لها؛ لما تتمّتع به من مؤهّلات، فهي سليلة البيت النبوي، فالسلام على الحوراء زينب بطلة كربلاء، وعلى قلبها الصبور، ولسانها الشكور.
الخاتمة
كان البحث محاولة لبيان الأثر القرآني في خطب السيّدة زينب(عليها السلام)، ومدى تمكّن القرآن الكريم منها، فانطلق به لسانها دون تكلُّفٍ، وقد أفضت رحلة البحث إلى النتائج الآتية:
1ـ سارت السيّدة زينب(عليها السلام) على نهج الرسول الأعظم(صلى الله عليه واله) والإمام علي(عليه السلام) في افتتاح خطبها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله(صلى الله عليه واله)، على الرغم من عِظَمِ الفاجعة وهول المصيبة، فلم تتجاوز الطريقة الإسلامية المتّبعة في ابتداء الخُطب الإسلامية، وهذا يدلّ على رباطة جأشها، وقوّة إيمانها وصبرها.
2ـ إنّ خطاب السيّدة زينب(عليها السلام) في الكوفة يُعدُّ أوّل تصريح لأهل البيت(عليهم السلام) بعِظَم هذا الخَطب، وتكمن أهمّية الخطاب في أنّه يبيِّن تخاذل أهل الكوفة وتقاعسهم عن نصرة الحسين(عليه السلام)، ويحمّلهم المسؤولية.
3ـ كان القرآن الكريم متمكّناً منها(عليها السلام)، فجاء الاقتباس شديد الامتزاج بكلامها، فلم نجد انفصالاً بين الآية ونصّ الخطبة؛ لأنّ النصّ القرآني جزء من مخزونها الذهني.
4ـ اقتباسات السيّدة زينب(عليها السلام) للّفظة القرآنية تحمل معها المواقف والسياقات التي جاءت منها في النصّ القرآني، وتلك سمة فنّية تُضاف إلى طبيعة اقتباساتها، فهي تُضيف مزيداً من المعاني داخل النصّ الجديد الذي حلّت فيه، وتمتزج معه بعلاقات غاية في التمكّن والانشداد.
5ـ نجد في نصوص الخطب الزينبية دقّة في اختيار الألفاظ، فلا نجد الغرابة والتقعير، كما تتميّز خطبها(عليها السلام) بمتانة البناء، والتماسك بين تراكيبها، فضلاً عن البلاغة في أسمى مراتبها؛ فهي تزخر بالفنون البيانية، كالتشبيه، والاستعارة، والكناية.
المصادر والمراجع
*القرآن الكريم.
1. تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأُولى، 1422هـ/2001م.
2. الأثر القرآني في نهج البلاغة.. دراسة في الشّكل والمضمون، عباس علي حسين الفحّام، العتبة العلوية المقدّسة، النجف، 1432هـ/2011م.
3. الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي (ت620هـ)، منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأُولى، 1380هـ.ش.
4. إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش (ت1403هـ)، دار ابن كثير، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1420هـ/1999م.
5. بلاغة الحِجاج.. الأُصول اليونانية، الحسين بنو هاشم، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2014م.
6. البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة السابعة، 1418هـ/1998م.
7. التناصّ الشعري.. قراءة أُخرى لقضية السـرقات، منشأة توزيع المعارف بالاسكندرية، 1991م.
8. الخطابة وإعداد الخطيب، عبد الجليل عبده شلبي، دار الشـروق، القاهرة ـ مصـر، الطبعة الأُولى، 1401هـ/1981م.
9. زينب الكبرى(عليها السلام) من المهد إلى اللحد، السيّد محمد كاظم القزويني، تحقيق: مصطفى القزويني، دار المرتضى، بيروت ـ لبنان، 1420هـ.
10. قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، الجيزة ـ مصر، الطبعة الأُولى، 1995م.
11. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأُولى، 1418هـ/1998م.
12. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور(ت711هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
13. مستقبل الخطابة الحسينية وسُبل تحديثها، أحمد بن محمد اللويمي، موقع (شبكة الإمامين الحسنين(عليهما السلام)).
________________________________________
[1] شلبي، عبد الجليل عبده، الخطابة وإعداد الخطيب: ص13.
[2] اُنظر: بنو هاشم، الحسين، بلاغة الحِجاج..الأُصول اليونانية: ص203.
[3] اُنظر: الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين: ج1، ص78.
[4] اُنظر: المصدر السابق: ص108.
[5] اللويمي، أحمد بن محمد، مستقبل الخطابة الحسينية وسُبل تحديثها: ص10.
[6] ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص97ـ 98.
[7] محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: ص147.
[8] السعدني، مصطفى، التناصّ الشعري..قراءة أُخرى لقضية السرقات: ص 8.
[9] الفحام، عباس علي حسين، الأثر القرآني في نهج البلاغة..دراسة في الشكل والمضمون: ص9.
[10] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص26.
[11] اُنظر: القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام)من المهد إلى اللحد: ص292 ـ 293.
[12] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص26.
[13] المصدر السابق.
[14] المائدة: آية80.
[15] الأنعام: آية31.النحل: آية25.
[16] النحل: آية59.
[17] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص282.
[18] الروم: آية10.
[19] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص31.
[20] آل عمران: آية178.
[21] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص31.
[22] المصدر السابق: ص32.
[23] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام)من المهد إلى اللحد: ص348.
[24] المصدر السابق: ص348.
[25] آل عمران: آية154.
[26] الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف: ج1، ص644.
[27] القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى(عليها السلام)من المهد إلى اللحد: ص284.
[28] التوبة: آية82.
[29] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص26.
[30] الملك: آية11.
[31] أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط: ج8، ص294ـ295.
[32] المؤمنون: آية41.
[33] الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه: ج8، ص439.
[34] البقرة: آية90.
[35] آل عمران: آية112.
المصدر:مؤسسة وارث الأنبياء
https://warithanbia.com/?id=2232
لینک کوتاه
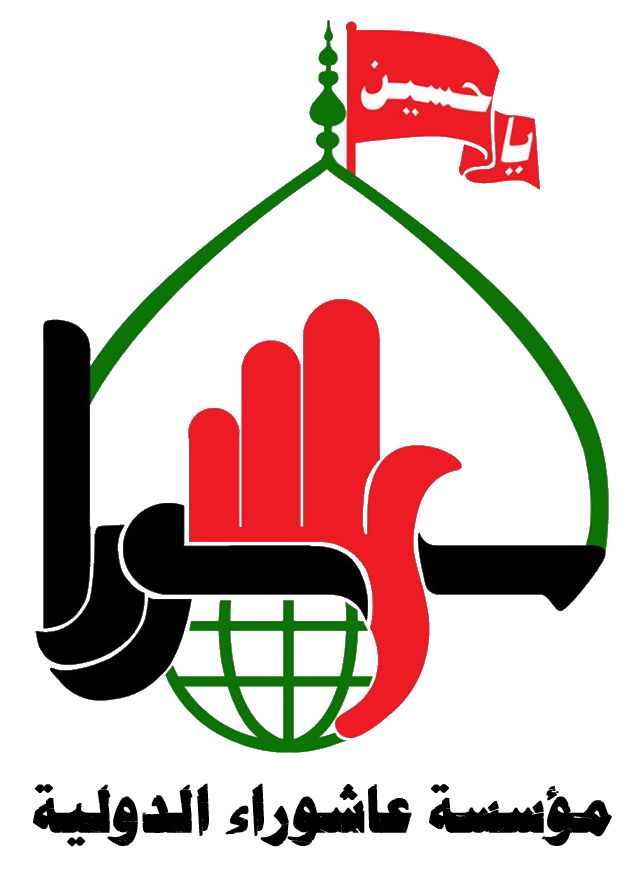
سوالات و نظرات