المأساة والأصداء ثورة الحسين (عليه السلام)
بقلم: يوسف عبد المسيح ثروت
ها قد بغی الظلم وتوسع واستشری الشر وتأصل، وتناهب (السادة) سواد الناس، في أرزاقهم وأموالهم وضمائرهم، فساموهم الخسف والذل، وأخذوهم كل مأخذ، إذ سقطت هيبة الحكم، بتناثر الشوری -إثر مقتل أبي الحسنين، فالتبس الأمر، وتخاذل القوم، وارتج علی أصحاب الرأي، بصعود يزيد إلی دست العرش القيصري من غير أن يكون للناس إلاّ الطاعة والخضوع والقبول المزري بالحال العابث الجاني العهد العنيد يتبختر بصولجانه!
وتوالت المصائب يأخذ بعضها برقاب بعض، فإذا الحوادث المرعبة تتدلی وتدور في غابة كثيفة من ظلام دامس، وإذا الاختبار العسیر ينتظر رجلاً، عز نظيره، رجلاً صادق العزم، نبيل التحدي، جریئاً في الحق، صامد الإيمان، ثابت الثقة بالنفس وبأتباعه أيضاً، وكان الحسين مثل هذا الرجل، عرف الطواغيت ودواخلهم ومساربهم ومخارجهم، عرفهم أصناماً وأوثاناً جاهلة، مزوقة بزي جديد، كله نفاق وخداع يضفي علی السلطان أبهة الحكم وعلی الرعیة ذل الطاعة.
ووقف الرجل في المدینة يتسائل ويتأمل، ويغرق نفسه في استجلاء الأمور واستقرائها، بعد أن نال السم من أخيه الحسن ما ناله، وينهض الحسين بالعبء الثقيل، ويمتثل الأحداث الجلائل المواضي والأحوال التي تنتظر الأمة، وقد طعن ربانها بيد آثمة.
ويطيل التأمل والاستقراء والتوقع والتفكير، فیری المشهد المتسربل بالدماء قدامه، ويجد نفسه في وسط الساحة تحيط به من جهة أكإلیل الشهادة الشائكة، وحرقة العطش، وفظاعة الإثم، وجناية الظالمين، وتعلوه من جهة أخری نجوم تتلألأ جلالاً وبهاء وسمواً، إيذاناً بالساعة الحاسمة، ساعة التحدي والمجابهة، ومقارعة الظلم والظالمين ساعة الثورة وتحمل المسؤولية: الرجل المليء بالعزم والثقة والصبر والشجاعة، لا يجد بداً من الانتظار العسیر لأنّ الانحياز للحق والدفاع عن المستضعفين والتصدي للباغين أمور لابد من إمعان البصر والفكر والقلب فيها وإلاّ انقلب الهدف، وضاقت الغایة، وتلاشی القصد..
ماذا يفعل وقد احيط به من كل جهة، والمحيطون به عصابة من الآبقين برئاسة رجل داهية وهو مروان بن الحكم؟..
الظلم یرید أن يركز قدامه في المدینة نفسها، برغم وجود الحسين حياً يرزق، ليثبت أنّ هذا الوجود حقیقة واقعة، وأنّ الشوری، كانت، إذا كانت، تعله للضعفاء، ومصيدة للأقوياء، لأنّها ظلت حجة يتلاعب بها الأقوياء ويتحاشاها الضعفاء الذين لم يكونوا موجودين، إلاّ للقتال وخوض المعامع، وسفك الدماء، لتحقيق أهداف متناقضة بحجج فريدة غريبة كانت متشابكة أصلاً. وظاهرة ثورة الحسين ظاهرة طبیعیة، لأنّها استنهاض علی الجور وانتقاض عليه، وهي -مع ذلك- فريدة في بابها لأنّها دلالة علی الإيمان بحق ضائع إيماناً لا يتزعزع، مهما انتفت ظروف هذا الإيمان، ومهما قل النصير وعز الأتباع والمريدون، وهذا الإيمان المثالي حقیقة تدل علی إصرار علی موقف، واستماته من أجل الدفاع عن هذا الموقف مهما تكن النتائج وكيفما مالت الريح، وهذا برهان علی بعد نظر أصيل، ذلك أنّ القائد، ولو افتقد جيشه مؤقتاً، مدعو ألا يترك الساحة في ساعة المحنة، وإلا فقدت القیادة سمتها الرئيسة، وهذا ما فعله الحسين، فإيمانه بحق الأمة في حكم نفسها، ظل القاعدة الأمينة التي فرضت علی الإمام الخروج علی يزيد والتوجه إلی العراق، استعداداً لدك معاقل الخارجين علی شرعة الأمة وسارقي حقها في حكم نفسها ولصوص قوتها وما من شك في أنّ المشاهد التي انتفضت من المدینة، لتواكب الحسين حتی مصرعه، في كربلاء مشاهد تنتظم عقداً عجيباً من الفواجع التي لم تعرف حدوداً، ففيها أنين ليل عجيب، لأنّه لم تزل أصداؤه تتعالی وتتعالی: ليل فيه تنكر أصحاب له يتنكروا للظلم الذي لف أرض السواد بسواده، وقيل هذا التنكر الغريب، تمت المؤامرة عليه، لافي الکوفة فحسب بل في المدینة أيضاً، ذلك أنّ إخراجه بأي وسیلة من المدینة، سيفسح المجال للطامعين في الخلافة من اهتبال هذه الفرصة الذهبية وهاهوذا ابن الزبير ينصح الامام الحسين قائلاً: «علي أي شيء عزمت يا أبا عبد الله؟» فلما أعلمه بعزمه الأكيد علی إتيان الکوفة قال له ابن الزبير: «فما يحبسك. فوالله لو كان مثل شيعتك بالعراق ما تلومن في شيء» ولكن ماذا عن هؤلاء الشیعة وقد نبذهم شرفاؤهم، ملتحقين بابن زياد وإلی الکوفة الجديد، وقاتل مسلم بن عقيل، الأمير الذي وضع نصب عينيه خدمة العرش الأموي ويزيد بالذات، لأنّ ابن الدعي كان یرید أن يثبت أصالته الأموية ، وليكن هذه المرة متفنناً مع المنقضين علی هذا الحكم المبني علی الجماجم، المتجلبب بالجاهلية، المتخذ من طاغوت يزيد رحماناً له يستذكره ويستخيره ويلوذ به، عملاً بشریعة الحكام، الذين جاءوا إلی الحكم وأنوف الناس في الرغام وعيونهم في أقفيتهم، وجباههم في مواطیء أقدامهم. وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد استهل ابن زياد ولايه الکوفة بقوله: «أما بعد، فإنّ أمير المؤمنين.. أمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم» توطئة لقوله: «والشدة علی مريبكم.. وسيفي وسوطي علی من ترك أمري وخالف عهدي» وهذا التهديد وحده كان للتعرف علی حق ابن زياد، ولمعرفة موقفه الحاسم وتلون منطقه بين الإنصاف والشدة ينبئ بعقليته المتجبرة المخاتلة، التي تعطي بيد لتسترد بيد أخری.. ابن زياد هذا ممثل الحكم المكيافيلي، المتحصن بسيوف أشراف الکوفة ومرتزقتها، يقف في قباله الحسين، الإمام المؤمن بحق الثورة علي الظلم والانتفاض علي الشر واقتلاعه، هذا الأمير- في عرف الحكم والواقع الراكض كالكلب وراء هذا الحكم يلهث من جوع وعطش یرید أن ينتزع البیعة لسيده يزيد بالقوة والعنف والتسلط، وأن ينزل الحسين علی حكمه خاضعاً يعطي إعطاء الذليل، فماذا كانت نتيجته مساعي عمر بن سعد بين الاثنين؟ كانت نتیجة قول الإمام:
«لا، معاذ الله أن انزل علی حكم ابن مرجانه أبداً».
وفي هذا الجواب فصل الخطاب في الرد علي المتعللين بحجج الانتكاس والنكوص ومن ثم فلا مرد للموت ولا سبيل إلی حیاة الأجيال من غير الوصول إلی شريعته المقدسة دفاعاً عن حق الناس في حكم أنفسهم ورفع الظلم والجور والسلطان عن كواهلهم، ولو كانت القلة الرائدة في الدفاع عن هذا الحق أقل من آل الحسين وصحبه وبذلك كانت ريادته – في هذا الشأن – حافزاً قوياً لا يمكن نسيان أثره، في كل الفعالیات الثوریة التي هزّت أركان حكم الطغاة من يوم استشهاده، وسط أحوال تعجز شم الجبال احتمال بعض من وطأتها. ولكن صدر الحسين برحابته التي تتجاوز كل رحابة، يأبي إلا يحمل الأمانة، فتعقد – من أجل ذلك – مقالید الریادة في جيده، حقاً لا ينازعه فيه منازع.. ومن أجل ذلك، قد امتلأ صدر ابن زياد بسم الحقد والضغینة والشماتة، فكان امره وقد فارقت روح الحسين جسده الفاني أن «يوطأ صدر الحسين، وظهره، وجنبه فاجریت الخيل عليه» وهكذا تری كيف يمكن أن يكون شموخ التحدي بديلاً لا مفر منه لذي الطاعة العمياء، الذي يولد مع الناس الأذلاء، الذين يستطعمون الهوان فيستذوقونه، ولو علی حساب عمی قلوبهم قبل عيونهم … وأمام هؤلاء الناس يقف الحسين يداً تطرد العمی من النفوس والبصائر قبل الأبصار يداً تفتح العيون لتری اين هي سائرة، ولخدمة من تتمرغ علی جنوبها، في وقت يعز عليها حتی القيام والنهوض مشاهد الإمام کثیرة ومتنوعه تغري كلّها بالتأمل والإعجاب، مشهده وهو يقف الموقف الصلب تجاه الوليد بن عتبة وإلی المدینة، الرجل الثعلب الذي يحاول الإغراء بمختلف السبل والإشراك، لكن دون جدوی. مشهده مع مروان بن الحكم وما كاد يتطور إلیه من نتائج، ومع ذلك فالإمام قائم بأمر الأمة لا يحيد ولا يميد، وبذا ذهبت كل محاولات يزيد وعبيد أدراج الرياح ومشهده وقد وصل أرض الکوفة ، وعرف بمقتل مسلم بن عقيل، وبالقدر عليه، والعطش الذي عاناه مع آله وصحبه، الذي فرض علی الجميع توطئة لذلك القدر، ومشهده وهو يخطب قومه ویرید منهم اعتزاله، لأنّه أوصلهم إلی ما أوصلهم إلیه كل تلك المشاهد تزلزل الجبال الرواسي، ولكنها عجزت عن المس بوتر من أوتار أعصاب الإمام الحسين وهذا امر واقع وحقیقة فذة ذلك ان المشاهد التي اراها علی مدی التاريخ العربي والإسلامي – لم تسطع مهما اتاها الحظ – ان ترقی سفح الجبل الذي قمته مشهد ثورة الحسين واستشهاده الفاجع مع من استشهد معه، ومن ظل من أتباعه ينتظر الشهادة بعده، احتذاءً بأسرته واقتفاءً لاثره، فالمثل الذي ينتصب شامخاً امامنا والقدوة التي تجتذبنا إلیها بكل تلك الروعة والجلال، والدرس الذي خطه علی جبين الزمن تلك الشهادة الیتيمة، والرمز العظيم الذي حفر في كل قلب حزاً ندياً أبد الدهر، والصفعة التي كالها الإمام لوجه طاغوت الظلم والشر والاستبداد، كل ذلك يحفزنا علی ألا نمر بالعاشر من المحرم مر العابثين السادرين في غي الاقيون، اللاهثين وراء ملذات الجسد والتراب، المتنكبين الجادة، باسم الدعة والاطمئنان، وهم أولي بالسکینة الذلیلة ، والنكوص الأذل، وعاد السكوت! هذه الخواطر وأصداؤها كانت تثير في منذ زمن بعيد، وكنت أمن إلی الكتابة عنها بين الحين والحين، غير أن المناسبة التي كنت انتظرها كانت تفلت مني لهذا السبب أو ذاك.. أمّا لأنها كانت غير مؤاتية، أو ضعيفة الاستجابة، أو عرضية أو ظاهرة الانفعال والتكلف. وكل ذلك لا يفيد في إثارة دخائل النفس وتحريك أغوارها وكشف مظانها لتكون قاعدة الصدق في الحديث وبؤره التعبير الأصيل وعل کثرة ما قرأت عن المأساة، فان الذي
كنت افتقده أشد ما يكون الافتقاد وهو خلود أدبنا – وفي القرن العشرين بالذات من أثر مسرحي واحد يعالج المأساة عرضاً درامياً جديراً بجلالها ومداولاتها وصنوف تأثيرها في مجمل التاريخ والأدب وكل دروب الحياة ، انطلاقاً منها ورجوعاً إلیها تقويماً للدرس وصیانة للأثر، وفضحاً للأستار الكثيفة من تبريرات الحكام، وتلبيات أذنابهم وجلاوزتهم وكتبت مسرحيات من أوائل القرن وتابعتها أُخر، وكلها عن المأساة لاهية متغاضية، متجاهلة، وكأن الطالبيين وأشياعهم لم يهزوا التاريخ هزات متوالیات. وكان انتظار طويل، كنت أحسبه ليلاً واجباً مدید العمر، خلت منه النجوم والأقمار. وأغلب المسرح العربي يعني بكثير من توافه الشخوص فيضعها هنا وهناك في مجالات الصراع منحدراً بالملهاة من شامخ اهتماماتها إلی حضيض المهزلة المبتذلة، جراً لمغانم آتية، من طريق إثارة أوسع الاجراء الهزلية، التي تتلاعب بالأحاسيس الرخیصة.
غير إنّ استطالة الزمن مع هذا النحو من المسرح، وهذا النوع من الإثارة قد أعاقت نحو مسرحنا وأخرت انفتاحه علی المسرح العالمي، الذي لا يعرف قيمه للعبث والعابثين، وطال هذا الانتظار أكثر مما يجب، حتی وجدت نفسي وبمحض المصادفة قبالة ثنائية (الحسين ثائر -والحسين شهيداً) لعبد الرحمن الشرقاوي. وقرأت الثنائية بنهم ما بعده نهم، واستطعت أن أقول بعد جهد جهيد: «وجدتها» فما الذي وجدت؟ وهل اوفي الشرقاوي بالعهد؟ وهل تمكنت الثنائية من تسليط الأضواء علی المأساة؟ وهل استطاعت أن تملأ الفراغ المرعب بالأسلوب المشرق شكلاً، وبالروح الحیة مضموناً وإدراكاً؟ ليس لي بعد هذا إلاّ أن أحاول الإجابة عن هذه الأسئله فلا فعل …
ها نحن في رحاب المسرحية الأولی، فماذا نجد أول ما نجد؟ جماعة من أهل المدینة تنادوا للاجتماع في دار أحدهم للتشاور في أمر الأمة بعد أن قضی معاویة نحبه. وطبيعي أن تثور المناقشة في هذه المناسبة لتناول قضايا مهمة، فمؤيدو الحسين ينصرون تولیته الحكم بحجج: منها إن الأمة ليست غير الفقراء، وإنّ حكم الأمة ينبغي ان يستند علی الشوری، وإنّ الشوری التي كان معاویة يتوسّل بها – وهو في دست السلطان- لم تكن إلاّ لاستكمال أُبهة الحكم. ولهذا كانت الشوری – بهذا المعنی – فخاً لاصطياد الضعفاء، من طريق رجال كان كل همهم وعملهم ومشاركتهم في السلطة، لا يتعدی نطاق کلمة «نعم» الخبيثة. وإذا كانت دولة الظلم قد ولّت وأدبرت، فإن معاویة لم ينس أن يمد ظل هذه الدولة علی ابنه يزيد. ومن ثم انتفت الشوری، لأنّ الناس لم يؤخذ برأیهم، ولو أجبر بعض سادتهم علی بيعة يزيد إجباراً، أو دفعتهم مصلحتهم إلی هذه البیعة اخياراً فإمارة يزيد لابد أن تثير «النقمة … في النفوس الطيبة» لأنها «بيعة إكراه وخوف.. وطمع» ولما كانت الارادة الطوعية أول شرط من شروط البیعة، وانتفاؤها في قضیة تولیة يزيد واردة أصلاً. فبيعته منقوضة شرعاً: والرجل الوحيد الذي يمكن أن يحظی بهذه الارادة الطوعية هو الحسين، فولايته هي الولاية الشرعية الوحيدة حتی لا تتحول دولة الشوری إلی أرث موروث لآل أمیة. فالبیعة لا يمكن أن تنال قسراً أو طمعاً، وإلاّ انقلب إلی تسلط قيصري أو كسروي، وهذا معناه الاستهتار بأبسط شرائع القوم.
أمّا أصحاب يزيد فلا يذهبون مذهب الأكثرية، لأنّ الحسين وأصحابه أصحاب تقوی وورع، و(الدولة تحتاج إلی كيد سياسي حصيف) ذلك بأنّ لكل زمان دولة ورجالاً، وقد مضی عهد التقوی والورع، ليحلّ محله جديد هو عهد السیاسة الحصيفة والكيد والمكر… وبما أنّ الحسين لن يسلك إلاّ مسلك أبيه، فيحكم الأمة كما كان أبوه يفعل، بما عرف به من عدل وإنصاف وتسوية أمور الناس علی وفق الحق والخير، بالضرب علی أيدي الظالمين والأخذ بناصر الضعفاء والمسحوقين وهذا لا يتفق في شيء- مع مصالح الأغنياء الأقوياء، الذين یریدون من الدولة أن تكون أداة طيعة في أيديهم للاستزادة من الاستغلال، والتحكم في الرقاب، والارتفاع علی الكواهل كما كانت الحال أيام معاویة، وكما كان یریدها أن تكون بعده! وبعد الاتفاق بين الوليد وابن الحكم، الاتفاق الذي يفلسفه الأخير بقوله: «کثرة الآراء تغري بالتردد، إنّ ضرباً في رقاب الضعفاء سوف يعطينا ولاء الأقوياء» يجتمع حاكما المدینة بأبي عبد الله، فيعلمه الوليد ببيعة يزيد المزدوجة، بيعته التي یرید يعقدها الآن والأخری التي عقدت قديماً، أمّا الأولی فليس لها قوام شرعي لأنها «أخذت في ظل إرهاب البوارق» أمّا الثانیة التي يراد لها مثل الذي أريد الأولی، فهي لابد ان تكون قسراً واغتصاباً وتحت حد السيف وعندئذ لابد أن يكون الأمر قائماً علی الإرهاب أو الطغيان أو البغي، وفي تلك الحال ينحسر الحق عن أهله ويصبح المال والقوة والاستبداد مطايا لافساد الضمائر وتخريب النفوس وسحب ثقة الناس من أنفسهم ومن قادتهم. ابن الحكم يمتطي صهوة المال ليحول بينه وبين خير الناس، فهو صاحب بيت المال، فمن حقه إذن أن يجود علی من أرضيه وأن يقبض يده عمن لا يرضيه، لأنّه يتصور نفسه ظل الله علی الأرض، بكل زهو وخيلاء. وظل الله ذاك. لا يمكن أن يكون الممثل الشرعي لمصالح سادات قريش، الذين لا يمكن أنّ يرتضی لهم ابن الحكم الهبوط من عليائهم ليكونوا سواسية مع رعاه الماشية.. بيد ان الحسين لا يجد الحال كذلك، بل يراه علی الضد من ذلك، فالعمل ونيس المحتد هو الذي يسبغ علی الإنسان القيمة الحقیقیة لوجوده. الحسين یری «الناس سواسية كأسنان المشط» ولكن «الظلم (الذي) يعشعش في أعماق النفوس الخربة» هو الذي جعل الناس لخطر الموت جوعاً، وهو خطر رهيب! ويتقدم بما في جعبته من رأی سديد، فإذا باغراء العطاء يزداد أكواماً أكواماً، إن كان أبو عبد الله راغباً في السلامة: وتجنب عواقب الفتن ولظی الثورات والانشقاقات والانقسامات والحرص علی الحياة الآمنة في جو الرفاه وبحبوحة العيش..
بيد أنّ کلمة الحرص التي يلوح بها الوليد، لا تلبث إلاّ أن تنفجر بركاناً في قلب أبي عبد الله (حرص لعين) لأنّه يهون قيمة الإنسان فهو كالخوف يهدر إباء الرجل العزيز. من غير أن يطيل عمره لحظة واحدة وبعد أن يعجز الوليد عن استلال کلمة واحدة توميء إلی شيء يسير من الاهتمام بما يراوغ به لتكن کلمة واحدة وحب
الحسين. ويجد باب الإباء مؤصدة في وجه تشتیتاته وحتی الاته والاعيبه، يعود إلی آخر سهم في كنانته، فيطلب من أبي عبد الله بضراعة غريبة أن يعتزل الناس. ويعتكف علی تدريس علوم الدين والتقوی.
ولكن الکلمة التي يستسهلها الحاكمان بامرهما، تظل في وجدان الحسين معنی المعاني. لأنها تعني الشرف والرجولة والمروءة والنبل، ومتی ما استلبت بالقهر والجور ضاعت كل هذه المعاني وتبددت كل هذه القيم، فالکلمة التي (زلزلت) المظالم وحضت (الحریة) واسبغت علی الإنسان إنسانيته، تصبح مقبرة لمثل هذه الإنسانية إذا ما ديست في ثنايا التراب، بفعل الظلم وما يفتعله الطاغوت من أفانين! ومن ثم فالحسين يقف الموقف الصحيح الوحيد، لأنه لا يمكن أن يقف موقفاً غيره، وقد عرف شرف الکلمة وأدرك قدسيتها وارتضی لنفسه طائعاً مختاراً الدفاع عن وجودها تاريخياً. وبذا شق الحسين الطريقة الصحیحة في التاريخ العربي الإسلامي متأثراً بذلك سیرة أبيه التي لم تعرف المهانة أو المساومة، أو المخاتلة، أو المراوغة، وهذه الجدية من الحسين والحزم والعزم. جعلت ابن مروان يستل سيف الإجماع لمحاربة الحسين بدعوی أنّ الخروج علی الإجماع بدعة وشق لعصا الطاعة، ومن ثم فمقاتلة الخارجين علی طاعة أمير المؤمنين واجب ينبغي تنفيده وبأسرع وقت ممكن تجنباً لإراقة الدماء، ورأباً للشقاق والانقسام.
مروان ينصح الوليد بهذه المشورة بعد أن يكون الوليد قد عجز عن اقناع الحسين بالبیعة، ولكن أبا عبد الله يفوت علی الوليد فائدة المشورة التي محضها له مروان، فلا يجد معنی للانتصاح ولا للراحة و(الحق والحرمان والعدل) أيعز من معنی للراحة واستباحة كل منهن شرط من شروط هذه الراحة؟ فمن حق الحسين إذن ألاّ يجامل في مثل هذا الحق، وألا يهان أو يصانع، أو يداجي أو يجاري.. إنّ المسأله مسأله مبدأ ومتی ما تتزحزح أساس المبدأ، فلم يبقَ لكيانه أن ينتظر شيئاً غير الانهيار. وثبات المبدأ – عند الحسين- أمرٌ مفروغ منه. ولهذا فقد تحتم علی الوليد أن يتعثر بأذيال خيبته، وأن ينهار هو أمام صمود الحسين وأن يبدي هذا الانهيار في كلماته:
«علامَ يقوم إذن ملكنا؟ أنبنيه فوق ذيول الكلاب؟ أنبنيه فوق ذليلي الرقاب.. فوق رؤوس الثعالب».
وبهذه الكلمات التي لا تحتاج إلی شرح وإفاضة، بدفع الوليد -صاغراً- حكم للظالم بميسم الذلة والصغار والتفاهة! وفي منظر آخر نجد بعض أتباع الحسين يرتاؤون عليه هذا الرأي أو ذاك وكلهم مخلص فيما فاعل إلا الشيخ أسد الذي يبرر التنازل بوفائه لخير الجميع، وحقناً للدماء التي سالت بما فيه الكفاية. الشيخ أسد هذا ضرب علي وتر تجنب الفتنة لأنّها ستؤدي إلی (القتل والحرق وألوان الخراب) وهل علی ذلك فالحکمة تفترض التنازل، ولو إكراهاً واعسافاً وتفترض المسايرة والحجارة.. وهذه هي حال الدنيا علی كر العصور وتعاقب الأيام. الحکمة هذه يرفضها الحسين رفضاً باتاً، لأنّ (أكثر الناس ضلالاً عارف بالله لا يهديه قلبه) وعلی ذلك إن كان هذا الرفض سكوتاً، فلن يصيب الحسين الهدوء الذي يرتجيه، لأنهم لن يطمئنوا إن لم يدركو ما يطلبون ومن الحسين بالذات السكوت قد يكون مجلبه للاصلاح وبراً وسلاماً، ولكنه لن يفسر إلا بصفته الحقيقية، بصفته رفضاً للبيعة وإشارة للانتفاضة، وليس للحسين إذن من خيار غير الانتفاض والثورة علی الظلم.
أدلهم الخطب إذن، وجاء دور الامتحان امتحان الضمير واختيار صلاحه واثبات صموده أمام الملمات والكوارث والمحن. تری أممكن لأبي عبد الله يمنح يزيد (بيعه ذل) ليطمئن علی نفسه واله وشيعته (مثل شاة في قطيع)؟ أم تری يجهر بالثورة في وجه الطغاة؟ السؤالان واردان، وهما جناحا مأساة الحسين ومأساة كل قائد إنساني في موقف يماثل موقف الحسين.
وفيما أبو عبد الله يتأمل في أشباه هذين السؤالین، يظهر له عن كثب أخوه محمد ابن الحنفیة كأنّه إعصار جبار هب ليقتلع أركان الطغيان، وكل جبار عنيد، هب يطالب الحسين وأتباعه أن ينقذوا العالم (المجنون الذي ظل طريقه) أن ينقذوا (الدنيا من الفوضی وطغيان المخاوف) وكيف لا وقد (قامت لأهل الشر دولة)؟ فماذا يكون من عزم الحسين وقد رأی أخاه ناراً تتأجح وثورة تتماوج، ورجولة كلها إباء وشمم، أيكون أخوه أمضی منه حداً، وأهدی منه سبيلاً، وأشدّ منه علی البغي مقتاً؟ يقسم أبو عبد الله ألاّ يترك الظالم حتی يأخذ حق المظلوم منه، واذن هي الثورة، هي الحرب العوان التي لا محيص منها ولا مناص. وهنا تبرد حرارة محمد بعد التهابها، لأن الحرب تعني ما تعني بالقياس إلی الحسين، وهو -وقد جد الجد- لا یرید لأخيه أن يحل به ما حل بأبيه، فلهذا السبب بالذات تضرع بأخيه ان ينأی بنفسه عن الخطر، لأن أعداء الحسين من أغلظ الناس أكباداً وأشدهم حقداً وأبعدهم صيتاً في تأريث العداوة، وأفضعهم فتكاً، ولكن ماذا يعني ذلك النأي عن الخطر، ألا يعني قبول بيعة طاغية مستبد؟ ألا يعني بيع كل ما ثمن وغلی وشرف واعتلی في سوق النخاسة في مقابل ذلة ذهبية ويقرر الحسين امره إقراراً لا رجعة فيه ولا انتكاس، وتسمع أخته زينب بهذا الأمر، فتهتز لوعة وأسی، لأنها تعرف معنی ذلك الأمر وذلك القرار، ويتدارك مخاوف زينب بالتلويح بالنداء فيقول: «فإذا نوديت فلا مهرب» معلقاً قيامه بالأمر بهذا النداء. وتدرك زينب ما في قرارة أخيها فتقول: «فلينهض غيرك للأشرار، فليس لأهل البيت سواك» وهنا ينطق الحسين بلسان القدر قائلاً: «جف القلم بما قد كان! » فلا فائده اذن في تضرعات زينب أو محمد ولا مندوحة من الجهاد في ساعة عسیرة تتطلب الجهاد. صحيح إنّ الدولة قد شيدتها المطامع والمخاوف، فما هو صانع في هؤلاء الذين اختطفتهم المطامع لبيعة يزيد أو دفعتهم المخاوف لهذه البیعة؟ هؤلاء بحكم مصلحتهم أعداء الداء، ولهذا السبب بالذات لابد ان يحسب لهم كل حساب وأن يقرر ما يمكن أن يقرر من حقهم، فيما لو استتب له الأمر ورجع الحق إلی نصابه.
وتشدد الحال سوءاً وتتظافر زمر الأعداء في المدینة، حتی لا يجد الحسين مفراً من اللجوء إلی مکة، وهناك يلتقي بابن عمه ابن جعفر، فيعلمه الأخير بكل تفاصيل المؤامرة المدبرة بحقه من قبل زبانية يزيد، ويزيد علی ذلك رأیه في مهادنة الطغاة، حتی تهدأ سورة يزيد، وينفسح له المجال، بعد أن يشتد أزره، فينتقص علی ما فعله من مهادنة، ويكون، قد تمكن من تحقيق مأربه والوصول إلی هدفة، في ظروف غير الظروف التي يمر بها الحسين وهو لائذ بأعتاب الکعبة. وهنا وقد رأی أبو عبد الله ما رأی من ابن عمه، تهبط علی نفسه كآبة حزينة سحابة داكنة من الأسس تثقل علی نفسه، وماذا حاله غير تلك إذ «أصبح الخير طريد، وغدا الحق شريداً، والدنيا تزدهي بالطيلسان»؟
ماذا ينتظر من باطل يعتلي عرشاً؟ ومن ملك ملكه الزيف والنفاق والدجل؟ ومن حكم مبني علی الرياء والبغي والمذلة والمسكنة؟ ومن دنيا ذلیلة ، الخوف فيها ملك ذو سلطان وصولجان؟ ومن حیاة كلما طالت أصبحت ناراً وعذاباً وشراً لا نصيب إلاّ الرجال الأخيار؟ عند ذاك لابد أن (يختنق ضوء النجم في الليل الثقيل) وتصبح الحکمة مذلة، ويرتفع صوت الفجور عالیاً، وينخفض إباء النفوس ليحل محله سلطان الإرهاب وعاد الطاعة، (ويصير الصمت والإذعان من حزم الأمور) ويتم للسلطان كل ما يشتهيه من أفانين الاستعباد والاستذلال والاسترقاق، فلا تعود الدولة إلا ضيغة کبیرة يتلاعب بمصيرها السلطان كما يتلاعب الطفل بالکرة !
الأمور تتأزم شديداً وبصورة سريعة مذهلة، فماذا يفعل أبو عبد الله؟ لابد له أن يفعل شيئاً ليتأكد من أحوال شيعته في الکوفة ومدی تأييدهم له. وماذا يفعل خيراً من إرسال ابن عمه مسلم. ويذهب مسلم بن عقيل ويستقبل الفاتحين، ويحاصر ابن زياد في قصر الإمارة، ولكن مكر الأخير الذي عرف به سرعان ما يحول الحصار إلی مطاردة تتعقب آثار مسلم حتی يتم القبض عليه وتلقی جثته من أسوار القصر المنيف. وقبل أن يتم ذلك تكون رسائل مسلم ومؤيدي الحسين قد وصلت إلی أبي عبد الله. ويكون التشاور الأخير بين الحسين ولاسيما أتباعه قد وضع اللمسات الأخيرة علی المنظر الجديد، المرعب الفاجع، الذي كان – في الواقع تجسيداً درامياً حياً لارادة الحسين في شق الطريق نحو الشوری والحریة والکرامة الإنسانية، ولما كان هذا التشاور منحی خطراً حاسماً في طريق الشوك والآلام والمآسي، طريق الدم والموت والفجيعة، طريق الحسين. فلا مناص من الإلمام يسيراً. مما جری قبل أن يتخذ أبو عبد الله قراره النهائي. محمد بن جعفر يعرض حقیقة ابن زياد بقوله: «إنّه يملك في الکوفة الآن الفساد. يملك المال والسلطة، والضمير الميت القادر علی أن يلوي أعناق العباد» وهذا يعني إنّه یرید من ابن عمه التمهل والانتظار، بينما حال الحسين تنطق بهذه الكلمات: «لا… بل انهض لاناضلهم.. لا بل انهض ضد الظلم وضد البغي وضد الجور» حفاظاً علی حقوق الضعفاء وأخذاً بأيديهم، لأنّ المنكر لا ينبغي السكوت عنه حتی الموت. وآراء الحسين هذه تثير حزناً عميقاً في نفس ابن جعفر، لأنها تشير إلی نهاية معلومة مسبقاً، فليقدم ابن جعفر إذن وساطته فعسی ولعل.. غير إنّ الحسين وقد أدرك ما هو فيه من حرج، من ذئاب الليل وثعالب النهار، من صمته الثقيل الفظيع، من الخنجر الغدار الذي سيطارده أينما يمضي، لا یری مفراً من التحدي لأنّه الطريقة الوحيدة الباقیة إمامه وبخاصة وقد وصلته رسالة مسلم وصرخات المعذبين في أرض العراق، فضلاً عن أنّه – لو فرضنا المستحيل- والتزم أبو عبد الله الصمت فهو لن ينجو من إحدی اثنتين أما البیعة وأمّا الموت. وهكذا قدرللحسين أن يسير ليرد (غاشية المظالم) وإذا كان الحسين سيقتل حتماً بسبب الظروف الغريبة في الکوفة ، فإنّ العبرة ليست في قتل الحسين. إنّما العبرة فيمن قتلوه ولماذا قتلوه؟ العبرة في الثأر الأعظم، ثأر الحسين، في الثأر من كل سفاح مهما يكن ومن تابعه من قتلة الحسين علی مدی التاريخ الذي وضع أبو عبد الله أساساً جديداً له ببعد نظره وحكمته وأصاله إيمانه بحق الفقراء والضعفاء الذين ظلوا ينتظرون مخلصاً من السماء قروناً وقروناً، فجاء استشهاد أبي عبد الله تعبيراً جديداً لهذا الخلاص،لانه انبثق من إرادتهم في أن يكونوا بشراً أسوياء، لا ماشيه هملاً يساقون للذبح، وهم محنيو الرؤوس، متثاقلو الخطی، عبيداً لارادة جبار شديد، كريه، مقيت، اسمة (ملك) لأنهم جميعاً مملكون. وقبل أن نساير أبا عبد الله، في مسيرته الدامیة، ينبغي لنا أن نلتفت إلی سلوك ابن زياد وكيف تمكن من لي رقاب أهل الکوفة ، ابن عروه يجد الأمر غريباً كل الغرابة، وفي الحق إنّه غريب، إذ كيف ينقلب الناس بين عشية وضحاها هذا الانقلاب المفاجئ ومن ثم فمن حق ابن عروة أن يتسائل: «كيف بالله قلبت الأمر حتی صار لك؟» فيجيبه ابن زياد ضاحكاً: «قد أخفت الناس حتی رهبوا، وبذلت المال حتی رغبوا» وطريق ابن زياد هذه، هي طريق جميع الساسة الطغاة، المحنكين الذين لا يعتبرون «الحياة غير صياد وصيد» ومن ثم ففي الغابة الکبیرة لا يعيش أخو عدل لا يملك سيفاً قاطعاً وقوساً ونشاباً. وإلاّ كان هو أول الصيد. وموقف ابن زياد وهذا موقف منطقي ومنسجم مع مجمل سلوكه، غير أن سلوك أسد الحربائي، الذي تمثل بالتلاعب بالمشاعر، والتنقل من صف واللعب علي حبال المساومة والمخادعة، هذا السلوك هو الذي ينبغي أن يفتح عيون الناس جميعاً، فأسد الحجازي صاحب الضياع الواسعه في الکوفة ، لا يمكن أن يكون – بأي حال- مؤيداً للحسين ولو تظاهر – في أول الأمر بذلك- لأنّ مصلحته العليا تتنافی ومصلحة الحسين وأتباعه، والسائرين في أثره.. مصلحة هذا الرجل جعلت منه منادياً منه متطوعاً يبحث عن رأس مسلم قبل مقتله، وجعلت منه سنداً يركن إلیه ابن زياد باطمئنان وثقه! ومشهد الاختلاف في قضیة مسلم بن عقيل مشهد فيه خصوبة درامیة رائعة التفنن،عمیقة التحليل، سليمة المنطق، قوية الأداء زخمه العطاء، فالمختار الثقفي يمثل الجانب الثوري الصادق، يمثل الموقف الصارم الحازم الذي لا يعرف التساوم والتخاذل أو التراجع، فالمختار يذكر القوم بالعهد والذمة، ويحذرهم من الخيانة والجبن ويستثير إباءهم وشهامتهم ومروءتهم، وها هو يعبر عن كل ذلك بقوله: «تذكروا إن نحن خنا عهدنا ماذا يكون؟ ستعربد الأشباح فوق شموخنا. سيبصق الأطفال فوق قبورنا..».
ويؤكد (الشيخ) المختار في رأیه الصائب الجریء، غير أنه يتملص من هذا التأييد باستناده علی حجة القدر البالیة، فالقدر هو الذي رمی بابن زياد، ومع أنه (فاجر يقتل بالظنة والريب ويلهو بالدماء) فهم مضطرون للإذعان له، لذلك «إنّ المكره المضطر لا إثم عليه» وهكذا تغدو (الحکمة والرأي.. والتقوی) تجارة رابحة ومصداق ذهل هو ما يتفضل به (التاجر) من آراء، ومن هذه الآراء الحكيمة: «هذا الرجل (يعني ابن زياد) يعطي في سخاء» وعلی ضوء هذه الحکمة يسير سائر شيوخ مذحج ومراد، فإذا بالرؤوس تنحني أمام الذهب، وإذا بالحشود التي نفرت لنصرة الحسين تضافرت لاستقباله، تتناثر وتتبعثر وتتلاشی، وإذا بالمختار يبقی وحيداً يتآكل قلبه الكمد لأنّ «الآكلين علی المآدب كلها، السابحين وراء تيار الزمن الباحثين عن السعادة الماثلين إلی الشموس إذا طلعن.. يتسلقون إلی ذؤابات الشجر» وهذا التشبه المتسلسل للوصوليين، فيه إيماضات ولمعات تخطف البصر لما فيها من أوج الحق وسلامة المنطق وإصابة الهدف ودقة الوصف، وإذا اضفنا إلی ذلك قول المختار وهو يدفع المنافقين بما يستحقون من سمة! الطابعون علی شفاههم ابتسامات النفاق مطبعة تحت الطلب. الراسمون علی ملامحهم جهامات الكآبة والتأمل والترقب.
استطعنا أن نحس بالنار التي كانت تسري في عروق المختار وهو يجد الحق يذبح ذبحاً، والباطل ينتصر انتصاراً رخيصاً هيناً، وعيون القوم غافية، بل غارقة في نوم عميق، سخيف، ثقيل، ذليل وتمضي صيحة المختار هذه لتلف نفسها بطيات الرياح الهوج، ويبقی المختار مثخن النفس جرحاً.
مثقل الروح هماً، لأنّ العاقل من ينافق، لأنّ المجرم من يجابه السلطان، لأنّ (من يشرب قلبه بعض الحاكم تكثر أحزانه) وبخاصة و(الناس يؤخذون بالنوايا.. بالأفكار المكتومة، بالخلجات والخفقات وهمس الهمس) هذه هي فلسفة ابن زياد وهي فلسفة ذوي السلطان طوال هذه الدهور الموغلة في العراقة والقدم ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان يمكن لنخاس كابن زياد أن يبتاع ولاء الأمة بحد السيف أو ببارق المطامع، فيتمرغ الأذلون في الذهب كما تتمرغ الحمر في أكوام التبن، وإلاّ ما تتداعی أشراف الکوفة علی الذهب، كما تتداعی الغربان علي الجثة النتنة، وإلاّ ما مس الأبرار صرٌ وأباؤهم أغلی من ذهب الدنيا قاطبة. وإلاّ ما «دب علي قدميه الرجل وليس سوی جدث في نعش» كما يقول المختار محسناً في القول والتشبيه معاً. وإلاّ ما استطاع ابن زياد ان يكون قضاء الله حالاً في الدنيا بأخذ الناس بالهمس بل بالخلجات الراجفات. وممن يقف في صف المختار زيد بن الأرقم، الفقيه، المفكر، الذي يخشاه ابن زياد أشد الخشية، لأنّ الرجل ذو فكرة، فهو اذن أخطر أهل الأرض طراً ولأنّ الفكر والفقه لا يمكن ان يجد له موضع قدم في ظل الإرهاب وظلمة الجور، وغاشيه القهر.
وهذا أمرٌ يصح قبوله حتی عند الشيخ أسد، الذي لا يفلسف أي ما يصلح شأنه، ويعلي مقامه لدی الأمير الجليل ابن زياد!
وإلی هذا البلد، المكفهر، المقهور، الخانع لابن زياد، يتوجه أبو عبد الله، وهو يحسب أنه يتوجه إلی بلد المكرمات والمروءات البلد الأمين، الذي سيحمي ذماره، ويفتح له صدره،ليكون منطلقه إلی ما يصبو إلیه من نصر علی الطواغيت، وهم في عقر دارهم..
وبعد مسیرة العديد من الأيام، في أشد ما تكون هذه الأيام حراً وغباراً ونصباً، تصل قافله أبي عبد الله إلی مشارف الفرات ليستقبلها عدد ضئيل من أصحابه في الکوفة ، وعلي رأسهم برير فزعين من جور ابن زياد لائذين بالحسين ثم يتبعهم أعرابي مع ثلة من صحبه، يتوج هؤلاء جميعاً مراد ومذحج، يتم إجماع بين كل أولئك وأبي عبد الله ومن معه وتتطاير أخبار الشر ويتضح مقتل مسلم وتلوح الکارثة التي تنتظر الجميع ويدلي الأعرابي بدلوه وينصح الحسين قائلاً:
(عد ولا تمض إلی من خذلوك).
فيرد الإمام بعزم راسخ:
«إنما هذا طريقي ليس لي غير ارتياده».
ويتفضل شيخ مراد علی القوم بنصيحته: «نحن يا سبط رسول الله لا نغدر بك، غير أني حائر والله في الأمر، إذا كانت هي الحرب الضروس، فكلا الحزبين مسلم» فإذا النصيحة حكمة الشيوخ، حيرة ظالمه مظلمة، حيرة تنكر حقاً ناصعاً، لتحل محله باطل الذل، وحقهم المسكنة، وفقر الضمير، والتشبث الرخيص بنشب الدنيا الحقير لزوغان في البصر وعمي مصطنع، وضلال مفتعل.. فما مرد كل ذلك وما مصدره؟ إنّ مصدر كل ذلك، وكل ماله صلة بذلك عن تبريرات وتحذيرات وتحفظات، هو الخوف من المسؤولية في الساعة الحاسمة، الخوف الذي يفسد في الإنسان فعالیة الحریة واختيار المواقف وتحديد التخوم، الخوف الذي يقهر النفوس الضعيفة، فيبدد قممها ويحطم روحها، ويمزق كيانها الإنساني، شيخ مراد هذا يعترف بهذا الخوف قائلاً: «إنّ بعض الخوف يقهر.. » فيرد عليه الامام قائلاً: «إن تخاف الله أولي بك من خوف الولاة» وعند هذا الحد الحاسم من المسألة، يضع شيخ مرادالقضیة في موضعها الإنساني بقوله: «إنّ هذا الامتحان لنبي.. نحن لسنا أنبياء» وفي هذا الوضع الذي يصطنعه شيخ مراد تتبين حقیقة ذات دلالات، وهي إنّ اعتماد «الأشراف» لقضیة شريفة، أمر فيه كثير من المحاذير في ساعة الحسم ساعة تقرير المصير، لأنّ مصلحة «الأشراف» قد تتضارب مع القضیة الشریفة في أغلب الأحيان، وعندئذ تكون طريق الخذلان، طريق الأمن والسلام والعافية، هي الطريق الوحيد التي يسلكها «الأشراف» لكي تبقی نعمتهم في محلها الرفيع وجاههم في علياء مقامهم عند ذوي السلطة والنعمة والأيادي البيض والخيرات الكثيرات. و«إذا ما سامهم (السلطان) سوم الإبل» واقتضاهم ميثاق الذل وبيعه فليس لهم إلاّ أن يخنعوا ويستظلوا بظلال أولي النعم، لأنّ هذا شرط من شروط الوجاهة والحکمة والشرف والسيادة. وإذا كانت زينب أخت الإمام ترید أن تعمل شيئاً من أجل أن ينفر الرجال في نصرة أخيها، فإنها لم تجد فيما أجارت فيه خيراً من قولها: «لأن يشهر سيف فوق هام المفسدين الظالمين، لهو عند الله أزكی من جهاد المشركين» ذلك إنّ في هذا القول حقاً، وأن يكن جریحاً، فهو حق منتصر لامحالة في النهایة. ويأتي دور شيخ مذحج ليجيب عن سؤال بشر: «إنكم أصحاب حق.. فلماذا تنكصون؟» فإذا به يقول لافض فوه: «نحن نرجو أن يعود العز فينا، غير إنّا ينبغي أن نتشاور» فإذا هذه الشوری في ساعة الخوف، غير (غطاء للنذالة) كما يقول سعيد والبطش الذي هو أداه الخوف، (يخفي الحق حتی عن عيون العقلاء) ويجعلهم كما يقول برير (يتسكعون ببعض وديان الضلال) وهكذا أضاع الحق، وانثلم حده وتناثر أنصاره بدداً، في مواجهة نهر الفرات، ليتسلم نثاره أبو عبد الله ورهطه في وحدة قاسیة، ويقل أصحاب الحق ساعة حتی لا يظل – في الساحة منهم غير سبعين وحسب. ومن هذا المشهد المهيب، وطريق اللاعودة، والإخلاص لرأیه المبدأ يبدأ الموكب الفاجع، موكب الشهداء في السير نحو الحتوف ببطولة خارقة وشجاعة تمرغ جباه الجبابرة(1).
________________________________________
1- مجلة الرابطة -النجف- العدد-3- السنة الأولی- 1974/ ص 19.
لینک کوتاه
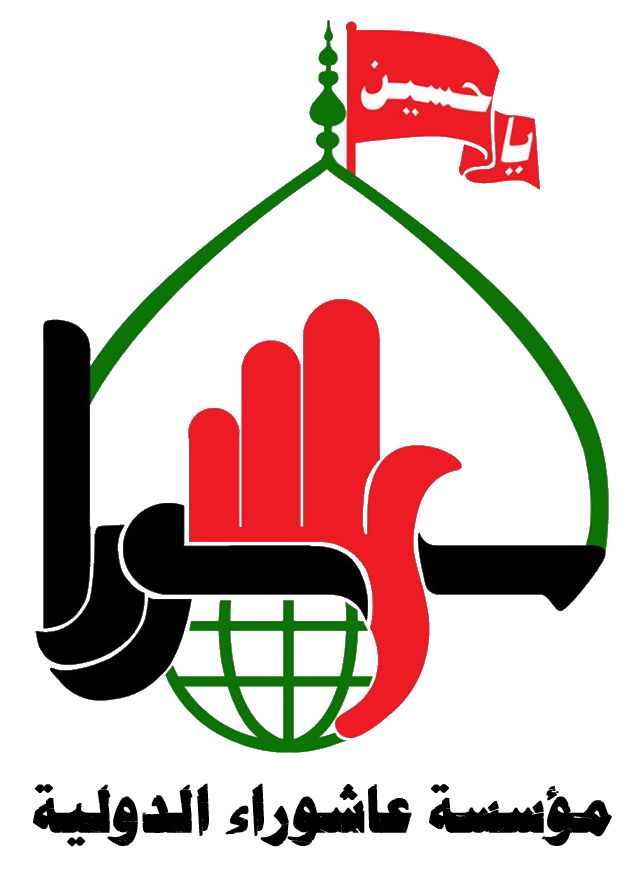
سوالات و نظرات