الشواخص العرفانية في خطبة السيدة زينب (عليها السلام) في الشام وأثرها في تحكيم ثقافة عاشوراء
{ د. فاطمة كريمي / ترجمة: زهراء السالم }
مقدّمة [1]
لقد رحلت السيّدة زينب(عليها السلام) في الخامس عشر من شهر رجب للسنة الثالثة والستّين من الهجرة النبوية، تلك السيّدة البطلة التي حملت رسالة عاشوراء ورايتها بعد شهادة الإمام الحسين(عليه السلام)، والتي التحقت بلقاء الله بعد سفرها من المدينة إلى الشام برفقة زوجها عبد الله بن جعفر، وقد وُري جسدها الطاهر في تلك البقعة المقدّسة من الشام.
إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لجديرة بأن تكون قائدة منيرة لدرب كلّ مَن يريد النهوض لأجل عقيدته، فهي التي ورثت روح مكافحة الظلم من أُمّها الزهراء وأبيها حيدر الكرار(عليهما السلام)؛ الأمر الذي جعلها لم تألُ جهداً في إفشاء الظلم، وإحقاق الحق، والتضحية والفداء.
تلك السيّدة التي جاؤوا بها بعد ولادتها إلى رسول الله(صلى الله عليه واله)، فاحتضنها الرسول الكريم ونظر إليها وبكى، ثمّ قال: (مَن بكى على مصاب هذه البنت كان كمَن بكى على أخويها الحسن والحسين) [2]، بمعنى أنّ سكب دمعة واحدة على مصائب تلك السيّدة(عليها السلام) تساوي البكاء على إمامين معصومين، ولم يقل: البكاء على الإمام الحسين(عليه السلام) فحسب.
إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) ـ مع وجود كلّ هذه الآلام والمصائب ـ لم تفقد معنوياتها، ليس هذا فحسب، بل ارتقت إلى مقام الرضا، فهي التي أُخذت أسيرة سبيّة، وتحمّلت الجوع والعطش، والنزوح والضياع في الصحاري، وهذا جزء يسير من مصائب زينب(عليها السلام) التي سُمّيت بـ (أُمّ المصائب)، وحقاً أنّ تلك المصائب لو نزلت على الجبال الراسيات لدكّتها، ولو صُبّت على الأيام لتحوّلت إلى ليالٍ مظلمة.
نعم، إنّ زينب(عليها السلام) ليس لها نظير في صبرها، كيف لا وهي التي ورثت الصبر من الأنبياء أُولي العزم، وخاصّة النبي الخاتم(صلى الله عليه واله) الذي كان يدعوه تعالى إلى التحلّي بالصبر، فيقول: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ)[3]، وهي التي تعلّمت الصبر من أخيها الحسين(عليه السلام)، ذلك الرجل الذي انبهر الجميع بصبره، حتّى الملائكة الواقفون على صبر العباد[4]؛ ولذا ورد في الزيارة: (قَد عَجِبَت مِن صَبرِكَ مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ)[5].
ذلك السبي العصيب الذي تُشير إليه السيّدة(عليها السلام) في خطبتها الشريفة: (أمِن العدل يابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وسَوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههنّ، تَحدُو بهنّ الأعداء من بلدٍ إلى بلد، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيّ والشريف، ليس معهنّ من رجالهنّ وليّ، ولا من حُماتهنّ حَمِيّ؟! وكيف يُرتجى مراقبةُ من لفَظَ فُوه أكبادَ الأزكياء، ونَبَت لحمه بدماء الشهداء؟! وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت مَن نظر إلينا بالشنَف والشَّنآن، والإحَن والأضغان، ثمّ تقول غير متأثّم ولا مُستعظِم:
وأهَلُّوا واستَهلُّـوا فرَحَـاً ثمّ قالوا: يا يزيدُ لا تُشَـل
مُنتحياً على ثنايا أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنّة، تنكتها بمِخصَرتك؟! وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة، واستأصلت الشأفة بإراقتك دماءَ ذريّة محمد(صلى الله عليه واله)، ونجومِ الأرض من آل عبد المطلب؟! وتهتف بأشياخك زعمتَ أنّك تناديهم، فلَتردنّ وَشيكاً موردهم، ولَتودّنّ أنّك شُللت وبَكُمت ولم يكن قلت ما قلت، وفعلت ما فعلت)[6].
ويمكن الإشارة بصور عامّة إلى فضائل السيّدة زينب(عليها السلام) من خلال النقاط الآتية:
1ـ صبر السيّدة زينب(عليها السلام): (إنّ أعظم شخص قد تعلّم درس التحمّل والصبر في الملحمة الحسينية، هو السيّدة زينب(عليها السلام)، وإنّ أكثر شخص قد توهّج الشعاع الحسيني على روحه المقدّسة، أُخته العظيمة السيّدة زينب(عليها السلام))[7]، (حقاً، لم يشهد التاريخ منذُ بدء الخلقة ـ حتّى من نساء الأنبياء والأولياء ـ امرأة بهذا الحلم والصبر)[8].
2ـ عبادة السيّدة زينب(عليها السلام): (إنّ السيّدة زينب الكبرى(عليها السلام) لم ينقطع تهجّدها ونافلتها حتّى في أيام الأسر)[9]، (ولم تترك عبادتها وتهجّدها في الليل حتّى ليلة الحادي عشر من المحرّم)[10].
3ـ خطابة السيّدة زينب(عليها السلام): (إنّ خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) في مجلس يزيد لمن الخطب التي ليس لها مثيل في العالم)[11].
4ـ علم السيّدة زينب(عليها السلام): عندما ألقت السيّدة زينب(عليها السلام) خطبتها في سوق الكوفة، تلك الخطبة العظيمة التي أجّجت فيها المشاعر، خاطبها الإمام زين العابدين(عليه السلام) مؤيّداً لعلمها: (يا عمّة… ففي الباقي من الماضي اعتبار، وأنتِ بحمد الله عالمة غير مُعلّمة، فهمة غير مُفهّمة)[12]. إنّ كلام الإمام(عليه السلام) هذا إشارة إلى العلم اللدني للسيّدة زينب(عليها السلام).
5ـ كرامة السيّدة زينب(عليها السلام): يكفي في كرامة تلك السيّدة وعظمتها أنّها لم تخرج لأبنائها الشهداء في عصر عاشوراء، بينما كانت المسلّية للإمام الحسين(عليه السلام) في كلّ شهيد يؤتى به إلى الخيام، وما ذلك إلّا لعظمة تلك السيّدة الجليلة التي لا تريد أن تجعل إمامها في موقف محرج؛ ولذا فإنّها لم تخرج من الخيمة عندما أتوا بجثامين أبنائها (رضوان الله عليهم).
6ـ عصمة السيّدة زينب(عليها السلام): إن لم يكن مقام العصمة (ضرورة دينية) للسيّدة زينب(عليها السلام)، فإنّها قد وصلت إلى تلك المرتبة، ويمكن القول: (إنّ الشؤون الباطنية والمقامات المعنوية للسيّدة زينب(عليها السلام) كنائبة الزهراء(عليها السلام)، أو أمينة الله… لا يمكن أن يحتويها القلم بتقريره… إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) كانت أكثر الناس شبهاً بأبيها عليّ(عليه السلام) وأُمّها فاطمة(عليها السلام)، بفصاحتها وبلاغتها، بزهدها وعبادتها، بفضيلتها وشجاعتها وسخائها)[13].
إنّ من الأُمور التي لم يُتطرّق إليها بصورة كبيرة هي المباحث العرفانية لخطبة السيّدة زينب(عليها السلام)، و(العرفان: عبارة عن العلم بالحقّ سبحانه، من حيث أسمائه وصفاته ومظاهره، والعلم بأحوال المبدأ والمعاد، وبحقائق العالم، وكيفية رجوع تلك الحقائق إلى الحقيقة الواحدية التي هي الذات الأحدية للحقّ تعالى، ومعرفة طريق السلوك والمجاهدة؛ لأجل تحرّر النفس من قيود الجزئيات والاتصال بمبدئها، واتّصافها بلغة الإطلاق والكلّية)[14]. يقول الباحث الإنجليزي إستيس: (إنّ الوحدة أو الواحد هو التجربة والمفهوم الأساسي لكلّ المدارس العرفانية المختلفة؛ وذلك لأنّ الوحدة في العرفان هي العنصر والعامل الأساسي، وهذا أمر لا شكّ فيه. قال ابن الجنيد (ت 298هـ) ـ وهو من العرفاء المشهورين ـ في حديث (كان الله ولم يكن معه شيء): الآن كما كان)[15].
إنّ الأصالة في العرفان إنّما تحصل من العلم وطيّ المقامات والمنازل، ممّا يُعبّر عنه اصطلاحاً بـ(السير والسلوك)، فالعرفان من أهمّ الأُسس المعنوية التي يمكن من خلالها الوصول إلى الكمال، وقد كان موضع اهتمام الأديان الموحّدة وغير الموحّدة[16].
إنّ البدع والرسوم الظاهرية والميل للزهد المفرط بين المجتمعات المختلفة، كلّ ذلك لا يتلاءم مع روح الأحقية الدينية والتشريع الإلهي والعدالة الاجتماعية عند المعصومين(عليهم السلام) وعظماء الدين. وعليه؛ فلأجل تمييز العرفان الإيجابي البنّاء من العرفان السلبي الهادم، علينا معرفة الشواخص العرفانية في خطب السيّدة زينب(عليها السلام)، وخاصّة خطبها القيّمة بعد واقعة كربلاء.
أسئلة البحث
إنّ الأسئلة المطروحة في هذا المقال عبارة عن:
1ـ هل أُشير في خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) إلى مراتب السير والسلوك؟ وكيف كان دور واقعة عاشوراء فيها؟
2ـ كيف بُيّنت مراتب السير والسلوك في خطبة السيّدة زينب(عليها السلام)؟
أُسلوب البحث
إنّ أُسلوب البحث في هذا المقال (تحليلي توصيفي)؛ وذلك تبعاً لنوع الموضوع، فكان بهذه الصورة: مطالعة المصادر المختلفة والمعتبرة، وانتقاء المعلومات التي تفيد البحث، ثمّ تدوينها وجمعها، وبما أنّ الهدف من المقال قراءة وتحليل الشواخص العرفانية في خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) كان من اللازم مراجعة النصوص التي شرحت تلك الخطبة، وكشفت التعاليم التربوية والعرفانية فيها، والنظر في مدى ارتباطها بواقعة عاشوراء.
الشواخص العرفانية في خطبة السيّدة زينب(عليها السلام)
في صباح اليوم الثاني عشر من شهر محرم الحرام، سير بحرم آل الرسول(صلى الله عليه واله) بقيادة السيّدة زينب والإمام السجاد(عليهما السلام) نحو الكوفة التي كان قد أعدّ فيها ابن زياد مراسيم تُعبّر عن فرحه واستبشاره بما حدث في كربلاء.
ثمّ سير بذلك الركب نحو الشام، المكان الذي كان يُقيم فيه يزيد بن معاوية، وقد أعدّ القوم مراسم خاصّة في البلاط الأُموي تفوق مراسم ابن زياد، وقد أُحضر رأس الحسين(عليه السلام) وأصحابه أمام يزيد، فقام زحر بن قيس ـ الذي كان ممثلاً لابن زياد ـ متحدّثاً عما حلّ في عاشوراء، من استشهاد الإمام وأصحابه وأهل بيته(عليهم السلام)[17]، فاعترض بعض الحاضرين على أسرِ نساء بيت الوحي، ويزيد صامت من دون جواب، وكان كبار أهل الشام من بين الحضور، قد دعاهم يزيد لهذه المراسم بمناسبة النصر[18]، وفي هذه الأثناء قام رجل من أهل الشام أحمر، فقال ليزيد: يا أمير المؤمنين، هب لي هذه الجارية. فردّت السيّدة زينب(عليها السلام) عليه، بأنّ ذلك ليس لك ولا ليزيد[19]، فغضب يزيد من ذلك ودار بينه وبين السيّدة(عليها السلام) حديث عصيب، بعد أن ضرب اللعين شفتي أبي عبد الله(عليه السلام) بخيزرانته، فقامت السيّدة زينب(عليها السلام) وألقت خطبتها الشريفة.
التوبة
لقد أشارت السيّدة زينب(عليها السلام) في خطبتها إلى ندم يزيد يوم القيامة بعدما قام به في واقعة عاشوراء؛ وذلك في قولها: (… مُنتحياً على ثنايا أبي عبد الله، سيّد شباب أهل الجنّة، تنكتها بمِخصَرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأتَ القرحة، واستأصلت الشأفة، بإراقتك دماءَ ذريّة محمد(صلى الله عليه واله)، ونجوم الأرض من آل عبد المطّلب؟! وتهتف بأشياخك زعمتَ أنّك تناديهم، فلتَردنّ وشيكاً موردهم، ولتودّنّ أنّك شُللتَ وبَكُمتَ، ولم يكن قلتَ ما قلتَ، وفعلتَ ما فعلتَ. اللّهمّ خُذ بحقِّنا، وانتقم ممّن ظلمنا، وأحلِل غضبك بمَن سفك دماءنا، وقتل حُماتنا)[20].
تستند التوبة على قواعد أربعة: ندم القلب، وطلب العفو باللسان، والعمل بالأعضاء والجوارح، والإرادة والعزم بجدّ على عدم الرجوع إلى ارتكاب الذنب والتلوّث السابق.
وعليه؛ فإنّ التوبة ليست صرف لفظ فحسب، بل يجب أن يندم القلب، ويتنفّر من المعصية، ثمّ يأتي دور اللسان، فيُعلن لنفسه وللآخرين شعار ترك المعاصي، ويُلقّن التائب نفسه الاستمرار في ذلك، ثمّ يجعل أعضاء بدنه وعناصره الوجودية في دائرة الأعمال الصالحة بدلاً من الذنوب؛ حتّى يتحوّل إلى عنصر آخر غير ما كان عليه، بحيث لا يهمّ بالعودة إلى القبح واللهو والتلوث السابق.
ورد في القرآن الكريم ثلاثة اصطلاحات قريبة المعنى من بعضها، وهي: (التوبة، الإنابة، الأوبة) التي تشتق من الجذور التالية: (توب، نوب، أوب)؛ ولأجل الوقوف على اختلاف معاني هذه الكلمات نذكر هذا المثال: عندما تسير مركبة خلاف قوانين المرور، كأن تدخل في شارعٍ قد مُنع الدخول فيه، سوف يضطرّ سائقها للوقوف حين يصل شرطي المرور، فيندم وينطق بلسان الاعتذار، ثمّ يبادر بالرجوع إلى ما قطعه من الطريق مرةً أُخرى، فيجبر ما فات، ويتعهّد أن لا يكرّر الخطأ ثانيةً، إضافة إلى ما يدفعه من فاتورة الغرامة. خلاصة الأمر أن سائق تلك المركبة سوف يرجع إلى الطريق الأساسي، ويستمرّ في السير للوصول إلى مقصده، فيرجع وهو يراقب كلّ علامات المرور من دون غفلة حتّى يصل إلى هدفه.
لقد تمّ الإقدام على ثلاث مراحل في المثال، المرحلة الأُولى: الوقوف والندم والاعتذار، وتدارك ما فات، والعزم على عدم العودة، وهذه هي مراتب التوبة، التي يسمّى آخرها بالاستغفار الذي هو عبارة عن الاعتذار. وأمّا المرحلة الثانية: فهي الرجوع إلى الطريق الأساسي، والدخول عملياً في الصراط المستقيم، وهذا ما يسمّى بالإنابة. والمرحلة الثالثة: هي الرقابة الدقيقة بعد الاعتذار والرجوع إلى الطريق الأساسي حتّى نيل الهدف، وهو ما يسمّى بالأوبة، وهذا ما نقله (عبد الكريم هوازن) عن أبي علي الدقاق: أنّ الرجوع على ثلاث مراحل: أوّله توبة، وأوسطه إنابة، وآخره أوبة.
مقام الإحسان
الإحسان في اللغة: بمعنى فعل الخير بشكل حسن، أي: إنّ للإحسان جانبين، الجانب الأول: في نفس عمل الإحسان، والثاني: في كيفية إجراء العمل؛ إذ من الممكن أن يجرى العمل الحسن بالوسائل السيئة، وبالعكس أيضاً، أي: يمكن القيام بالعمل السيء بوسائل حسنة، لكن كلا الأمرين لا يمكن أن يكونا من مصاديق الإحسان أبداً؛ ومن هنا جاء في القرآن الكريم أنّ الصبر، والجهاد، والعيش الحلال، والثروة الحلال، وخدمة الوالدين، وكذا الصلاة، وكظم الغيظ، والعفو، كلّها حسنة في حدّ ذاتها، لكن لا يشملها مفهوم الإحسان إلّا بعد أن تؤدّى بشكلٍ حسن أيضاً. والسيّدة زينب(عليها السلام) تُشير إلى مغفرة الله تعالى وإحسانه، فتقول: (فالحمد لله ربّ العالمين، الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة)[21]. وعليه؛ يكون مقام المغفرة ممزوجاً بالسعادة والإحسان.
إنّ الناس في هذا المجال على فئات ثلاث، الفئة الأُولى: غارقة في التوحيد، يائسة من الحياة، تعيش في محضر الله في كلّ مكان، معرضة عن الانشغال في أُمور النفس والحياة. والفئة الثانية: الوالهون في الهيبة، والتائهون في الغيبة، كورقة قشٍّ في فلك الخلقة العظيم. والفئة الثالثة: الممتلؤون بالنشوة، الواصلون إلى مقام الحضور، النائلون للشهود الحقّ، والمنوّرون بنورانية الإشراق على حدّ تعبير العرفاء.
وبعبارة أُخرى: قد غاب هوى النفس في العزيمة، وتاهت الأسباب في الجمع، وضاع الفرق في الوحدة، والخلاصة: هي الإعراض عن النظر إلى الأهواء النفسانية في مسير السير نحو الكمال، وبما أنّ السالك يعلم أنّ كلّ شيء بيد القدرة الإلهية، فكلّ توجّهه سيكون لله تعالى، وبما أنّه وصل إلى الوحدة في الوجود، فإنّه ينفي كلّ الأسباب، وهذا ما تُشير إليه الآية الكريمة: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) [22]، فلا يبقى من البدن إلّا السمع لا غير، ومن اللسان إلّا الذكر لا غير، ومن القلب إلّا الألم لا غير، ويكون النظر والفكر بالقلب وكأنّه العيان، قد أُطلق وحُرّر من السعي الإنساني، ومن خمود الهوى، وعناء التعلّقات، وهذا هو الإحسان وآثاره.
وقد أوضح الخواجة في (منازل السائرين) ذلك، مستعيناً بالمعنى اللّغوي والاصطلاحات القرآنية، وخلاصة كلامه: (أن تعبد الله كأنّك تراه)[23].[24].
إنّ الإنسان في واقعه الحالي ليس كُلّياً، لكنّه عندما يتخلّى عن فرديته سوف يرتقي مرتبتين إلى الأعلى، وسوف يستطيع النفوذ في كلّ العالم، فيصبح متّحداً مع كلّ شيء[25].
مقام الاطمئنان
مقام الاطمئنان: هو مقام السكون والهدوء إلى جانب الشعور بالأمن والأُنس. وبعبارة أُخرى: إنّ مقام المشاهدة قد لوحظ في ساحة الإحسان، ومن مقام المشاهدة يحصل اليقين، ومن اليقين يحصل الأمن العلمي، والإنسان يصل إلى السكون الروحي من الأمن العلمي، وعندما يتحوّل السكون إلى صفة دائمة وثابتة، ينتقل إلى مرحلة الاعتقادات القطعية دون خوالج، والأمن الكامل، فيتحقّق حينئذٍ مقام الاطمئنان الرفيع. وعليه؛ فإنّ الاطمئنان عبارة عن السكون الروحي المصاحب للأمن المطلق، بعيداً عن الخطر والأثر، ومتحرّراً من الاضطراب والقلق.
وقد جاء في آيات الذكر الحكيم أنّ الاطمئنان على ثلاث مراحل، أحدها: الاطمئنان العقلي والفكري، الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الهداية الإلهية العامّة، فيتخلّص بواسطتها من التردّد والتحيّر العلمي، كما في الآيتين (94 و95)[26] من سورة الإسراء[27]. وقد أشارت السيّدة زينب(عليها السلام) إلى الاعتماد والاستناد إلى الله تعالى بقولها: (أَلا فالعجب كلّ العجب لقتل حزبِ الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء! فهذه الأيدي تَنطِف من دمائنا، والأفواه تتحلّب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العَواسِل، وتعفّرها أُمّهاتُ الفَراعل، ولئن اتّخذتنا مَغنَماً، لتجِدَنّا وشيكاً مَغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، وما ربُك بظلّامٍ للعبيد، فإلى الله المشتكى، وعليه المعوَّل)[28].
مقام الاعتصام
الاعتصام بالله: بمعنى التحلّي برعايته ومساندته، ويستفاد من آيات القرآن الكريم أنّ العبودية ومناجاة الله تعالى تجعلان الإنسان غنياً عن غيره، ومن هنا فإنّ الآية الكريمة تقول: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ)[29].
وقد أشارت السيّدة زينب(عليها السلام) في إحدى فقرات خطبتها إلى أنّ الاعتصام يكون بالله، والملجأ الأساسي هو الله تعالى، حيث تقول(عليها السلام): (نسأل الله أن يُكمل لهم الثواب، ويُوجب لهم المزيد، ويُحسن علينا الخلافة، إنّه رحيم ودود، وحسبنا الله ونِعمَ الوكيل)[30].
أفاد العرفاء المسلمون أنّ مراتب الاعتصام تكون كالآتي:
الاعتصام: بمعنى أداء الأعمال الحسنة التي تقوم على أساس الأمر والنهي، والاعتراف بالوعد والوعيد الإلهيين، وهذا هو اعتصام العوام.
اعتصام الخواصّ: وهو بمعنى الانقطاع والإعراض والابتعاد عن التعلّقات النفسانية، والإقبال على الله جملة واحدة، بحيث يسلب الإنسان عن نفسه الاختيار.
اعتصام خواصّ الخواصّ: ذلك عندما يبتعد العبد عن كلّ شيء، ويصل إلى مقام الاتصال جملة واحدة، وهو عبارة عن شهود حقانية الحقّ تعالى ولقائها، ففي تلك الحالة ينال السالك نهاية الاستكانة والخضوع والخشوع[31].
مقام الإخلاص
إنّ توقّع الحلول من غير الله، والأمل بغير الله، وطلب الشكر والثناء من غير الله، وعمل الخير لأجل كسب رضا الآخرين، والاعتناء بقدح الآخرين أو مدحهم، وإدخال الرياء والسمعة عند القيام بالعبادة، كلّ ذلك يُعتبر إضافات تهدم الإخلاص، حتّى أنّ طلب الجنة والتحرّر من النار يتنافى مع الإخلاص التام؛ لأنّ الإنسان في كلّ هذه الموارد المذكورة يقبل لنفسه شخصية وجودية، ويريد أن يرضي هذه الشخصية الوجودية والاعتبارية، فهو يقول: (أنا أُريد)، و(أنا أرجو الجنة)، (أنا أخاف من النار).
وخلاصة القول: إنّ الإنسان يقبل لنفسه نوعاً من الأنانية، وهذا لا يتلاءم مع الإخلاص؛ لأنّ الإخلاص بمعنى اكتساح الأنانية والاعتبار النفسي، والوصول إلى مقام كهذا ليس أمراً ميسوراً بالطبع، حتّى أنّ رسول الله(صلى الله عليه واله) ينقل عن الله تعالى حديثاً قدسياً، يقول فيه: (الإخلاص سرّ من أسراري، استودعته قلب مَن أحببته من عبادي)[32]، وإنّ ترك العالمينِ والإعراض عن النشأتين لمن آثار هذا السـرّ.
وتشير السيّدة زينب(عليها السلام) في بعض المقاطع من خطبتها إلى أنّها لا تُريد المآل والعقاب إلّا من الله تعالى؛ لأنّ ما فعله أهل البيت(عليهم السلام) كان نابعاً من إخلاصهم له(عز وجل)، فتقول: (اللّهمّ خذ لنا بحقّنا، وانتقم ممّن ظلمنا، وأحلل غضبك بمَن سفك دماءنا، وقتل حُماتنا، فو الله، ما فريتَ إلّا جلدك، ولا حززتَ إلّا لحمك، ولترِدنّ على رسول الله(صلى الله عليه واله) بما تحمّلتَ من سفكِ دماء ذرّيته، وانتهكتَ من حُرمته في عترته ولُحمته، حيث يجمع الله شملهم، ويَلُمّ شعَثَهم، ويأخذ بحقّهم، (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)، وحسبك بالله حاكماً، وبمحمدٍ خَصيماً، وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم مَن سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين (أي: أبوك معاوية)، بئس للظالمين بدلاً، وأيّكم شرٌّ مكاناً وأضعَف جُنداً)[33].
وعليه؛ يكون (الرزق) في هذه الخطبة من أهمّ الأعمال التي تكون سبباً لتثبيت الإخلاص في الفرد المؤمن، ومن هنا؛ يتجلّى إخلاص السيّدة زينب(عليها السلام) وثباتها في دخولها ميدان كربلاء وخروجها منه بكلّ إخلاص.
مقام التوكّل
إنّ الله تعالى هو المالك الحقيقي لأصل الوجود، ومالك لكلّ الموجودات المادّية والمعنوية وآثارها وخصائصها، فالله هو الخالق والمالك لوجود الموجودات، وهو المالك لآثارها وخصائصها أيضاً، بمعنى أنّ الله مالك للوجود، ومالك للإيجاد والإبقاء، ومالك لآثارهما وخصائصهما، وعندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة التي يرى فيها أنّ كلّ هذه الأُمور من الله تعالى، فيفوّضها إلى الله، ويخلع يده منها، ولا يرى للآخرين فيها أيّ أصالة أو استقلال، بمعنى أنّه يعلم أنّ الآخرين مملوكون ومحتاجون إلى الله أيضاً، وليس لديهم ذرّة واحدة من الاستقلال، يكون حينئذٍ قد وصل إلى مرحلة التوكّل.
لكن ينبغي الإشارة إلى أنّ الله تعالى ليس مالكاً للشرور والقبائح، أو للخصائص السيئة وآثارها، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الآيات الكريمة، إضافةً إلى ما يبيّنه الشهيد مطهّري من أنّ الشرور والقبائح من مقولة العدم، وإنّها توجد من النقصان، وليست هي أمراً وجودياً، ومالكية العدم مساوية لعدم المالكية، والأهمّ من ذلك هو أنّ الله تعالى خير محض، والخير لا يصدر منه إلّا الخير، كالنور الذي لا يصدر منه سوى النورانية، وإن كان هناك ثمّة ظلام، فإنّه من وجود الحاجب والمانع من وصول النور.
وعلى أيّة حال، فإنّ الحقّ تعالى منشأ الوجود، وهوية الوجود هي الخيرية، إذاً؛ فالله تعالى هو المالك الحقيقي للخيرات التي تظهر من الأشياء، فكلّ خير منه تعالى، وكلّ شرٍّ فهو من المخلوق، وعلى هذا؛ فإنّ تفويض الأُمور إلى المالك الحقيقي يُسمّى بالتوكّل[34].
والسيّدة زينب(عليها السلام) تُشير في خطبتها إلى الإيمان القلبي لأهل البيت(عليهم السلام)، وتوكّلهم التامّ على الله تعالى، فتقول: (أَلا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيدي تَنطِف من دمائنا، والأفواه تَتحلّب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العَواسِل، وتعفّرها أُمّهاتُ الفَراعل، ولئن اتخذتنا مَغنَماً، لَتجدنّا وشيكاً مَغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، وما ربُكَ بظلّامٍ للعبيد، فإلى الله المشتكى، وعليه المعوَّل)[35].
مقام التقوى
التقوى: من الوقاية، بمعنى: الحفظ وضبط النفس، فإذا جاءت بصورة اسم دلّت على الوقاية والاحتراز، وإذا جاءت بصورة فعلٍ يكون معناها الخوف من الله. والتقوى أهليّة واستعداد روحي، لها ميدانها الوسيع في السير والسلوك، كالبرّ والعبودية، بمعنى أنّ التقوى عبارة عن الهوية العامّة الجارية في كلّ المنازل والميادين ومقامات السير والسلوك، وهي الهوية السارية في كلّ المواقف والفضائل الإنسانية. يقول الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) للصحابي المعروف (همام) في إحدى خطبه التي يعدّ فيها صفات المتّقين: (فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل)[36]، ثمّ يذكر الكثير من صفاتهم إلى درجة أنّ هماماً قد غُشي عليه[37]؛وذلك لأنّ هماماً لم يستطع تصوّر وتصديق تلك الصفات. ويقول(عليه السلام) في محلٍّ آخر: (التقوى رئيس الأخلاق)[38].
وعليه؛ فإنّ التقوى حاضرة في كلّ المؤهّلات والفضائل الإنسانية على حسب درجاتها، وبعبارة أُخرى: إنّ التقوى متربعة على رأس كلّ السجايا والمحاسن، والفضائل والملكات الخُلقية، سواء السجايا التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الوراثة، أو السجايا التي يحصل عليها بالتنمية، أو الفضائل التي هي محاسن عقلانية، أو الملكات التي تمثّل المؤهّلات الخالدة والثابتة للإنسان.
يقول الإمام الصادق(عليه السلام): (التّقوى على ثلاثة أوجه: تقوى الله في الله، وهو ترك الحلال فضلاً عن الشبهة، وهو تقوى خاصّ الخاصّ، وتقوى من الله، وهو ترك الشبهات فضلاً عن حرام، وهو تقوى الخاصّ، وتقوى من خوف النار والعقاب، وهو ترك الحرام، وهو تقوى العام)[39].
وعلى أيّة حال، فإنّ التقوى لها مراتب، تبدأ من الإيمان بالغيب والطاعة المطلقة للأوامر والنواهي الإلهية، حتّى يصل العبد إلى حدّ الارتياح والرضا والقرب والفناء[40].
والسيّدة زينب(عليها السلام) تُشير في خطبتها إلى بعض النقاط في مجال التقوى والطهارة من الأُمور البغيضة، وإلى أفعال يزيد الشنيعة، فتقول: (الحمد للهِ ربِّ العالمين، وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)، أظنَنتَ يا يزيد، حيث أخَذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبَحنا نُساق كما تُساق الأُسراء، أنّ بنا هَواناً على الله، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لِعِظَم خطرك عنده، فشَمَختَ بأنفِك، ونظرتَ في عِطفِك، جَذلانَ مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مُستَوثِقة، والأُمور مُتّسِقة، وحين صفا لك مُلكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً! أنَسِيتَ قول الله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؟!)[41].
مقام الخشوع
الخشوع: عبارة عن الاستعداد الروحي الرفيع، بحيث يكون الخوف فيه ممزوجاً بالمهابة والأدب، بمعنى أنّ عناصر الخشوع عبارة عن:
1ـ الخوف.
2ـ مهابة المولى.
3ـ الأدب الكامل.
فسّر البعض الخشوع بالتواضع، في حال كون التواضع ثمرة للفقر الذاتي، لكنّ الخشوع ثمرة الخشية والخوف الدائم، كما أنّه يستند إلى الفقر أيضاً، ومن هذا المنطلق يقول الخواجة: إنّ ميدان الخشوع يولد من ميدان الخشية، إنّ الخشوع خوف مصاحب لليقظة والاستكانة، وهو يوجب التسليم والإيثار في التعامل مع الله تعالى وخلقه، ولا بدّ من مراعاة هذه الحرّية والعظمة بالنسبة إلى المولى تعالى. كما يقول الخواجة في مكانٍ آخر: الخشوع هو المنزل الرابع عشر من منازل السير والسلوك، وهو عبارة عن خمود النفس وهمود الطبع، وهو أعلى من التواضع والخضوع، وهو موجب لانكسار النفس وتذلّل الأُمور، واستسلام الحكم، بحيث إنّ العبد لا يحكم من قِبل نفسه، فلا شيء سوى الله تعالى، ليس ذلك تسليماً وإسلاماً فحسب، بل إنّ ذلك استسلام وإيجاد للتسليم المطلق في القلب والنفس والروح[42].
فبعض الأفراد يخشعون في الظاهر، ويأخذون طابع الخشوع في الصلاة، إلّا أنّ قلوبهم ليست في مقام الخوف والتسليم والخشوع، فإنّ هؤلاء قد حمّلوا الخشوع على أنفسهم لخداع الآخرين، وهذا هو خشوع المنافق الذي نهى عنه الرسول(صلى الله عليه واله)، والذي يُرى كثيراً مع الأسف.
وقد أشارت السيّدة زينب(عليها السلام) في خطبتها إلى الخشوع والخوف من الله، واجتناب الخوف من غير الله بقولها: (ولئن جَرَّت علَيّ الدواهي مُخاطبتَك، إنّي لأستصغرُ قَدرَك، وأستَعظمُ تَقريعك، وأستكثر توبيخك، لكنّ العيون عَبرى، والصدور حَرّى)[43].
مقام الخشية
وردت في القرآن الكريم بعض الكلمات تُبيّن الأبعاد المختلفة للخوف، من قبيل: الخوف، الوجل، الإنذار، الحذر، اليأس، الخشوع، التقوى، الهلع، الشفقة، الرهبة والخشية.
إنّ كلمة الخشية التي هي محلّ بحثنا هنا، والتي ترتبط بالصلاة، هي بمعنى: المراقبة والمواظبة المساوقة للخوف، أي: الخوف المطلق والعميق بالنسبة للصلاة، ممّا يوجب المواظبة عليها بصورة مطلقة، فإنّ الخشية من الرحمن تعالى، والخشية من القيامة، والخشية من الناس التي ذُكرت في القرآن، كلّها قد أتت بهذا المعنى، مع اختلاف يتمثّل في أنّ الخوف من الناس أمرٌ اعتباري، وهو مورد للإنكار الإلهي. ولعلّ الأعداء أرادوا في الحرب أن يُلقوا الخوف والرعب في قلوب المؤمنين، فحذّرهم سبحانه بقوله: (فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) [44]، فلا تخافوهم؛ لأنّهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، بل اخشوني أنا، وواظبوا على العمل بما آمركم به.
إنّ الخشية من الله هي هكذا أيضاً، فإنّها تعني: المراقبة والمواظبة على أداء الأعمال والأوامر، وترك النواهي الإلهية؛ خوفاً منه تعالى. فإنّ المتّصف بهذه الصفة ينظر إلى الأُمور بصورة دقيقة مع علمه ومعرفته بها، فيواظب عليها ويؤدّيها خوفاً من مقام العدالة الإلهية. وعليه؛ فإنّ الخشية أمرٌ وسطي بين الخوف والمراقبة، والمصلّون أصحاب الخشية هم الذين يؤدّون صلاتهم، وهم يرقبون ضمن ذلك وقتها ومقدّماتها والأذكار المتعلّقة بها، بأن تكون على أفضل صورة وأكملها، وأن لا تُصيبهم الغفلة عن مخافة الله في أيّ آنٍ أو لحظةٍ من لحظاتها، فقد سألوا أحد العظماء عن الخشية، فقال: هي حالة بين الخوف والرجاء، كما سُئل أحد السالكين عنها، فقال: (هي المواظبة مع الرجاء،والمراقبة مع الوعيد،والمراودة بمعية التفاؤل،فلا يُصاب باليأس عند المواظبة،ولا ينسى الوعيد عند المراقبة،ولا ييأس عند المراودة)[45].
وقد أشارت السيّدة زينب(عليها السلام) في خطبتها إلى مقام الخشية والخوف من الله، كما مرّ ذكره في مقام الخشوع؛ حيث قالت: (ولئن جرَّت عليَّ الدواهي مخاطبتك، إنّي لأستصغرُ قدرك، وأستَعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكنّ العيون عَبرى، والصدور حَرّى)[46]. إذاً؛ فالعارف والسالك الحقيقي هو مَن يخشى الله تعالى لا غير.
مقام الذكر
الذكر سادس منزلة من البدايات التي تُطرح في طريق السير والسلوك إلى الله تعالى، وهو يحصل بعد الإنابة والتفكّر، بمعنى: أنّ الذكر نتيجة التفكّر، وقد ذكروا أنّ التفكّر بحثٌ، والتذكّر اكتشاف، والإنابة وثبة، أمّا الذكر فهو إمّا أن يكون عن خوف، أو عن أمل ورجاء، أو عن رغبة وحاجة، فالذكر على ثلاث مراتب.
فلو كان الذكر ناشئاً من الخوف، فعلى الذاكر أن يكسر العادات والتقاليد ويُغطّيها، ثمّ لا يعيرها أيّ اهتمام، وأن يتأسّف على ضياع أوقات الخشوع[47].
أمّا إن كان الذكر لأجل الأمل، فيجب أن يدفع بصاحبه نحو التوبة، فيكون طالباً لشفاعة الشافعين ورحمة الحقّ تعالى.
وإن كان الذكر لأجل الحاجة، فيجب أن يكون مرافقاً للمناجاة، حتّى يصبح الفرد لائقاً للحضور، وشاكراً وسعيداً ومنشرح الصدر عندما ينظر إلى المولى(عز وجل).
ولذا؛ نجد عند الذاكرين أوراداً متنوعة وأذكاراً مختلفة، كتكرار الصفات والأسماء الإلهية تبعاً للأعداد الخاصّة بالحروف الأبجدية، أمثال: (القدّوس) الذي يجب أن يُردّد 170 مرّة، أو (يا الله) 66 مرّة، أو (الرحمن) 298 مرّة، وهكذا يتمّ حسابها وتكرارها تدريجياً طبقاً لحساب الأبجد الكبير، وقد أشار الشهيد مصطفى الخميني(رحمه الله) في تفسيره للقرآن الكريم إلى بعض هذه الأذكار.
إنّ الذكر محوري في منظومة السلوك العرفاني، ويمكن القول: إنّ كلّ عناصر المنظومة ترتبط بنحوٍ أو بآخر بمقام الذكر، وتدور حوله؛ لأنّ الهدف الغائي من السلوك العرفاني هو التقرّب إلى الله تعالى، وأنّ أكبر حجاب ومانع من التقرّب هو نسيان الله تعالى[48].
يبدأ الذكر من مرحلة الخوف، ويرتقي إلى المراحل الأُخرى، حتّى يصل إلى درجة يكون الله تعالى فيها ذاكراً، فهناك بونٌ واسع بين أن تذكر الله وأن يذكرك الله.
وآيات الذكر الحكيم تُشير إلى نقاط مهمّة ومفيدة في مجال ذكر الحقّ تعالى، كذكر الله تعالى عن طريق تذكّر نعمه، من قبيل: ذكر أيام الله، وذكر آلائه، وذكر آياته، وذكر رحمته، وذكر النعم المادّية، وذكر الأسماء الإلهية، وذكر القرآن وتلاوة آياته، والصلاة وإقامتها، وذكر القيامة، وغير ذلك مما يجعل الإنسان من الذاكرين، فإنّ هذه الطرق تُحقّق الذكر لله تعالى بصورة عملية.
والكثير من الآيات تذكر أنّ الصلاة ذكرٌ لله تعالى، وبعضها تحصر الذكر في الصلاة، كما في الآية (15) من سورة الأعلى، أو الآية (34) من سورة طه، أو الآيتين (41) و(191) من سورة آل عمران، أو الآيتين (103) و (142) من سورة النساء، أو الآية (45) من سورة العنكبوت، أو الآية (37) من سورة النور، أو الآية (9) من سورة الجمعة، وغيرها من الآيات التي تُشير إلى ذكر الله تعالى.
إضافة إلى ذلك، هناك آيات أُخرى تُشير إلى الموانع التي تحول دون ذكر الله تعالى، من قبيل: عدم التعقّل، الوساوس الشيطانية، الوساوس الخَلقية والخُلقية، وقساوة القلب، كما أشار أهل البيت(عليهم السلام) إلى تفاصيل هذه الموانع الأربعة التي ذُكرت في القرآن الكريم، والتي تتطلّب جهداً كبيراً لشرحها.
في مقابل ذلك، فإنّ ما يوجب زيادة الذكر هو عبارة عن: الخشوع، والتعقّل، وفوق كلّ هذا هو التوفيق الإلهي، بمعنى: أنّ العرفان والمعرفة والتواضع النفسي كلّ ذلك يهيّئ الأرضية اللازمة التي تجعل الإنسان لائقاً لذكر الله تعالى؛ ولذا قالوا: إنّ التفكّر في الآلاء الإلهية والتعوّذ بربّ الناس، وخدمة خلق الله، لها دور كبير في توفيق الإنسان لذكر الله تعالى.
وقد جاء في خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) أنّها قامت وقالت: (الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)، أظننت يا يزيد، حيث
أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نُساق كما تُساق الأُسراء، أنّ بنا هواناً على الله، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك، جذلان مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوثقة، والأُمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا؟! فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؟!)[49].
إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) كانت ذاكرة لله تعالى، وهذا ما كان واضحاً منها في واقعة عاشوراء وما بعدها.
مقام السكينة
تمثّل السكينة ـ كما عبّر عنها الخواجة عبد الله الأنصاري في (منازل السائرين) ـ المقام الثامن والخمسين، وقد اشتُقّت كلمة السكينة من السكون، أي: الاطمئنان في مقابل الحركة، ويؤخذ في معنى السكون أيضاً الاستقرار ورفع الضبابية والتشويش والحيرة والتردّد، ويُعبَّر عن السكينة في مرتبة عالية بالطمأنينة، فالطمأنينة تحصل من وادي السكينة، وتستبطن السكينة القوّة والاستقرار والوقار والنورانية والعدالة، وكلٌّ من هذه الأوصاف يمثّل ـ في الحقيقة ـ بُعداً من أبعاد السكينة.
إنّ الأعمال والعبادات الملائمة للفطرة يصحبها الهدوء والاستقرار، ثمّ بفعل الممارسة والتكرار تؤول إلى السكينة والفضيلة، وإذا اشتدّت السكينة أضحت مقاماً واسعاً وعظيماً، أمّا إذا ابتعدت تلك العبادات عن الفطرة وتعلّقت بالأُمور الدنيوية، وامتزجت بالوهم والخيال والأُمور الاعتبارية، فإنّها ستؤدّي آنذاك إلى الانحراف عن الصراط المستقيم وعن الاستقرار والسكينة، قال تعالى: (أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)[50]، بمعنى أنّ الكفار يقعون في الأخطاء بسبب ابتلائهم بالظلمات، وابتعادهم عن الفطرة.
لذا؛ فإنّ مصدر السكينة هو النور، وهو عبارة عن الإيمان، والإيمان هو أساس التقوى، وبواسطتها يصل الخائف إلى الأمن، فتتحوّل الوحشة إلى سلوى، والخوف إلى صفاء باطني.
وخلاصة القول: إنّ السكينة والسكون من حالات القلب التي توجب طمأنينة النفس وثبات القلب، وكما ورد في آيات القرآن فإنّ السكينة تُلازم قوّة الإيمان، وتُلازم التقوى أيضاً، فقد عبّر المرحوم العلّامة الطباطبائي(رحمه الله) في (تفسير الميزان) عن السكينة بأنّها: (غير العدالة التي هي ملكة نفسانية تردع عن ركوب الكبائر والإصرار على الصغائر، فإنّ السكينة تردع عن الصغائر والكبائر جميعاً. وقد نسب الله السكينة في كتابه إلى نفسه نسبة تُشعِر بنوعٍ من الاختصاص، كما نسب الروح إلى نفسه دون العدالة)[51].
وإذا كان ثمّة إشارة إلى الجزع في خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) فإنّ ذلك ليس خوفاً من يزيد؛ لأنّ ذكر الله تعالى والاعتصام به يملأ قلبها بالطمأنينة والسكينة، قالت(عليها السلام): (ولئن جَرَّت عليَّ الدواهي مخاطبتك، إنّي لأستصغرُ قدرَك، وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكنّ العيون عَبرى، والصدور حَرّى)[52].
مقام الصبر
الصبر: هو سعة الصدر والتحمّل في جميع الأحوال، بمعنى أن لا يغترّ الإنسان ولا يثمل في حال الثروة والغنى، ولا ييأس في حال الفقر والحاجة، لا تزلّ قدمه عند النعم، ولا ينسى نفسه، لا ييأس عند البلاء، ولا يغترّ في السرّاء، يُبعده التفكير بالعاقبة ومآل الأعمال عن اليأس والتسرّع، شاكراً لله الرحيم بخلقه، عارفاً بذاته.
وقد أمر القرآن الکريم الناس بالصبر، لکن کلٌّ حسب إيمانه وقدرته، فللصبر درجات: درجة العوام، ودرجة العلماء، ودرجة العرفاء، ودرجة العُبَّاد، ودرجة الأنبياء، وكلّ واحدة من هذه الدرجات تتحدّد وفق السعة الوجودية والمسؤولية؛ وعلی أساس هذا التقسيم للصبر قالوا: (والصبر ما أوّله مُرّ وآخره حلو لقوم، ولقوم مُرّ أوّله وآخره، فمَن دخله من آواخره فقد دخل، ومَن دخله من آوائله فقد خرج، ومَن عرف قدر الصبر لا يصبر عمّا منه الصبر)[53].
تقول السيّدة زينب(عليها السلام) في خطبتها: (الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)، أظننت يا يزيد، حيث أخذت علينا أقطار
الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأُسراء، أنّ بنا هواناً على الله، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك، جذلان مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوثقة، والأُمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا؟! فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؟!)[54].
فالسيّدة زينب(عليها السلام) مثال الإنسان المؤمن الصبور، وهذا ما جعلها الداعية لكربلاء، والفاضحة لأعدائها، بكلّ وعي وحنكة.
النتيجة
لقد احتوت خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) ـ حسب ما تمّ من بحثٍ وتحليل ـ على أُمورٍ لافتة لنظر الأعداء، لكنّها(عليها السلام) إضافة إلى ما وجهته للعدو من خطاب قد أشارت إلى الكثير من الأُمور القيّمة والأسرار العرفانية، كما وضّحت طريق السير والسلوك الذي يوجب سعادة الدنيا والآخرة.
وأهمّ خطوة عرفانية بيّنتها السيّدة(عليها السلام) هي الطاعة المطلقة والمحضة لله تعالى، والتقوى والعبودية له(عز وجل)، وهذا ما نلمسه في الكثير من محطّات خطبتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا بالطبع أهمّ أهداف ثورة عاشوراء، وقد أكّدت السيّدة(عليها السلام) رعايةَ الأوامر الإسلامية من أُصول وفروع، تلك الأوامر التي ترقى بالفرد إلى مقام العبودية الرفيع.
وعليه؛ فإنّ الشواخص العرفانية الأساسية: كالعدالة، والصبر، والمغفرة، والشكر
لله، والتوكّل، والاطمئنان بالله وغيرها، هي من لوازم الوصول إلى مقام العبودية والتقوى، وقد جعلتها السيّدة زينب(عليها السلام) مبنىً ومنطلقاً لكلّ أفعالها بعد واقعة عاشوراء.
إنّ أهمّ الشواخص العرفانية التي تمّ البحث عنها في خطبة السيّدة(عليها السلام) عبارة عن: مقام الصبر، ومقام السكون، ومقام الذكر، ومقام الخشية، ومقام الخشوع، ومقام التقوى، ومقام التوكّل، ومقام الإخلاص، ومقام الاعتصام، ومقام الاطمئنان، ومقام الإحسان، وغيرها.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد المعروف بالشيخ المفيد، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ/1993م.
2. الأمالي، محمد بن علي الملقّب بالصدوق، مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة، الطبعة الأُولى، 1417هـ.ق.
3. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1983هـ.ش.
4. بررسي ارتباط ذكر وسكوت عرفاني، قربان وليئي محمد آبادي، مجموعة مقالات الملتقى الدولي الثامن لاتحاد ترويج اللّغة والأدب الفارسي، 1393هـ.ش.
5. بررسي تطبيقي عرفان مولانا وعرفان بودا در باب تمركز فكر.. نقاط مشترك وتأثير بر معنويت إيران امروز، مجموعة مقالات مؤتمر (فرهنگ و انديشه) الدولي، 1393هـ.ش.
6. تشيّع در مسير تاريخ، حسين محمد جعفري، ترجمة: السيد محمد تقي آية اللّهي، الطبعة العاشرة، 1359هـ.ش.
7. تطابق عرفان وسايبرنتيك در وحدت وجود، حورية أدهم، فصلنامه تخصصي عرفان، السنة السادسة، العدد 22.
8. تفسير سوره مزمل، مرتضى مطهّري، مطبعة صدرا، طهران، 1364هـ.ش.
9. حضرت زينب(عليها السلام) در مقام تسليم ورضا، حسين علوي مهر، مجلّه ماهنامه كوثر (مجلة كوثر الشهرية)، العدد السادس، 1393هـ.ش.
10. حماسه حسيني، مرتضى مطهري، مطبعة صدرا، طهران، الطبعة الحادية والعشرون، 1375هـ.ش.
11. زينب قهرمان، أحمد صادقي أردستاني، طبعة مطهر، طهران، الطبعة الأُولى، 1372هـ.ش.
12. عرفان نظري، يحيى يثربي، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1372هـ.ش.
13. الفتوحات المكّية، محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي، السفر الرابع والرابع عشر، طبعة عثمان يحيى، القاهرة، 1412هـ. ق.
14. فلسفه أخلاق، مرتضى مطهّري، مطبعة صدرا، طهران، 1375هـ.ش.
15. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365هـ.ش.
16. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى المعروف بابن طاووس، طهران، 1381هـ.ش.
17. مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة، المنسوب للإمام الصادق(عليه السلام)، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأُولى، 1400هـ/1980م.
18. مقام مقدّس اعتصام، السيّد حسن الأبطحي، مكتبة تبيان الإلكترونية، 1390هـ.ش.
19. مقامات عرفاني نماز در قرآن، رضا هاشمي نجف آبادي، لجنة إقامة الصلاة، طهران، 1378هـ.ش.
20. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطبأطبائي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين، قم المقدّسة.
21. ناسخ التواريخ، محمد تقي لسان الملك سپهر، كتابفروشي إسلاميه (مكتبة إسلامية)، الجزء الأوّل.
22. نهج البلاغة، الشريف أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي، تحقيق: صبحي الصالح، الطبعة الأُولى، بيروت، 1387هـ/1967م.
23. وفاة حضرت زينب(عليها السلام)، مجلة إشارات، العدد العاشر بعد المائة، 1387هـ.ش.
24. وفيّات الأئمة، مجموعة من علماء البحرين والقطيف، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأُولى، 1412هـ/1991م.
________________________________________
[1]باحثة إسلامية، من إيران./ المترجمة من مؤسّسة وارث الأنبياء/القسم النّسوي.
[2] مجموعة من العلماء، وفيات الأئمة(عليهم السلام): ص431.
[3] الأحقاف: آية35.
[4] اُنظر: علوي مهر، حسين، زينب(عليها السلام) در مقام تسليم ورضا (زينب(عليها السلام) في مقام التسليم والرضا): مجلّة ماهنامه كوثر، العدد 6.
[5] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص240.
[6] المصدر السابق: ج45، ص134.
[7] مطهّري، مرتضى، حماسه حسيني (الملحمة الحسينية): ج2، ص225.
[8] سبهر، ميرزا محمد تقي، ناسخ التواريخ: ص73.
[9] مطهّري، مرتضى، تفسير سورة المزّمل: ص73.
[10] رُوي عن زين العابدين(عليه السلام) أنّه قال: «رأيتها تلك الليلة تُصلّي من جلوس». مجموعة من العلماء، وفيات الأئمة(عليهم السلام): ص441.
[11] مطهّري، مرتضى، حماسه حسيني (الملحمة الحسينية): ج2، ص 59.
[12] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص31.
[13] صادقي اردستاني، أحمد، زينب قهرمان (زينب(عليها السلام) البطلة): ص392.
[14] يثربي، يحيى، عرفان نظري (العرفان النظري): ص25.
[15] استيس (1370): ص59.
[16] اُنظر: ترابي، آزاده، بررسي تطبيقي عرفان مولانا وعرفان بودا در باب تمركز فكر( قراءة مقارنة في عرفان مولانا جلال الدين وعرفان بوذا في مجال تركيز الفكر): ص1.
[17] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص118.
[18] جعفري، حسين محمد، تشيّع در مسير تاريخ (التشيّع في حركة التاريخ): ص80.
[19] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص231.
[20] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص108. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[21] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص108.
[22] الأنفال: آية17.
[23] إشارة إلى قول الرسول(صلى الله عليه واله): «الإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه». المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج66، ص203.
[24] اُنظر: هاشمي نجف آبادي، سيّد رضا، مقامات عرفاني نماز در قرآن (مقامات الصلاة العرفانية في القرآن): ص6.
[25] اُنظر: أدهم، حوريه، تطابق عرفان وسايبرنتيك در وحدت وجود (المطابقة بين العرفان والسايبرنتيك في الوحدة الوجودية)، مجلة فصلنامه تخصصي عرفان: العدد22.
[26] الآيتـان المشـار إليهما، همـا قولـه تعـالى: (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً * قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً).
[27] اُنظر: هاشمي نجف آبادي، سيّد رضا، مقامات عرفاني نماز در قرآن (مقامات الصلاة العرفانية في القرآن): ص9.
[28] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[29] الحج: آية78.
[30] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص108.
[31] اُنظر: أبطحي، سيد حسن، مقام مقدّس اعتصام (مقام الاعتصام المقدّس): ص1.
[32] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج67، ص249.
[33] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[34] اُنظر: ابن عربي، محمد بن علي، الفتوحات المكّية: ص152.
[35] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[36] نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح: خطبة193، ص303.
[37] اُنظر: المصدر السابق.
[38] الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص42.
[39] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج67، ص295.
[40] اُنظر: هاشمي نجف آبادي، سيّد رضا، مقامات عرفاني نماز در قرآن (مقامات الصلاة العرفانية في القرآنية): ص26.
[41] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص106.
[42] اُنظر: هاشمي نجف آبادي، سيّد رضا، مقامات عرفاني نماز در قرآن (مقامات الصلاة العرفانية في القرآنية): ص46.
[43] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[44] البقرة: آية150.
[45] هاشمي نجف آبادي، سيّد رضا، مقامات عرفاني نماز در قرآن (مقامات الصلاة العرفانية في القرآن): ص46.
[46] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[47] اُنظر: هاشمي نجف آبادي، سيّد رضا، مقامات عرفاني نماز در قرآن (مقامات الصلاة العرفانية في القرآن): ص78.
[48] اُنظر: وليئي محمد آبادي، قربان، بررسي ارتباط ذكر وسكوت عرفاني (تحليل العلاقة بين الذكر والصمت العرفاني): ص1.
[49] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105.
[50] الأنعام: آية122.
[51] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص227.
[52] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص107.
[53] كتاب مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق(عليه السلام): ص186.
[54] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبياء
http://warithanbia.com/?id=2139
لینک کوتاه
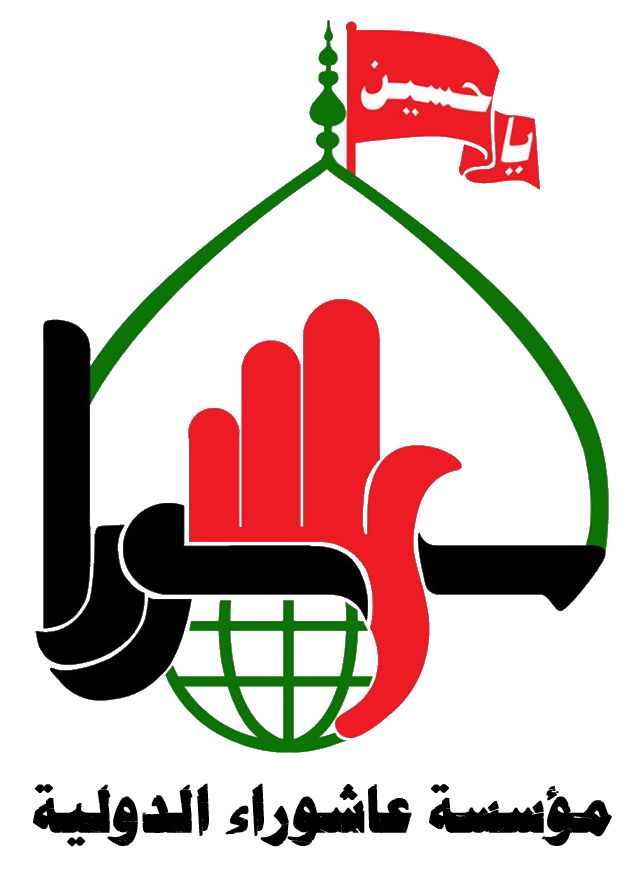
سوالات و نظرات