موسم الحجِّ ورحلة الفتح الحسيني_تأمّلاتٌ في الغايات والأبعاد
{ أ. د. هادي عبد النبي التميمي – دكتوراه في التاريخ الإسلامي، عميد كلية العلوم الإسلامية ـ الجامعة الإسلامية/النجف الأشرف }
المقدّمة
أعلن الإمام الحسين(عليه السلام) في الأشهر الحُرم ثورته المباركة ضدّ كلّ مظاهر الظلم والاستكبار الأُموي، والانحراف الذي طالَ مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية، وقد توخّى لثورته (دار هجرة) ـ إذا صحّ التعبير ـ فكانت مكة، و(دار نصـرة) فكانت الكوفة؛ وقد تقيّدت هذه الهجرة إلى مكّة بزمانٍ خاصٍّ توافق مع موسم الحج العبادي، ممّا منح الثورة فرصة (الدعوة العامّة) للالتحاق بركبها، وكلّ ذلك وفّر للتحرّك الحسيني أن يكون حدثاً تاريخياً ودينياً بامتياز؛ لما تضمّنه من صراع بين محورين، رباني وشيطاني من جهة، وما أنتجه من الاحتفاظ بالقدرة على الإصلاح العقدي والتشريعي من جهةٍ أُخرى.
إنّ هذا البحث يختصّ بمقاربة الغايات والأبعاد التي انطوى عليها التحرّك الحسيني في موسم الحج، تحديداً من حيث الزمان والمكان، ومن حيث الهدف والبُعد العقدي والاجتماعي والسياسي، إذ تستطيع القراءة المتأنِّية لتاريخ الثورة الحسينية أن تسجّل العديد من التساؤلات على وفق المعطيات التاريخية والدينية، وقد حاولنا من خلال البحث والتقصِّي الإجابة عن بعض ما يخصّ عنوان البحث منها.
يتكوّن البحث من خمسة محاور، تضمّنت هذه المحاور عدداً من الاستفهامات التاريخية والفقهية التي سنتلمّس الإجابة عنها في صفحات هذه الدراسة المتواضعة، وذلك فيما يرتبط بالموضوعات المدرجة أدناه:
طلب البيعة من الإمام الحسين(عليه السلام) في المدينة المنورة.
مسوّغات هجرة الإمام الحسين(عليه السلام) من المدينة إلى مكة.
تحرّكات الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة.
مغادرة الإمام الحسين(عليه السلام) لمكة يوم التروية (الأسباب الموضوعية والبُعد العقدي).
الرأي الفقهي في خروج الإمام الحسين(عليه السلام) من مكة قبل تأدية مناسك الحج.
1ـ طلب البيعة من الإمام الحسين(عليه السلام) في المدينة المنورة
بُويع ليزيد بن معاوية بعد هلاك أبيه في رجب من سنة (60هـ)[2]، فكتب إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان[3] بأخذ البيعة من أهل المدينة عامّةً والإمام الحسين(عليه السلام) خاصّةً[4]، فأنفذ الوليد بن عتبة ـ بعد وصول كتاب يزيد إليه ـ إلى الحسين(عليه السلام) في الليل، فاستدعاه[5] ليبايع خشية أن يعلم بموت معاوية، فيُظهر الخلاف والمنابذة والدعوة إلى نفسه قبل إتمام بيعة يزيد في المدينة[6].
وتصوّر بعض المصادر جواب الإمام الحسين(عليه السلام) لوالي المدينة على طلب البيعة بأنّه كان بمثابة طلب الإمهال، إذ قال(عليه السلام):( أمّا ما سألتني من البيعة، فإنّ مثلي لا يُعطي بيعته سرّاً، ولا أراك تجتزئ بها منّي سراً دون أن نظهرها على رؤوس الناس علانيةً؛ قال: أجل. قال [الإمام الحسين(عليه السلام)]: فإذا خرجتَ إلى الناس فدعوتَهم إلى البيعة، دعوتَنا مع الناس فكان أمراً واحداً. فقال له الوليد ـ وكان يُحب العافية ـ: فانصـرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. فقال له مروان: والله، لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، إحبس الرجل، ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضـرب عنقه. فوثب عند ذلك الحسين(عليه السلام)، فقال: يابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. ثمّ خرج…)[7].
بينما تذكر مصادر أُخرى أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد رفض البيعة مباشرةً، وأنّ عامل يزيد على المدينة حينها عمّه عتبة بن أبي سفيان، فقال:( ما كنت أُبايع ليزيد)[8]، وقد ورد في رواية الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) عن أبيه الإمام الباقر(عليه السلام) عن جدّه الإمام زين العابدين(عليه السلام) جواب الإمام الحسين(عليه السلام) لعُتبة برفض البيعة، وقد جاء فيه:( يا عتبة، قد علمت أنّا أهل بيت الكرامة، ومعدن الرسالة، وأعلام الحقّ الذي أودعه الله قلوبنا، وأنطق به ألسنتنا، فنطقَتْ بإذن الله(عزوجل)، ولقد سمعتُ جدي رسول الله(صلى الله عليه واله) يقول: إنّ الخلافة مُحرَّمةٌ على وِلْد أبي سفيان. وكيف أُبايع أهل بيتٍ قد قال فيهم
رسول الله(صلى الله عليه واله) هذا؟!)[9].
ويبدو أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) تدرّج في رفض البيعة من طلب الإمهال إلى الرفض القاطع على وفق متطلبات الموقف مع والي المدينة، كما يتبيّن ذلك من رواية ابن طاووس التي فصّلت في استدعاء الوليد بن عتبة للإمام الحسين(عليه السلام)، وعرض بيعة يزيد عليه، فقال(عليه السلام):( إنّ البيعة لا تكون سرّاً، ولكن إذا دعوتَ الناس غداً فادعُنا معهم. فقال مروان: لا تقبل أيّها الأمير عذره، ومتى لم يبايع فاضرب عنقه. فغضب الحسين(عليه السلام)… فقال: أيّها الأمير، إنّا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجلٌ فاسقٌ، شاربُ الخمر، قاتلُ النفس المحرّمة، معلنٌ بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نُصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أيُّنا أحقُّ بالخلافة والبيعة؟)[10] ثمّ خرج الإمام الحسين(عليه السلام).
وقد يكون من ضمن مسوّغات الموقف الأوّل للإمام الحسين(عليه السلام) ـ وهو إرجاء موقفه من بيعة يزيد حتى يجتمع أهل المدينة ـ إلقاء الحجّةِ على الناس بعدم صلاحية يزيد لمنصب الخلافة، وتذكيرهم بحقّ أهل البيت(عليهم السلام)، إلّا أنّ تهديد مروان العنيف بقتل الإمام الحسين(عليه السلام) قد حال دون هذه الخطوة، فأعلن رفضه المباشر لبيعة يزيد، ثمّ أعدَّ مباشرةً للخروج من المدينة إلى مكة المكرمة، ليفوّت الفرصة على والي المدينة وعتاة الأُمويين فيها من التدبير لأيِّ عمليةِ اغتيالٍ تطاله؛ تنفيذاً لأوامر يزيد[11]، وتمنعه من اللقاء بالجمهور الأكبر في مكّة المكرَّمة، ممّا يوّفر له تعبئة وإعداد أكبر للناس ضدّ هذه البيعة النكراء؛ فخرج الإمام الحسين(عليه السلام) لليلتين بقيتا من رجب سنة (60هـ) باتّجاه مكة[12].
كان الإمام الحسين(عليه السلام) يريد أن يكون زِمامُ المبادرة بيده هو لا بيد أعدائه، فهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو الذي ينهض، وهو الذي يتحرّك، وهو الذي يقرّر، وهو الذي يحدّد قدر الإمكان طبيعة المواجهة… كان(عليه السلام) لا يريد أن يظلّ متخفِّياً حتى يأتوا إليه ليعتقلوه أو يقتلوه، ولا يريد أن تكون حركته صدىً لحركتهم[13].
2ـ مسوِّغات هجرة الإمام الحسين(عليه السلام) من المدينة إلى مكّة
عندما أمر الله تعالى المؤمن بمقاومة الباطل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، علم أنّ بعض الظروف قد لا تسمح للإنسان بالمقاومة، ولا تعينه على الصمود؛ فأذن الله لعباده بالهجرة من الأرض التي يُفتنون فيها، أو يخشون فيها على دينهم، ويكون فيها الابتلاء عظيماً، وربّما يصل الحكم في بعض الأحيان إلى وجوب الهجرة من مثل هذه الأرض[14] لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا)[15]، فالحق والعدالة ليسا حكراً على أرضٍ دون أُخرى، مثلما أنّ الأراضي ليست واحدةً في تقبّل الدعوة، فما يواجه بالصدّ في بلدٍ ما قد يواجه بالترحيب في بلدٍ آخر[16]، وعلى الإنسان الرسالي أن يختار الأرض المناسبة التي تحتضن دعوته وتتلقّاها بالقبول، فقد هاجر نبي الله إبراهيم(عليه السلام)، وهاجر موسى(عليه السلام) منفرداً ومجتمعاً مع قومه، وهاجر نبينا الأكرم محمد(صلى الله عليه واله) من مكة إلى المدينة، فكانت هجرته(حدثاً تاريخياً فاصلاً، ودرساً سياسياً كبيراً في ضرورة المناورة واستغلال الأقاليم والأقطار في نشر الدعوة وتأسيس النظام)[17].
وعندما ضاقت أرض المدينة بالإمام الحسين(عليه السلام)، خرج منها إلى مكة على مثل حال موسى(عليه السلام) (خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)[18]، ولم يكن هذا الأمر رضوخاً لحال الخوف على نفسه من الاغتيال، بل تأسّياً بقول نبي الله موسى(عليه السلام) الذي( أشفق من غلبةِ الجُهّال، ودُول الضَّلال)[19].
وقد اختار الإمام الحسين(عليه السلام) مكة المكرمة مكاناً لهجرته، ودعوته إلى الثورة على ظلم بني أُميّة لعدّة مسوغات، منها:
1ـ أنّ مكة هي الحرم الإلهي الآمن وفقاً للعديد من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً…) [20]، وقوله عزّ من قائل: (وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)[21]، وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)[22].
وقد وقف النبي(صلى الله عليه واله) بوجه أيِّ تأويلٍ لاستحلال حرمتها فقال:( إنّ مكة حرَّمها الله تعالى ولم يحرِّمها الناس، ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، أو يعضد بها شجرةً، فإن أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) فيها فقولوا له: إنّ الله أذن لرسوله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم)، ولم يأذن لك، وإنّما أذن لي فيها ساعةً من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب)[23]، وأكّد في آخر حجّةٍ له(صلى الله عليه واله) قدسية المكان والشهر الحرام[24].
وبناءً على ما تقدّم من الأمر الإلهي والنبوي باحترام قدسية مكة، والعرف السائد بذلك، فإنّها تمنح اللائذ بها ـ ولا سيّما في الأشهر الحرم ـ حصانةً ومنعةً، فهي حرم الله، (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)[25]، كما يقول الله تعالى، ومن ثمَّ فهي المكان المناسب لهجرة الإمام الحسين(عليه السلام)، المهدّدُ بالقتل إن لم يبايع، فحرمتها تمنع السلطة الأُموية( من إعلان الحرب فيها أو الغدر به، وبهذا سوف يكون آمناً على الأقل حتى قدوم أمير الحاج)[26].
2ـ مركزية مكة، وتتمثّل هذه المركزية بالمحورين الآتيين:
أـ إنّ مكة هي المكان العام لإعلان المواقف والتبليغ، كما جرى في عهد النبي(صلى الله عليه واله) عندما أرسل الإمام علي(عليه السلام) لتبليغ سورة براءة، وإعلان البراءة من المشركين بعد ذلك العام[27].
ب ـ إنّ مكة هي المكان الوحيد من العالم الإسلامي كلّه الذي يجمع في موسم الحج عدداً كبيراً من المسلمين رجالاً ونساءً، ومن مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، ممّا يضمن لصاحب الثورة أن تصل دعوته لمسامع هؤلاء، بما يقطع عذر المعتذر منهم من جهة، ويؤمّن لثورته المباركة إعلامياً أن يستمرَّ صوتها صادحاً في مختلف الأقطار، عبر تناقل خبر النهوض والتحرّك من جهةٍ ثانية، فهي أنسب محطّةٍ لرجل أراد أن يبدأ انطلاقه الكبير بإيصال صوته لكلِّ الناس، وبيان هدفه الرسالي من الثورة.
3ـ إنّها المكان الذي اجتمع عليه رأي الإمام الحسين(عليه السلام) ريثما يتبيّن له الموقف، ويلقي الحجّة على كافّة أبناء الأُمّة الإسلامية المتواجدين في موسم الحج بمكة، فضلاً عن رأي مَنْ استشارهم[28]، وبذلك صرّح عندما قال(عليه السلام):( وإنّي قد عزمتُ على الخروج إلى مكة، وقد تهيَّأت لذلك أنا وإخوتي وبنو إخوتي وشيعتي، وأمرهم أمري ورأيهم رأيي…)[29]، وكانت تلك هي نصيحة أخيه محمد بن الحنفية، مفضلاً مكة على غيرها من الأمصار؛ لأمانها، ولأنّها توفر للإمام الحسين(عليه السلام) حرية التحرّك والتصرّف ودعوة الناس، فقال له:( يا أخي… تنحَّ بتبعتك عن يزيد بن معاوية، وعن الأمصار ما استطعت، ثمّ ابعث رسلك إلى الناس، فادعُهم إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك، لم يُنقص الله بذلك دينك ولا عقلك، ولا يُذهب به مروءتك ولا فضلك، إنّي أخاف أن تدخل مصـراً من هذه الأمصار، وتأتي جماعة من الناس، فيختلفون بينهم، فمنهم طائفةٌ معك، وأُخرى عليك فيقتتلون، فتكون لأوّل الأسنّة، فإذا خير هذه الأُمة كلّها نفساً وأباً وأماً أضيعها دماً… فانزل مكّة، فإنّ اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نَبَتْ بك لحقت بالرمال، وشعف الجبال، وخرجت من بلد إلى بلد، حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس، وتعرف عند ذلك الرأي)[30].
وبالفعل فقد كانت مكة مكاناً آمناً – نسبياً – مكث فيه الإمام الحسين(عليه السلام) ريثما تبيّن الموقف، وتلقّى فيها دعوة الكوفيين[31]، وهي المكان الأوّل الذي انبرى للنصـرة، فتحرّك الإمام(عليه السلام) بخطوات متأنِّية لاختبار موقفهم بهذا الاتجاه.
إنّ سرعة الانتقال إلى مكة فوّتت الفرصة على بني أُمية لكتمان صوت الإمام الحسين(عليه السلام)، أو التعمية على قضيّته عبر إجباره على البيعة، أو اغتياله في المدينة المنورة، فإنّ إرباك السلطة بسرعة انتقاله إليها، وتواصله مع جموع الوافدين إليها من مختلف الأقطار حُجّاجاً ومعتمرين، استلزم من السلطة الأُموية التي كانت في فترةٍ انتقالية – إذا صحَّ التعبير – أن تتأنّى فيما ينبغي أن تتّخذه من تدابيرَ بشأنه.
3ـ خطوات الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة المكرمة
خرج الإمام الحسين(عليه السلام) من المدينة ليومين بقيا من رجب[32]، ووافى مكة في الثالث من شعبان سنة (60هـ)[33]، فنزل بأعلاها، وضرب هناك فسطاطاً ضخماً، ثمّ تحوّل إلى دار العباس بن عبد المطلب[34]، ففرح به أهلها فرحاً شديداً، وجعلوا يختلفون إليه بكرةً وعشيةً[35]، ويأتونه ومَنْ كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق[36]، فكانوا يجتمعون عنده حلقاً حلقاً[37]، ويستمعون كلامَه[38].
أراد الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة أن يلفت النظر إلى قيامه ودوافع ذلك القيام وأهدافه، وأن يستعرض المواقف العامّة للناس، ويشدّ اهتمامهم[39]، ولم يُخفِ ـ طيلة الأربعة أشهر التي أقام فيها في مكة، من 3 شعبان وحتى 8 ذي الحجّة ـ نيّته على الثورة ضدّ يزيد؛ بدليل أنّه(عليه السلام) تلقّى نصائح عدد من وجهاء الأُمّة المشفقين عليه من الخروج على يزيد؛ مخافة قتله وفشل ثورته[40].
ولا شكّ في أنّ الأيّام المائة وخمسة وعشرين التي قضاها في مكة، والتي تشكّل الفترة الأطول من عمر النهضة الحسينية المقدّسة، قد حفلت بكثير من الاتصالات واللقاءات، والمحاورات والمراسلات، وأنشطةٍ أُخرى غيرها كان الإمام الحسين(عليه السلام) قد قام بها، ومن المؤسف أنّ التاريخ لم يُسجّل عن هذه الأيام المكية إلّا ملاحظاتٍ عامّةً غضّت الطرف وأغمضته عن كثير من التفاصيل التاريخية[41].
ومهما يكن من أمرٍ فلا شكّ في أنّ الفترة التي قضاها الإمام الحسين(عليه السلام) في مكّة هي فترةٌ استثنائية في حياة مكّة المكرمة بالذات، فهي أيّام الموسم العبادي الكبير (الحج)، الذي يشهد وفود المعتمرين والحجاج في الأشهر المباركة، ومن ثمَّ كان للإمام الحسين(عليه السلام) متّسع من الوقت لإعلان قضيته، وبيان أحقّيته بالخلافة، وأولويته بقيادة الأُمّة من يزيد[42]، وممّا يدفعنا إلى ترجيح القول باحتمال قيام الإمام الحسين(عليه السلام) بحركة اعتراضٍ واسعةٍ على مساوئ بني أُميّة عامّة، ويزيد بصورةٍ خاصّةٍ، ما روته بعض المصادر عن نشاطه(عليه السلام) قبل هلاك معاوية بسنتين، وفي المكان والزمان ذاته، إذ حجّ الإمام الحسين(عليه السلام)، وقد جمع ودعا بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم، مَن حجّ منهم ومَن لم يحجّ، ومن الأنصار ممَّن يعرفونه وأهل بيته، ثمّ لم يدَع أحداً من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه واله) ومن أبنائهم والتابعين، ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلّا جمعهم، فاجتمع عليه بمنى سبعمائة رجل في رواية[43]، أو أكثر من ألف رجل في روايةٍ أُخرى[44]، والإمام الحسين(عليه السلام) في سرادقٍ، عامَّتُهم التابعون وأبناء الصحابة، فقام الإمام الحسين(عليه السلام) فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:( فإنّ الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم، وإنّي أُريد أن أسألكم عن أشياء، فإن صدقت فصدّقوني، وإن كذبت فكذّبوني، اسمعوا مقالتي واكتموا قولي، ثمّ ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم مَنْ أمنتموه ووثقتم به، فادعوهم إلى ما تعلمون، فإنّي أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهب، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون. فما ترك الحسين شيئاً أنزل الله فيهم [أهل البيت] من القرآن إلّا قاله وفسّره، ولا شيئاً قاله الرسول في أبيه وأُمّه وأهل بيته إلّا رواه… ثمّ قال: أُنشدكم بالله إلّا رجعتم وحدّثتم به مَنْ تثقون به)[45].
فإذا كانت هذه الخطبة بما فيها من محظورات ـ تمثّلت بالدعوة إلى حقّ أهل البيت(عليهم السلام) في الحكم، ورواية أحاديث النبي(صلى الله عليه واله) بتقديمهم وتفضيلهم، وذكر مساوئ معاوية وتجاوزاته ـ قد أعلنها الإمام الحسين(عليه السلام) في السنتين الأخيرتين من حكم معاوية، المعروف بقوّة جهازه القمعي، فكيف سيكون نشاط الإمام الحسين(عليه السلام) في الموسم والمكان ذاته، بجمع تلك الأعداد الغفيرة من الوافدين إلى مكة، وفي فترةٍ حساسة من عمر الدولة الأُموية التي شهدت موت طاغيتها معاوية، وانتقال السلطة إلى مَنْ لا يماثله طغياناً ودهاءً؟! لا شكّ في أنّه سيكون نشاطاً أكبر على مستوى اللقاءات والمحاورات والمراسلات؛ ودليل ذلك تواصل الإمام الحسين(عليه السلام) مع شيعته من أهل الكوفة والبصـرة، عبر اللقاءات وإرسال رسائل الدعوة لهم لنصرة الثورة[46]، وانضمام عددٍ من أهل هذين المصـرين لركب الثورة الحسينية، وهو لا يزال في مكة[47].
إنّ الفترة الزمنية التي أمضاها الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة كانت كافيةً لتقييم وضع الأمصار الإسلامية إزاء ثورته المباركة، وكان بقاؤه في مكة إلى يوم التروية فرصةً مؤاتية لـمَن أراد الالتحاق به من مختلف الأماكن والبلدان؛ إذ إنّ قوافل الحجاج في توافدٍ مستمر، ولا يمكن تمييز مَنْ يدخل مكة بهدف نصرة الإمام الحسين(عليه السلام) أو الحج.
وقد يُثار تساؤلٌ مشروعٌ عن السرّ في إمهال السلطة الأُموية للإمام الحسين(عليه السلام) طيلة فترة الأربعة أشهر التي مكثها في مكة، وعدم معالجته أو القضاء عليه، على الرغم من تصـريح الإمام(عليه السلام) برفض بيعة يزيد وخلافته؟ وقد يبدو التساؤل أكثر منطقية وجدّية إذا ما أضفنا إليه أنّ السلطة الأُموية قد أُحيطت علماً بتحرّكات الإمام الحسين(عليه السلام)، وربما تكون قد وقفت على مكاتباته لأهل العراق على الرغم من توخّي الإمام الحسين(عليه السلام) السرّية في ذلك[48]، ناهيك عن كثرة المختلفين إليه من الناس في مكة، ممّا يشكل خطراً ماثلاً للعيان.
وللجواب عن ذلك نقول:
إنّ السياسة الأُموية هي ذاتها في المدينة وفي مكة، فقد جرت سُنّة الأُمويين أن يكون تخيير الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة ـ كما في المدينة ـ بين البيعة أو القتل، فلمّا يئست السلطة الأُمويّة من أمر البيعة اتّخذت قرارها بتنفيذ خطّةِ الاغتيال.
إنّ إمهال الإمام الحسين(عليه السلام) لم يكن أمراً اختيارياً من السلطة الأُموية، بل هو وضعٌ أُجبرت عليه بفعل خطوة الإمام الحسين(عليه السلام) المدروسة والذكية بتعجيل التوجّه إلى مكة، والاندماج مع المسلمين الذين قدموا من كلّ أقطار العالم الإسلامي، والذين أسرعوا لزيارته والالتفاف حوله، فالسلطة لا تستطيع ـ إزاء هذا الوضع ـ أن تُسفر عن وجهها القبيح بهذه السـرعة باعتقال الإمام الحسين(عليه السلام) أو قتله علانيةً، في مكان وزمان خاصٍ جداً، دون أن يكون لها عذر مقبول أمام هذا الجمهور الكبير، فلمّا توفّر هذا العذر بسريان دعوة الإمام الحسين(عليه السلام) إلى معارضة بيعة يزيد، صار التعجيل بإيقاف ذلك من الأُمور المصيرية التي لا تحتمل التأجيل بالنسبة للسلطة الأُموية، ولكن هذه المرّة أحرزت أمام الجميع أنّها منحت الإمام الحسين(عليه السلام) الفرصة ليدخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعة الخليفة الجديد،
لا سيّما وأنّها لا تزال آخذةً بأزمّة الأُمور في جميع الأمصار الإسلامية.
4ـ مغادرة الحسين(عليه السلام) لمكّة يوم التروية (الأسباب الموضوعية والبُعد العقدي)
اختلفت المصادر في ذكر تاريخ خروج الإمام الحسين(عليه السلام) من مكة إلى العراق، فمنها ما ذكرت اليوم الثالث من ذي الحجة[49]، ومنها ما ذكرت اليوم السابع من ذي الحجة[50]، ومنها ما ذكرت أنّ الثامن من ذي الحجة كان موعداً لخروجه(عليه السلام) من مكة[51]، والأشهر من هذه التواريخ هو اليوم الثامن من ذي الحجة[52]، وهو يوم مغادرة الحجيج إلى مِنى، والراجح أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد خرج في هذا اليوم من مكة إلى العراق[53]، بعد أن أقام في مكة بقية شعبان، وشهر رمضان، وشوالاً، وذا القعدة، وثماني ليالٍ خلون من ذي الحجّة[54].
وتقف وراء خروج الإمام الحسين(عليه السلام) من مكّة أسباب، عدّة أهمّها:
1ـ لم تكن مكة مكاناً مناسباً لإقامة الإمام الحسين(عليه السلام) فيها بعد انقضاء الشهر الحرام وموسم الحج الذي أوشك على الانتهاء، فهي تحت السيطرة المباشرة لوالي يزيد، ممّا يجعل الإمام الحسين(عليه السلام) تحت أعين السلطة ومراقبتها، إن لم يكن تحت ضغط تهديدها بإعطاء البيعة التي رفضها الحسين(عليه السلام) في المدينة.
2ـ إنّ المجتمع المكّي معروف بولائه، فهو قرشي أُموي[55]، ومعظمه من أبناء الطلقاء أو الموتورين من آل علي(عليه السلام)، وقد سبق أنّ أهل مكة أبوا أن يبايعوا الإمام علياً(عليه السلام) في أوّل خلافته[56]، وكانت أوّل مكان تجمّع فيه معارضوه الذين ادّعوا المطالبة بثأر عثمان بن عفان، وهم: عائشة، وطلحة، والزبير، ومَنْ انضمّ إلى دعوتهم من ولاة عثمان الذين عزلهم أمير المؤمنين الإمام علي(عليه السلام)، وعدد من أهلها، ثمّ خرجوا لحربه في معركة الجمل سنة (36هـ) في البصرة[57]، فضلاً عن أن بعض أهلها قد انضمّ إلى معاوية أو لحق به، وحضروا معه صفين ضدّ أمير المؤمنين الإمام علي(عليه السلام)[58]، فلا يظهر من ذلك أن يتحقّق أيُّ تعاطفٍ جدّي منهم مع ثورة الإمام الحسين(عليه السلام)، ولم تكن مكة على وفق ذلك مؤهّلةً لاحتضان الثورة وتحقيق غاياتها البعيدة.
3ـ إنّ تخطيط السلطة الأُموية لتنفيذ أمر يزيد بن معاوية باغتيال الإمام الحسين(عليه السلام)، كان من أهمّ الأسباب التي دَعَت الإمام الحسين(عليه السلام) للخروج مسرعاً؛ لما في ذلك من انتهاك لحرمة وليّ الله ووصيّه من جهة، ولما في بقائه من احتمال نجاح الأُمويين بتنفيذ خطّة الاغتيال التي يبدو أنّها وصلت إلى شوطها النهائي[59]، وما في ذلك من انتهاكٍ لحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام[60] من جهةٍ أُخرى، فكان على الإمام الحسين(عليه السلام) الحفاظ على ذاته المقدّسة؛ لأداء ما حُمّل من رسالة وأمانة، وقد صرّح الإمام الحسين في أكثر من نصٍّ بنيّة بني أُميّة على قتله في مكة دون رادعٍ، ودون مراعاة لقدسيّتها، فقال لأخيه محمد بن الحنفية:( قد خفتُ أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، فأكون الذي يُستباح به حرمة هذا البيت)[61].
وقال لعبد الله بن الزبير:( والله، لئن أُقتل خارجاً منها بشبرٍ أحبّ إليّ من أن أُقتل داخلاً منها بشبرٍ، وأيم الله، لو كنت في حجر هامّةٍ من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا فيَّ حاجتهم، ووالله، ليعتدنّ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت)[62]، أو قوله(عليه السلام):( لئن أُقتل بمكان كذا وكذا أحبُّ إليَّ من أن يُستحلَّ بي حرم الله ورسوله)[63].
فكما أنّ البقاء في الحرم له مبرِّراته ومميّزاته، كذلك له موانعه ومحاذيره، وهي هتك حرمة البيت والحرم[64].
ولنا أن نتساءل عن السبب الذي دفع يزيد إلى توجيه الأمر إلى والي مكة عمرو ابن سعيد بن العاص الأشدق[65] بقتل الإمام الحسين(عليه السلام) غيلةً[66] في مكة المكرمة، والإقدام على المخاطرة في بداية حكمه بمثل هذا العمل، على ما فيه من المحاذير؟
وللجواب عن ذلك نقول: إنّ مباغتة الإمام الحسين(عليه السلام) وتحرّكه السـريع نحو مكة مثَّل خطراً واقعياً على خلافة يزيد واستقرارها، استلزم مواجهته؛ إذ إنّ إقبال الناس على الإمام الحسين(عليه السلام) واستماعهم إليه ينذر بحراجة الموقف إذا ما وجد الإمام الحسين(عليه السلام) أُذناً صاغية من هؤلاء، وهو ينتقد حكم بني أُميّة وتسلّطهم وظلمهم، وإنّ إعلان الإمام الحسين(عليه السلام) لمعارضته للدولة الأُموية وسكوتها عنه قد يُغري آخرين بتمثّل الموقف نفسه إذا ما وجدوا تهاوناً في قمعه وردعه، فضلاً عن أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) يمتاز بـخصائص وميزات دينية وأُسرية وذاتية مقارنةً بيزيد بن معاوية، تستلزم النظر إليه بوصفه أكثر أهليةً من يزيد؛ ممّا يهدّد شرعية شخص الحاكم الأُموي، ويجعل اعتراضه ذا بُعدٍ عقدي، فضلاً عن بعده السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
بقي أن نقف عند زمان مغادرة الإمام الحسين(عليه السلام)، وهو يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)، وعدم تريّثه بضعة أيام ريثما يُتمّ مناسك الحج كبقية الناس، لنستشفّ أسباب وأبعاد هذا الفعل التي تمثّلت بما يأتي:
لقد تحرّك الإمام الحسين(عليه السلام) قبل عرفة بيومٍ واحد، وقد ارتدى الإحرام كبقية الحجّاج، فظنّ الناس أنّه سيتوجّه لأداء مراسم الحج معهم، لكنّه فاجأ الجميع بأن أدّى العمرة، وأحلَّ إحرامه، وغادر مكة مسرعاً؛ ليفوِّت على الأُمويين نجاح مؤامرتهم التي كانت تستهدف حياته، في الحال الذي لا يمكنه دفع ذلك وهو في لباس الإحرام مجرّداً من السلاح، وفي الساعات العبادية التي يكون الإنسان فيها آمناً مطمئنّاً[67]، فقد قرّر الفاسق أن يقتله أينما وجده[68]، إذ يتمكّن الأُمويون أن يدّعوا أنّهم بريؤون ممّا جرى على الإمام(عليه السلام)، لأجل أن يحافظوا بذلك على الإطار الديني لحكمهم، أو أن تزداد المصيبة سوءاً حين يُطالبونَ بدم الإمام الحسين(عليه السلام)، فيقتلون مَن أمروه بقتله، أو يتّهمون بريئاً بقتله فيقتلونه، ويخدعون الناس بادّعائهم أنّهم أصحاب دمه، الآخذون بثأره، فيزداد الناس انخداعاً بهم، ومحبّةً لهم، وتصديقاً بما يتظاهرون به من التديّن والالتزام، فتكون المصيبة على الإسلام والأُمّة الإسلامية أدهى وأمرّ[69].
5ـ الرأي الفقهي في خروج الإمام الحسين(عليه السلام) من مكة قبل تأدية شعائر الحج
اختلفت الأوساط الفقهية قديماً وحديثاً في تفسير خروج الإمام الحسين(عليه السلام) من مكة يوم التروية دون أن يُتمّ حجّه، ونجم هذا الاختلاف عن تعارض بعض النقول التاريخية مع المروي من حديث بعض أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) في هذا الشأن، ويمكن أن نقسّم هذه الآراء إلى قسمين على النحو الآتي:
الرأي الأول
إنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد بدّل في اليوم الثامن من ذي الحجة إحرامه من الحج وعمرة التمتع إلى العمرة المفردة؛ اعتماداً على ما ورد لدى عددٍ من المؤرّخين وأرباب المقاتل مثل:
• قول الشيخ المفيد (ت413هـ): إنّه( لمّا أراد الحسين(عليه السلام) التوجّه إلى العراق، طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وأحلَّ من إحرامه، وجعلها عمرةً؛ لأنّه لم يتمكّن من تمام الحج؛ مخافة أن يُقبض عليه بمكة…)[70].
• قول ابن الفتال النيسابوري (ت508هـ):( وأحلَّ من إحرامه، وجعلها عمرة؛ لأنّه لا يتمكَّن من إتمام الحج)[71].
• قول الطبرسي (ت548هـ):( لمّا أراد [الحسين] الخروج إلى العراق طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وأحلَّ إحرامه، وجعلها عمرة؛ لأنّه لم يتمكّن من إتمام الحج؛ مخافة أن يُقبض عليه بمكة)[72].
وقد عضّد بعض الباحثين[73] هذا الرأي بما رُوي عن الإمام الصادق(عليه السلام) في نيّة الحج إذ يقول:( اللّهمَّ إنّي أُريدُ التمتُّع بالعُمرةِ إلى الحَجّ على كتابك وسُنّةِ نبيّك(صلى الله عليه واله)، فإن عَرَضَ لي شيءٌ يَحبسُني فحُلَّني حيثُ حَبَسْتني لقدَرِكَ الذي قدَّرتَ عليَّ، اللّهم إن لم تكن حَجَّةً فعمرةً)[74].
نستنتج من هذه الرواية أنّ مَن كان مضطرّاً يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة اضطراراً، ويترتّب على هذا أنّ مَنْ كان بعيداً فلا يجزئه إلّا التمتّع، والحاضر إلّا الإفراد أو القران، إذا كان ما نواه حجّة الإسلام، أمّا الحجّ الندبي فيجوز لكلٍّ من البعيد والحاضر جميع تلك الأقسام الثلاثة (التمتع، أو الإفراد، أو القران) بلا إشكال، والأفضل التمتّع[75]، فإذا كان الإمام الحسين(عليه السلام) ـ وفقاً لهذا الرأي ـ لم ينوِ حجّة الإسلام ونوى الحجَّ الندبي، يجوز له أن يأتي بالإفراد أو القران أو التمتّع بلا إشكال، وهذا يتوافق مع ما روته بعض المصادر من أنّه(عليه السلام) قد حوّل حجّه إلى عمرةٍ اضطراراً [76].
وممّا يُضعف القول بهذا الرأي من أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد بدّل حَجّه إلى عمرة مفردة ما يلي:
أـ المشهور عدم جواز تبديل عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة، وأنّ مَن دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج لا يجوز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكة حتى يأتي بالحج؛ لأنّها مرتبطةٌ بالحجِّ[77].
ب. إن كان التبديل (من عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة) قد وقع لأجل الصدّ، ومنْع الظالم، فإنّ المصدودَ عن الحجِّ يكون إحلاله بالهدي، لا بقلب إحرام الحجِّ إلى عمرة على وفق ما نصّ عليه الفقهاء[78].
الرأي الثاني
ويرى البعض أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد دخل مكة وهو محرم إحرام العمرة المفردة ابتداءً، لا عمرة التمتّع، ولم يكن ثمّة تبديل في الإحرام؛ لأنّه لم يكن قاصداً للحجِّ من أوّل الأمر، بل كان قاصداً للعمرة المفردة، فلا يبقى موضوعٌ للتبديل، ولم يكن يواجه مشكلةً من هذه الناحية[79].
ويستند القائلون بهذا الرأي إلى روايتين وردتا عن الإمام الصادق(عليه السلام):
الرواية الأُولى: عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام)، أنه سُئل عن رجلٍ خرج في أشهر الحجِّ معتمراً، ثمّ رجع إلى بلاده؟ قال(عليه السلام):( لا بأس، وإن حجَّ في عامه ذلك وأفرد الحجّ، فليس عليه دم، فإنّ الحسين بن علي(عليهما السلام) خرج قبل التروية بيومٍ إلى العراق، وقد كان دخل معتمراً)[80]. ومفاد هذه الرواية أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد دخل مكة المكرمة محرماً للعمرةِ لا للحجِّ.
الرواية الثانية: سُئل الإمام الصادق(عليه السلام): من أين افترق المتمتِّع والمعتمر؟ فقال(عليه السلام):( إنّ المتمتِّع مرتبطٌ بالحجّ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين بن علي(عليهما السلام) في ذي الحجّة، ثمّ راح يوم التروية إلى العراق، والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمَن لا يريد الحج)[81].
وبذلك فإنّ الدليل يدل على أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) لم يقصد التمتّع ثمّ أبدله إلى عمرة مفردة مبتولة[82] (مقطوعة) اضطراراً كما في الرأي الأوّل، فالاعتمار وحده ـ وفقاً لهذه الرواية ـ مشـروع في نفسه، وجائزٌ للمعتمر الخروج بعده من مكة بلا لزوم الإتمام بالحج[83].
ولعلّ المتأمّل في موقف الإمام الحسين(عليه السلام)، وخروجه في اليوم الذي يستعدّ فيه الحجّاج لأداء الشعيرة المقدّسة، يستوقفه سؤالٌ: هل ثمّة فرقٌ معنويٌّ كبيرٌ بين ما يُفترض أن يؤدّيه الحجّاج في ذلك الزمان والمكان الخاصّ ـ والذي لم يتمكّن الإمام الحسين(عليه السلام) من أدائه حينها ـ وبين ما قام به(عليه السلام) فعلياً بخروجه ثائراً إلى العراق، معلناً أنّه متّجهٌ إلى الفتح العظيم؟
ولعلّ الإجابة: أنّ الحج في مراسمه وأهدافه يستبطن غاية تحرير الإنسان من عبودية الطاغوت والهوى، وربطه بالله، وتعبيده، واستقطاب ولائه له (عزّ وجل)، ولا تختلف غاية وهدف الإمام الحسين(عليه السلام) من ثورته عن هذا البعد والمعنى، فلقد وقف يوم عاشوراء في كربلاء يدعو البشـرية إلى العودة إلى الله، وتحطيم الطاغوت، وكسـر كبريائه وجبروته، والعودة إلى عبودية الله… ومقارعة الظالمين، وكسر شوكتهم وسلطانهم… وتحكيم شريعة الله تعالى وحدوده في حياة الإنسان، وانتزاعه من محور الطاغوت إلى محور الولاء لله تعالى[84].
ولعلّ كفاءة الإنجاز الحسيني في ذلك الصراع الضاري بين الشرك والتوحيد، وخلوص النيّة فيه لله، كان وراء اعتبار أجر زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) تعدل الحجّ ـ وهو الفريضة الواجبة ـ بأضعافٍ كثيرةٍ، كما دلّت على ذلك الأخبار المشهورة التي رواها أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)[85].
الخاتمة
بعد أن أتممنا البحث بعونٍ من الله تعالى قد توصّلنا إلى جملةٍ من الاستنتاجات، منها:
خرج الإمام الحسين(عليه السلام) من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد أن طُلبت منه البيعة ليزيد بن معاوية؛ ليفوّت الفرصة على والي المدينة وعتاة الأُمويين فيها من تنفيذ أوامر يزيد باغتياله أو قتله؛ فتُقتل الثورة في مهدها، وحرص الإمام الحسين(عليه السلام) ـ وهو بصدد تأدية دوره الرسالي ـ على أن يكون زمام المبادرة بيده هو لا بيد أعدائه.
كان اختيار مكة المكرمة مقراً لهجرة الإمام الحسين(عليه السلام) في نهضته المباركة لعدّة مسوغات، منها:
إنّها حَرمٌ آمن بموجب النصِّ القرآني والنبوي، ولا سيّما في الشهر الحرام، فهي تتيح للإمام الحسين(عليه السلام) فرصة البقاء والتحرّك فيها إلى حين انتهاء التهديد لحياته، فضلاً عن كونها مقصداً لعددٍ كبيرٍ من المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية، ممَّن جاؤوها للتعبّد بتأدية العمرة والحجّ؛ ممّا يتيح للإمام الحسين(عليه السلام) إيصال صوته بمعارضة الحكم الأُموي، وعرض مساوئه على مسامع الناس، وإعلان الثورة وهدفها المبدئي، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك إقامةٌ للحجّة على الناس، وفي مكة يمكن للإمام الحسين(عليه السلام) أن يقوم بأقصى مايمكن أن يقوم به من الإعداد والتحشيد لتحرّكه المرتقب، ناهيك عن أن مكة كانت محطّة الانتظار للإمام(عليه السلام)، حتى وصلته دعوة الكوفيين وسواهم من الأمصار الإسلامية لاحتضان نهضته المباركة.
استثمر الإمام الحسين(عليه السلام) الفترة الاستثنائية التي تواجد فيها في مكة، والتي بلغت حوالي أربعة أشهر، باللقاءات المباشرة مع وفود الزائرين، والاتصالات والمحاورات مع أبرز رجالات الأمصار الإسلامية؛ لبيان أسباب النهضة وأهدافها المقدسة، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى شيعته في الكوفة والبصرة، وقد كان الزمن الذي أمضاه الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة مناسباً لتقييم موقف الأمصار الإسلامية إزاء تحرّكه المبارك من جهة، وفرصةً مؤاتية لانضمام مَن يريد الالتحاق به من جهةٍ أُخرى.
من أهمّ الأسباب التي دفعت الإمام الحسين(عليه السلام) لترك مكّة المكرمة، والتوجّه إلى العراق في الثامن من ذي الحجة، عدم أهليّة مجتمعها لنصرة الثورة إذا ما انقضى موسم الحج، لا سيّما أنّها مدينة قرشية مغلقة للأُمويين، وبسبب وصول مؤامرة السلطة الأُموية باغتياله(عليه السلام) إلى شوطها الأخير، ممّا يهدّد الثورة تارةً، وحرمة مكة بالانتهاك تارةً أُخرى، فأسرع الإمام الحسين(عليه السلام) بالخروج منها قبل وقوع المحذور.
انقسم الرأي الفقهي في تفسير خروج الإمام الحسين(عليه السلام) من مكة يوم التروية قبل إتمام الحج إلى رأيين:
الرأي الأوّل يقول: إنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد أبدل حجَّه إلى عمرةٍ مفردةٍ، واستند هذا الرأي إلى بعض ما ورد في المصادر التاريخية من أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) أحلَّ إحرامه وجعلها عمرةً؛ لأنّه لم يتمكَّن من إتمام الحج.
الرأي الثاني يقول: إنّ الإمام الحسين(عليه السلام) لم يدخل مكّة قاصداً الحجّ، فلمّا أدّى العمرة المفردة جاز له أن يتوجّه إلى أيّ مكانٍ يشاء، وذلك على وفق ما ورد في روايتي الإمام الصادق(عليه السلام)، ويرجِّح هذا الرأي ـ المعتضد بالروايتين ـ قول الفقهاء بعدم جواز التبديل من الحجّ إلى العمرة المفردة في أشهر الحجّ، ومَنْ أراد الخروج من إحرامه اضطراراً خرج بالهدي لا بالإبدال.
إنّ شعيرة الحج المقدّسة ـ بما تنطوي عليه من بُعدٍ عقديٍّ ومعنويٍّ خاصٍّ، تستهدف ربط الإنسان بالله، وتحريره من سيطرة الهوى والشيطان ـ لا تختلف عن هدف وغاية الإمام الحسين(عليه السلام) من تحرّكه الرسالي، وثورته المباركة، فلئن كان الحاج قد أدّى مراسمه في يوم التروية وما بعده، ولم يتمكّن الإمام الحسين من ذلك؛ فلقد أدّاها الإمام الحسين(عليه السلام) على أروع صورةٍ في العاشر من محرم، في عرصات كربلاء، وفي موقف الصراع الأكبر بين محور الشرك ومحور التوحيد، وكانت مراسمه تتمثّل في الانقطاع إلى الله، والإخلاص في طاعته، لإخراج الناس من ظلمات بني أُميّة إلى نور الهداية والحرية وإباء الظلم، فاستحقّ أن يكون الطواف حول مثواه الأخير ومزاره المقدّس استثنائياً في أجره وثوابه، عجيباً في تأثيره فيمَن زاره عارفاً بحقّه.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. اتفاق الحسن وكربلاء الحسين(عليهما السلام)، عبد العزيز بن سعيد المصلي.
2. الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي (ت620هـ)، تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف، 1386هـ/1966م.
3. الأحكام الشرعية في النهضة الحسينية، صلاح عودة الدعمي (رسالة ماجستير)، كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء.
4. الأخبار الطوال الدينوري، أحمد بن داوود الدينوري (ت276هـ)، تحقيق عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة، ط1، 1960م.
5. الإرشاد، محمد بن محمد المفيد (ت413هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، نشـر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1414هـ/1993م.
6. الأُصول النظرية للدولة، محمد رضا الشريفي.
7. إعلام الورى بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، قم، ط1، 1417هـ.
8. الأمالي، محمد بن علي الصدوق (ت381هـ)، تحقيق مؤسسة البعثة، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، ط1، 1417هـ.
9. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت279هـ)، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1394هـ/1974هـ.
10. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت774هـ)، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1408هـ/1988م.
11. تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، دار التراث، بيروت، ط2، 1387هـ.
12. تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (ت284هـ)، دار صادر، بيروت.
13. تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن ابن عساكر (ت571هـ)، تحقيق علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1415هـ.
14. تذكرة خواص الأُمّة في خصائص الأئمّة، يوسف بن فرغلي (سبط بن الجوزي) (ت654هـ)، تحقيق عامر النجار، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1429هـ/2008م.
15. تقريرات الحج، محمد رضا الكلبايكاني (ت1414هـ)، طبعة حجرية.
16. جامع البيان، محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1415هـ/1995م.
17. الجمل، محمد بن محمد المفيد (ت413هـ)، مكتبة الداوري، قم.
18. الجمل وصفين، أبو مخنف لوط بن يحيى (ت158هـ)، جمعه وحققه حسن حميد السنيد، مؤسسة دار الإسلام، لندن، ط1، 1423هـ/2002م.
19. الدروس الشرعية، الشهيد الأوّل محمد بن مكي العاملي (ت786هـ)، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط2، 1417.
20. روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري (ت508هـ)، تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي، قم.
21. سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (ت275هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
22. سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1403هـ/1983م.
23. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي ت(748هـ)، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مأمون صاغرجي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ/1993م.
24. شرح نهج البلاغة، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد المعتزلي (ت656هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
25. العثمانية في عهد الإمام علي (دراسة تاريخية)،الحسناوي، ختام راهي، بحث منشور في مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، السنة الثالثة، 1430هـ/2009م، العدد6.
26. العقل ودوره في صيانة النهضة الحسينية وتكريس قابلية التكرار والمحاكاة، محمد منصور نجاد، ترجمة الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي، مجلة الإصلاح الحسيني، بحث منشور في مجلة الإصلاح الحسيني، مؤسسة وارث الأنبياء (مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية سابقاً)، العدد2، السنة الأُولى، 1434هـ/2013م.
27. الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي (ت283هـ)، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني، طبع على طريقة أُوفست في مطابع بهمن، إيران.
28. الفتوح، أحمد ابن أعثم الكوفي (ت314هـ)، تحقيق علي شيري، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1411هـ.
29. في رحاب عاشوراء، محمد مهدي الآصفي (ت1436هـ)، مؤسسة نشر الفقاهة.
30. قراءة في نهضة الإمام الحسين، مرتضى فرج، وقائع مؤتمر الإصلاح الحسيني، مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، العتبة الحسينية المقدسة، 2016م.
31. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت329هـ)، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط3، 1367هـ.ش.
32. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه (ت367هـ)، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، ط1، 1417هـ.
33. كتاب الحج، عبد الله الجوادي الطبري الآملي تقريراً لأبحاث المحقق الداماد (ت1388هـ).
34. كتاب سليم، سليم بن قيس الهلالي (المتوفى في القرن الأوّل الهجري)، تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني، نشر دليل ما، قم، ط1، 1422هـ.
35. الكشاف، محمود بن عمر الزمخشـري (ت538هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاهم، خلفاء، الطبعة الأخيرة، 1385هـ/1966م.
36. اللهوف في قتلى الطفوف، السيد رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس (ت664هـ)، أنوار الهدى، قم، ط1، 1417هـ.
37. مثير الأحزان، جعفر بن محمد ابن نما الحلّي (ت645هـ)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1369هـ/1950م.
38. مسالك الأفهام، الشيخ زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني) (ت965هـ)، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط1، 1413هـ.
39. مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم (ت1390هـ)، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، 1404هـ.
40. المشروع الاستراتيجي للنبي(صلى الله عليه واله) وأوصيائه، صادق جعفر، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، بيروت، 1424هـ/2004م.
41. مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة (الإمام الحسين(عليه السلام) في مكة)، نجم الدين الطبسي، مركز الدراسات الإسلامية لحرس الثورة، ط2، 1428هـ.
42. معتمد العروة الوثقى (ضمن موسوعة الإمام الخوئي)، محمد رضا الموسوي الخلخالي تقريراً لأبحاث السيد أبي القاسم الخوئي (ت1413هـ)، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط4، 1430هـ/2009م.
43. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1404هـ/1984م.
44. مقتل الحسين، أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي (ت157هـ)، تعليق حسن الغفاري، المطبعة العلمية، قم، 1398هـ.
45. مقتل الحسين(عليه السلام)، محمد بن أحمد الخوارزمي (ت568هـ)، تحقيق شيخ محمد السماوي، أنوار الهدى، قم، ط1، 1418هـ.
46. مقتل الحسين(عليه السلام) أو حديث كربلاء، عبد الرزاق المقرم (ت1391هـ)، قدم له محمد حسين المقرم، منشورات الشريف الرضي.
47. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي ابن شهر آشوب (ت588هـ)، تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1376هـ/1956م.
48. مهذَّب الأحكام، السيد عبد الأعلى السبزواري (ت1414هـ)، مكتب آية الله العظمى السيد السبزواري، ط4، 1416هـ.
49. موسوعة الإمام الحسين(عليه السلام)، محمد الريشهري بمساعدة السيد محمود الطباطبائي نژاد والسيد روح الله السيد طبائي، تحقيق ونشر مركز بحوث دار الحديث، قم، ط1، 1431هـ.
50. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي (ت1404هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المشرفة.
51. نهج البلاغة، خطب الإمام علي(عليه السلام)، شرح الشيخ محمد عبده، دار الذخائر، قم، ط1، 1412هـ.
________________________________________
[2] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص156.
[3] وليَ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب المدينة بعد عزل مروان بن الحكم عنها سنة (57هـ)، وقد غضب عليه يزيد بن معاوية بعد أن فشل في إجبار الإمام الحسين(عليه السلام) على البيعة فعزله، ثمّ أعاده على المدينة سنة (61هـ)، ثمّ عزله سنة (62هـ) إبان تحرّك عبد الله بن الزبير في مكة، أراده أهل الشام على الخلافة بعد موت معاوية الثاني بن يزيد، فطُعن فمات. للمزيد اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج63، ص206 ـ 212. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص534.
[4] اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص241. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص237 ـ 238. سبط بن الجوزي، يوسف، تذكرة الخواص: ص512.
[5] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص32.
[6] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص228.
[7] المصدر السابق: ج5، ص228 ـ 229. واُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص33.
[8] ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص240.
[9] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص216.
[10] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[11] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص18.
[12] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص34.
[13] اُنظر: فرج، مرتضى، قراءة في نهضة الإمام الحسين، وقائع مؤتمر الإصلاح الحسيني: ج1، ص392.
[14] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج5، ص315 ـ 320. الزمخشـري، محمود بن عمر، الكشاف: ج1، ص557. الشريفي، محمد رضا، الأُصول النظرية للدولة: ص131.
[15] النساء: آية97.
[16] اُنظر: الشريفي، محمد رضا، الأُصول النظرية للدولة: ص130.
[17] المصدر السابق: ص131.
[18] القصص: آية21. وكان الإمام الحسين(عليه السلام) يتلو هذه الآية عندما سار إلى مكة.
[19] نهج البلاغة، خطبة رقم4: ص39. وقد ذكر العلّامة الطباطبائي أنّ الخوف هنا يعني: (الأخذ بمقدمات التحرز عن الشر، غير الخشية التي هي تأثّر القلب واضطرابه… والأنبياء(عليهم السلام) يجوز عليهم الخوف دون الخشية…). الطباطبائي، محمد حسين، الميزان: ج16، ص144.
[20] البقرة: آية125.
[21] القصص: آية57.
[22] الحج: آية25.
[23] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي (الجامع الصحيح): ج2، ص152.
[24] اُنظر: ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة: ج2، ص1022.
[25] آل عمران: آية97.
[26] المصلي، عبد العزيز بن سعيد، اتفاق الحسن وكربلاء الحسين(عليهما السلام): ص108.
[27] اُنظر: نجاد، محمد منصور، العقل ودوره في صيانة النهضة الحسينية، بحث منشور في مجلة الإصلاح الحسيني، مؤسسة وارث الأنبياء (مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية سابقاً)، العدد2: ص84 ـ 85.
[28] اُنظر: المصدر السابق: ص85.
[29] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21.
[30] الطبري، محمد بن جريـر، تـاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص230. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص272.
[31] اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص241 ـ 242. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص237 ـ 238.
[32] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص229. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص34. ومن المُلاحَظ أنّ هذا التاريخ يتوافق منطقياً مع تاريخ هلاك معاوية في الخامس عشر من رجب، ومدّة وصول البريد إلى المدينة بموته وبيعة يزيد، وبقاء الإمام الحسين(عليه السلام) على مدى ليلتين في المدينة يقلّب الأُمور، ويفكّر في الأمر، حتى عقد العزم على الخروج من المدينة إلى مكة.
[33] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص35.
[34] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص277.
[35] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص23.
[36] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تـاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص236.
[37] اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص229.
[38] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص162.
[39] اُنظر: جعفر، صادق، المشروع الاستراتيجي للنبي وأوصيائه: ص250.
[40] ومنهم: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جعفر، عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، زرارة بن صالح، وغيرهم. اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص229، وص360 ـ 361. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص258 ـ 259. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص68 ـ 69.
[41] اُنظر: الطبسي، نجم الدين، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة (الإمام الحسين في مكة): ج2، ص17 ـ 18.
[42] اُنظر: المصلي، عبد العزيز بن سعيد، اتفاق الحسن وكربلاء الحسين(عليهما السلام): ص108.
[43] اُنظر: سليم بن قيس، كتاب سليم: ص320.
[44] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص18.
[45] المصدر السابق: ج2، ص19.
[46] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص238. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص29 ـ 31. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص15 ـ 16.
[47] اُنظر لقائمة من أسمائهم في: الطبسي، نجم الدين، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة (الإمام الحسين في مكة): ج2، ص381 ـ 392.
[48] يتبيّن هذا من وصيته(عليه السلام) لمسلم بن عقيل بكتمان أمره إذا ما وصل الكوفة. اُنظر: الطبري، محمد ابن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص238. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39.
[49] اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص242.
[50] اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص535. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص152، ح184.
[51] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص257. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص69. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص66.
[52] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص172.
[53] يتبين ذلك من رسالة الإمام الحسين(عليه السلام) الثانية إلى أهل الكوفة، وقد جاء فيها: (وقد شخصتُ إليـكم من مكة يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذي الحجة يوم التروية). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص266. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص70.
[54] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص66.
[55] وصف ابن أبي الحديد أهل مكة بأنّهم كانوا كلّهم يبغضون أمير المؤمنين الإمام علياً، ويمالؤون بني أُمية، ومع أنّه وصفٌ قد يكون مبالغاً فيه، إلّا أنّه يلقي ضوءاً على ولاء أهل مكة. اُنظر: شرح نهج البلاغة: ج4، ص80.
[56] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص211.
[57] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، الجمل وصفين: ص97، وص209 ـ 210. البلاذري، أحمد ابن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص221وما بعدها . الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص295. اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص182. المفيد، محمد بن محمد، الجمل: ص231 ـ 232، وص364، وص393 ـ 394. الحسناوي، ختام راهي، العثمانية في عهد الإمام علي (دراسة تاريخية)، بحث منشور في مجلّة الكلية الإسلامية الجامعة: العدد 6، ص70 ـ 71.
[58] اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص254. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص277 وما بعدها. أبو مخنف، لوط بن يحيى، الجمل وصفين، ص534 ـ 535. الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص429. رسالة عقيل بن أبي طالب لأمير المؤمنين الإمام علي(عليه السلام) في أعقاب معركة صفين، التي يبيّن فيها انضمام عددٍ من أبناء الطلقاء في مكة إلى صفِّ معاوية.
[59] يتبيّن ذلك من جواب الإمام الحسين(عليه السلام) للفرزدق عندما سأله عن الخروج قبل الحج، فقال الإمام(عليه السلام) معبّراً عن هذا المغزى: (لو لم أعجل لأُخذت). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص260. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص67.
[60] قال الإمام الحسين(عليه السلام): (إنّ أبي حدثني أنّ بها [مكة] كبشاً يستحلّ حرمتها، فما أحبّ أن أكون أنا ذلك الكبش). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص66. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص259.
[61] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص39 ـ 40.
[62] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص67. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص147. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص259.
[63] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص120.
[64] اُنظر: المصلي، عبد العزيز بن سعيد، اتفاق الحسن وكربلاء الحسين(عليهما السلام): ص134.
[65] عمرو بن سعيد الأشدق، من سادة بني أُميّة، استخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق لمّا سار إلى العراق، فوثب في دمشق وبايعه الناس، فلمّا توطّدت العراق لعبد الملك رجع وحاصر عَمراً في دمشق، وأعطاه أماناً مؤكّداً، ثمّ غدر به وقتله. اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص449.
[66] اُنظر: المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين: ص165.
[67] للوقوف على هذا المعنى اُنظر في رسالة عبد الله بن عباس ليزيد بن معاوية بشأن الظروف التي رافقت حركة الإمام الحسين(عليه السلام) من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، فقال: (وما أنسَ من الأشياء، فلستُ بناسٍ إطرادك الحسين بن علي من حرم رسول الله إلى حرم الله، ودسّك إليه الرجال تغتاله، فأشخصته من حرم الله إلى الكوفة، فخرج منها خائفاً يترقّب… ثمّ إنّك الكاتب إلى ابن مرجانة أن يستقبل حسيناً بالرجال، وأمرته بمعاجلته وترك مطاولته). اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص49.
[68] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص67. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص259.
[69] اُنظر: الطبسي، نجم الدين، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة (الإمام الحسين في مكة): ج2، ص90.
[70] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص67. اُنظر: ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص27.
[71] النيسابوري، محمد بن الفتال، روضة الواعظين: ص177.
[72] الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص445.
[73] اُنظر: الدعمي، صلاح عودة، الأحكام الشرعية في النهضة الحسينية: ص165.
[74] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص332.
[75] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معتمد العروة الوثقى (المجلد 27 في الموسوعة): ج2، ص191.
[76] اُنظر: الدعمي، صلاح عودة، الأحكام الشرعية في النهضة الحسينية: ص165.
[77] اُنظر: الطبسي، نجم الدين، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة (الإمام الحسين في مكة): ج2، ص98.
[78] اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج1، ص478. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج2، ص388.
[79] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى: ج11، ص192. السبزواري، عبد الأعلى، مهذَّب الأحكام: ج12، ص349. الكلبايكاني، محمد رضا، تقريرات الحج: ج1، ص58. المحقق الداماد، كتاب الحج: ج1، ص333. الريشهري، محمد، موسوعة الإمام الحسين(عليه السلام): ج3، ص304. الطبسي، نجم الدين، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة (الإمام الحسين في مكة): ج2، ص96 ـ 97.
[80] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص307.
[81] المصدر السابق: ج4، ص308.
[82] عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) قال: (العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ يحلُّ فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل). الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص537.
[83] اُنظر: المحقق الداماد، كتاب الحج: ج1، ص333.
[84] اُنظر: الآصفي، محمد مهدي، في رحاب عاشوراء: ص240.
[85] رُويت عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) في ثواب زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) رواياتٍ كثيرةٍ، منها ما جعلت زيارته تعدل ثواب حجّة وعمرة مبرورة، أو حجّتين وعمرتين، وزادت أحاديث أُخرى الثواب إلى أضعاف مضاعفة حتى وصلت إلى ألف حجّة وألف عمرة مبرورة. اُنظر: ابن قولويه، جعفر ابن محمد، كامل الزيارات: ص238 وما بعدها.
المصدر:مؤسسة وارث الأنبياء
https://www.warithanbia.com/?id=2392
لینک کوتاه
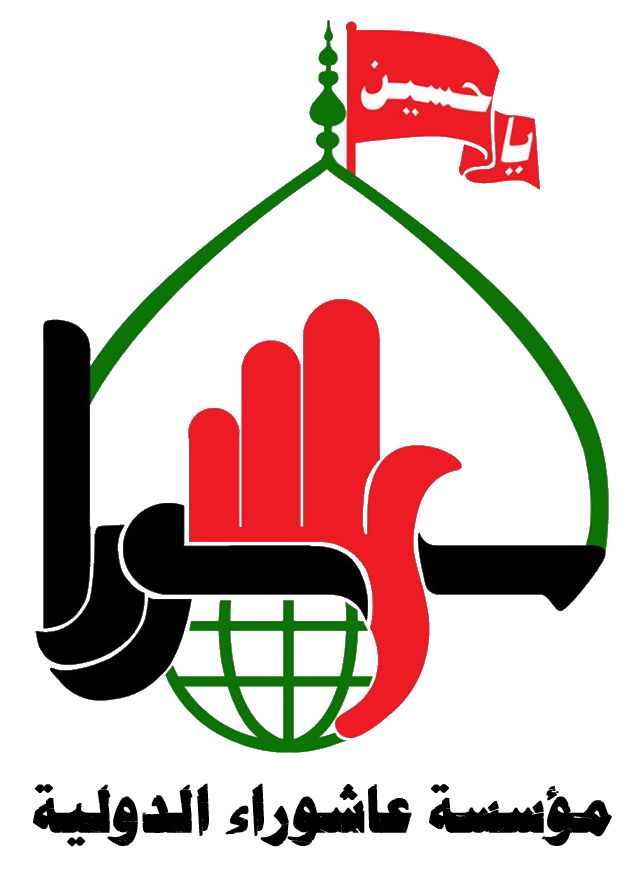
سوالات و نظرات