1 منهج الإمام الحسين عليه السلام في علاج الطغيان.. يزيد بن معاوية أُنموذجاً
{ م. د. ضرغام علي محيي المدني }
المقدّمة [1]
كان ولا يزال الإمام الحسين عليه السلام نشيد الأحرار، وضمير هذه الأُمّة الخالد، ووجدانها الحي، ويقظتها وثورتها التي لا تهادن الطغاة والجبارين، بل وترفض حياة الذلّ والهوان، وتعمل بنهجه من أجل حياة كلّها كرامة وعزّة وإباء، حيث أصبح الإمام الحسين عليه السلام كلمة حقّ ترسّخت في أذهان هذه الأُمّة، بل أصبحت قرآناً لها يُتلى في كلّ المجالات سلماً وحرباً، ثقافةً وعبادة، ولو أنّ هذه الأُمّة في هذا العصر العصيب عملت بنهج سيّد شباب أهل الجنة لما تسلّط عليها أحد من الطغاة، سواء في الداخل ـ من حكّام مستبدّين ظالمين وتابعين لدوائر الاستكبار العالمي ـ أو في الخارج من أنواع المستعمرين وأشكالهم المعروفة وغير المعروفة، وهمّهم جميعاً سَلْخُنا عن هوّيتنا الإسلامية، وإذاقتُنا شتّى أنواع الذل والهوان، وهذا صوت الحسين لا يزال مدوّياً إلى الآن يصدح: «هيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون…»، فلو نهجت الأُمّة بذلك النهج المبارك لما أصبحنا على ما نحن عليه اليوم؛ لأنّ منهجه وخطّه منبثقٌ من النور الأوّل انبثاق النور من النور، وعقله هو العقل الكامل في بني البشـر؛ لأنّه الإمام المعصوم المسدّد من الله تعالى في جميع أفعاله وأقواله وتقريراته دون شك، فالعقل هو نورٌ إلهي بذاته، وهو يكشف للإنسان مجاهل الطريق، ويرشده إلى الصحيح من السقيم، والحقّ من الباطل.
فهو بتضحيته واستشهاده أوضح الحقّ من الباطل، والظلمة من النور، والهدى من العمى، لكلّ مَن يريد الحق لوجه الحقّ تعالى من هذه الأُمّة؛ لذلك بقي نهجه المبارك ووقوفه أمام طغاة زمانه رسالة خالدة للأجيال المتعاقبة، لتثير العقول وتفتحها إلى النور، ولا تتركها غارقة في بحر الظلمات والديجور، وهذه بحدّ ذاتها رسالة السماء إلى الأرض.
وبحقٍّ كان سيّد الشهداء عليه السلام ذلك القلب الكبير الذي استوعب هموم ومآسي الأُمّة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وحاول إصلاح أحوالها، عندما تحكّم بها مَن أراد هوانها ومحقَ إسلامها، فاجرٌ فاسق، طاغٍ مستبدٌّ ظالم، فلمّا رأى أنّ الحق لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، رغب في لقاء ربّه مُحقّاً، فلم يرَ الموت في سبيل القضاء على مَن أمات الدين وأحيى البدعة إلّا سعادة وشهادة، وأنّ الحياة في ذلٍّ وخنوع إلّا برماً، ولمّا لم يجد بدّاً لإصلاح تلك الأُمّة قدَّم كلّ ما يملك من أبناءٍ وإخوةٍ وأهلٍ وأقرباءٍ وأحبّاءٍ وأصحاب، ومن ثَمّ بذل نفسه المقدّسة إلى سيوفها القاطعة، ورماحها النافذة، ولسان حاله: «إن كان دِين محمد لم يستقم إلّا بقتلي فيا سيوف خذيني».
وسيبقى الإمام الحسين عليه السلام جرحاً نافذاً ونازفاً في قلوب المؤمنين، وما صرخاته المدوّية أو نداءاته الثورية، أو استغاثته الحزينة إلّا لإيقاظ القلوب؛ لتجلوها من الرين الذي يتراكم عليها عبر الأيام والآثام، فنهجه ونداءاته: «مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحُرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيِّر عليه بفعلٍ ولا قول؛ كان حقّاً على الله أن يُدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيَّر»[2]، وغيرها، هي كصعقة كهربائية تجبر القلوب على الخفقان، والأجساد على النهوض والثورة ضدّ كلّ متسلّط ظالم، ومتجبّرٍ طاغٍ، فـمنهجه وخطواته في علاج الطغيان هو ضرورة حضارية لهذه الأُمّة، وخاصّةً في هذه الظروف المختلفة التي جعلت من الأُمّة أذلّ أُمم الأرض قاطبةً، رغم كثرتها واتّساع رقعتها وغناها في ثرواتها، إلّا أنّها غثاء كغثاء السيل، لا أحد يحسب لها حساباً، ولا ترعى لها إلّاً ولا ذمّة. نعم، نقرأ في التقارير والكتب المترجمة عن حساباتهم الحذر، إذا فاقت أو استيقظت هذه الأُمّة، ويعملون كلّ ما بوسعهم للحيلولة دون ذلك؛ لأنّها جبارة بكلّ ما تعني هذه الكلمة، ومرعبة لهم في يقظتها، وسرّ يقظتها وشفاء سقمها هو في كتابها المنزل ودستورها الخالد القرآن الكريم وبشقّيه (الصامت والناطق)، ولا يمكن للأُمّة أن تستيقظ من سكرتها أو تصحو من نعاسها إلّا بعودتها إلى حظيرة القدس الإلهية، هذا هو منهج الإمام الحسين عليه السلام.
ومن هذا المنطلق بدأتُ البحث والتنقيب في كتاب الله المجيد وكتب السير والتواريخ؛ لأجد علاقة بين منهج القرآن ومنهج المعصوم ـ المتمثّل بالإمام الحسين عليه السلام ـ في علاج الطغيان المتمثّل بيزيد، فكان سبط النبي صلى الله عليه وآله خير مصداق فيما اتّخذه من أُسلوب ينهل من صميم القرآن الكريم، فكان عنوان البحث (منهج الإمام الحسين عليه السلام في علاج الطغيان ـ يزيد بن معاوية أُنموذجاً ـ).
وقد قسّمتُ البحث على مقدّمة وأربعة مباحث، حاولت من خلالها استعراض الطغيان ومراحل علاجه من خلال الأمثلة القرآنية، ودراسة جزء منها في ثنايا البحث، والاطلاع على بعض الأحاديث الشـريفة التي وردت في كتب السنّة النبوية المطهّرة، ممّا أجد فيها بياناً أو توضيحاً أو استدلالاً في البحث، ولم أتجاوز سيرة الإمام الحسين عليه السلام، فقد رويتُ من مائها العذب، فكان منها التوضيح أو التبويب.
فما وُجد فيه من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى، وما وُجد فيه من خطأ فهو منّي ومن الشيطان، (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)[3]، (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)[4].
المبحث الأوّل: الطغيان مفهومه ومعانيه
المطلب الأوّل: الطغيان في اللغة
عرّفه الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ) بأنّه: «كل شيء يجاوز القدر فقد طغى، مثل ما طغى الماء على قوم نوح، وكما طغت الصيحة على ثمود»[5].
ويقول ابن فارس (ت 395هـ): «الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس، وهو مجاوزة الحد في العصيان، يقال: هو طاغ، وطغى السيل إذا جاء بماء كثير، قال الله تعالى: (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ)[6]، يريد ـ والله أعلم ـ خروجه عن المقدار، وطغى البحر: هاجت أمواجه، وطغى الدم: تبيّغ» [7]. و«طَغَى يَطْغى طَغْياً ويَطْغُو طُغْياناً جاوَزَ القَدْرَ وارتفع وغَلا في الكُفْر»[8].
وعلى وفق ما تقدّم يظهر جلياً أن الطغيان في اللغة هو: (مجاوزة الحد أو القدر المعلوم)، وأمّا المعاني الأُخرى التي ذكرها اللغويون إنّما هي متحصّلة من جهة الاستعمال القرآني لها كما سيتبيّن لاحقاً.
وعليه؛ فالطاغية والطاغوت مشتقّان من طغى كما يقول النحاس (ت338هـ): «وأصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان»[9].
والطاغوت «يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وزنه فَلَعُوت؛ لأنّه من طَغَوْت، قال ابن سيده: و إنّما آثَرْتُ طَوَغُوتاً في التقدير على طَيَغُوتٍ؛ لأنّ قلب الواو عن موضعها أكثر من قلب الياء في كلامهم… وقد يكسَّر على طَواغِيتَ وطَواغٍ»[10].
المطلب الثاني: الطغيان في الاصطلاح
عرّفه علماء التفسير بتعريفات متعدّدة اتّفق البعض على معنى وزاد الآخرون قيوداً على التعريف، إليك جملة من التعريفات:
عُرّف الطغيان بأنّه: «مجاوزة الحد»[11].
وعرّفه الشيخ الطوسي(ت460هـ) بأنّه: «الإفراط في مجاوزة الحد في العدل»[12].
فيما عرّفه الشيخ الطبرسي (ت 548هـ) بأنّه: «مجاوزة الحد في الفساد وبلوغ غايته»[13].
وذهب الفخر الرازي (ت 604هـ) إلى أنّه «الغلو في الكفر ومجاوزة الحد في العتو»[14].
ويرى ابن الجوزي (ت 637هـ) أنّ الطغيان: «الزيادة على القدر، والخروج عن حيِّز الاعتدال في الكثرة»[15].
فيما ذهب الثعالبي (ت 875هـ) إلى أنّ الطغيان: «التخبّط في الشرّ، والإفراط في ما يتناوله المرء»[16].
وهناك مَن يرى أنّ الطغيان هو مجاوزة الحدّ في الشر[17].
وفي موسوعة العلوم السياسية عُرّف الطغيان بأنّه: «نظام الحكم الذي يتمّ بتركيز شديد للسلطة في يد فردٍ واحد، أو تنظيم واحد، يمتلك سلطات غير محدودة، ويتسيّد سياسياً على المحكومين كلّهم، ويمارس الحكم بصورة تحكّمية قهرية، فلا يعترف بالحرية السياسية أو القانون»[18].
ويظهر ممّا سبق أنّ أغلب علماء التفسير متّفقون على أنّ المعنى العام للطغيان هو مجاوزة الحد، فكلّ مجاوزة للحد متضمّن لمعنى الإفراط، والخروج عن دائرة الاعتدال.
المطلب الثالث: الطغيان في ضوء القرآن الكريم
استعمل القرآن الكريم لفظ الطغيان ومشتقّاته في تسعة وثلاثين موضعاً، وبصيغٍ ومعانٍ تنوّعت بتنوّع الاشتقاق وسياق النص المبارك، ومن جملة هذه الألفاظ:
أوّلاً: لفظ (طغى)
ورد لفظ طغى في ستّة مواضع في القرآن الكريم مختلفة المعاني، أبرزها مجاوزة الحد والكثرة في علو الشـيء وارتفاعه، كما في الطوفان الذي أهلك قوم نوح عليه السلام، قال تعالى: (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ)[19].
فاستُعير لفظ الطغيان نتيجة مجاوزة الماء القدر المعلوم والحدّ المعقول[20].
ومثله استُعمل لفظ الطغيان مرادف للصيحة التي أهلكت قوم ثمود؛ لتجاوزها الحدّ الذي معه تخرق قانون الطبيعة، فهي صيحة خرجت عن حدّ كلّ صيحة، قال تعالى: (فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ)[21]، يقول الزمخشـري: «بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة…»[22].
أو يرد بمعنى مجاوزة الحد في الاستكبار والعثو في الأرض ظلماً وفساداً، وهناك جملة من الآيات المباركة تضمّنت هذا المعنى قال تعالى: (ذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ)[23]، وقوله: (اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ)[24]، بمعنى أنّه تكبّر على الله وكفر به، وقِيل: إنّه طغى على بني إسرائيل فاستعبدهم، واستحيى نساءهم، وذبح أبناءهم، وسامهم سوء العذاب[25]. وربّما يمكن الجمع بين الرأيين، فكما أنّ كمال العبودية ليس إلّا صدق المعاملة مع الخالق والمخلوق، كذا أشدّ مرتبة الطغيان الجمع بين سوء العلاقة مع الخالق والمخلوق.
ومثله قوله تعالى: (وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ)[26]. بمعنى أنّهم تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حظر من الكفر بالحق والعتو والتمرّد والبغي في بلادهم، اغتراراً بالقوّة وعظم السلطان[27]. وأمّا في قوله تعالى: (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِّلطَّاغِينَ مَآبًا)[28]. أي: الذين طغوا في الدنيا فتجاوزوا حدود الله استكباراً على ربّهم[29].
ثانياً: لفظ (طغيانهم)
حيث ورد في تسعة مواضع في القرآن الكريم وتنوّعت معانيها بتنوّع السياق القرآني، إلّا أنّ أغلبها تكاد تعطي نفس المعنى، حيث جاءت بمعنى الضلال أو الكفر، كما في الآيات القرآنية المباركة من قوله تعالى: (اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)[30].
وفي الآية استعارة جميلة من حيث يمدّ لهم، كأنّه يخليهم، والامتداد في عمههم والجماح في غيهم، إيجاباً للحجّة، وانتظاراً للمراجعة، تشبيهاً بمَن أرخى الطَّول للفرس أو الراحلة، ليتنفس خناقها، ويتّسع مجالها[31].
فيكون المعنى يريد أن يتركهم من فوائده ومِنَحه التي يؤتيها المؤمنين ثواباً لهم، ويمنعها الكافرين عقاباً لهم، كشرح الصدر وتنوير القلب، فهم في كفرهم وضلالهم يتحيّرون؛ لأنّهم قد أعرضوا عن الحق فتحيّروا وتردّدوا[32]. ويمكن الاستدلال على أنّ معنى الطغيان في الآية الكريمة هو الضلال أو الكفر مجيء قوله تعالى: (أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)[33]، وقد أشار به إلى مَن تقدّم ذكرهم من المنافقين، حيث أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، كما عن ابن عباس. وقيل: استبدلوا الكفر بالإيمان. وحتى قيل: كيف وصفهم بذلك وهم منافقون، ولم يتقدّم نفاقهم إيمان؟ وفي ذلك للعلماء وجوهٌ:
أحدها: أنّه استعمل لفظ اشتروا بمعنى استحبّوا واختاروا؛ لأنّ كلّ مشترٍ مختار ما في يدي صاحبه على ما في يديه.
ثانيها: أنّهم وُلدوا على الفطرة، كما جاء عن قتادة، فتركوا ذلك إلى الكفر، فكأنّهم استبدلوه به.
ثالثها: أنّهم استبدلوا بالإيمان الذي كانوا عليه قبل البعثة كفراً؛ لأنّهم كانوا بُشّروا بمحمد، ويؤمنون به عليها السلام، فلمّا بُعث كفروا به، فكأنّهم استبدلوا الكفر بالإيمان[34].
ومن القرائن الأُخرى التي تدلّ على ذلك أيضاً كلمة: (يَعْمَهُونَ) ، وهي جملة في موضع الحال، والعمه: التحيّر، يُقال: عمه يعمه فهو عمه وعامه بمعنى متحيّر. والعمه هو التردّد والحيرة، وهو حال معروفة للضال حقيقةً ومجازاً يقول الزجاج: «ومعنى يعمهون في اللغة: يتحيّرون. يُقال: رجل عمه وعامه: أي: متحيّر»[35].
ثالثاً: لفظ (تطغوا)
حيث ورد في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم يجمعها معنى واحد، ألا وهو الإسراف في الظلم والعصيان، قال تعالى: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ)[36]. أي: لا تسـرفوا.
يقول الزمخشري: «طغيانهم في النعمة: أن يتعدّوا حدود الله فيها، بأن يكفروها ويشغلهم اللهو والتنعّم عن القيام بشكرها، وأن ينفقوها في المعاصي، وأن يزووا حقوق الفقراء فيها، وأن يُسرفوا في إنفاقها، وأن يبطروا فيها ويأشروا ويتكبّروا»[37].
ومثله قوله تعالى: ( أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ)[38]، بمعنى: لا تتجاوزوا بالإفراط حدّ الفضيلة والاعتدال[39].
وغير ذلك من مشتقّات لفظ الطغيان، التي تكاد تكون متقاربة المعاني تجاوزها الباحث تجنّباً للإسهاب والإطالة.
وعلى وفق ما تقدّم، يتّضح أنّ القرآن الكريم استعمل لفظ الطغيان في معاني متعدّدة، ومتباينة بتباين الاشتقاق والسياق، فجاءت المعاني على النحو الآتي:
الطغيان بمعنى الضلال أو الكفر، قال تعالى: (اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)[40].
الطغيان بمعنى العصيان والتكبّر، كما في قوله تعالى: (ذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ)[41]، وقوله: (اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ)[42].
الطغيان بمعنى مجاوزة الحد في الكثرة والارتفاع والعلو، وذلك في قوله تعالى: (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ)[43].
الطغيان بمعنى الظلم، كما في قوله تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[44].
الطغيان بمعنى الإسراف، وذلك في قوله تعالى: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ)[45].
المبحث الثاني: عوامل نشوء الطغيان والطغاة
حينما نتصفّح سيرة الأُمم الماضية، ونطّلع على طبيعة ملوكها وشعوبها، نجد أنّ هناك مجموعة عوامل لها أثر سلبي في نشوء الطغيان والطغاة، وبحسب الاستقراء الناقص وُجِد أنّها على نوعين: عوامل ذاتية متعلّقة بشخص الطاغي، وأُخرى خارجية، وهي كالآتي:
المطلب الأوّل: العوامل الذاتية (عوامل داخلية)
ويُقصد بها تلك الآفات النفسية التي تحيط بقلب المرء ممّا يؤول به الأمر إلى طغيانه وتجبره، ولعلّ من أهمّ هذه العوامل التي لها الأثر البالغ في تكوين شخصية الطاغي:
الكبر والعلو
يُعدّ هذا العامل من أخطر الأسباب التي تعجّل في هلاك ابن آدم، وسبب من أسباب طغيانه الرئيسة، بل هو باب لدخول جهنم والخلود فيها، قال تعالى: (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)[46]. والكبر: هو التعالي على الآخرين ورؤية النفس أنّ قدرها فوق قدر الآخرين، وهو نتيجة من نتائج العُجب بالنفس، وقد يكون بالامتناع عن قبول الحق معاندة، فـ«لا يزال الرجل يتكبّر ويذهب بنفسه حتى يُكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم»[47].
ولا يتكبّر طاغٍ ويعلو إلّا نتيجة نقصٍ أو ذلّة فيه، قال الإمام الصادق عليه السلام: «ما من رجلٍ تكبّر أو تجبّر إلّا لذلّة وجدها في نفسه»[48] .
وقد وضّح كتاب الله المجيد عن هذه الآفة وكونها سبب طغيان فرعون، قال تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)[49]. وقال جلّ اسمه: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ)[50].
الحقد والحسد
الحقد: إضمار نيّة السوء والحرص والتربّص على الإيذاء، وهو من شيمة الحسدة وطبائع الأشرار، كما أنّه شرّ سلاح[51]، وشرّ داء يُحرق قلب صاحبه، فما إن يرى لله منّة أو إسباغ نعمة على غيره، فيدفعه ذلك إلى ممارسة الطغيان حقداً وحسداً، فها هم اليهود إلى اليوم يصرّون على طغيانهم ويرفضون رسالة النبي الأكرم محمد عليها السلام حقداً وحسداً، مع كونه مكتوباً في توراتهم، وقد أنكر الله تعالى عليهم حقدهم وحسدهم، قال تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا)[52]. وسبب حقدهم وحسدهم كان الطغيان نتيجة جلية، ومن ثمّ خسرانهم المؤكّد، قال تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّـهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّـهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[53].
عدم الإيمان بالله واليوم الآخر
لا شكّ في أنّ عدم إيمان الإنسان بالله وإنكاره ليوم الحساب والجزاء؛ يؤدّي إلى استكبار وطغيان الحاكم، وقد أفصح القرآن الكريم في آيات جمّة عن خطورة ذلك العامل وما له من تأثير في تحويل الإنسان إلى طاغٍ متجبّر، غير مبالٍ بما يقوم به من سياسةٍ ظالمة، أساسها قائمٌ على القهر وسفك الدماء، معتقداً أنّ هذه الحياة هبة ليس بعدها بعث ومحاسبة على ما اقترفت يداه، قال تعالى حكاية على ألسُن هؤلاء الطاغين: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِ)[54].
ونتيجةً لاستكبارهم وعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أُهلكوا بطغيانهم، وقد أبان القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية كريمة تتحدّث عن استكبار فرعون وجنوده، قال تعالى: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)[55].
ومن هنا نجد أنّ يزيد وأغلب ملوك بني أُميّة، لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر، وإنّما كانوا رؤوس الشـرك والنفاق، فهذا يزيد يكشف عن هويّته حينما جِيء برأس الحسين عليه السلام، ووُضع بين يديه في طست، فجعل يضـرب ثناياه بمخصرةٍ كانت في يده، وهو يقول:[56]
لعبت هاشم بالملك فلا
خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل
ليت أشياخي ببدر شهدوا
جزع الخزرج من وقع الأسل
لأهلّوا واستهلّوا فرحاً
ولقالوا يا يزيد لا تُشل
فجزيناه ببدرٍ مثلها
وأقمنا مثل بدرٍ فاعتدل
لست من خندفٍ إن لم أنتقم
من بني أحمد ما كان فعل(1).
فهذا الإمام أحمد بن حنبل، يقول على ما نُقل عنه: «إن صحَّ ذلك عن يزيد فقد فسق»[57].
إذن؛ فالكفر بيوم الحساب من أخطر عوامل الطغيان، والطاغية «يظنّ أنّ حياته الدنيا هي كلّ شيء، ويعتقد أنّ قوّته باقية، وسلطانه دائم، ولو آمن هذا بيوم القيامة، وخاف الحساب في يوم الحساب لأقلع عن بغيه وطغيانه»[58].
حبّ المنصب والرياسة والحرص عليها
تُعدّ غريزة حبّ المُلك والرياسة من الغرائز التي جُبل عليها الإنسان، فهو «منذ وُجِد وُجدت معه غريزة حبّ المُلك، ويستحيل القضاء على هذه الغريزة ما دام الإنسان يملك وعيه واختياره، والذي ينكر ذلك فإنّما ينكر كلّ ما يوحي به طبع الإنسان وفطرته التي فطر الله الناس عليها»[59].
ثمّ إنّ بالملك يجمع الإنسان كلّ ما يريده من العلو والجاه وغير ذلك من ملذّات الدنيا ومغرياتها التي جُبل على حبّها والانجذاب اتجاهها، فيؤول به الأمر إلى مهلكته نتيجة اتّباع الهوى، يقول المدرّسي: «إنّ في كلّ نفس بشـر (يد طاغوت) صغير خفي، فإن أُعطي الإنسان منصباً وغرّته الحياة الدنيا، وتوفّرت له الشـروط، فإنّ ذلك الطاغوت الصغير سيظهر إلى حيّز الوجود، ويصبح فرعوناً طاغياً»[60].
وهذا ما أفصح عنه القرآن الكريم بصورة جليّة، فإنّ أهمّ عامل دفع نمرود إلى الطغيان ومجاوزة الحد في ادّعائه الربوبية هو إيتاء الملك، قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّـهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّـهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)[61]. أي: كفر وتمرّد نمرود لا لشيء إلَّا لأنّه تملَّك وتحكّم بالعباد والبلاد ظلماً وعدواناً، وفي الآية إشارة واضحة إلى الدافع الأساس للطغيان، حيث إنّ ذلك الجبّار تملّكه الغرور والكبر وأسكره المُلك أن آتاه الله المُلك، وما أكثر الأشخاص الذين نجدهم في الحالات الطبيعية أفراداً معتدلين ومؤمنين، ولكن عندما يصلون إلى مقام أو ينالون ثروة فإنّهم ينسون كلّ شيء ويسحقون كلّ المقدّسات[62] .
فإن قيل: كيف يجوز أن يؤتيَ الله الكافر الملك؟ حيث إنّ لفظ الملك عند المفسّرين على وجهين:
أحدهما: يكون بكثرة المال واتّساع الحال، فهذا يجوز أن ينعم الله (عزّ وجل) به على كلّ أحد من مؤمن وكافر، كما قال في قصة بني إسرائيل قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ)[63].
وثانيهما: ملك بتمليك الأمر والنهي والتدبير لأُمور الناس، فهذا لا يجوز أن يجعله الله لأهل الضلال؛ لما فيه من الفساد بنصبِ مَن هذا سبيله للناس؛ لأنّه لا يصحّ مع علمه بفساده إرادة الاستصلاح به[64]، ومن هنا قد اشتبه الأمر على هؤلاء أنفسهم ـ أعني بني أُميّة ـ في هذه الآية، ففي الإرشاد في قصّة إشخاص يزيد بن معاوية رؤوس شهداء الطف، قال المفيد:
«ولمّا وُضعت الرؤوس وفيها رأس الحسين عليه السلام، قال يزيد:
نفلق هاماً من رجالٍ أعزّة
علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما
… ثمّ أقبل على أهل مجلسه، فقال: إنّ هذا كان يفخر عليّ ويقول: أبي خير من أب يزيد، وأُمّي خير من أُمّه، وجدّي خيرٌ من جدّه وأنا خيرٌ منه، فهذا الذي قتله. فأمّا قوله: بأنّ أبي خيرٌ من أب يزيد، فلقد حاجّ أبي أباه فقضى الله لأبي على أبيه. وأمّا قوله: بأنّ أُمّي خيرٌ من أُمّ يزيد، فلعمري لقد صدق، إنّ فاطمة بنت رسول الله خيرٌ من أُمّي. وأمّا قوله: جدي خيرٌ من جدّه، فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: بأنّه خيرٌ من محمد. وأمّا قوله: بأنّه خيرٌ مني فلعلّه لم يقرأ هذه الآية: (قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[65] … »[66].
فكان جواب زينب بنت علي عليهما السلام مبيّناً للملأ حقيقة ما أراد تضليله من أنّ المُلك هو هبة من الله إليه، وأنّ الحسين هو خارج على إمام زمانه، فقالت فيما خاطبته: «أظننت يا يزيد، حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نُساق كما تُساق الأُسارى، أنّ بنا على الله هواناً، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لِعِظم خطرك عنده؟! فشمخت بأنفك! ونظرت في عطفك جذلان مسـروراً! حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأُمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا! مهلاً مهلاً، أنسيت قول الله:
(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)[67]؟!»[68].
تقول الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها (بطلة كربلاء): «لقد أفسدت زينب أُخت الحسين على ابن زياد وبني أُمية لذّة النصر، وسكبت قطراتٍ من السم الزعاف في كؤوس الظافرين»[69] .
وعلى وفق ما تقدّم نجد أنّ سبب طغيان ملوك بني أُميّة عامّة، ويزيد خاصّة، أساسه المُلك والترف، فالحرص على كرسي الحكم كثيراً ما يدفع الإنسان إلى ارتكاب كلّ قبيحة تضمن له البقاء مدةً أطول.
المطلب الثاني: عوامل خارجية
رضوخ الناس للطاغي وسكوتهم على الظلم
إنّ المجتمع الذي يترأسه طاغٍ ظالم بمجرّد أن يستمرؤوا الظلم، ويرضوا بالهوان؛ نتيجة تغلب الخوف عليهم، فإنّ ذلك يُعطي الظالم فرصة تشجّعه على الاستمرار والزيادة في البغي، ولنلاحظ كيف بلغ الخوف بقوم موسى بعد أن نجّاهم الله من فرعون وجنوده وطلب منهم دخول الأرض المقدسة، فرفضوا؛ لخوفهم من الجبابرة، قال تعالى: (قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ)[70]. وهذا الخوف والسكوت عن أعمال فرعون وقبولهم استبداده هو ما جرّأه عليهم من قبل ولكنّهم لم يتّعظوا، قال تعالى : (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)[71].
فساد المؤسّسة العسكرية
إنّ المفصل الرئيس والقاعدة الرصينة التي تبتني عليها ديمومة حومة الظالم هي المؤسّسة العسكرية؛ بوصفها اليد الباطشة لكلّ مَن يقف بوجه الحاكم، فهي الدافعة إلى مزيد من الظلم والطغيان، فلولا دفاعها وتأييدها الدائمَين لَما أمكن للحاكم المستبد فعل شيء، ولا سيما أنّ الطغيان يُمارس بالبطش والقوّة التي تقوم بتنفيذه المؤسّسة العسكرية. يقول رهبر: «إنّ المستكبرين قابعون في قصورهم، ومنهمكون بالملذّات، فيما ينفّذ عملاؤهم ـ وأكثرهم من المستضعفين مع الأسف ـ المخطّطات المشؤومة، فأفراد الجيش والشرطة والدرك والجمارك في النظام الاستكباري هم من المستضعفين، حيث يسلّم السلاح والقلم إليهم، ليقدّموا مقابل أُجور ضئيلة أكبر الخدمات للمستكبرين… إنّ المستضعفين هم الذين يحرسون قصور المستكبرين المنهمكين بلهوهم وطربهم، بل هم الذين يسحقون الانتفاضات الجماهيرية، ويُمارسون التعذيب بحقّ السجناء، في حين أنّهم ينتمون إلى طبقة محرومة حتى من أبسط الأشياء»[72].
تزلّف حاشية الطاغية ونفاقها
اعتاد الطغاة على مرّ العصور إقحام مَن هو متزلّف ومتملّق من ضعاف الشخصية، ممَّن يجدون أنفسهم منبوذين من قبل المجتمع، سواء ممَّن كانت له صبغة دينية كرجال الدين، أو ما يسمّى بوعّاظ السلطان، الذين اشترى الطاغية ضمائرهم بأبخس الأثمان، وباعوا ذممهم بحطام الدنيا، فكانت وظيفتهم إضفاء الشرعية المزيّفة على جرائم الحاكم المستبد، فضلاً عن كونهم يضعون مرويات كاذبة وينسبونها إلى المعصوم؛ ليشرعنوا كلّ ما يصدر من ظلم واستبداد عن الطاغية، وليخدعوا بها البسطاء من أفراد المجتمع، ولم يزَل ولا يزال هذا ديدن الطغاة على مرّ السنين.
وعلى مستوى ما يسمّيه القرآن بالملأ أو البطانة التي تُرغِّب الحاكم في اتّخاذ أحكام وقوانين تعسّفية ومستبدّة في شأن كلّ صوت يعلو، وإن كان صوت الحقّ والعدل، ويُظهرون للطاغي أنّهم حريصون على مصلحته وديمومة حكمه، وهذا الحرص الكاذب مبنيٌ على أساس القرب منه، وحبّاً للمناصب، وزيادة الثروة. يقول العطار: «وأكثر ما تتقرّب بطانة السوء إلى الحاكم بالثناء عليه، وتزيين أعماله وتقديم الهدايا له؛ لتظفر منه على موافقته على مآرب غير مشروعة، أو تجعله يغض الطرف عن مفاسدهم، واستغلال نفوذهم»[73]. محرّضين إيّاه لاتخاذ القرارات القمعية الجائرة في حق دعاة الإصلاح والحرّية، وقد أفصح القرآن، عن ذلك حكاية عن ملأ فرعون، قال تعالى: (وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ)[74].
ولتلك البطانة صفات كثيرة أفصح عنها القرآن الكريم، منها: أنّها بطانة متبّعة لما يتفوّه به الحاكم المستبد دون علم أو رشاد أو استشارة، بل ليس لها أدنى رأي، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ)[75].
فهم يردّدون ما يتفوّه به الطاغي، وكأنّهم ببّغاوات، ومن هنا نجد أنّ السحرة في أوّل وهلة كانوا يردّدون ما تفوّه به فرعون، قال تعالى: (قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ * قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ * فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)[76]. فالكلام ذاته ليس فيه أدنى خلاف عمّا أطلقه فرعون.
ومن ثمّ إنّ هؤلاء الملتفّين حول الطاغي لا يقلّون إجراماً عنه، وإنّ مصيرهم مرتبط بمصير الطاغي؛ ولذلك تجد أنّ القرآن الكريم لا يفرّق بين الطاغية وملأه، قال تعالى: (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)[77]. وقال عزّ وجلّ: (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ)[78].
المبحث الثالث: شخصية يزيد الطاغوتية وسياسته التعسّفية
إنّ طاغيةً مستهتراً يميل إلى الطرب، ويتعاطى الخمر، ويلعب مع القرود والفهود مثل يزيد بن معاوية، لم يكن يتحرّج عن هتك حرمات الله تعالى، وطمس معالم الإسلام ، قد أفصح المؤرّخون عن سياسته، إليك جملة من هذه النصوص التي تُفصح عن شخصية ذلك الحاكم المنحرف:
النصّ الأوّل: ما ذكره المسعودي (ت346هـ) في مروج الذهب
«وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب… وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ما كان يفعله من الفسوق، وفي أيّامه ظهر الغناء بمكّة والمدينة، واستُعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب…»[79].
النصّ الثاني: ما ذكره الطبري (ت 310هـ) وغيره
«وبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة، فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري… ورجالاً كثيراً من أشراف أهل المدينة، فقدموا على يزيد بن معاوية فأكرمهم… فلمَّا قدم أُولئك النفر الوفد المدينة، قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد وعتبه، وقالوا: إنّا قدمنا من عند رجلٍ ليس له دين، يشرب الخمر، ويعزف بالطنابير، ويُضرب عنده القيان، ويلعب بالكلاب، ويسامر الخراب والفتيان، وإنّا نُشهدكم أنّا قد خلعناه. فتابعهم الناس»[80] .
النصّ الثالث: ما ذكره ابن الأثير(ت630هـ) في الكامل
قال: «وقال عمر بن سبيئة: حج يزيد في حياة أبيه، فلما بلغ المدينة جلس على شراب له… فقال يزيد:[81]
ألا يصاح للعجب دعوتك ذا ولم تجب
إلى الفتيات والشهو ات والصهباء والطرب
وباطية مكللة عليها سادة العرب
وفيهن التي تبلت فؤادك ثمّ لم تتبِ»(2).
النصّ الرابع: ما ذكره ابن قتيبة (ت276هـ) في الإمامة والسياسة
يقول ابن قتيبة: إنّ الإمام الحسين عليه السلام حينما دعاه معاوية ابن أبي سفيان للبيعة ليزيد بولاية العهد، قال له: «… وهيهات هيهات يا معاوية، فضح الصبح فحمة الدجى، وبهرت الشمس أنوار السرج… وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لأُمّة محمد، تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنّك تصف محجوباً، أو تنعت غائباً، أو تُخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلمٍ خاصٍّ، وقد دلَّ يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه، من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش، والحمام السبق لأترابهن، والقيان ذوات المعازف، وضرب الملاهي، تجده باصراً، ودَع عنك ما تحاول…»[82].
ولعلّ من أبشع الجرائم التي كشفت عن سياسة ذلك الطاغية ما قامت به بطانته المجرمة في واقعة الحرّة؛ حيث قتلوا في هذه الواقعة جمعاً كبيراً من الصحابة ومن أبناء المهاجرين والأنصار، واستباحوا المدينة المنوّرة ثلاثة أيّام بإيعاز منه[83]؛ ويُعزى سبب هذه الواقعة هو أنَّ أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية؛ لفسقه، وأنَّه لا دين له، وأنَّه يشرب الخمر ويُضرب عنده القيان[84] .
وحتى نوثّق ما ذكرناه، إليك نصوص المؤرِّخين في شأن هذه الواقعة:
يقول ابن الأثير (630هـ): «كان أوّل وقعة الحرّة ما تقدّم من خلع يزيد… فبعث إلى مسلم بن عقبة المرِّي ـ وهو الذي سُمّي مسرفاً ـ وهو شيخٌ كبير مريض، فأخبره الخبر… أمر مسلماً بالمسير إليهم، فنادى في الناس بالتجهّز إلى الحجاز، وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار، فانتدب لذلك اثني عشر ألفاً، وخرج يزيد يعرضهم وهو متقلِّد سيفاً… وسار الجيش وعليهم مسلم، فقال له يزيد: … ادعُ القوم ثلاثاً، فإن أجابوك وإلّا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً، فكلُّ ما فيها من مالٍ أو دابَّةٍ أو سلاحٍ أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاثة فاكفُفْ عن الناس… وقال ـ مسلم بن عقبة ـ: يا أهل الشام، قاتلوا… وانهزم الناس… وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، فأفزع ذلك مَن بها من الصحابة… ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أنّهم خول له، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء، فمَن امتنع قتله… وكانت وقعة الحرّة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاثة وستين»[85]. وقد ذكر الطبري مثل هذا النصّ باختلافٍ بسيط [86] .
أمّا اليعقوبي، فيقول: «لمَّا انتهى الخبر إلى يزيد بن معاوية وجّه مسلم بن عقبة، فأقدمه من فلسطين وهو مريض، ثمّ قصّ عليه القصّة، فقال: يا أمير المؤمنين، وجّهني إليهم، فو الله، لأدعَنَّ أسفلها أعلاها ـ يعني مدينة الرسول عليها السلام ـ فوجّهه… إلى المدينة، فأوقع بأهلها وقعة الحرّة… فلم يبقَ بها كثير أحد إلّا قُتل، وأباح حرم رسول الله عليها السلام حتى ولدت الأبكار لا يُعرف مَن أولدهنّ، ثمّ أخذ الناس أن يبايعوا على أنّهم عبيد يزيد بن معاوية، فكان الرجل من قريش يُؤتى به فيُقال: بايع على أنّك عبدٌ قِنٌ ليزيد. فيقول: لا، فيُضرب عنقه»[87].
وقد ذكر ابن قتيبة أنّه لمَّا أجمع رأي يزيد على إرسال الجيوش: «… دعا مسلم ابن عقبة، فقال له: سِر إلى هذه المدينة بهذه الجيوش… فإن صدّوك أو قاتلوك فاقتل مَن ظفرت به منهم، وانهبها ثلاثاً. فقال مسلم بن عقبة: …لست بآخذٍ من كلّ ما عهدت إلّا بحرفين…أقبلُ من المُقبل الطائع، وأقتلُ المدبرَ العاصي. فقال يزيد: …فإذا قدمت المدينة فمَن عاقك عن دخولها، أو نصب لك الحرب فالسيف السيف، أجهِز على جريحهم وأقبل على مدبرهم، وإيّاك أن تُبقي عليهم… فمضت الجيوش… وجعل مسلم يقول: مَن جاء برأس رجل فله كذا وكذا. وجعل يُغري قوماً لا دين لهم… فما تركوا في المنازل من أثاث ولا حُليّ ولا فراش إلّا نقض صوفه، حتى الحمام والدجاج كانوا يذبحونها»[88] .
ويقول أيضاً: «إنّه قُتل يوم الحرّة من أصحاب النبي عليها السلام ثمانون رجلاً، ولم يبقَ بدريٌّ بعد ذلك، ومن قريش والأنصار سبعمائة، ومن سائر الناس من الموالي والعرب والتابعين عشرة آلاف»[89] .
ويذكر السيوطي (ت911هـ) في تاريخ الخلفاء أنّ «في سنة ثلاث وستين بلغه أنَّ أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسل إليهم جيشاً كثيفاً، وأمرهم بقتالهم، ثمّ المسير إلى مكّة لقتال ابن الزبير، فجاءوا وكانت وقعة الحرّة على باب طيبة، وما أدراك ما وقعة الحرّة؟! ذكرها الحسن مرةً فقال: والله، ما كادَ ينجو منهم أحد، قُتل فيها خلقٌ من الصحابة (رضي الله عنهم) ومن غيرهم ، ونُهبت المدينة، وافتضَّ فيها ألف عذْراء، فإنا لله وإنّا إليه راجعون. قال (صلّى الله عليه وسلّم): مَن أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»[90] .
وغير ذلك من النصوص المستفيضة التي ذكرها المؤرِّخون في شأن واقعة الحرّة، ولولا خوف الإسهاب والإطالة لذكر الباحث الكثير من النصوص والشواهد التي تبيّن شناعة الجرائم التي ارتُكبت في تلك الواقعة.
ولم يكتفِ طغيان ذلك الفاسق بتلك الجرائم، وقتل سبط النبي، حتى أمر مسلم ابن عقبة المرِّي بأن يغزو مكّة بعد أن رفض عمرو بن سعيد الأشدق وعبيد الله بن زياد إنجاز هذه المهمّة، وبعد أن فرغ مسلم بن عقبة من غزو المدينة المنورة وإباحتها ثلاثاً، سار إلى مكّة إلّا أنَّه مات في الطريق، وتولَّى القيام بهذه المهمّة الحصين بن نمير، فسار بالجند إلى مكّة المكرمة، وحاصرها وضربها بالمنجنيق، واحترق من جرّاء ذلك طرفٌ من الكعبة الشريفة [91] .
وإليك بعض ما نصّ عليه المؤرِّخون في ذلك:
ما ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: «…فقال يزيد: فسِر على بركة الله… إن حدث بك حدث فأمرُ الجيوش إلى حصين بن نمير، فانهض باسم الله إلى ابن الزبير واتّخذ المدينة طريقاً…»[92] .
يقول ابن الأثير في الكامل: «لمَّا فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها، شخص بمَن معه نحو مكّة يُريد ابن الزبير… فلمّا انتهى إلى المشلل نزل به الموت… فلمّا مات سار الحصين بالناس، فقدم مكّة… ثمّ أقاموا يقاتلونه بقية المحرم وصفر حتى مضت ثلاثة أيّام من شهر ربيع، رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار… وأقام الناس يحاصرون ابن الزبير…»[93].
وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه: أنّ الحصين بن نمير لمّا قدم مكّة ناوش ابن الزبير الحرب في الحرم، ورماه بالنيران حتى أحرق الكعبة [94].
وجميع ما ذكره المؤرِّخون في سياسية يزيد التعسّفية وكلّ ما قام به من جرمٍ مشهود، ليس من مبرّر لذلك سوى الحرص على استقرار سلطانه، وهذا ما يُهوِّن العظيم، ويُبيح الدم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، فليس على يزيد من حريجة في دينه بعد أن كان هذا مرامه!!!
المبحث الرابع: الإمام الحسين عليه السلام ومنهجه في علاج الطغيان
لا ريب أنّ المرحلية سنّة تاريخية أودعها الله تعالى في الكون والحياة والمجتمع؛ حيث إنّ أيّ أمر أو ظاهرة لا يُكتب لها أن تتمّ ما لم تمرّ بمراحل متعدّدة، وتتدرّج في النشوء والتكوين والترعرع والاستمرار في الوجود، حتى تصبح في قمّة أوجها.
وقد تتباين مظاهر المرحلية بتباين طبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع، من حيث قربه وبُعده عن المفاهيم والقيم الإسلامية، فضلاً عن اختلاف ما يملكه ذلك المجتمع من طاقات وإمكانات، وباختلاف المؤهّلات التي يتّصف بها المنضوون تحت لوائه، وطبيعة الانحراف الذي يواجهه، وخصائص المخالفين والمعارضين كمّاً ونوعاً، إضافةً إلى الزمن المُستغرق في أداء التكليف للوصول إلى الهدف.
ويمكن القول: إنّ مراحل علاج الطغيان على قسمين، هما:
القسم الأول: المرحلة الوقائية
حيث يتمّ فيها دعوة المسلمين إلى التمسّك بما آمنوا به من مفاهيم وقيم، ومن خلالها يتمّ تقرير مبادئ الإسلام في واقع الحياة بصورة عملية منظورة ومحسوسة، من خلال تفنيد أُسس المفاهيم والعقائد الجاهلية التي غرسها طغاة بني أُميّة، فضلاً عن إبعادهم عن ذلك السلوك؛ لأنّ السلوك تتحكّم به الأفكار والعواطف، فإذا آمن الإنسان بخطأ أفكاره ومعتقداته، وانكسرت الأُلفة معها، وتحطّمت الحواجز النفسية بينه وبين العقيدة السليمة، عندها يسهل إبعاده عن السلوك الجاهلي، فهم بحاجة إلى تفنيد تصوّراتهم الخاطئة، ومتبنّياتهم العقائدية الواهية، عن طريق الأدلّة والبراهين والحجج، وكشف مواطن الضعف في الأُسس التي تقوم عليها، عبر الإضاءات والإثارات التي تخاطب العقل لتوقظه.
وقد كانت سيرة الإمام الحسين عليه السلام حافلة بالمواقف الفذّة، القائمة على أساس تفنيد الأُسس والمفاهيم والعقائد الباطلة، كالشرك بالله تعالى، والإيمان بالأوهام والخرافات، وانتهاك المحرّمات، وإعادة المجتمع إلى رشده، ونبذ أغلب العادات السيّئة، من خلال جملة من الأساليب الوقائية، ولعلّ من أبرز تلك العلاجات الوقائية:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات المفروضة، وقد امتدح الله تعالى الأُمّة وجعلها خيراً من الأُمم التي سبقتها؛ نتيجة كونها اتّصفت بصفات، إحداها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)[95].
يقول الشيخ المفيد (ت413هـ): «فمدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدحهم بالإيمان بالله تعالى، وهذا يدلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»[96].
والأُمّة لا تزال بخير، ومنعمة بالأمن والأمان، ومترفة بالخيرات ما دامت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، فإذا تركت ذلك أصابها ما أصابها، وقد أوضح رسول الله عليها السلام ذلك في الحديث الوارد عنه، قال: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البرّ، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات، وسُلِّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصرٌ في الأرض ولا في السماء»[97].
ومن هنا نجد أنّ أوّل الأسباب الوقائية التي اتّخذها الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، بل جعلها هدف ثورته، ومناط خروجه على دولة الطغيان، كما بيّن ذلك في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية قال عليه السلام: «…وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي عليها السلام، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومَن ردّ عليَّ هذا أصبر حتى يقضـيَ الله بيني وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين، وهذه وصيّتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت وإليه أُنيب»[98].
إلقاء المسؤولية على عاتق الأُمّة
حرّك الإمام الحسين عليه السلام بمنهجه الحراك الجماهيري بضرب الوعي الجمعي، من خلال إفصاحه أنّ ما يحصل في بلاد المسلمين من أحداث وأزمات تتنافى مع معتقدهم ودينهم، وتتجافى مع مصالحهم، وهي مسؤولية كبرى تقع على عاتق كلّ مسلم، فليس من التديّن أن يقف المسلم من هذه الأحداث موقف المتفرّج واللامبالي أمام الأزمات، التي تدمّر الأُمّة وتسحق كرامتها وتُفسد مصالحها، مذكّراً إياهم بأحاديث جدّه المصطفى عليها السلام، حينما أعلن هذه المسؤولية على كلّ فرد من أفراد المجتمع، حيث قال عليها السلام: «كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيّته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤولٌ عنهم، والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها ووِلْده وهي مسؤولةٌ عنهم…»[99]. فكلّ مَن يشهد الشهادتين مسؤولٌ أمام الله في رعاية مجتمعه، والسهر على مصالح بلاده، والدفاع عن أُمّته، وعلى ضوء هذه المسؤولية ناهض سيّد شباب أهل الجنة جَوْر الأُمويين المستبدّين، وناجز مخطّطاتهم التي أرادوا بها استعباد الأُمّة وإذلالها، ونهب خيراتها، فقد ألقى الحجّة في عنق تلك الأُمّة، بل جعلها كلمةً تصدح إلى فناء الدنيا بقوله عليه السلام: «أيّها الناس، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مَن رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحُرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدخله مدخله. ألا وإِنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر»[100].
تحرير اقتصاد الأُمّة
انهار اقتصاد الأُمّة الإسلامية في عصر الأُمويين، وخصوصاً في عهد يزيد، فقد عمد الأُمويون بشكلٍ سافر إلى نهب الخزينة المركزية والاستئثار بالفيء، وجميع ثمرات الفتوح والغنائم، فجمعوا التراث العريض، وتكدّست في بيوتهم الأموال الجمّة، ولا عجب في ذلك، فأبوه معاوية قد أعلن أمام ناظر المسلمين أنّ المال مال الله، وليس لأحد من المسلمين حقّ فيه، فقد بذّروها في المجون والمنكرات، حتى امتلأت بيوتهم بالمغنّيات وأدوات اللهو، وما خروج سبط النبي إلّا لفضح تلك السياسة المستبدّة، حيث كشف زيف آل أُميّة وسرقتها لبيت مال المسلمين.
إماتة البدع
عمد طغاة بني أُميّة إلى إذاعة البِدع بين المسلمين كانتشار النار في الهشيم، ولم يكن مبتغاهم من ذلك إلّا محق الإسلام، وإلحاق الهزيمة به، حتى أنّ الإمام الحسين عليه السلام كشف هذه الحقيقة أمام الملأ، كما في رسالةٍ بعثها عليه السلام إلى أهل البصرة يقول فيها:
«…وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله، فإنّ السنّة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أُحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدِكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله»[101]. فالإمام الحسين عليه السلام يؤسّس محاور في النظام الاجتماعي السياسي للمسلمين وللبشرية، حيث يقوم هذا النظام على أُسس رصينة، منطلقها كتاب الله وسنّة نبيه محمد عليها السلام، والعدل والقسط، وهو متمسّك بهذه المبادئ في صراعه مع بني أُميّة [102].
تحرير إرادة الأُمّة
لم تمتلك الأُمّة في عهد معاوية وولده المشؤوم يزيد إرادتها واختيارها، فقد كُبّلت بقيود ثقيلة، حالت بينها وبين إرادتها، ثمّ إنّها صارت كالجثّة الهامدة، فقد عمد طغاة بني أُميّة على تدمير الحركة الفكرية عند المسلمين، فلا وعي ولا اختيار، فأصبحوا أذلّاء صاغرين تحت وطأة سياط الأُمويين وحرّ سيوفهم، فقد أذاقوا الأُمّة الويلات، وجرّعوها حرّ النار والحديد، فكان الكثير منهم معلّق القلب بسبط النبي الأكرم عليها السلام، إلّا أنّهم لا يتمكّنون من متابعة قلوبهم وضمائرهم، فقد استولت عليها حكومة الأُمويين بالقهر؛ ولذا نضا ثوب الحياة ابن أمير المؤمنين، ليُطعم المسلمين بروح العزّة والكرامة، فكانت شهادته نقطة تحوّل في تاريخ المسلمين وحياتهم، فانقلبوا رأساً على عقب، فتسلحّوا بقوّة العزم والتصميم، وتحرّروا من جميع السلبيات التي كانت مُلمّة بهم، وانقلبت مفاهيم الخوف والخنوع التي كانت جاثمة عليهم إلى مبادئ الثورة والنضال، فهبّوا متضامنين في ثورات مكثّفة، وكان شعارهم (يا لثارات الحسين!)، فكان هذا الشعار هو الصرخة المدوّية التي دكّت عروش الأُمويين وأزالت سلطانهم[103].
إحياء عزّة الأُمّة وكرامتها
إنّ من أبرز السبل الوقائية التي كشف عنها منهج سيّد الشهداء إحياء عزّة الأُمّة الإسلامية، وإعادة كرامتها إليها، فهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانية، ورسم طريق الشرف والعزّة، فلم يخنع، ولم يخضع، فها هو يصـرّح لأخيه محمد بن الحنفية مجسّداً ذلك الإباء بقوله عليه السلام: «يا أخي، والله، لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى، لما بايعت يزيد بن معاوية»[104]. وآثر الموت تحت ظلال الأسنّة على العيش ذليلاً مسلوب الإرادة، فوقف صارخاً بوجه جحافل الشـر والظلم قائلاً عليه السلام: «والله، لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أُقرّ إقرار العبيد… إنّي عذت بربّي وربّكم أن ترجمون»[105]. لقد تجلّت صورة الثائر المسلم بأبهى صورها وأكملها في إباء الإمام الحسين عليه السلام، يقول ابن أبي الحديد بهذا الصدد وهو يصف سيّد شباب أهل الجنة عليه السلام: «سيّد أهل الإباء الذي علَّم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف اختياراً له على الدنية، أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليها السلام، عُرِض عليه الأمان وأصحابه، فأنف من الذلّ، وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان إن لم يقتله، فاختار الموت على ذلك»[106]، فنادى قائلاً: «ما أهون الموت على سبيل نيل العزّ وإحياء الحق، ليس الموت في سبيل العزّ إلّا حياة خالدة، وليست الحياة مع الذلّ إلّا الموت الذي لا حياة معه»[107]؛ لذا وصفه المؤرِّخ الشهير اليعقوبي بأنّه شديد العزّة[108]، وكيف لا! وكلامه يوم الطف يكشف عن أسمى مواقف العزّة لأصحاب المبادئ والقيم وحملة الرسالات، وهو يصوّر العزة والمنعة والاعتداد بالنفس فيقول عليه السلام: «ألَا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلة، وهيهات منّا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وجدودٌ طابت وحجورٌ طهُرت، ونفوس حميّة، وأُنوف أبيّة لا تُؤثِر طاعة اللئام على مصارع الكرام…»[109]. وبذلك يستذكر الإمام عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى: (وَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)[110]. فيأبى الله له الذلّ وهو سيّد المؤمنين في زمنه، وتأبى له نفسه العظيمة التي ورثت عزّ النبوة أن يقرّ على الضيم، لذلك يعلّمنا الإمام الحسين عليه السلام هذه القيمة التربوية، أي: كيف يكون العزّ والإباء، والحفاظ على كرامة الإنسان، وكيف تكون التضحية من أجل الرسالة.
القسم الثاني: المرحلة التنفيذية
وكانت الشهادة من أجلّ السبل لقطع روافد هذا الداء والقضاء عليه، إذ لم يُقدِم الإمام على الثورة إلّا بعد أن انسدّت أمامه جميع الوسائل، وانقطع كلّ أملٍ له في إصلاح الأُمّة، وإنقاذها من السلوك في المنعطفات، فأيقن أنّه لا طريق للإصلاح إلّا بالتضحية الحمراء، فهي وحدها التي تتغيّر بها الحياة، وترتفع راية الحقّ عالية في الأرض.
ولأجل هذه الغاية النبيلة فجّر تلك الثورة الخالدة، فهو لم يخرج أشراً ولا بطراً، ولم يبغِ أيّ مصلحة مادية له أو لأُسرته، وإنّما كان هدف خروجه خروجاً على حكم الظلم والطغيان، يريد أن يُشيّد صروح العدل بين الناس [111]، ولعلّ مقولته الرائعة تفصح عمّا يطلب سبط النبي صلى الله عليه وآله: «فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أوْلى بالحقّ، ومَن ردّ عليَّ أصبر حتى يقضـيَ الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين»، فهو يُفصح أنّ غاية خروجه لم تكن إلّا من أجل إحقاق الحقّ وإماتة الباطل، ودعا الأُمّة باسم الحق إلى الالتفاف حوله؛ لتحمي حقوقها وتصون كرامتها وعزّتها التي انهارت على أيدي الأُمويين، وإذا لم تستجب لنصرته فسيواصل وحده مسيرته النضالية بصبرٍ وثبات في مناجزة الظالمين والمعتدين، حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحقّ وهو خير الحاكمين [112].
وهو بذلك الخطاب كان «يريد أن ينتشل الأُمة من جمودها، ويحرّكها للثورة ضدّ الكيان الأُموي الجاثم على السلطة، ولا بدّ له من تضحية، ولا بد من دم شريف يُراق؛ ليحدث الانقلاب في نفوس القوم الذين خذلوا قضيّته وما زالوا يخذلون!»[113].
ولم يكن خروج ابن رسول الله عليها السلام عبثياً غير مدروس، بل كان عليه السلام مدركاً بعمق وشمول جميع جوانب أبعاد الثورة، فدرسها بعمق وشمول، «وخطّط أساليبها بوعي وإيمان، فرأى أن يزجّ بجميع ثقله في المعركة، ويُضحّي بكل شيء لإنقاذ الأُمّة من محنتها في ظل ذلك الحكم الأسود الذي تنكَّر لجميع متطلّبات الأُمّة. وقد أدرك المستشـرق الألماني ماريين تخطيط الإمام الحسين لثورته، فاعتبر أنّ الحسين قد توخّى النصر منذ اللحظة الأُولى، وعلم النصـر فيه، فحركة الحسين في خروجه على يزيد ـ كما يقول ـ إنّما كانت عزمة قلب كبير عزّ عليه الإذعان، وعزّ عليه النصـر العاجل، فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ به النصر الآجل بعد موته، ويحيي به قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة»[114]. وقد أيقن سيّد الشهداء عليه السلام أنّه لا يمكن القضاء على جذور الطغيان والظلم إلّا بفخامة ما يقدّمه من التضحيات، فصمّم بعزمٍ وإيمان على تقديم أروع التضحيات، ومن جملة هذه التضحيات[115]:
1ـ تضحيته بنفسه الطاهرة
فقد أذاع عليه السلام في مكّة عن عزمه على التضحية بنفسه، بعد أن قام خطيباً، فحمد الله تعالى ثمّ قال: «خُطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصـرعٌ أنا لاقيه، كأنّي وأوصالي يتقطّعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملأنّ منّي أكراشاً جوفاً، وأجربةً سغباً، لا محيص عن يوم خُطّ بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفّينا أُجور الصابرين، لن تشذّ على رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّ بهم عينه، وينجز بهم وعده، مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل، فإنّي راحلٌ مصبحاً إن شاء الله»[116] .
«وكان في أثناء مسيرته إلى العراق يتحدّث عن مصرعه، ويشابه بينه وبين أخيه يحيى ابن زكريا، وأنّ رأسه الشريف سوف يُرفع إلى بغي من بغايا بني أُمية كما رُفِع رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل… وقد كان في تلك المحنة الحازبة من أربط الناس جأشاً، وأمضاهم جناناً»[117] ، حينما أحاطت به جحافل الجيوش الهائلة، وهي تبيد أهل بيته وأصحابه في مجزرةٍ رهيبة، اهتزّ من هولها الضمير الإنساني، «فلم يُرَ قبله ولا بعده شبيهاً له في شدّة بأسه، وقوّة عزيمته، كما لا يعرف التاريخ في جميع مراحله تضحيةً أبلغ أثراً في حياة الناس من تضحيته عليه السلام، فقد بقيت صرخة مدوّية في وجوه الطغاة الظالمين والمستبدّين»[118] .
2ـ التضحية بأهل بيته
لم يُقدّم أيّ مصلح اجتماعي في الأرض ما قدّمه الإمام الحسين عليه السلام، «فقد قدّم أبناءه وأهل بيته وأصحابه فداءً؛ لما يرتأيه ضميره من تعميم العدل، وإشاعة الحقّ والخير بين الناس… فكان يشاهد الصفوة من أصحابه الذين هم من أنبل مَن عرفتهم الإنسانية في ولائهم للحق، وهم يتسابقون إلى المنيّة بين يديه، ويرى الكواكب من أهل بيته وأبنائه، وهم في غضارة العمر وريعان الشباب، وقد تناهبت أشلاءهم السيوف والرماح، فكان يأمرهم بالثبات والخلود إلى الصبر قائلاً: صبراً يا بني عمومتي، صبراً يا أهل بيتي، لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً. واهتزّت الدنيا من هول هذه التضحية التي تُمثّل شرف العقيدة، وسمو القصد، وعظمة المبادئ التي ناضل من أجلها، وهي ـ من دون شك ـ ستبقى قائمة على مرّ القرون والأجيال، تُضـيء للناس الطريق، وتمدّهم بأروع الدروس عن التضحية في سبيل الحق والواجب» [119].
ونحن نرى اليوم فتيةً جعلوا من الحسين عليه السلام قدوةً وشعاراً في الذود عن بيضة الإسلام من خطر أُمويي العصر (الدواعش)، فهم يتسابقون إلى المنيّة، قد رووا الأرض من نحورهم، يرون أنّ الموت سعادة والحياة مع الظالمين إلّا شقاءً وبرماً.
3ـ حمل بنات الوحي والنبوة
وقد أظهر سيّد شباب أهل الجنة عليه السلام عن حنكته وسداد ما خطّط له في ثورته الكبرى، من حيث حمله لبنات النبوّة ومخدّرات الرسالة إلى كربلاء، وهو على يقين بما سيحدث عليهنّ من النكبات والخطوب، ناظراًَ إلى دور تلك المخدّرات المشرق في إكمال نهضته المباركة، فأيقظنَ المجتمع بعد سباته، وأسقطنَ هيبة الحكم الأُموي، وفتحنَ باب الثورة عليه، ولولاهنّ لم يتمكّن أحد أن يتفوّه بكلمة واحدة أمام ذلك الطغيان الفاجر، وقد أدرك ذلك كلّ مَن تأمّل في نهضة الإمام ودرس أبعادها[120].
وما أحوج الأُمّة، وسط هذا الظلام الأُموي وهذه الفتنة العمياء إلى موقف حسيني يبدّد الظلمات، موقف لا يتحدّث عن الحقّ وإنّما يفعله، وما أحوج الأُمّة الإسلامية والبشرية كلّها إلى هذا النور المتوهّج؛ لتبقى شمس الحسين تهدي الحائرين، وتدلّ السائلين على الحدود الفاصلة بين الحقّ والباطل، بين مرضاة الله وسخطه، هكذا كان منهج الحسين، لم يكن حالة انفعالية نشأت أشراً أو بطراً، ولا كانت حركة إلى المجهول أملتها أجواء رسائل البيعة المشكوك في صدقها، بل كانت ـ منذ البدء ـ فعلاً مدروساً ومخطّطاً سديداً في علاج الطغيان والطغاة.
الخاتمة والنتائج
في خاتمة المطاف أحمد الله تعالى على آلائه حمداً كثيراً إذ وفّقني لإتمام هذا البحث، ومكّنني بعد هذا المرور المتأنّي الراصد في (منهج الإمام الحسين عليه السلام في علاج الطغيان.. يزيد بن معاوية أُنموذجاً)، وقد استخلصتُ مجموعة من النتائج:
1 ـ إنّ المصدر الذي استقى منه الحسين عليه السلام منهجه في علاج الطغيان هو القرآن الكريم، وسنّة جدّه المصطفى عليها السلام، والتي قام عليها بناء الدين المشيد.
2ـ إنّ سُبل علاج الطغيان مرتبطة واحدة بالأُخرى؛ إذ ليس من الصواب الاهتمام بسبيل من السبل العلاجية وإهمال السبل الأُخرى؛ وذلك لأنّ كلّ واحدة منها تكمّل الأُخرى، وهذا التداخل فيما بينها يجعلها تشكّل كتلة واحدة، فتحرير إرادة الأُمّة، وإشاعة العدل بين أفرادها، والوقوف بوجه الظالم الطاغي، بحاجة إلى الشجاعة والحكمة والعِزّة، فضلاً عن الحفاظ على كرامة الأُمّة ومعتقداتها، إذ لا بدّ لها من التضحية والشجاعة، والتي قد يكون طريقها الشهادة، وهكذا تتداخل هذه السبل العلاجية فيما بينها لتشكّل المنهج الرصين في زلزلة عروش الطغاة والقضاء على حكمهم المستبد.
3 ـ ما لاحظه الباحث في ضوء نتائج البحث أنّ المنهج العلاجي الذي اتّخذه الإمام الحسين عليه السلام كيانٌ مترابط الأجزاء، تتشابك فيه العقيدة مع العبادات، والأخيرة مع الأخلاق، والكلّ يعطينا تلك الثمرة الطيبة التي هي الإنسان، وبالنتيجة المجتمع الإسلامي الفاضل، فمثلاً: الزكاة عبادة اجتماعية، لا يخفى دورها في دعم بنيان المجتمع الاجتماعي والاقتصادي من خلال ما تزوّد به بيت مال المسلمين، ومن خلال معاني المحبّة والتكافل التي تبثّها بين الأغنياء والفقراء، وقِس على ذلك بقية الفرائض.
تحدّث القرآن الكريم عن الطغيان بوصفه ظاهرة بعيداً عن ذكر أسماء الطغاة وتواريخهم، أو الأمكنة التي ظهروا فيها، ومن ذلك نجد أنّ القرآن فصّل في وصف مثال واحد فقط وهو فرعون؛ باعتبار أنّ الطغيان واحد، سواء في طريقة تفكير الطغاة، أو الأساليب التي يتوسّلون بها .
أفصح القرآن الكريم أنّ الدوافع التي تدفع الحاكم إلى الطغيان، منها دوافع ذاتية نفسية ترجع إلى الحاكم، كعدم الإيمان بالله تعالى، والتكبّر والغرور، والحقد وغير ذلك، وأُخرى خارجية، منها: تملّق البطانة ونفاقها، وتقبّل الرعية للظلم والطغيان، وفساد المؤسّسة العسكرية.
إنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتضحيته جفّفت منابع الطغيان، وقطعت روافده من خلال غرس قيمة الشهادة والتضحية بالنفس، فقد مثّل سيّد الشهداء عليه السلام التضحية بكلّ أنواعها أعظم تمثيل، فلقد ضحّى بالنفس والمال والأهل والبنون في سبيل الله، وخضوعاً لأمر الله، فها هي أُمّ سلمة تحذّره من الذهاب إلى كربلاء؛ خشية موته، فيجيبها عليه السلام قائلاً : «يا أُمّاه، قد شاء الله عز وجل أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين، وأطفالي مذبوحين مظلومين، مأسورين مقيّدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً»[121].
كما أنّ لسان حاله عليه السلام يوم الطف ينادي: إن كان دين محمد لا يستقيم إلّا بقتلي فيا سيوف خُذيني. فهل هناك تصريح بالتضحية في سبيل الله أكثر من ذلك، ومن هذا نجد الإمام الحسين عليه السلام كان مستعدّاً للتضحية بنفسه في سبيل المبادئ التي يحملها قبل أن تقوم واقعة كربلاء، وليس كما يصوّره البعض بأنّه أخطأ من الناحية التكتيكية، كما يُسمّى بالمصطلح العسكري؛ وذلك لأنّ الإمام الحسين عليه السلام على يقين من نبل مبادئه ومصداقيتها؛ لذا سعى بالتضحية بحياته من أجل تلك المبادئ والقيم، «وقد سُئل الفيلسوف الإنكليزي برنارد رسل: هل أنت مستعدّ للتضحية بحياتك من أجل أفكارك؟ قال: لا؛ لأنّي على يقين من حياتي، ولكنّي لست على يقين من أفكاري»[122].
4ـ لقد تبنّى الإمام الحسين عليه السلام الحقّ بجميع رحابه ومفاهيمه، واندفع إلى ساحات النضال؛ ليُقيم الحقّ في ربوع الأُمّة الإسلامية، ويُنقذها من التيارات العنيفة التي خلقت في أجوائها قواعد للباطل، وخلايا للظلم، وأوكار للطغيان، تركتها تتردّى في مجاهيل سحيقة من هذه الحياة، فرأى الإمام عليه السلام أنّ الأُمّة قد غمرتها الأباطيل والأضاليل، ولم يعُد ماثلاً في حياتها أيّ مفهوم من مفاهيم الحق، فانبرى عليه السلام إلى ميادين التضحية والفداء ليرفع راية الحق، وقد أعلن عليه السلام هذا الهدف في خطابه الذي ألقاه أمام أصحابه قائلاً: «ألَا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله…»[123]. ويقول عليه السلام في النتائج التي يؤدّي إليها التهاون في أداء هذا الواجب، وهو الدعوة إلى الحقّ والعمل به: «وما سلبتم ذلك إلّا بتفرّقكم عن الحقّ، واختلافكم في السنّة بعد البيّنة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أُمور الله عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم، وأسلمتم أُمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات، ويسيرون في الشهوات، سلّطهم على ذلك فراركم من الموت، وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء في أيديهم، فمن بين مستعبدٍ مقهور، وبين مستضعفٍ على معيشته مغلوب، يتقلّبون في الملك بآرائهم، ويستشعرون الخزي بأهوائهم»[124].
5ـ إنّ منهج الإمام الحسين عليه السلام في عدم سكوته على الحاكم المستبدّ كان قد دعا إلى ضرورة مطالبة الإنسان بحقّه في الحرية بكافّة أشكالها وألوانها سواء إن كانت حرية شخصية أو فكرية أو اجتماعية منذ مئات السنين، ومارسها بشكل عمليّ لدرجة أنّه ضحّى بكلّ ما لديه من أجل أن لا ينال من حرّيته أحد، في حين يتصوّر البعض أنّ المطالبة بهذا الحق هو من إنجازات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (1)، والتي تجد جذورها في الثورة الفرنسية (1798م)، وكأنّ هذا المبدأ الذي يُشكّل قيمة أساسية في حياة الإنسان قد بدأ مع الإعلان المذكور، والذي أُقرّ عام (1948م)، وقد تجاوز هذا الإجحاف حدّه إلى درجة أنّ المستشرق (روز نتال) زعم بأنّ المسلمين في العصر الوسيط ما كانوا يملكون مفهوماً للحرية الإنسانية وما شابهها للمفهوم الإغريقي[125].
التوصيات
في ضوء ما توصّلت إليه من استنتاجات أُورد التوصيات الآتية:
1ـ تبنّي واضعي المناهج الدراسية وخاصّة تلك المتعلّقة بترسيخ القيم التربوية، التي أبرزتها النهضة الحسينية، ومحاولة تثبيتها في نفوس الطلبة من خلال طرح الموضوعات التي تؤكّدها، ومن المستحسن اقتباس بعض النصوص التي صدرت عن الإمام الحسين عليه السلام، ووضعها شعارات داخل هذه المناهج، أو تظمينها محتوى في بعض المقرّرات الدراسية في المراحل الدراسية المختلفة.
2ـ على الباحثين الاهتمام بإحياء نفائس التراث المتعلّق بالإمام الحسين عليه السلام، التي تغيب عن أذهان الكثيرين في هذا العصر، فالاهتمام بهذا الجانب مسؤولية كلّ مربٍّ؛ لإبراز دور تراثنا ومدى فضله على المسلمين.
3ـ الدعوة لعقد الندوات، والمؤتمرات، والحلقات النقاشية، التي يُسهم فيها الأساتذة والطلبة لمناقشة القيم الإسلامية التي ثار من أجلها سيّد الشهداء عليه السلام بشكل عام، ودور الثورة الحسينية في إحياء و إعلاء هذه القيم بشكل فعلي، وتضمين جوانب من حياة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام.
4ـ تفعيل دور المثقّف والباحث الإسلامي في نشر ثقافة الإصلاح، ومكافحة طغيان الفساد الذي يهدّ اقتصاد الأُمّة.
فهرست المصادر
* القرآن الكريم.
الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت548هـ)، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان، مطبعة منشورات دار النعمان للطباعة والنشر، 1386هـ/ 1966م، النجف الأشرف.
الاستكبار والاستضعاف من وجهة نظر القرآن الكريم ، محمد تقي رهبر ، ط1، منظمة الإعلام الإسلامي، 1407هـ/1987م، طهران.
الإمامة والسياسة، أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت286هـ)، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني، الناشر: مؤسّسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي، ط2، دار إحياء التراث العربي، 2005م ، بيروت.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر بن محمد تقي المجلسـي (ت1111هـ)، تحقيق: محمد تقي اليزدي، ومحمد باقر البهبودي، ط3، دار إحياء التراث العربي، 1983م.
بحوث معاصرة في الساحة الدولية، الشيخ محمّد السند، ط1، مطبعة ستارة ، الناشر: مركز الأبحاث العقائدية، 1428هـ.
البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت774هـ)، دار أحياء التراث، 1408هـ، بيروت.
بطلة كربلاء زينب بنت علي، عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت1998م)، دار المعارف، 1971م، مصر.
تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين محمد مرتضى الزبيدي (ت1205هــ)، تحقيق: علي شيري، مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414هـ/1994م، بيروت.
تاريخ الخلفاء السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، ط1، المطبعة ـ فتح ـ جدة، الناشر دار المعرفة، 1365هـ.
تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (ت284هـ)، منشورات أهل البيت، قم.
التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (460هـ) ، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع، 2010م، بيروت.
التفسير الكبير، فخر الدين محمد بن عمر التميمي المعروف بالفخر الرازي (ت606 هـ)، ط1، دار الكتب العلمية، 1421هـ/2000م، بيروت.
تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن عبد الجبار السمعاني (ت489هـ)، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط1، دار الوطن، 1418هـ/1997م، الرياض ـ السعودية.
التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية (ت1400هـ)، ط4، مطبعة أُسوة، دار الكتاب الإسلامي،1421هـ.
التفسير المبين، محمد جواد مغنية (ت1400هـ)، دار الكتاب الإسلامي، ط2، مطبعة ستارة،1402هـ/2000م، قم.
تلخيص البيان في مجازات القرآن، محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (الشريف الرضي) (ت406هـ)، تحقيق: عبد الغني حسن، ط2، دار الأضواء، 1986م، بيروت.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، تحقيق: صدقي جميل العطار، طبع ونشر دار الفكر، 1415هـ، بيروت.
جوامع الجامع، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، 1418هـ، قم.
الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن الثعالبي (ت875هـ)، ط1، مؤسّسة الأعلمي، 1977م، بيروت ـ لبنان.
حقوق الإنسان والفكر الإسلامي المعاصر، مجلّة العربي، رضوان السيد، الكويت، 2001م.
حياة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، باقر شريف القرشي (ت1433هـ)، ط1، دار البلاغة، 1993م، بيروت.
دستور للأُمّة من القرآن والسنّة، عبد الناصر توفيق العطار، ط1، مؤسّسة البستاني للطباعة، 1416هـ/1995م، القاهرة.
زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت597هـ)، المكتبة الإسلامية، ط3، 1404هـ، بيروت ـ لبنان.
شرح نهج البلاغة ، عز الدين عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي (ت655هـ)، دار أحياء التراث العربي، 1385هـ، القاهرة.
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن أسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: مصطفى الزين، ط3، بيروت، دار ابن كثير، 1987م.
صحيح مسلم بشرح النووي، النووي (ت676 هـ)، ط2، دار الكتاب العربي، 1407هـ، بيروت.
العمل الإسلامي منطلقاته، السيد محمد تقي المدرسي، ط2، دار القارئ، 2008م، بيروت.
العمل وحقوق العامل في الإسلام، تحقيق: جعفر مرتضى الحسيني، دار التبليغ الإسلامي، 1978م.
العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ط2، دار الهجرة، 1409هـ، إيران.
فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)، محمد بن علي الشوكاني (ت1250هــ)، دار الفكر، 1983م، بيروت.
الكامل في التاريخ ، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (637هـ)، دار أحياء التراث، 1404هـ، بيروت.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، ط2، دار إحياء التراث العربي، 2001م، بيروت.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،:علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت975هـ)، مؤسّسة الرسالة، 1979م، بيروت.
لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت711 هـ) ، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مراجعة: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط1، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 1424هـ/2002م، بيروت.
لقد شيعني الحسين عليه السلام، إدريس الحسيني المغربي، ط1، مطبعة مهر، الناشر منشورات أنوار الهدى، الاعتصام للطباعة والنشر، 1415هـ.
لواعج الأشجان في مقتل الحسين عليه السلام، السيد محسن الأمين العاملي (ت1371هـ)، مطبعة العرفان صيدا، الناشر منشورات مكتبة بصيرتي،1331هـ، قم.
مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)، تحقيق: لجنة من العلماء والمحقِّقين الاختصاصيين، ط1، الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1415هـ، بيروت.
محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط1، دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م، بيروت.
مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي (ت345هـ)، دار الأندلس، 1983م، بيروت.
معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق ابراهيم الزجاج، شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط1، عالم الكتب، 1408هـ/1988م، بيروت.
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط1، دار إحياء الكتاب العربي، 1366هـ، القاهرة.
مفردات غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الإصفهاني (ت502هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط4، دار القلم، دمشق، 1425هـ.
المقنعة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت413هـ)، ط2، منشورات دار المفيد للطباعة والنشر، 1414هــ، بيروت.
من قصص السابقين، صلاح عبد الفتاح، ط2، دار المفيد للطباعة والنشـر والتوزيع، 1414هـ/1993م، بيروت ـ لبنان.
موسوعة العلوم السياسية، محمد محمود ربيع، مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي، 1994م، الكويت.
________________________________________
[1] جامعة الكوفة/كلّية التربية.
[2] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص304.
[3] البقرة: آية127.
[4] آل عمران: آية8.
[5] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج4، ص435.
[6] الحاقة: آية11.
[7] ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص412.
[8] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص7.
[9] النحاس، أحمد بن محمد، معاني القرآن: ج1، ص269.
[10] اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص444.
[11] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج1، ص135. الزجاج، إبراهيم، معاني القرآن وإعرابه: ج5، ص96. السمعاني، منصور بن محمد، تفسير القرآن: ج6، ص149. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج9، ص465. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف: ج2، ص407.
[12] الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج9، ص465.
[13] الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القران: ج10، ص368.
[14] الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج2، ص71.
[15] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير: ج1، ص36. الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير: ج2، ص482.
[16] الثعالبي، عبد الرحمن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ج1، ص551.
[17] اُنظر: البروجردي، حسين، تفسير الصراط المستقيم: ج4، ص317. مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف: ج4، ص138.
[18] ربيع، محمد محمود، موسوعة العلوم السياسية: ج1، ص294.
[19] الحاقة: آية11.
[20] اُنظر: الراغب الإصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص304.
[21] الحاقة: آية5.
[22] الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف: ج4، ص602.
[23] طه: آية24.
[24] طه: آية43.
[25] الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج31، ص40.
[26] الفجر: آية10ـ13.
[27] اُنظر: القاسمي، جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل: ج9، ص 469.
[28] النبأ: آية21ـ22.
[29] اُنظر: القاسمي، جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل: ج9، ص 391.
[30] البقرة: آية15.
[31] اُنظر: الرضي، محمد بن الحسين ، تلخيص البيان في مجازات القرآن: ص114.
[32] اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج1، ص109.
[33] البقرة: آية16.
[34] اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج1، ص111.
[35] الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه: ج1، ص91.
[36] طه: آية81 .
[37] الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف: ج3، ص80.
[38] الرحمن: آية8.
[39] اُنظر: القاسمي، جمال الدين، محاسن التأويل: ج9، ص101. الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه: ج5، ص96.
[40] البقرة: آية15.
[41] طه: آية24.
[42] طه: آية43.
[43] الحاقة: آية11.
[44] هود: آية112.
[45] طه: آية81 .
[46] الزمر: آية72.
[47] المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال: ج3، ص528.
[48] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج73، ص156.
[49] القصص: آية4 .
[50] القصص: آية39.
[51] اُنظر: الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج3، ص134.
[52] النساء: آية54.
[53] المائدة: آية64.
[54] المؤمنون: آية37 .
[55] القصص: آية39ـ40.
[56] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص34.
[57] مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مجلّة تراثنا: العددان الثاني والثالث (50ـ51)، ص205.
[58] الخالدي، صلاح عبد الفتاح، من قصص السابقين: ص107.
[59] القرشي، باقر شريف، العمل وحقوق العامل في الإسلام: ص20.
[60] المدرسي، محمد تقي، العمل الإسلامي (منطلقاته وأهدافه): ج2، ص607.
[61] البقرة: آية285.
[62] الطبرسي، الفضل بن الحسن، جوامع الجامع: ج1، ص237. مغنية، محمد جواد، التفسير المبين: ص54. اُنظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل: ج2، ص268.
[63] المائدة: آية20 .
[64] اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، جوامع الجامع: ج1، ص237ـ 238.
[65] آل عمران: آية26 .
[66] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص131.
[67] آل عمران: آية 178.
[68] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص80.
[69] بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، بطلة كربلاء: ص176ـ177.
[70] المائدة: آية22.
[71] الزخرف: آية54.
[72] رهبر، محمد تقي، الاستكبار والاستضعاف: ص56.
[73] العطار، عبد الناصر، دستور للأُمّة من القرآن والسنّة: ص200.
[74] الأعراف: آية127.
[75] هود: آية96ـ 98.
[76] الشعراء: آية34ـ 38.
[77] الأعراف: آية103.
[78] يونس: آية75.
[79] المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج3، ص77 .
[80] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص368. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص307.
[81] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص317ـ318.
[82] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص186.
[83] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، البداية والنهاية: ج8، ص225.
[84] المصدر السابق: ج8، ص238.
[85] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص310ـ315.
[86] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص372.
[87] اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص250ـ251.
[88] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص209ـ213.
[89] المصدر السابق: ج1، ص216.
[90] السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء: ص209.
[91] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص371. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص311.
[92] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص209.
[93] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص316.
[94] اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص251.
[95] آل عمران: آية110.
[96] المفيد، محمد بن محمد، المقنعة: ص808.
[97] المصدر السابق: ص809.
[98] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص330.
[99] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج6، ص152. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج6، ص8. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنور: ج72، ص39.
[100] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص304.
[101] المصدر السابق: ص266.
[102] اُنظر: السند، محمد، بحوث معاصرة في الساحة الدولية: ص230.
[103] اُنظر: القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين عليه السلام: ج2، ص278.
[104] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنـوار: ج44، ص329.
[105] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص323.
[106] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج1، ص249.
[107] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم عليه السلام، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ص436.
[108] اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص293.
[109] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ج1، ص603.
[110] المنافقون:آية8.
[111] اُنظر: القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين عليه السلام: ج2، ص265.
[112] اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص265ـ266.
[113] الحسيني، إدريس، لقد شيّعني الحسين: ص297ـ 298.
[114] القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين عليه السلام: ج2، ص294.
[115] اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص296 ـ300.
[116] ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص29 .
[117] القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين عليه السلام: ج2، ص295.
[118] المصدر السابق.
[119] المصدر السابق: ج2، ص296.
[120] اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص297.
[121] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص331.
[122] أبو زينة، إيمان، التضحية من أجل الوطن (مقال في صحيفة الوطن السورية)، شبكة المعلومات العنكبوتية.
[123] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص307.
[124] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج97، ص80.
[125] السيد، رضوان، حقوق الإنسان والفكر الإسلامي المعاصر، مجلّة العربي، الكويت، 2001: ص154.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبياء
http://warithanbia.com/?id=1301
لینک کوتاه
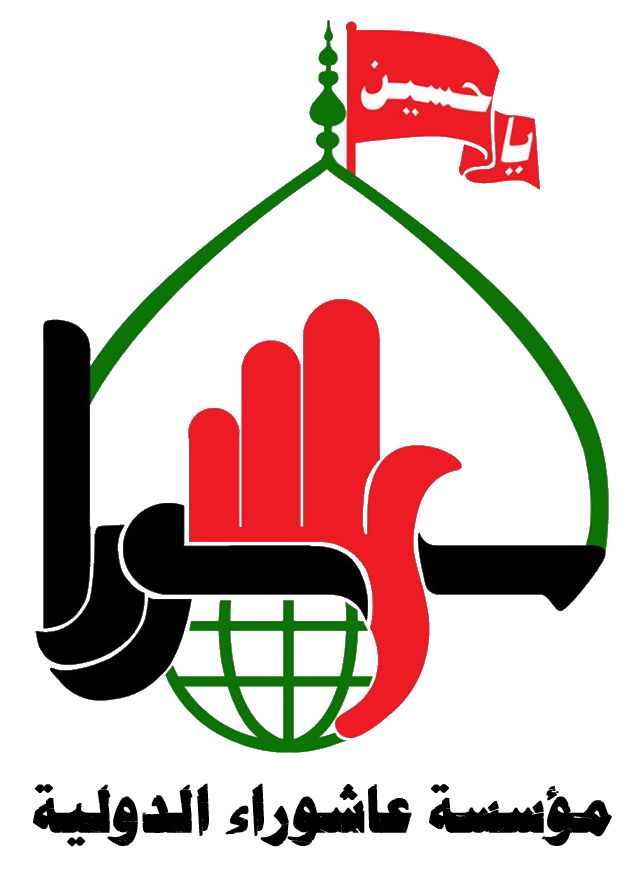
سوالات و نظرات