مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية وتعزيزها في المنهج المدرسي.. دراسة استقرائية ـ نظرة معاصرة
{ أ. د. صباح حسن عبد الزبيدي }
المبحث الأول: مدخل عام
مشكلة الدراسة[1]
إنّ من أهم ما أكّد عليه الأنبياء والمرسلون وأهل البيت عليهم السلام هو إصلاح أحوال الناس في كافة مجالات الحياة (السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والأخلاقية، والتربوية)، وذلك بالقضاء على الفساد بكلّ أشكاله، وهذا ما أكّد عليه القرآن الكريم: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)[2].
وفي ضوء ما تقدم ورد الإصلاح في عدة معانٍ، ومنها: القضاء على الفساد بكل أشكاله (الإداري والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقضائي والأخلاقي والتربوي)؛ وبذلك كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار عليهم السلام علامة بارزة في تاريخ الإنسانية في التضحية والفداء في سبيل إصلاح العباد والدين، ورفعة مبادئ الدين الإسلامي الحنيف؛ ولكي يبقى الدين والأُمّة الإسلامية خالية من التدهور والفساد والانحطاط، ولكي يعيش الإنسان المسلم بصورة خاصة والإنسانية بصورة عامة في الأرض بحرية وكرامة، وأن يسود المجتمع العدالة الإلهية الحقة بعيداً عن الذل والهوان والتكفير والغلو والتطرف والإرهاب.
وبناءً على ما تقدّم؛ كان للثورة الحسينية معنى كبير في إصلاح العباد استناداً إلى قول الإمام الحسين عليه السلام: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدي صلى الله عليه وآله، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب…»[3].
وعليه؛ فإنّ الإصلاح أصبح ضرورة أساسية للقضاء على الفساد بكلّ أشكاله،
لا سيما ونحن بأمسّ الحاجة إلى إصلاح الإنسان فكراً وعقلاً ومنطقاً وأخلاقاً، وكذلك مؤسّساتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية التي تغذّي الجيل، وتربِّيه تربية صالحة لخلق المواطن الصالح والمواطنة الصالحة، ومجتمع يسوده العدالة والحرية والديمقراطية (مجتمع النزاهة والشفافية)؛ كي يساهم في بناء الحضارة الإنسانية
أهمّية الدراسة
إنّ الأُمّة الإسلامية اليوم تعيش في ظلام دامس بسب الفوضى والاضطرابات والقلق، فهي بحاجة إلى الإصلاح، ولا يتمّ الإصلاح إلّا بالرجوع إلى كتاب الله وسنّة نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار عليهم السلام؛ وذلك استناداً إلى قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله: «إنّي مخلِّف فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»[4].
1 ـ إنّ الإمام الحسين عليه السلام أصبح مصباح الهدى وسفينة النجاة، فالإمام الحسين عليه السلام أقام الدين وحفظ الشريعة، فلولاه لما كانت هناك صلاة اليوم ولا صيام ولا حج بيت الله الحرام، لأنّ بني أُميّة كانوا على وشك القضاء على الدين، ولكن الإمام الحسين عليه السلام حفظه بدمه ودماء أهل بيته عليهم السلام، كما يفعل اليوم حشدنا المقدّس ضدّ (الدواعش) الذين نشروا الفساد وقتلوا الأبرياء بدم بارد.
2 ـ إنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام أفرزت قيماً أخلاقية للأجيال القادمة والأُمم والشعوب المضطهدة فهي ثورة ليست محلّية، بل هي ثورة عالمية تدعو للإصلاح ضد الظلم والجور والعبودية من خلال: (الحرية، والعدل، والمساواة، والدمقراطية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنزاهة والشفافية لمحاربة الفساد السياسي والاجتماعي والإداري والمالي والأخلاقي والتربوي…).
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1ـ ما مضمون الاستقراء، أو الطريقة الاستقرائية؟
2ـ ما مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية في ضوء الطريقة الاستقرائية؟
3ـ ما مضمون حركة الإصلاح للنهضة الحسينية في ضوء النظرة المعاصرة؟
4ـ ما أساليب تعزيز مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية في المنهج المدرسي؟
حدود الدراسة
تقتصر حدود الدراسة على:
1ـ الأدبيات التي تناولت حركة الإصلاح في كافة مجالات الحياه المنشورة في الأدبيات المختلفة.
2ـ الأدبيات التي تناولت معركة الطف الخالدة من جميع جوانبها الأدبية والعلمية والتربوية.
تحديد المصطلحات الآتية
أولاً: الحركة: (movement)
وتُعرّف بـأنّها:
1ـ التغيّر المتصل، وقد تكون في «الكم أو الكيف أو المكان أو الوضع، ويقصد بالحركة من الناحية الاجتماعية التغيرات الشديدة التي تحدث في أحد أو بعض ميادين النشاط الإنساني»[5].
2ـ ويمكن تعريفها إجرائياً بالتغيّرات التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام بعد معركة الطف الخالدة عام (61هـ) في إحداث تغيّرات في بنية المجتمع العربي والإسلامي بحركة إصلاحية تهدف إلى إزالة الفساد بكلّ أشكاله الذي أصاب المجتمع العربي والإسلامي آنذاك.
ثانياً: الإصلاح: (Reform)
ويُعرّف بعدة تعاريف، منها:
1ـ تعديل غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون مساس بأُسسها.
2ـ تحسين في النظام السياسي أو الاجتماعي القائم، دون المساس بأُسس هذا النظام.
3ـ تحسين في الأنماط الاجتماعية، مع التأكيد على الوظيفة لا على البنيان.
وتهدف حركة الإصلاح إلى إزالة المساوئ دون التغيّر في الأوضاع الأساسية النفسية للمجتمع[6].
ويمكن تعريفها بأنها تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية بهدف إصلاح بنية المجتمع العربي والإسلامي من الفساد بكلّ أشكاله آنذاك.
ثالثاً: النهضة الحسينية
وهي الثورة التي فجّرها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار عليهم السلام في معركة الطف الخالدة عام (61هـ) التي أدّت إلى إيقاظ النفوس وتحريك إرادة الأُمّة بعد هلاك معاوية، ومقاومة تسلّط يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي فرض نفسه على الأُمّة الإسلامية خليفة، والذي لم يكن مؤهّلاً للخلافة، بل فاقد لكلّ شروط القيادة، وفاسد ومنحرف؛ ممّا جعل الإمام الحسين عليه السلام أن يُعلن ثورته من المدينة المنوّرة إلى العراق في كربلاء، ووقعت معركة الطف في العاشر من محرّم عام (61هـ) التي كانت بحقّ ثورة بين الحق والباطل، وبين الإيمان كلّه والكفر كلّه، ورفع شعار الثورة والشهادة التي قَدِم عليها الإمام الحسين عليه السلام، وقدّم حياته وأصحابه قرابين للدين الإسلامي، ودماء أهل بيته وصحبه الأبرار الذين فاق عددهم على السبعين شهيداً[7].
رابعاً: التعزيز: (Reinforcement)
ويُعرّف بعدّة تعاريف:
1ـ وهي عملية إرضاء أو مكافأة أو دافع يعمل لخلق الاستجابة[8].
2ـ عرّفه إبراهيم نوفل بأنّه: عملية لزيادة السلوك المعزز وتقويته، وبالتالي إجراء تعليم باتّباع وسائل وطرق معينة متنوعة مرتبطة بالسلوك المراد تعزيزه وتقويته[9].
3ـ ويُعرّف إجرائياً بأنّه: إدخال مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية في ضوء طريقة الاستقراء وبنظرة معاصرة في المنهج المدرسي مستقبلاً.
خامساً: المنهج المدرسي
ويُعرّف المنهج بأنّه:
1ـ وثيقه تربوية مكتوبة تصف أهداف التعلّم التي ستعمل المدرسة على تحقيقيها لدى التلاميذ مع ما يناسبها من المعارف والخبرات والأنشطة التربوية والتعليمية[10].
2ـ مجموعة من الخبرات التربوية والاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفنية والعلمية التي تخطّطها المدرسة وتقدّمها للطلبة داخل المدرسة وخارجها، بقصد تعديل سلوكهم وبناء شخصيتهم المتكاملة (العقلية، الجسمية، المهارية، الوجدانية، الاجتماعية) طبقاً للفلسفة التربوية التي تريدها الدولة والمجتمع[11].
سادساً: الاستقراء: (induaction)
ويُعرّف بعدّة تعاريف:
أ ـ الاستقراء: هو تتبّع الجزئيات للتوصل إلى حكم كلي أو الوصول عن طريق الملاحظة من الخاص إلى العام، وتكوّن القوانين أو المبادئ.
ب ـ الاستقراء: هو أُسلوب المحاكمة الفكرية الذي يؤدّي إلى الانتقال من الوقائع إلى التعميمات[12].
ج ـ الاستقراء: وهو عملية عقلية يقوم بها الناقد عندما يكتشف الوحدات المتشابهات في النص التي عن طريقها يستطيع الوصول إلى حكم عام عن النص[13].
د ـ الاستقراء: (طريقة الاستقرائية): وهي العملية التي ينتقل فيها الفرد بتفكيره من الخاص إلى العام، ويتمّ استخلاص مبادئ وقواعد عامة من الجزئيات والحالات الفردية، وتكوين مصطلحات وتعميمات مبنية على أمثلة متعددة من الحقائق[14].
منهجية البحث
استخدام الطريقة الوصفية التحليلية (الاستقرائية) للأدبيات التي تتناول الثورة الحسينية، ومن ثمّ استنباط مؤشرات تفيد الدراسة.
المبحث الثاني
يتناول هذا المبحث ثمانية محاور، وهي:
المحور الأول: الاستقراء من حيث المفهوم، والمصطلح، والفلسفة
1ـ مفهوم الاستقراء: وهي كلمة لاتينية الأصل وتدلّ على تفحّص البلاد قرية فقرية، فهي استخلاص أو استنباط الأساليب للاستدلال، والاستقراء.
2ـ الاستقراء في اللغة: التتبّع والتفحّص، أي: تفحّص الأمثلة والحوادث الجزئية والبحث عن وجود الشبه والاختلاف للوصول إلى الأحكام العامّة من مفاهيم وقواعد ونظريات من خلال المقارنة والاستنباط والقياس.
3ـ الاستقراء: وهي العملية التي ينتقل فيها الفرد بتفكيره من الخاص إلى العام، ويتمّ استخلاص مبادئ وقواعد عامة من الجزئيات والحالات الفردية وتكوين مصطلحات وتعميمات مبنية على أمثلة متعددة من الحقائق.
4ـ الاستقراء (طريقة تدريسية): وهي دراسة الجزئيات للوصول إلى حكم كلي يشملها جميعها، أي: الوصول من الأمثلة إلى التعريف[15].
5ـ الاستقراء: عملية عقلية يقوم بها الناقد عندما يكتشف الوحدات المتشابهات في النص، عن طريقها يستطيع الوصول إلى حكم عام من النص، فعن طريقة (الاستقراء) يستطيع الانتقال من الحكم على الأثر الأدبي إلى المبادئ العامة التي تحكم مجموعة من الآثار الأدبية العامة[16].
6ـ الاستقراء (طريقة تدريسية): وهي عملية فحص أمثلة ومعلومات، ثمّ محاولة الوصول إلى قاعدة عامّة، وتُسمّى الطريقة الاستقرائية (طريقة تحليل) لأنّها تحلّل الكلّ إلى إجزاء[17].
7ـ الاستقراء: عملية منطقية يُحاكم فيها الإنسان متنقلاً من الخاص إلى العام[18].
8 ـ المعنى الفلسفي للاستقراء: هو العملية التي ينتقل بها الذهن من عدد معيّن من القضايا المفردة أو الخاصة. وقد عرّفه قديماً (أرسطو) بقوله: «إنّه الانتقال من الحالات الجزئية إلى الكلية الذي ينظّمها».
أهمّية الاستقراء
تكمن أهمّية الاستقراء من خلال ما يلي:
1ـ معرفة الجزئيات للحوادث لأجل الوصول إلى القواعد العامة، أي: تجميع الوقائع، ثمّ الإيصال إلى القانون الذي ينظّمها.
2ـ إنّ استخدام منهج الاستقراء له مزايا تربوية عديدة، فهو يتيح للطالب فرصة المشاهدة والملاحظة واكتشاف الحقائق تدريجياً من الجزء إلى الكلّ.
3ـ يُعوّد الطالب على تطبيق ما توصّل إليه في مواقف وأمثلة جدّية؛ ممّا ينمِّي لديه مهارات التفكير السليم من دقّة الملاحظة والتأنّي في الاستقراء والاستنباط.
4ـ يُعدّ الاستقراء وسيلة مناسبة في التدريس، حيث إنّها تمكِّن الطالب على مزاولة النشاط والعمل والاعتماد على النفس والتعويد على الصبر وزيادة الثقة بالنفس.
5ـ يساعد الاستقراء على زيادة الانتباه ممّا يُبعد الذهن عن الشرود والملل والتشتت.
6ـ يساعد الاستقراء الطالب في إصدار حكم كلي بالاعتماد على الملاحظة حول قضية ما.
وعليه؛ فإنّ للاستقراء أهمّية كبرى في مناهج البحوث العلمية؛ إذ يتوقّف عليه تأليف القواعد العلمية العامة والتوصّل إليها، فعالم الفيزياء مثلاً لا يستطيع أن يتوصّل إلى قواعد عامة في علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر لأجل إعطاء قواعده العامّة؛ وبذلك فالاستقراء يزوّدنا بالقواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العملية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات[19].
المحور الثاني: طبيعة الاستقراء في المنهج المدرسي
من المعلوم أنّ المنهج يعني مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المؤسسة التعليمية للطلاب، سواء داخلها أو خارجها، بقصد مساعدتهم على النمو الشامل والمتكامل، أي: النمو في كافة جوانب الشخصية (العقلية، الجسمية، الاجتماعية، النفسية، الفنية، البيئية)، نمواً يؤدِّي إلى تعديل سلوكهم، ويكفل تفاعلهم بنجاح مع بيئتهم ومجتمعهم وابتكارهم بما هو حولهم، وبما يواجههم من مشكلات، وللمناهج عدّة أنواع[20].
ومن الواضح أنّ المناهج العراقية هي التي تقرّرها وزارة التربية والتعليم، من خلال المقرّرات الدراسية والمصادق عليها رسمياً، والتي تؤلّف على شكل كُتُب مدرسية رسمية تُدرَّس في المدارس.
اتجاهات بناء المناهج الدراسية في العالم
توجد ثلاثة اتجاهات، وهي:
الاتجاه الأول: يرى أنّ المتعلّم (الطالب)، هو محور بناء المناهج، فهو يأخذ من المتعلّم قدراته وميوله وخبراته السابقة أساساً في بناء واختيار محتوى المنهاج التربوي وتطبيقه، وهذا الأساس يمثِّل الأساس النفسـي للمنهاج.
الاتجاه الثاني: يرى أنّ (المعرفة/المعلومة) هي محور بناء المنهاج، فهي الغاية التي لا يمثّلها شيء في الأهمّية، حيث كافة الجهود تصبّ لأجل المعلومة في عقول المتعلّمين بصورة تقليدية؛ ممّا يجعل مهمة المدرِّس تقتصر على نقل المعرفة من الكتب إلى عقول الطلبة، وهذا الاتجاه يمثِّل الأساس الفلسفي المعرفي للمنهج.
الاتجاه الثالث: يرى أنّ (المجتمع) هو محور بناء المنهاج، وهذا الاتجاه يركّز على ما يريده المجتمع، ويمثِّل الأساس الفلسفي والاجتماعي للمنهاج[21].
أهمية المناهج الدراسية في العالم
قام الباحث باستنباط عدة مؤشّرات لأهمية المناهج التربوية في الوقت الحاضر وعرضها بالشكل الآتي:
1ـ تنشر المفاهيم والأفكار التي ترتبط بالمجتمع المدني، ولا سيما مفهوم التسامح، الحوار، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، احترام الآخر، حوار الحضارات، صراع الحضارات، السلام العالمي، التربية المدنية، العالمية، العولمة، الإرهاب، التكفير، التعايش السلمي، وغير ذلك.
2ـ تُبرز أهمّية بناء الإنسان وتنميته وفق متغيّرات العصر؛ وذلك لمعرفة حركة المجتمع والتغير في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي، وأُسلوب إدارة هذه الأزمات، وطرق تطوير الشعوب والمجتمعات.
3ـ تغرس القيم والمفاهيم الإنسانية والثقافية والفكرية والآيديولوجية؛ كونها وسيلة العلم وأداة في تحقيق أهدافه وترجمة ذلك في خلق التنمية الشاملة، ومن هذه القيم (الهوية الوطنية ـ الثقافية) في نفوس الناشئة لأجل إكسابهم المعارف والقيم والمهارات ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، ومحبّين لوطنهم، ومعتزّين بتاريخه وحضارته، وتوسيع اختياراتهم الفردية والاجتماعية.
4ـ توعية المتعلّمين بالأحداث والتطورات العلمية التي تحدث في بعض الدول، والقضايا والمشكلات، بدءاً من غزو الفضاء، وانتشار نقص المناعة (الإيدز)، وانتشار المخدرات، والإدمان، وتلوّث البيئة، وتآكل طبقة الأوزن، وانتشار الأمراض الجديدة مثل: جنون البقر، وأنفلونزا الطيور، والحروب الجرثومية، والعنف، والطائفية…
5ـ توعية المتعلّمين لتجنّب الأمراض الاجتماعية التي ظهرت في الساحة العالمية ومنها الأمراض الاجتماعية المغلّفة باسم الدين، وهي التطرّف والغلو، وأزمة المواطنة، والهوية والفساد بكل أشكاله[22].
خصائص المناهج التربوية الناجحة
يُمثّل المنهج بأنّه مجموعة من الخبرات المربية التي ينبغي أن يعكس وظيفة المؤسسة التعليمية في مستوى التعليم، أي: المستوى التعليمي لكافة مراحل الدراسة وبذلك تكون خصائصها هي:
1ـ الشمولية: أي أنّ المنهج التربوي يحتوي على جميع الخبرات التربوية التي يحتاجها المتعلّمون.
2ـ التكاملية: أي أنّ المنهج التربوي يحتوي على جميع أنواع المعرفة، القيم الأخلاقية، المهارات؛ لكي يكون متكاملاً.
3ـ الموضوعية: أي أنّ المنهج التربوي يحتوي على مشكلات المجتمع المرتبطة بواقع المجتمع وبشكل موضوعات (مشكلات) يمكن أن يتناولها أصحاب الاختصاص، وتمثّل محورين، هما: الأُفقي (س) يمثل المراحل الدراسية، والمحور العمودي (ص) يمثل موضوعات التخصّص.
4ـ المستقبلية: أي أنّ المناهج التربوية ذات اتجاه مستقبلي في الموضوعات ومستجدات تواكب العصر.
5ـ التطبيقية: أي أنّ المناهج التربوية لها القدرة على تطبيق المفاهيم والأفكار التي تظهر على الساحة العالمية[23].
وصف المناهج الدراسية العراقية
وذلك من خلال الدراسات التحليلية كما أشارت إليها عدة دراسات، وقد قام الباحث باستنباطها وعرضها بالشكل الآتي:
1ـ إنّ المناهج التربوية الحالية تلقينية أكثر من أنّها تحفيزية، ليس لها من دور للطالب في التفاعل.
2ـ إنّها لا تهتم ببناء الطالب وتطويره وفق قدراته الفكرية الفردية والاجتماعية، وإنّما تجعل الطالب متلقّياً سلبياً.
3ـ إنّ مادتها وطريقة عرضها لا تعمل على بناء السلوك الجماعي والمشاركة الجماعية، بل تتجه نحو السلوك الفردي.
4ـ إنّها لا تُنمّي عند الطلبة الاهتمام بالقضايا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ لذلك نقول: إنّ المجتمع العراقي اليوم يواجه تحدّيات وإشكاليات وأزمات قيمية ومفاهيمية أخذت تنخر في جسمه، كالجهل والتخلّف والفقر والعنف والطائفية والإرهاب والتكفير، فإذا لم نجد مناهج تربوية تساهم في التوعية لإبعاد اليأس والإحباط والفشل لا يمكن أن نبني مفهوم المواطنة الصالحة، وهي دولة القانون والمؤسسات التي تعتمد على التوعية والإحاطة التامة بما يجرى من حولنا[24].
طرق تضمين المناهج التربوية مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية المقترحة
هناك عدّة طرق وأساليب في إدخال وتضمين المناهج التربوية، وقد قام الباحث بدرجها بالشكل الآتي:
1ـ أُسلوب الاندماج: أي إدماج موضوعات ومفاهيم وأفكار معيّنة في المناهج التربوية، وهذا الأُنموذج أو الطريقة هي تقليدية حيث تحتوي الكثير من المناهج على موضوعات مندمجة وربطها بالمحتوى الدراسي على شكل (قضايا)، وأن تكون هذه الموضوعات تراعي تحقيق أهداف التربية، ويُعتبر هذا الأُسلوب الأشهر، حيث يربط المعلّم خصائص العلوم بالبيئة كما يراها؛ وبذلك يُتيح الفرصة لممارسة الأنشطة ذات الصلة بالبيئة.
2ـ أُسلوب الوحدات الدراسية: أي تضمين المناهج التربوية على شكل وحدات، وتكون الوحدة على شكل (مشكلة اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو فكرية) يتم إدخالها في المناهج الدراسية، مثل العلوم والاجتماعيات، وخير مثال على ذلك على الوحدات الدراسية في المناهج الدراسية التي تُمثّل حركة الإصلاح للنهضة الحسينية بالمفردات الآتية: (الإيمان، التقوى، العفو، العدل، الإحسان، العبادة، البر، الصبر، إطاعة الله، الأمر بالمعروف، عمل الصالح…)، في ضوء الطريقة الاستقرائية أو حركة الإصلاح للنهضة الحسينية في ضوء النظرة المعاصرة: (النزاهة، الشفافية، التسامح، التعايش السلمي، الولاء، الانتماء، الحقوق، الواجبات، الحرية، الديمقراطية، العدالة، وقبول الآخر…).
3ـ أُسلوب المستقل: أي تعد مساقات دراسية بصورة مستقلة لموضوع دراسي مستقل يُدرس كمنهج دراسي مستقل، وهذا يناسب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على اعتبار هذا المساق غير معني بالتفرّعات، كفروع المعرفة والعمق، وينظرون إلى المشكلة بنظرة تكاملية، هذا الأُسلوب منتشر في دول محدّدة.
4ـ الأسلوب المتكامل: وهو الأُسلوب الذي يتضمن إعداد وحدات مرجعية قائمة على الخبرة تتكامل فيها مواد دراسية عدة، ومنها مبدأ التأمّل بين فروع المعرفة في إطار الأُسلوب في المدخل السياسي، الاجتماعي، الديني، القانوني، وبذلك يُحقق التأمّل المعرفي، المادة العلمية، بحيث تغطّي فروعاً متعددة.
وفي ضوء ما تقدّم يمكن استخدام (أُسلوب الوحدات الدراسية)، وهو أفضل مثال في إدخال موضوع مفردات حركة الإصلاح الحسيني بالطريقة الاستقرائية أو بالنظرة المعاصرة في هذه الدراسة الحالية الذي يُعدّ هو الأنسب في إدخاله مفردات حركة الإصلاح الحسيني؛ لأنّه يغرس ويُنمّي لدى التلاميذ والطلبة (حركة الإصلاح للنهضة الحسينية) بالجانب النظري والجانب التطبيقي؛ لمعرفةي دور المناهج والطلبة والمدرِّس عند التعامل مع هذه المفردات مستقبلاً[25].
المحور الثالث: مضمون الإصلاح من حيث اللغة والمصطلح
أولاً: الإصلاح (Reform) من حيث اللغة
تتفق معاجم اللغة على أنّ الصلاح ضد الفساد[26]، وقال ابن منظور في لسان العرب مادة (صلح): «الصّلاح: ضدّ الفساد؛ صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً… ورجل صالح في نفسه… وقد أصلحه الله»[27].
ثانياً: الإصلاح من حيث المصطلح
أ ـ تقويم المعوج، وإزالة الفساد، وإقامة العدل، وإرادة الخير والاستقامة.
ب ـ القضاء على الفساد في الأجهزة الحكوميّة والمتناقضات في أهداف المؤسسات المختلفة ونظمها.
ج ـ نقيض الإفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه. والصلح: تصالح القوم بينهم. والصلح: السلم. والصِّلاح بكسر الصاد: مصدر المصالحة.
د ـ تقويم وتغيير وتحسين[28].
هـ ـ الإصلاح الاجتماعي: مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى إعادة التنظيم للمؤسسات الاجتماعية للوصول إلى مستوى أفضل من العدالة الاجتماعية.
ومن الملاحظ أن الإصلاح نقيض الفساد، ومن المعلوم أن معاجم اللغة العربية تناولت معنى الفساد، حيث أشار صاحب لسان العرب في مادة (ف، س، د): «الفساد: نقيض الإصلاح. فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُدَ فَساداً وفُسُوداً ، فهو فاسدٌ وفَسِيدٌ فيهما »[29]، وقوله تعالى: (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[30].
وكذلك يعني الفساد: البطلان والاضمحلال، فيقال: أيضاً فسد الشيء، أي: بطل واضمحل. وأفسد فلان المال. ويقال: فسد الشيء، أي: بطل واضمحل، كما في قوله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )[31].
ومن المعلوم أنّ الفساد ظاهرة ليست محصورة في دائرة أو وزارة أو حكومة أو دولة، بل أصبحت منتشرة حتى في الدول المتقدمة والدول النامية، على الرغم من وجود مؤسسات مثل هيئات النزاهة، ووجود الإعلام الحر والشفافية والقوانين التي تعمل على مكافحة الفساد.
وعليه؛ قد تنوّعت مصادره وآيديولوجياته التي تناولت مفهوم الفساد ضمن الإطار العام، وفي ضوء ما تقدّم، قام الباحث باستنباط مفهوم الفساد من الأدبيات، وهي:
1ـ الفساد: هو انحراف الأخلاق للمسؤولين في الحكومة والإدارة.
2ـ الفساد: هو التنازل عن أملاك الدولة من أجل مصالح شخصية.
3ـ الفساد: يعني التصرّفات التي يقوم بها المواطنون القياديّون في الدولة للحصول
على مزايا شخصية، مثال على ذلك (التحايل، وغسيل الأموال، والاتّجار بالمخدرات، والتعامل بالسوق السوداء).
4ـ الفساد: هو إجبار الموظّف بعمل مباشر أو غير مباشر بإجبار صاحب الحاجة بدفع ما يُسمّى هدايا عينية أو نقدية بشكل غير قانوني في سبيل إنجاز معاملته.
ويرى الباحث أنّ الفساد من حيث اللغة والاصطلاح قد ورد في القرآن الكريم بما يقارب عن (50) مرة[32].
المحور الرابع: الإصلاح في القرآن الكريم (المفهوم الإيجابي)
من المعلوم أنّ القرآن الكريم هو منهج كامل للحياة يرشد الإنسان إلى طريق الهداية والإيمان والحق، وفي ضوء ما تقدّم، ورد مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم في آيات عديدة ويقترن هذا المفهوم الإيجابي بعدد من المفاهيم الأُخرى مثل: (الإيمان، التقوى، العفو، العدل، الإحسان، العبادة، البر، الصبر، التوبة، إطاعة الله، الأمر بالمعروف، العمل الصالح…).
وقد قام الباحث بعرض مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم:
1ـ (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)[33].
2ـ (يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)[34].
3ـ (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)[35].
4ـ ( إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)[36].
5ـ (وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)[37].
6ـ (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖإِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[38].
7ـ (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّـهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّـهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)[39].
8 ـ (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّـهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[40].
المحور الخامس : الإصلاح في القرآن الكريم (القضاء على الفساد)
الإصلاح في القرآن الكريم: بمعنى القضاء على الفساد بكل أشكاله: (السحر، المخادعة، الهلاك، الكفر، الطغيان، الفتنة والغلو، الفاحشة، البغي، الغلو، المنكر، الإسراف، الظلم، السرقة، البخس، الكنز… إلخ)، وهي:
1ـ (فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)[41].
2ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)[42].
3ـ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)[43].
4ـ (وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)[44].
5ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)[45].
6ـ (مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ * ِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)[46].
7ـ (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)[47].
8ـ (وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ[48].
9ـ (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّـهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ)[49].
10ـ ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّـهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[50].
11ـ (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّـهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّـهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[51].
12ـ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّـهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّـهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)[52].
13ـ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[53].
14ـ ) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ([54].
15ـ (يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)[55].
المحور السادس: حركة الإصلاح ومجالاتها
لقد قام الباحث بعرض مجالات حركة الإصلاح في الحياة العامة وعرضها بالشكل الآتي:
أولاً: حركة الإصلاح في المجال السياسي
إنّ التغييرات السياسية التي حدثت في العراق منذ الثمانينات ولحد الآن، والتي تشمل الحروب والحصار الاقتصادي والأزمات والإرهاب وعدم الاستقرار والهجرة وغيرها، أثّرت تأثيراً عميقاً في الإنسان العراقي؛ وبذلك يكون الإصلاح السياسي ضرورة أساسية في الحياه السياسية في المجتمع العراقي.
ويرى الباحث أنّ الفساد السياسي يظهر في الزعماء والقيادات العليا في الدولة، فهو سلوك منحرف يخالف القواعد والأحكام التي تنظم النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة من خلال التسلّط على القوانين والتشريع والتنفيذ والقضاء، وبالتالي انعدام الديمقراطية وفقدان المشاركة، وانتعاش المحسوبية وفقدان الرقابة الشعبية.
ثانياً: حركة الإصلاح في المجال الاجتماعي
«ويهدف الإصلاح الاجتماعي إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون والعدالة في توزيع أعباء الإنفاق العام، وإشراك المجتمع في المسؤولية السياسية والتمتّع بالحريات الأساسية»[56].
فالإصلاح الاجتماعي حركةٌ عامّة تحاول القضاء على المساوئ التي تنشأ عن خلل في الوظائف أو النسق الاجتماعي أو أي جانب فيه. ويُستخدم هذا المصطلح لإزالة الفساد الحكومي.
ويرى الكاتب أنّ الفساد الاجتماعي يظهر في كبار المسؤولين من الناحية الأخلاقية، ومنها: (شبكات الرق، ومافيا الأطفال)، وهي الأعمال اللاأخلاقية اجتماعياً؛ لذا فهو بمجمله انحراف أخلاقي متعلق بسلوك الموظّف وتصرّفاته بأعمال مخلّة بالحياة العامّة وفي أماكن العمل، أو يجمع بين الوظيفة وأعمال خارجية دون إذن؛ فيستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة العامّة، أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمّى بـ(المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة والخبرة.
ثالثاً: حركة الإصلاح في المجال الإداري
إنّ الواقع المؤلم والمرير للمجتمع في ظل هذه الأوضاع السيّئة التي عاشها العراق فيما مضى، أدّى إلى نشوء معوّقات ومشكلات تقف بوجه تطوير المجتمع ومؤسساته الإدارية. ولكي يتحقق الإصلاح في أيّ مؤسسة؛ لا بدّ من أن يكون هناك دافع قوي للتغيير نحو الإصلاح يساهم في بناء الإنسان العراقي ومؤسساته الإدارية التي تقف بوجه تقدّمه وهو الفساد الإداري بكل أشكاله.
ويرى الباحث أنّ الفساد الإداري يظهر في الانحرافات الإدارية في الوظيفية والتنظيمية، ويشمل (الرشوة، المحاباة، المحسوبية، الاحتيال)، وبذلك تصدر عن الموظّف العام أثناء تأدّيته لمهام وظيفيته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسدّ الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين؛ وبذلك يغتنم الفرصة للاستفادة من هذه الفرص على صنع القرار.
فالفساد الإداري: هو نشاط يتم داخل الجهاز الإداري القومي، والذي يؤدِّي بالموظف الحكومي إلى أن يتصرّف لصالح أهداف شخصية، سواء متجددة أو مستمرة. أو أسلوب فردي أو جماعي منظّم؛ لذا فهو انعدام للقيم الأخلاقية بسبب انعدام الأُسس والقواعد والضوابط التي تحكم السلوك سوى ضبط واحد وهو تحقيق الربح والمحصلة الأنانية والفائدة لشخصية أو فئة من الناس بغضّ النظر عن النتائج التي تترتب على الآخرين وصالحهم.
رابعاً: حركة الإصلاح في المجال الأخلاقي
من المعلوم أنّ الإصلاح يرتبط بدافع ديني وضمير إنساني وواجب وطني أساسه الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة التي يعمل فيها، سواء أكانت في مستوى يؤهلها لبناء مجتمع متحضر ومتطور أم لا.
ويرى الباحث أنّ الفساد الأخلاقي يظهر في المتعلق بسلوك الموظّف وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلّة بالحياء العام في أماكن العمل، أو الجمع بين الوظيفية وأعمال خارجية، أو استعمال السلطة لتحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة العامة، أو يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي في التعيين دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والمهنية والجدارة؛ لذا نقول: إنّ غياب الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة يجعل الفساد ينعكس في كلّ مفاصل الحياة؛ حيث عدم تطبيق مبادئ الشفافية في الأداء الوظيفي يساهم في نشر الفساد في كلّ مفاصل الحياة العامة، وبالتالي أنّ استخدام مبادئ الشفافية في المسائل والرقابة والتفتيش هو ضمان أداء هذه المؤسسات.
خامساً: حركة الإصلاح في المجال الاقتصادي
إنّ الدول الفقيرة انعدم فيها الازدهار والتطور، فقد عاشت البؤس والحرمان وانتشار المرض؛ وبذلك خلق هذا الوضع الاقتصادي صراعاً ما بين الدول الغنّية والدول الفقيرة، وأخذ يتّسع بينهما، وأخذ الشعب يطالب بالتغيّر والتعبير عن احتياجاته؛ ومن هنا ظهر الفكر المتطرّف.
يرى الباحث أنّ الفساد الاقتصادي يظهر في صفقات الأسلحة والجريمة المنظّمة مثل: (المخدرات، غسيل العملة، التهرّب من الضريبة، وصفقات المساعدات الإنسانية)؛ لذا فهو سلوك منحرف ومخالف للقواعد والأحكام المالية الذي تسير عليها المؤسسة الإدارية والمالية في الدولة، أي: مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية والخاص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة، ويشمل (الرشاوي، والاختلاس، والتهريب الضريبي، وتخصيص الأراضي، والمحاباة، والمحسوبية في التعيينات الوظيفية).
سادساً: حركة الإصلاح في المجال الديني
يقول السيد الطباطبائي في تفسير الميزان: «إنّ النبوّة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو الناس إلى العدل، وتمنعهم عن الظلم، وتندبهم إلى عبادة الله والتسليم له، وتنهاهم عن اتّباع الفراعنة الطاغين والنماردة المستكبرين المتغلبين، ولم تزل هذه الدعوة بين الأُمم منذ قرون متراكمة جيلاً بعد جيل، وأُمّة بعد أُمّة، وإن اختلفت بحسب السعة والضيق باختلاف الأُمم والأزمنة…»[57].
فالقرآن يساهم في استنهاض الناس على الامتناع عن طاعة الإفساد، والإباء عن الضيم، وإنبائه عن عواقب الظلم والفساد والعدوان والطغيان، وقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)[58]. وغيرها من الآيات.
سابعاً: حركة الإصلاح في المجال التربوي
من المعلوم أن ليس من السهل إعادة بناء الإنسان العراقي ما لم تكن هناك رغبة حقيقية وصادقة عند أصحاب القرار؛ وذلك بوضع خطط واضحة ومنهجية علمية تجعل من مخرجات التربية والتعليم تتميز بتفوّق الكم على النوع، وتحسين الأداء، ومهارات أداء الطالب والتدريسي، والمنهج والمؤسسة التعليمية بشكل عام، ولكن الذي يقف أمام ذلك هو الفساد التربوي ومنها الغش في الامتحانات، وتزوير الشهادات، واعتلاء المناصب الإدارية من قِبَل أشخاص غير مؤهّلين مهنياً وتربوياً، والتدريس الخصوصي، والمحسوبية، والفئوية، والقومية، والعشائرية…
إنّ مهنة التعليم تحتلّ مركزاً مهمّاً بين المهن الأُخرى وهي تستلزم الأمانة العلمية والعدالة في معاملة الطلاب بصرف النظر عن الاعتبارات الاجتماعية والمصالح الخاصة.
كذلك أنّ الوسائل الإلكترونية أهمّ تحدٍّ يواجه المؤسسات التعليمية في الدول النامية، وهو ما يؤكّد ضرورة توظيف التعليم الإلكتروني والتدريس الإلكتروني لتطوير الأداء التعليمي الجامعي.
إنّ الندوات والمؤتمرات الدولية حول التربية والتعليم في عصر المعلومات أكّدت أنّ التكنولوجيا الحديثة ليست بالضرورة هي العلاج لكل المشكلات، إلّا أنّها ترفع كفاءة وأداء المنظومات التربوية إن أُحسن استخدامها من قِبَل أُسرة التعليم.
ثامناً: حركة الإصلاح في المجال القانوني
ويرى الباحث أنّ الفساد القانوني يظهر في فساد رجال القانون بتحريف اللوائح القانونية لصالح جهة لغرض مصالح ومنافع شخصية، وهو سلوك منحرف يقوم به مَن يعمل في القانون والمحاكم، وتظهر ما يسمّى التلاعب بالألفاظ القانونية؛ وبذلك فإنّ الفساد يظهر في ظل قوانين معقدة وغير واضحة ومعرّضة للتغيّر باستمرار ومبالغ فيها، أي: معرضة دائماً للتغيّر والتعديل، أمّا التطبيق فقد يكون ضعيفاً ممّا يخلق أنظمة مزدوجة.
تاسعاً: حركة الإصلاح في المجال الوظيفي
ويرى الباحث أنّ الفساد الوظيفي يظهر في انتهاك الموظّف في واجباته الوظيفية التي تجعل المنفعة الشخصية هي الأساس على حساب المصلحة العامّة، ومن خصائص الفساد الوظيفي هي:
1ـ السرّية الشديدة في ممارسة الفساد وتحت جنح الظلام بطريقة تحايل وخديعة وتظليل.
2ـ إصدار قرارات محددة تخدم مصالحهم الشخصية أو الآخر.
3ـ إبعاد الشفافية والنزاهة في العمل من الوظيفية، أي: إبعاد المُساءلة والمراقبة والتدقيق[59].
المحور السابع: مفردات حركة الإصلاح بصورة عامة في ضوء الطريقة الاستقرائية للنهضة الحسينية
أولاً: الحرية
إنّ مفهوم الحرية هو أن يشعر الإنسان أنّه حرّ في تفكيره وفي ثقافته دون قيود، كما أراده الله سبحانه وتعالى حراً، إلّا أنّ الإنسان والمجتمع في زمن بني أُميّة أصبح يرزح تحت كابوس الظلم والجور والعبودية.
وبذلك خرج الإمام الحسين عليه السلام مُطالباً بحرية الإنسان والمجتمع، مخاطباً جيوش بني أُميّة قائلاً: «إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم»[60]. وكذلك قال عند استشهاد القائد الحر بن الرياحي: «ما أخطأت أُمّك إذ سمّتك حرّاً»[61]. ومثله قول مسلم بن عقيل عليه السلام: [62]
أقسمت لا أُقتل إلّا حرّاً وإن رأيت الموت شيئاً نكراً(4).
ثانياً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لقد ترجم الإمام الحسين عليه السلام في ثورته مبدأً عظيماً نادى بأعلى صوته ليصل لكل سامع، وهو: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، حيث قال: «أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».
وبذلك حددت الثورة الحسينية واحدة من أهم مبادئها، وهو: السير بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك بالرجوع إلى السنّة النبوية الشريفة التي أسّسها النبي محمد صلى الله عليه وآله.
فمن الدروس المهمة التي نتعلّمها من النهضة الحسينية، هي: المحافظة على الشريعة المقدّسة الذي أراد يزيد بن معاوية أن يحرّفها، ويتسلّط على رقاب المسلمين كخليفة لهم وهو شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة.
الدروس التربوية المستنبطة
1ـ ترك الصلاة: عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: «مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلّا بُعداً»[63]. لذا؛ على المؤمن أن يحافظ على صلاته لأنّها تُبعد الفحشاء والمنكر.
2ـ الإفطار المتعمّد في شهر رمضان: وهذا ما نراه اليوم في المدن من الجهر بالإفطار وأمام الصائمين.
3ـ الغزو الثقافي: وهو ما يُعدّ من مظاهر التمدّن والحضارة، كمحاربة الحجاب وتشويه صورته، وانتشار ميوعة الشباب في الملبس والموديلات، وغيرها ممّا يخالف الشرع المقدّس.
4ـ بيع الأشياء المحرّمة: كاللحوم المستوردة من البلدان الكافرة، والتعامل بالمعاملات الربوية في الأسواق، وبيع الأقراص اللاأخلاقية، والغش في الأسواق.
ثالثاً: إقامة الصلاة
لقد حثّ القرآن الكريم على الصلاة وأدائها في أوقاتها والتمسّك بها، فهي ذات أثر نافع في تصحيح سلوك الإنسان؛ وذلك لارتباطها بالله سبحانه وتعالى، وهي من فروع الدين التي يجب علينا أن نحافظ عليها ونتمسّك بها فوزاً بثواب الله سبحانه وتعالى ورضاه، يقول تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)[64]. وعن الرسول محمد صلى الله عليه وآله قال: «حافظوا على الصلوات الخمس، فإنّ الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو بالعبد، فأول شيء يسأل عنه الصلاة، فإن جاء بها تاماً وإلّا زخ في النار»[65].
الصلاة: هي صلة الإنسان بخالقه ودعاؤه وتسبيحه وشكره وطلب معونته ورضاه، فإن كانت الصلاة من الله تعالى على الإنسان فهي الرحمة له والثناء عليه، والصلاة عبادة يؤدّيها المسلم خمس مرات في اليوم وحسب شروطها وأوقاتها وفرائضها، يقول تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)[66]. وهي بذلك لها من الأهمّية البالغة في حياة المسلم الروحية والعقائدية والخُلقية والاجتماعية والتربوية، وهي خيرٌ دائمٌ للمصلي ونورٌ، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ)[67].لذا؛ فإنّ الصلاة تجلب للمصلي صفاء الفكر وانشراح النفس، فهي انقطاع إلى الله عن هموم الدنيا وأتعابها.
موانع الصلاة
من موانع قبول الصلاة، هي:
1ـ عقوق الوالدين: روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن نظر إلى أبويه نظر ماقتٍ وهما ظالمان له، لم يقبل الله له صلاة»[68].
2ـ الغيبة: روي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: «مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلّا أن يغفر له صاحبه»[69].
3ـ شرب الخمر: روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: «إنّ مَن شرب الخمر لم تُحسب صلاته أربعين صباحاً»[70].
وبعد أن حانت معركة الطف وحان موعد صلاة الظهر، وكان الجيش في حالة حرب، وكان الموت عنهم قاب قوسين أو أدنى، لم يغفل الإمام الحسين عليه السلام عن ذكر ربّه؛ لذلك أقام الصلاة وذلك إيماناً بالله تعالى وإخلاصاً في أداء فريضة الصلاة، وبذلك أمر الإمام الحسين عليه السلام بإقامة الصلاة، فتقدّم (سعيد بن عبد الله الحنفي) يقيه بنفسه أمام السهام والرماح، ولم يتزحزح من مكانه حتى اُثخن بالجراح، وهوى إلى الأرض يتخبّط بدمه.
رابعاً: النصيحة (نصح الأعداء)
عُرف الإمام الحسين عليه السلام بالتعامل الحسن حتى مع عدوّه، فقد كان يتحلّى بالرحمة والنقاء، وكان ينظر إلى معسكر الأعداء وهم ملء الصحراء فيبكي، فسألته أُخته الحوراء زينب عليها السلام: ممَ بكاؤك يا أبا عبد الله؟ فأجاب: أبكي لدخول هؤلاء النار بسببي. وبذلك نقول: إنّ الإمام الحسين عليه السلام يبكي على أعدائه الذين أضرموا النار في خيامه، وشتّتوا عياله وأطفاله.. إنّه لقلب كبير مملوء بالرحمة والشفقة.
وفي ضوء ما تقدّم، روي أنّ الإمام الحسين عليه السلام وضع عمامة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله على رأسه الشريف، وكذلك تقلّده بسيفه، ووضع الكتاب الشريف على رأسه، وبذلك سطعت الأنوار من وجهه الشريف كهيبة الأنبياء، وقد نصح الأعداء على عدم مقاتلته وأنّها فتنه يُراد بها سفك دماء المسلمين من أجل المنصب وتسلّط بني أُميّة على السلطة.
وتأسيساً على ما تقدم فقد نصح الأعداء بقوله عليه السلام: «تباً لكم أيّتها الجماعة وترحاً، أفحين استصرختمونا ولهين متحيّرين فأصرختكم مؤدين مستعدين؛ سللتم علينا سيفاً في رقابنا، وحششتم علينا نار الفتن خباها عدوّكم وعدوّنا، فأصبحتم إلباً على أوليائكم ويداً عليهم لأعدائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، إلّا الحرام من الدنيا أنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه… فهلا، لكم الويلات! إذ كرهتمونا وتركتمونا، تجهزتموها والسيف لم يُشهر، والجأش طامن، والرأي لم يستحصف، ولكن أسرعتم علينا كطيرة الدبى، وتداعيتم كتداعي الفراش، فقبحاً لكم، فإنّما أنتم من طواغيت الأُمة وشُذّاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرّفي الكتاب، ومُطفئي السنن…»[71].
وكذلك خاطب الناس أيضاً بقوله: «أيّها الناس، إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم، وقدمت عليَّ رسلكم أن أقدم علينا فليس لنا إمام لعل الله أن يجمعنا وإيّاكم على الهدى والحق. فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئنّ إليه من عهودكم ومواثيقكم، وإن لم تفعلوا، وكنتم لمقدمي كارهين، انصرفتُ عنكم إلى المكان الذي جئتُ منه إليكم»[72].
خامساً: الوفاء
الوفاء وفاء لكلٍّ من:
الوفاء للدِّين: حينما يتعرّض الإسلام للخطر من قِبل المعتدين الذين يتنكّرون المبادئ السامية للإسلام، ولأجل أن ترتفع راية الإسلام خافقة؛ لا بدّ للإنسان أن يكون وفياً للدين.
الوفاء للأُمّة: عندما تكون الأُمّة الإسلامية في حالة خطر ترزح تحت كابوس العبودية التي تتلاعب في ثرواتها ومقدراتها والاستهانة بحرماتها، لا بدّ من الوفاء لهذه الأُمّة وتحريرها من واقعها المرير.
الوفاء للوطن: عندما يكون الوطن معرضاً للانقسام من قِبل قوى الشر، لا بدّ لحُماة الوطن أن يقفوا بوجه هذا الانقسام؛ عند ذلك يظهر الوفاء للوطن.
الوفاء للإخاء: عندما يتعرّض الأخ إلى الاضطهاد، وعدم وجود الناصر، يظهر الجهاد المقدس، وقد وقف أبو الفضل العباس عليه السلام في نصرة أخيه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، والمدافع الأول عن حقوق المظلومين، ولم يرَ الناس على امتداد التاريخ مثل وفاء أبي الفضل العباس عليه السلام الذي أصبح مثلاً جاذباً لكل إنسان حر وشريف.
الوفاء للعمّ: عندما طلب الإمام الحسين عليه السلام النصرة ظهر القاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام يطلب الإذن من عمّه ليجاهد بين يديه في سبيل الله وهو شاب، وقد استُشهد بين يديه، فقال الإمام الحسين عليه السلام: «بُعداً لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك… عزَّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يُجيبك، أو أن يُجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك»[73].
الوفاء للأب: عندما طلب النصرة الإمام الحسين عليه السلام ظهر الابن علي الأكبر عليه السلام، وسمح له الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم لمقاتلة الأعداء، وبعد أن أبلى بلاءً حسناً في قتل الأعداء استُشهد علي الأكبر عليه السلام، فقال الإمام الحسين عليه السلام: «اللّهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلامٌ أشبه الناس خلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى وجهه، اللّهم امنعهم بركات الأرض، وفرّقهم تفريقاً، ومزّقهم تمزيقاً، واجعلهم طرائق قدداً، ولا ترضِ الولاة عنهم أبداً، فإنّهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا»[74].
وفاء الأُخت: لقد وقفت الأُخت العفيفة الحوراء زينب عليها السلام مع أخيها الحسين عليه السلام منذ أن خرجت من المدينة حتى استشهاده عليه السلام في كربلاء، وكذلك بعد استشهاده، أُختاً مواسية لأخيها الحسين عليه السلام، وقائمة بنشر ثورته المباركة في أرجاء المعمورة، وأصبحت القناة الإعلامية لهذه الثورة ومبادئ الإنسانية التي فجّرها أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار.
سادساً: الجهاد المقدس
إنّ محاربة أعداء الإسلام الذين يريدون قتل الأنفس وتلف الأموال والحرمات هو بمثابة التجارة الرابحة، التي دلّنا عليها ربّنا ربّ العزة بأن نُقدّم فيها (أموالنا وأنفسنا في ساحات الجهاد) في مقابل ثمن غفران الذنوب والمعاصي، وفي واقعة الطف، وقف الإمام الحسين وأخوه أبو الفضل العباس عليهما السلام أمام الأعداء في حفظ معالم الدين الإسلامي وبقاء الدين نبعاً صافياً، ولولا معركة الطف لما بقي من الإسلام شيء.
سابعاً: مسؤولية الإمام
لقد عرّف الإمام الرضا عليه السلام (الإمام) بأنّه: «أمين الله في أرضه، وحجّته على عباده، وخليفته في بلاده، الداعي إلى الله والذّاب عن حرم الله»[75]. ويقول أيضاً: «يُحلّل حلال الله، ويُحرّم حرام الله، ويُقيم حدود الله، ويذبّ عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة»[76].
وبهذا الصدد يقول الإمام الحسين عليه السلام: «فلعمري، ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك لله»[77].
وتأسيساً على ما تقدّم، عندما علم الإمام الحسين عليه السلام أنّ يزيد فاسقٌ فاجرٌ وقاتلُ النفس المحرمة، رفض مبايعته في خلافة المسلمين بقوله عليه السلام: «إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسقٌ شاربُ الخمر، قاتلُ النفس المحرمة، معلنٌ بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نُصبح وتُصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقّ بالبيعة والخلافة»[78].
ثامناً: إطاعة الله ورسوله الكريم
إنّ الإيمان بالله هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، وهذا يُعرف بحقيقة الإيمان، وأنّ معنى الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى وتوحيده، ويشمل توحيد الربوبية: (الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)[79]، وتوحيد الأسماء والصفات: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)[80].
من الدروس المهمة للنهضة الحسينية هي إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى، فروي عن الإمام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من المحرم ـ عندما خرج من خيمته ليلاً ورأى خيلاً ورجالاً يحيطونه ـ أنّه استسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، وقال عليه السلام: «اللّهم، أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شديدة، وأنت لي في كل أمرٍ نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل فيه القريب، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمّن سواك، ففرجته وكشفته وكفيته، فأنت وليّ كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة»[81].
تاسعاً: الحلم وكظم الغيظ
إنّ الحلم هو عبارة عن التأنّي وكظم الغيظ وضبط النفس، بحيث لا تتحرّك قوّة الغضب الشخصي بسهولة، ولا تُؤدّي به مكاره الدهر إلى الاضطراب؛ لذلك قيل: إنّ الحلم هو عبارة عن إخفاء الغضب وحفظه.
وهو من القيم الأخلاقية الحسنة التي تجسّدت بالقائد (الحر بن يزيد الرياحي) الذي ظهر في معركة الطف، وقد استجاب للإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة وهو يفكّر في تلك اللحظات الحاسمة من حياته، فهل يلتحق بالحسين عليه السلام وينقذ نفسه من عذاب الله وسخطه؟ أو أنّه يبقى على منصبه كقائد فرقة في الجيش الأُموي وينعم بصلات ابن مرجانة؟ فاختار الحر نداء الضمير الحي، وقد اتّجه صوب الإمام الحسين عليه السلام مطأطأً رأسه إلى الأرض حياءً وندماً على ما صدر منه تجاه الإمام الحسين عليه السلام حين رفع صوته، ولكن بعد أن تبيّن له الحق قال الحر: «جُعلت فداك يا بن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، وسايرتك في الطريق، وجعجعت بك في هذا المكان، وما ظننت أنّ القوم يردّون عليك ما عرضته عليهم، ولا يبلغون منك هذه المنزلة، والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبتُ مثل الذي ركبت، وأنا تائب إلى الله ممّا صنعت، فترى لي من ذلك توبة؟». فقال الإمام الحسين عليه السلام: «نعم، يتوب الله عليك…»[82]. وبذلك ملأ الفرح قلب الحر حينما فاز برضا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله.
عاشراً: إقامة الحجّة على الأعداء
إنّ الإمام الحسين عليه السلام لم يبدأ بقتال الأعداء، بل بدأ بوعظ الناس وحذّرهم من الفتنة وغرور الدنيا؛ وذلك بإقامة الحجج عليهم، وقد خاطبهم عدة مرات بصوت عالٍ ومسموع وقال: «أيّها الناس… فانسبوني فانظروا مَن أنا، ثمّ راجعوا أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟! ألستُ ابن بنت نبيكم، وابن وصيّه، وابن عمه، وأول مؤمن مصدق لرسول الله صلى الله عليه وآله بما جاء به من عند ربه؟! أو ليس حمزة سيّد الشهداء عمّي؟! أو ليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمّي؟! أو لم يبلغكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنة؟! فإن صدّقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمّدت كذباً مذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، وإن كذّبتموني فإنّ فيكم مَن إن سألتموه عن ذلك أخبركم، اسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي، أمَا في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟!»[83].
حادي عشر: الثبات على المبدأ
إنّ الثبات على المبدأ هو ملكة التحمّل على الخوض في الأهوال وقوّة المقاومة مع الشدائد والآلام، بحيث لا يعتريه الانكسار وإن زادت وكثرت. وقيل: إنّ مبدأ الثبات على الإيمان هو اطمئنان النفس في عقائدها بحيث لا تتزلزل عند الشبهات.
وفي ضوء ما تقدم ظهر الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف مجسِّداً لقيم الثبات على المبدأ (الإيمان)، وقد استُشهد جميع أصحابه وأهل بيته وبقي الإمام الحسين عليه السلام وحيداً، فودّع عياله وأمرهم بالصبر والتحمّل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثمّ ركب جواده يقاتل أعداءه وحده، حتى سقط شهيداً فوق رمال كربلاء.
قال بعض الرواة: «فوالله، ما رأيت مكثوراً قط قد قُتِل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشاً منه، وإن كانت الرجال لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب، ولقد كان يحمل فيهم وقد تكمّلوا ألفاً، فينهزمون بين يديه كأنّهم الجراد المنتشر، ثمّ يرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم… بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي إنّك تعلم أنّهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره، ثمّ أخذ السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجرح، فلمّا امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة»[84].
ثاني عشر: الإخلاص
هو صفاء الأعمال من الشوائب والرياء، وجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، وهي من سجايا الفرد، فهو جوهر العبادة ونية العمل وقبوله لدى المولى عزّ وجل، حتى قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)[85]. لذلك فإنّ الإخلاص هو حجرٌ أساسي في كيان العقائد والشرائع، وشرط لصحة الأعمال نحو طاعة الله تعالى ورضاه، وكذلك فهو يُحرّر الإنسان من إغواء الشيطان.
ثالث عشر: محاسبة النفس ومراقبتها
أي: محاسبة النفس ومراقبتها كل يوم عمّا عملته من طاعات أو ما اقترفت من معاصي وآثام، فإن رجحت كفّة الطاعات على المعاصي، أي: الحسنات على السيئات، فعلى المحاسب أن يشكر الله تعالى على ما وفّقه إلى طاعة الله ورضاه. وبالعكس، فعليه أن يؤدِّب نفسه بالتأنيب وإصلاح نفسه.
رابع عشر: توحيد الأُمّة الإسلامية
ومن المعلوم أنّ الله سبحانه وتعالى وصف الأُمّة الإسلامية بقوله: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)[86]. ولكن الأُمّة الإسلامية قد تفرّقت، ولا بدّ أن تتوحّد، وقد توحّدت بعد أن ظهر الإمام الحسين عليه السلام مبيّناً أنّه لم يأتِ محارباً وإنّما جاء محرراً ومنقذاً من جور الأُمويين وظلمهم، قائلاً: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته: مَن رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثمّ لم يُغيّر بقول ولا فعل، كان حقيقاً [حقّاً] على الله أن يدخله مُدخله»[87].
وبذلك فالإمام الحسين عليه السلام هو موحِّد هذه الأُمّة بهذه الكلمات؛ وذلك من خلال وقفة أصحابه إلى جانبه ولسان حاله يقول: (يا أصحابي، إنّ وحدتكم هي وحدة الصادقين مع الله في عهدهم له).
المحور الثامن: مفردات حركة الإصلاح بصورة عامّة في ضوء النظرة المعاصرة للنهضة الحسينيّة
أولاً: الحرية
جاءت كلمة الحرية في اللغة في معناها (حرٌّ نقيض العبد، استقلال، شجاعة، نزاهة، أُلفة). والحرية بالنسبة للفرد أو المجتمع خالية من العبودية، وهي قدرة الفرد على ممارسة نشاطاته دون إكراه، فهي حق إنساني فطري ثابت قبل أن تكون حقّاً وطنياً وقانونياً مكتسباً.
أنواع الحريات
1ـ حرية العقيدة: أي لكل إنسان الحرية المطلقة لاختيار العقيدة التي يؤمن بها.
2ـ حرية التعبير عن الرأي: أي لكل إنسان أو مجتمع له حرية التعبير عن الرأي بالمناقشة، وتبادل الآراء عن طريق الكتابة والتأليف والنشر.
3ـ حرية الاختيار: أي لكل فرد أو مجتمع الحرية في اختيار رئاسة الحكم أو الدولة أو إشغال منصب ما، والمجتمع يسمح لأفراده بهذا الحق في الانتخابات.
4ـ الحرية الشخصية: أي لكل فرد أو مجتمع الحرية في القيام بالأعمال حسب الطريقة التي يرتضيها، وبشرط ألّا تتعدى على حقوق الآخرين أو مخالفة القوانين.
وقيم الحرية تشمل:
1ـ حرية العقيدة التي يؤمن بها الفرد.
2ـ حرية التعبير عن الرأي والمناقشة عن طريق الكتابة والتأليف والنشر.
3ـ حرية الاختيار للفرد أو المجتمع في اختيار رئاسة الحكم أو الدولة أو إشغال المناصب عن طريق الانتخابات الحرّة والنزيهة.
4ـ الحرية الشخصية للفرد أو المجتمع في التمسّك أو التنقّل في التملك، أو السفر، أو السكن…
ثانياً: الإحسان
هي مناعة نفسية تردع صاحبها عن استعمال الظلم وتسيّره نحو أداء الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ، وبذلك وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان والمجتمع بقوله: (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)[88].
وقيل في العدل أنواع: (العدل مع الله سبحانه وتعالى، والعدل مع المجتمع، والعدل مع أسلافهم الأموات، وعدل الحكّام)، فالشخص الذي يتحلّى بالعدل هو الإنسان الذي لا يظلم نفسه ومجتمعه.
ثالثاً: المساواة
جاءت كلمة المساواة بأنّها مفهوم يدل على (حالة التماثل بين الأفراد أو الجماعات)، وهي تعني أيضاً العدالة والمساواة في الكرامة والحقوق، أي: كل مَن وُهب العقل والوجدان لا بدّ أن يعامل معاملة تتسم بروح الإخاء.
وتظهر قيم المساواة من خلال:
1ـ المساواة أمام القانون: أي أنّ الأفراد، والجماعات، والطبقات الاجتماعية متساوية في تطبيق القانون دون تمييز لشرف أو نسب أو جاه.
2ـ المساواة أمام القضاء: أي أنّ الأفراد، والجماعات، والطبقات الاجتماعية متساوية في تطبيق القانون في إجراء المحاكم عليها دون شرف أو نسب أو خصوصية.
3ـ المساواة أمام وظائف الدولة، أي أنّ الأفراد، والجماعات، والطبقات الاجتماعية متساوية في تولّي وظائف الدولة حسب المؤهّلات والشروط دون مزايا، أو مكافاة.
4ـ المساواة في التكاليف والأعباء العامة: أي إنّ الأفراد، والجماعات، والطبقات الاجتماعية متساوية بالانتفاع من الخدمات العامة التي تُقدّمها الدولة، كذا في الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية.
رابعاً: الديمقراطية
من المعلوم أنّ مفهوم الديمقراطية عُرِّفت بعدّة تعاريف، ولكن الباحث عرّفها إجرائياً بأنّها نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي شامل يقوم على أُسس أخلاقية، وجوهرها هو احترام ذاتية الفرد، وقيم الفرد الذاتية وقيم المجتمع، وإفساح المجال للفرد والشعب بالمشاركة في جميع نواحي الحياة العامة من أجل تنظيم الحياة وتوجهها بما يضمن السعادة والمصلحة العامة.
ومن الواضح أنّ الديمقراطية في العصر الحديث أصبحت لها عدّة مفاهيم، منها: مفهوم سياسي، وهو: «الديمقراطية: تعني أنّ الشعب هو صاحب السلطة، والحقوق السياسية مقرّرة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الثروة»[89].
خامساً: النزاهة
وتعني الصدق والأمانة والإخلاص في العمل للعاملين داخل المؤسسة. والنزاهة أيضاً هي: قواعد ومعايير سلوكية أخلاقية في الحياة تتضمّن الأداء الصحيح لواجبات الوظيفة العامة في المجالات (التربوية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، العلمية، والتكنولوجية، والمعلوماتية).
وتظهر قيم النزاهة من خلال:
1ـ عدم قبول الهدايا والرشوة.
2ـ عدم قبول المحسوبية والمنسوبية في التعيين والمناقصات.
3ـ عدم تبذير الأموال العام للدولة.
4ـ عدم الاختلاس، التزوير، السرقة، الهدر في أموال الدولة.
5ـ عدم استغلال السلطة أو الوظيفة العامة والاستهتار بها.
ومن مبادئ النزاهة ما يأتي:
1ـ حُسن الخُلق: هو حالة نفسية تبعث على حسن معاشرة الناس ومجاملتهم بالبشاشة، وطيب القول ولطف المدارة.
2ـ الصدق: وهو مطابقة القول للواقع، وهو أشرف الفضائل النفسية والمزايا الخلقية، لما لآثاره الهامة على حياة الفرد والمجتمع من فوائد عظيمة، حتى قال الخالق سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)[90].
لذا؛ فإنّ الصدق له أقسام، هي: (الصدق في القول، والصدق في الأفعال، والصدق
في العزم، والصدق في النية). وفي ضوء ما تقدّم فإنّ الصدق له آثاره على الفرد نفسه ومجتمعه، فإنّه يؤدّي إلى سعادة المجتمع؛ لأنّه يخلق الانسجام والتفاهم والتعاون وتبادل الثقة والائتمان بين الأفراد. من المعلوم أنّ الصدق نجاة، والصادقين أحباب الله، والإنسان الصادق يحظى باحترام الناس وثقتهم ومحبّتهم.
لذلك نقول: إنّ العامل أو الموظّف الصادق يحبّه الناس وينجح في عمله، وبعكس الكاذب الذي يُزيّف الأشياء، فهو يشوّه الحقائق ويغشّ ويخون الناس؛ لذا فهو الذي يجلب الضرر والفساد على نفسه وعلى الناس. ومن هنا نقول: إنّ الشخص الصادق هو أمين ومخلص ونزيه لأنّه يقول الحقيقية، إضافة إلى ذلك فهو متمسّك بالعهد وموفي العهد، وإذا عمل شيئاً فإنّه يعمله بصدق وإخلاص بعيداً عن الرياء والغش والنفاق، وعليه فقد خصّ الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)[91].
3ـ التواضع: وهو احترام الناس حسب أقدارهم، وعدم الترفّع عليهم، وهو من الأخلاق الكريمة التي تستهوي القلوب وتستثير الإعجاب والتقدير، حتى خاطب الله سبحانه وتعالى الرسول محمد صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[92].
4ـ الأمانة: وهي أداء ما أُتُمن عليه الإنسان من حقوق، فهي من أنبل السجايا وأعز المآثر، وبها يحرز المرء الثقة والإعجاب، وينال النجاح والفوز، حتى قال سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)[93]؛ لذلك نقول: إنّ الأمانة مهمة في حياة الأُمم والأفراد فهي نظام، وقوامه استقامتهم.
5ـ العدل: وهو مناعة نفسية تردع صاحبها عن استعمال الظلم، وتسيّره نحو أداء الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ، وبذلك وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان والمجتمع: (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)[94].
وقيل في العدل أنواع: (العدل مع الله سبحانه وتعالى، والعدل مع المجتمع، والعدل مع أسلافهم الأموات، وعدل الحكّام)، فالشخص الذي يتحلّى بالعدل هو الإنسان الذي لا يظلم نفسه ومجتمعه.
6ـ حبُّ الناس: وهو من السجايا التي يتّسم بها مَن يكسب رضا الناس وحسن التعامل معهم، فحبّ الناس هو السلوك القويم ويجعلهم أقرب الناس لهم منزلة وإنّ تعاملهم مع الناس معاملة طيبة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أُسوة، أمينٌ حَسَنُ المعاشرة وعادل، يُحب الخير للجميع؛ لذلك مدحه القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)[95]. لذلك نقول: إنّ قيم النزاهة لها مبادئ يجب أن يتحلّى بها كلّ فرد، أو كل مجتمع، حتى يسمو إلى سُلَّم الحضارة الإنسانية، وبالتالي لا وجود للفساد في الحياة.
سادساً: الشفافية
وتعني توفير المعلومات والبيانات عن مؤسسات الدولة بالتدقيق الحر للمعلومات ورصد (الإيجابيات والسلبيات)، والكشف عنها في كيفية عملها. وتُعرَّف أيضاً: بأنّها اطّلاع الأفراد أو الفرد على سير العمل في السلطة الإدارية في كافّة المجالات داخل العمليات، وتتسم بالصدق والشفافية، ومن مبادئها:
1ـ مبدأ المحاسبة.
2ـ مبدأ المُساءلة.
3ـ مبدأ المراقبة في صنع القرار.
وتظهر قيم الشفافية من خلال:
1ـ كشف المعلومات والحقائق عن عمل المؤسسة التابعة للدولة في كيفية عملها.
2ـ تزويد الرأي العام بالبيانات والمعلومات (الإيجابية أو السلبية).
سابعاً: الحوار وقبول الآخر
ونعني بالحوار: الوسيلة في التواصل والتفاعل الإنساني، ويتم التداول بين أكثر من طرف في قضية أو مشكلة، فالحوار الوسيلة التي يستخدمها الناس سواء على مستوى الفرد أو الجماعة لأجل خلق تفاعل إيجابي بين أطراف مختلفة في القضايا السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية، وغيرها.
وتظهر قيم الحوار من خلال:
1ـ دعم قيم السلام والتنمية في المجتمع.
2ـ إتقان مهارات الحوار، ومنها: الاستماع، الكتابة، التلخيص.
3ـ خلق قيادات إيجابية لحل مشكلة ما.
ثامناً: الانتماء
جاءت كلمة الانتماء لغةً عن النماء، أي: الزيادة والارتفاع والعلو. وأمّا اصطلاحاً فتعني: الانتساب الحقيقي للدين، أو الوطن، كحق وممارسة تُجسّد جوارح الإنسان من خلال العمل. فالانتماء هو انتساب الفرد إلى الجماعية مما يُشعر الفرد المنتمي بإشباع حاجاته المادية، النفسية، الاجتماعية؛ وبذلك فهو يعني ما يلي:
امتثال الفرد للقيم الوطنية السائدة في مجتمعه، كالاعتزاز بالرموز الوطنية، واحترام القوانين، والمحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته العامة، وتشجيع المنتجات الوطنية، والتمسّك بالعادات والتقاليد، والمشاركة في الأعمال التطوعيّة والمناسبات الوطنية والاستعداد للتضحية من أجل رفعة الوطن، والقيام بأعمال تطوّعية خيرية لصالح الوطن والشعب والمواطنين، والمحافظة على اللغة والتراث الثقافي، والمحافظة على العادات والتقاليد التي يرغبها المجتمع.
تاسعاً: الولاء
جاءت كلمة الولاء لغةً من: ولي يلي ولياً، أي: دنّاه وقرّبه. أمّا الولاء اصطلاحاً فهو: تبع، نصير، طائع، خضع لسلطة القبيلة، أو العشيرة، أو الأب، أو المؤسسة. فالولاء اصطلاحاً يعني الارتباط، أي: ارتباط الفرد بالأُسرة، أو العمل، أو الوطن، والإخلاص له. وقد يكون الولاء طبيعي لسلطة الحكم. والولاء الواقعي هو ولاء إلى المجتمع، وهو: جملة من المشاعر والأحاسيس التي يحملها الفرد تجاه وطنه. ويتجسّد الولاء في الفرد من خلال الحبّ وتحمّل المسؤولية والتضحية من أجل نصرة الوطن ورفعته. والولاء هو صدق الانتماء. وقيم الولاء تظهر من خلال:
1ـ حبّ الوطن والدفاع عنه.
2ـ حبّ الأُسرة.
3ـ حبّ المؤسسة التي عمل فيها الفرد.
4ـ طاعة القيادة ونظام الحكم في الدولة.
عاشراً: التعايش السلمي
وهو الاعتراف بالهويات المتنوعة للشعوب (العرقيّة، القبليّة، الدينيّة، المذهبيّة)، وذلك بأن يعيش الكل في مجتمع يسوده الوئام والأمن والسلام، بعيداً عن الصراعات الفكرية والقسوّة والإرهاب أو التكفير.
مبررات التعايش السلمي
1ـ هو أن يعيش البشر في ضوء أطباعهم الشخصية وتوجيهاتهم (الدينيّة، القوميّة، العرقيّة، المذهبيّة)، أي: أن يعيشوا بعضهم لبعض، بعيداً عن الصراعات الفكرية، كالتكفير والقسوة، أو التطرّف أو الإرهاب.
2ـ أن يعش الفرد والمجتمع متسامحاً متحابّاً تسوده المحبّة والتعاون، له حقوق وعليه واجبات المواطنة تجاه الوطن؛ وذلك لأجل خلق سلوك إنساني متسامح ومتعايش على مستوى دول العالم.
أهمّية التعايش السلمي
1ـ إنّ الدول المتقدمة اهتمّت بمفهوم التعايش السلمي؛ لأنّه يؤمن بالهويات المختلفة لأبناء الشعب، وبهذا يُبعِد الصراع الفكري والمذهبي.
2ـ إدامة العلاقات بين أفراد المجتمع، وكذلك مع الدول الأُخرى كأن تكون المجاورة مثلاً.
3ـ إنّ الدين الإسلامي يؤمن بالتعايش السلمي فجعله مبدأ من مبادئ الحضارة الإسلامية؛ بدليل استطاعة العرب والمسلمين أن يعيشوا في الدول التي فتحوها ونشروا الدين الإسلامي فيها.
مبادئ التعايش السلمي والتسامح
سوف تتعرف أنّ للتسامح نفس مبادئ التعايش السلمي وذلك من خلال:
1ـ إنّ سلوك التعايش السلمي هي نفس مبادئ التعايش السلمي، فالتسامح يعني عدم الممانعة الواعية من قِبَل الفرد تجاه الفرد الآخر بالمعتقدات (الدينيّة، السياسيّة، الأخلاقيّة)، فهو سلوك يحترم ويُقدّر التنوّع الثقافي.
2ـ إنّ سلوك التعايش السلمي يؤمن بحرية الفكر والضمير، وكذلك التسامح يؤمن بالفكر والضمير.
حادي عشر: حقوق الإنسان
لقد عُرِّفت حقوق الإنسان بأنّها حقوق أصلية في طبيعتها، أي: من الله سبحانه وتعالى. وحقوق موضوعة، أي: مجموعة الحقوق والحريات العامة المقرّرة والمحمية بموجب المواثيق الدولية والإقليمية؛ وبذلك فحقوق الإنسان تشمل (الحقوق الطبيعية، والحقوق المكتسبة). والحقوق الأساسية هي حقوق الكائن البشري منذ لحظة ولادته كائناً حيّاً وحتى وفاته، وعلى الدولة الإقرار بها وضمانها وحمايتها وعدم انتهاكها أو الإخلال بها.
وتظهر قيم حقوق الإنسان من خلال:
1ـ حق التصويت، الانتخابات، الترشيح والترشّح.
2ـ حق الرقابة والحكم.
3ـ حق الجنسية، الهوية.
4ـ حق العقيدة الدينية، الثقافية، اللُّغوية، القومية.
5ـ حق التعبير عن الرأي والنشر في المجالات الشخصية والإعلامية.
6ـ حقّ العمل والتأليف والانتماء للأحزاب والمنظَّمات والجمعيات.
7ـ حقّ العمل والتنقّل والسفر والسكن والإقامة.
8 ـ حقّ الأمن والحماية.
9ـ حقّ تكافؤ الفرص وتقليد المناصب.
10ـ حقّ الاستدعاء القانوني الرسمي والوظيفي.
11ـ حقّ الأجر العادل.
12ـ حقّ الضمان الاجتماعي في حاله البطالة.
13ـ حقّ العجز والمرض والشيخوخة والترمّل.
وهذه الحقوق لا بدّ أن تثبت للجميع دون تمييز عرقي أو ديني أو قومي، أو غير ذلك.
ثاني عشر: الواجبات
الواجب: المهمة، المسؤولية. فالشخص الذي يتحلّى بالأمانة هو محل اعتزاز وثقة الناس به، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: «ليس منّا مَن أخلف الأمانة»[96]. ويُكلَّف الشخص وفق واجباته المختلفة وضرورة المحافظة عليها بعيداً عن اللا مبالاة واللا مسؤولية.
ثالث عشر: التسامح
كلمة التسامح تعني قبول أفكار وممارسة الآخرين دون عُنفٍ أو استسلام، أي: الإقرار بحقوق الآخرين في القضايا السياسية، والاجتماعية، والثقافية، وفي اللغة، والدين، والاختلاف في الرأي والفكر دون العنف والاستسلام أو التفريط، أو التسامح بالقول والفعل من خلال مشاركة الآخرين في مشاعرهم وعدم الاستخفاف بهم.
وإنّ قيم التسامح تظهر من خلال:
1ـ ترسيخ قيم المحبّة والتعاون بين الناس بعيداً عن العنف والتطرّف.
2ـ احترام ثقافة وعقيدة وقيم الآخرين دون عنف أو استسلام.
3ـ احترام الاختلاف في الرأي والفكر.
4ـ خلق الوعي بالقضايا الاجتماعية.
5ـ يخلِّص المجتمع من الرواسب، وبخاصّة لغة الانتقام، الإقصاء، التعصّب.
6ـ يُبعِد مفاهيم التعصّب والتحيُّز إلى فئة ما.
موضوعات التسامح وموضوعات التعايش السلمي
عزيزي الدارس: أنّ موضوعات التعايش السلمي هي نفس موضوعات التسامح، وتشمل: (الدين، الفن والإعلام، الأخلاق، السياسية، التاريخ، التربية والتعليم).
المبحث الثالث: طرق تعزيز حركة الإصلاح للنهضة الحسينيّة في المنهج المدرسي
وذلك من خلال:
1ـ تضمين المنهج المدرسي مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية.
2ـ استعمال طرائق التدريس الحديثة كطريقة الحوار.
3ـ استعمال الإدارة المدرسية الحديثة: الإدارة الديمقراطية.
4ـ استعمال الوسائل التعليمية الحديثة: الحاسوب والإنترنت والإذاعة المدرسية.
5ـ استعمال الأنشطة الفنية والأدبية: المسرح الحسيني ـ الأناشيد الحسينية بحبّ آل البيت عليهم السلام.
6ـ استعمال المناسبات الدينية: يوم (10) محرّم.
ملاحظة: لا يسع المجال شرحها في هذا البحث؛ لأنّها تحتاج تفصيل أكثر.
المبحث الرابع: النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج
1ـ إنّ حركة الإصلاح لها مفهوم شامل وكبير يشمل مجالات الحياه العامة (السياسية والاجتماعية، الإدارية، الأخلاقية، الاقتصادية، الدينية، التربوية، القانونية،
الوظيفية).
2ـ إنّ مفهوم الإصلاح له عدّة معانٍ ومفاهيم، كما وردت في القرآن الكريم بمعنى (الإيمان والتقوى، العفو، العدل، الإحسان، العبادة، البر، الصبر، التوبة، وغيرها).
3ـ إنّ مفهوم الإصلاح له عدة مفاهيم كما وردت في القرآن الكريم بمعنى (الفساد، ويشمل: السحر، المخادعة، الهلاك، الكفر، الطغيان، الفاحشة، البغي، الغلو، التطرّف، الظلم، السرقة، البخس، كنز المال والفضة).
4ـ إنّ مفردات حركة الإصلاح في ضوء الطريقة الاستقرائية للنهضة الحسينية هي (الحرية، الأمر بالمعروف، إقامة الصلاة، النصيحة، نصيحة الأعداء، الوفاء، الجهاد المقدس، مسؤولية الإمام الحجة، إطاعة الله ورسوله، الحلم وكظم الغيظ، إقامة الحجّة على الأعداء، الثبات على المبدأ، الإخلاص، محاسبة النفس، وحدة الأُمّة…).
5ـ إنّ مفردات حركة الإصلاح في ضوء النظرة المعاصرة شملت (الحرية، العدل، المساواة، الديمقراطية، النزاهة، الشفافية، الحوار وقبول الآخر، الانتماء، الولاء، التعايش السلمي، الحقوق، الواجبات، التسامح…).
6ـ يمكن للمدرِّس أن يستخدم طرائق وأساليب تعليمية وتدريسية تعتمد على الحوار واستثمار التكنولوجيا الحديثة في التدريس؛ لكي يؤثِّر في نفوس الطلبة لمحاربة الفساد بكلّ أشكاله.
7ـ إنّ الإمام الحسين عليه السلام جسّد معاني حركة الإصلاح في تصحيح مسار الأُمّة بدءاً من النفس حتى المجتمع ومؤسساته وذلك من خلال محاربة الفساد بكلّ أشكاله، حيث مقولته المشهورة: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدي صلى الله عليه وآله، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب».
8ـ إنّ الإمام الحسين عليه السلام أصبح مصباح الهدى وسفينة النجاة في حفظه مبادئ الدين وفروعه، وإنّ ثورته المباركة أفرزت قيماً للأجيال القادمة والأُمم والشعوب المضطهدة، فهي ليست محلية، بل أصبحت عالمية، ينبغي التمسّك بها، وبذلك قدَّم الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف الخالدة في (10/محرّم) قرابين للدين الإسلامي؛ لكي يبقى الإسلام صافاً معطراً بعطر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار.
9ـ يمكن تعزيز مفاهيم حركة الإصلاح للنهضة الحسينية في المناهج الدراسية على شكل مفردات، كما توصّلت إليها الدراسة الحالية وذلك لغرسها في نفوس أبنائنا الطلبة.
10ـ إنّ المناهج الدراسية تحتاج إلى إعادة النظر في مضمونها، لا سيما في مجال حركة الإصلاح ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وتعميم مفهوم حركة الإصلاح في كلّ مفاصل الحياة.
11ـ إنّ موضوع النهضة الحسينية أصبحت له أهمّية متزايدة لدى الباحثين والمهتمّين في جميع حقول المعرفة، ولا سيما في مجال التربية والتعليم، خصوصاً وأنّ هذه النهضة تُعدّ بمثابة (الثورة) من حيث الأهداف والدروس والعبر.
ثانياً: التوصيات والمقترحات
1ـ على وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إدخال مفاهيم حركة الإصلاح في المناهج الدراسية؛ وذلك لتوعية الطلبة بمضمون حركة الإصلاح التي جاء بها الإمام الحسين عليه السلام في محاربة الظلم والفساد بكلّ أشكاله.
2ـ على وزاره التربية الأخذ بالدراسة الحالية لمفردات الإصلاح في ضوء النظرة المعاصرة والتي شملت مفاهيم (الحرية، العدل، المساواة، الديمقراطية، النزاهة، الشفافية، الحوار وقبول الآخر، الانتماء، الولاء، التعايش السلمي، الحقوق، الواجبات، التسامح…)، وتضمينها في البرامج والأنشطة.
3ـ على المؤسسات الدينية المعنية (المساجد، الحسينات، أماكن العبادة) القيام بدورها في إرشاد الناس لمضمون حركة الإصلاح للنهضة الحسينية؛ لغرس هذه المفاهيم التي توصّلت إليها الدراسة الحالية ـ سواء في ضوء الطريقة الاستقرائية أو النظرة المعاصرة ـ وهذا ما يتطلّب تعليم الطفل حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه السادسة، حتى ينطبع في الذاكرة وهي تحميه من الوقوع في الفساد بكل أشكاله، وكذلك فإنّ حفظ القرآن الكريم يُعطي الإنسان طاقة نضالية ودعماً إيجابياً وصلابة، وصلة بالغيب.
4ـ على مؤسسات الشباب المعنية بتربية ورعاية الشباب، القيام بدورها وهو الإصلاح في تصحيح مسار حركة المجتمع في محاربة الفساد بكل أشكاله؛ وذلك من خلال الرقابة والنزاهة والشفافية والتعايش السلمي والتسامح، والحوار لتوعية الشباب بمضمون حركة الإصلاح.
5ـ على مؤسسات الإعلام الحر المعنية في تعبئة الرأي العام، نشر مقالات وبرامج حركة الإصلاح التي تبني المجتمع وتطوره من خلال مكافحة الفساد بكلّ أشكاله.
6ـ ضرورة إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية بشكل مستمر، يساهم بها أساتذة الجامعة والكليات كلٌّ حسب اختصاصه، في المناسبات الدينية والوطنية؛ لتعزيز مفهوم حركة الإصلاح الشامل التي يحتاجها المجتمع ولمحاربة الفساد بكلّ أشكاله.
فهرست المصادر
* القرآن الكريم
1ـ الأمالي، الشيخ محمد بن على الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، ط1، 1417هـ، الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة.
2ـ بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، ط2، 1403/1983م، الناشر: مؤسسة الوفاء/دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
3ـ بناء منظومة قيم المواطنة الصالحة وأثرها في المناهج الدراسية لتساهم في بناء شخصية الطالب العراقي، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقدّم إلى المؤتمر العلمي الرابع لأبحاث الموهبة والتفوق، الجامعة الأردنية وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية للفترة من 11-12/آب/2015 الأردن.
4ـ برنامج توعوي للشباب في الحوار، التسامح، التعايش السلمي، وقبول الآخر، الديمقراطية، في معالجة العنف والتطرف والإرهاب والتكفير، صباح حسن الزبيدي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول لحزب الفضيلة بالتعاون مع جامعة الكوفة للفترة من 9ـ10/10/2015م.
5ـ دور المناهج التربوية في غرس مفاهيم المواطنة والتعايش السلمي لبناء المجتمع العراقي الجديد، دراسة نظرية، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقدّم إلى مؤتمر الأكاديميين الدولي الثامن بالتعاون مع الأمانتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية وبالتعاون مع جامعة واسط كربلاء المقدسة للفترة من 16ـ17/ربيع الأول 2015م.
6ـ طرائق التدريس، هادي طوالبة، وآخرون، دار المسيرة، الأردن، 2010م.
7ـ طرق تعزيز التربية البيئية في منهج الجغرافية للتعليم الثانوي في العراق، نظرة نقدية، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقدّم إلى مؤتمر قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للبنات/جامعة بغداد عام 2011م.
8ـ قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية، بدوي، أحمد زكي، مكتبة لبنان، 1977م.
9ـ القيادة الحسينية كأسلوب ثوري في قيادة المجتمع وإصلاحه من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقدم إلى مهرجان ربيع الشهادة الخامس، وتحت شعار (الثابت الحسني في عالم متغير ـ مؤتمرهم العلمي الثالث يوم (7) من شعبان المعظم لعام 1430هـ، العتبة الحسينية والعباسية.
10ـ الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت329هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، ط3، 1367ش، المطبعة: حيدري، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
11ـ لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المعروف بابن منظور (ت711هـ)، ط3، 1414ه، الناشر: دار صادر ـ بيروت.
12ـ معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس والاجتماع ونظرية المعرفة، حجازي، سمير سعيد، دار الكتب العلمية، لبنان 2005م.
13ـ معجم مصطلحات الخدمة الاجتماعية، الدخيل، عبد العزيز عبد الله، انجليزي، عربي، دار المناهج، الأردن 2013م.
14ـ مفاهيم في الفلسفة والاجتماع، النورة جي، أحمد خورشيد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1990م.
15ـ المناهج التربوية، نظرياتها، مفهومها، أسسها، عناصرها، تخطيطها، تقويمها، محمد حسن حمادات، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 2009م.
16ـ مفهوم الإصلاح في النهضة الحسينية وأهمّية تطبيقه في التربية والتعليم، أنعام إسماعيل طاهر، بحث مقدّم إلى مؤتمر الإمام الحسين عليه السلام الدولي للنهضة الحسينية، تحت شعار (النهضة الحسينية مشكاة التكامل الإنساني) كربلاء المقدسة للفترة من (25 ـ 26/آب /2016م).
17ـ مناهج وطرائق تدريس المواد الاجتماعية، صباح حسن عبد الزبيدي، دار المناهج، الأردن2010م.
18ـ المناهج التعليمية، تصميمها، تنفيذها، تقويمها، تطويرها، الزند، وليد خضر الزند، وجميل عبيدات، دار عالم الكتب الحديث، الأردن، 2013م.
19ـ المناهج الدراسية في العراق، مجلس النواب، جمهورية العراق، دائرة البحوث، 2013م.
20ـ مدخل في مضمون الفساد (النزاهة، الشفافية، أساليب وطرائق واستراتيجيات تدريسها في الكليات والمعاهد)، صباح حسن عبد الزبيدي، مكتبة المتنبي للنشر والتوزيع، بابل، تحت الطبع.
21ـ موسوعة المصطلحات التربوية، علي، محمد السيد، دار المسيرة، الأردن 2011م.
22ـ الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي (1402هـ)، 1342هـ.
23ـ الوجيز في مصطلحات التربية وعلم النفس، نوفل إبراهيم، دار الجندي للطباعة والنشـر، دمشق 2003م.
24ـ الحسين عليه السلام مصباح الهدى، السيد محمد الحسيني الشيرازي، دار صادق للطباعة والنشر، كربلاء المقدسة 2004م.
25ـ دروس من يوم عاشور، الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، قسم الثقافة والإعلام، سلسلة (17).
26ـ نصرة الإمام الحسين عليه السلام، الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، قسم الثقافة والإعلام، سلسلة (65).
27ـ من ثغر الشهيد، الإمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، قسم الثقافة والإعلام، سلسلة (21).
28ـ خمسون درساً في الأخلاق، عباس القمي، دار الجوادين، كربلاء المقدسة 2012م.
29ـ في رحاب أهل البيت عليهم السلام، محمد حسين فضل الله، دار التوحيد، العراق 2004م.
30ـ أئمتنا (سيرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام)، علي محمد علي دخيل، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي 2006م.
31ـ أعلام الهداية، المجمع العلمي لأهل البيت عليهم السلام 2010م/1431هـ، لبنان: المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام.
________________________________________
[1] جامعه بغداد/كلية التربية للبنات.
[2] الروم: آية41.
[3] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[4] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص616.
[5] اُنظر: النورة جي، أحمد خورشيد، مفاهيم في الفلسفة والاجتماع.
[6] اُنظر: المصدر السابق.
[7] اُنظر: الزبيدي، صباح حسن، القيادة الحسينية كأُسلوب ثوري في قيادة المجتمع وإصلاحه من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[8] اُنظر: النورة جي، أحمد خورشيد، مفاهيم في الفلسفة والاجتماع.
[9] اُنظر: نوفل إبراهيم، الوجيز في مصطلحات التربية وعلم النفس.
[10] اُنظر: حمادات، محمد حسن، المناهج التربوية.
[11] اُنظر: الزبيدي، صباح حسن، مناهج وطرائق تدريس المواد الاجتماعية.
[12] اُنظر: النورة جي، أحمد خورشيد، مفاهيم في الفلسفة والاجتماع.
[13] اُنظر: حجازي، سمير سعيد، معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس والاجتماع ونظرية المعرفة.
[14] اُنظر: علي، محمد السيد، موسوعة المصطلحات التربوية.
[15] اُنظر: علي، محمد السيد، موسوعة المصطلحات التربوية.
[16] اُنظر: حجازي، سمير سعيد، معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس والاجتماع ونظرية المعرفة.
[17] اُنظر: النورة جي، أحمد خورشيد، مفاهيم في الفلسفة والاجتماع.
[18] اُنظر: المصدر السابق.
[19] اُنظر: طوالبة، هادي، طرائق التدريس.
[20] اُنظر: الزبيدي، صباح حسن، مناهج وطرائق تدريس المواد الاجتماعية.
[21] اُنظر: حمادات، محمد حسن، المناهج التربوية.
[22] اُنظر: المناهج الدراسية في العراق: مجلس النواب، جمهورية العراق، 2003م.
[23] اُنظر: الزند، وليد خضر، المناهج التعليمية (تصميمها، تنفيذها، تقويمها، تطويرها).
[24] اُنظر: المناهج الدراسية في العراق: مجلس النواب، جمهورية العراق، 2013م.
[25] اُنظر: الزبيدي، صباح حسن، طرق تعزيز التربية البيئية في منهج الجغرافية للتعليم الثانوي في العراق (نظرة نقدية).
[26] معجم المعاني الجامع: .http://www.almaany.com/ar/dict/ar
[27] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص516.
[28] اُنظر: معجم المعاني الجامع: .http://www.almaany.com/ar/dict/ar
[29] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص335.
[30] المائدة: آية33.
[31] الروم: آية41.
[32] الزبيدي، محمد حسن، مدخل في مضمون الفساد.
[33] الأنعام: آية48.
[34] الأعراف: آية35.
[35] الشورى: آية40.
[36] النحل: آية90.
[37] الأعراف: آية85.
[38] المائدة: آية2.
[39] البقرة: آية250ـ 251.
[40] التوبة: آية102.
[41] يونس: آية81.
[42] البقرة: آية8ـ11.
[43] هود: آية117.
[44] البقرة: آية205.
[45] الأنفال: آية73.
[46] الروم: آية44ـ45.
[47] القصص: آية83.
[48] الفجر: آية9ـ14.
[49] العنكبوت: آية28ـ30.
[50] القصص: آية76ـ77.
[51] المائدة: آية64.
[52] الحج: آية39ـ40.
[53] المائدة: آية38.
[54] الأعراف: آية84ـ85.
[55] التوبة: آية34ـ35.
[56] الدخيل، عبد العزيز عبد الله، معجم مصطلحات الخدمة الاجتماعية.
[57] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص147.
[58] الفجر: آية11ـ 14.
[59] الزبيدي، محمد حسن، مدخل في مضمون الفساد.
[60] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص51.
[61] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ص531.
[62] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص51.
[63] المصدر السابق: ج79، ص198.
[64] المؤمنون: آية1-3.
[65] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج10، ص369.
[66] النساء: آية103.
[67] العنكبوت: آية45.
[68] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج71، ص61.
[69] المصدر السابق: ج72، ص258.
[70] المصدر السابق: ج76، ص135.
[71] المصدر السابق: ج45، ص8.
[72] المصدر السابق: ج44، ص376.
[73] المصدر السابق: ج45، ص76.
[74] المصدر السابق: ص43.
[75] المصدر السابق: ج25، ص124.
[76] المصدر السابق: ص123.
[77] المصدر السابق: ج44، ص334ـ335.
[78] المصدر السابق: ص325.
[79] الفاتحة: آية2.
[80] الشورى: آية11.
[81] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج95، ص343.
[82] المصدر السابق: ج45، ص11.
[83] المصدر السابق: ص7.
[84] المصدر السابق: ص50ـ53.
[85] البيّنة: آية5.
[86] آل عمران: آية110.
[87] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص382.
[88] النحل: آية90.
[89] بدوي، أحمد زكي، قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية.
[90] التوبة: آية119.
[91] التوبة: آية119.
[92] الشعراء: آية215.
[93] المؤمنون: آية8.
[94] النحل: آية90.
[95] القلم: آية4.
[96] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5، ص133.
المصدر:مؤسسة وارث الانبیاء
http://warithanbia.com/?id=1300
لینک کوتاه
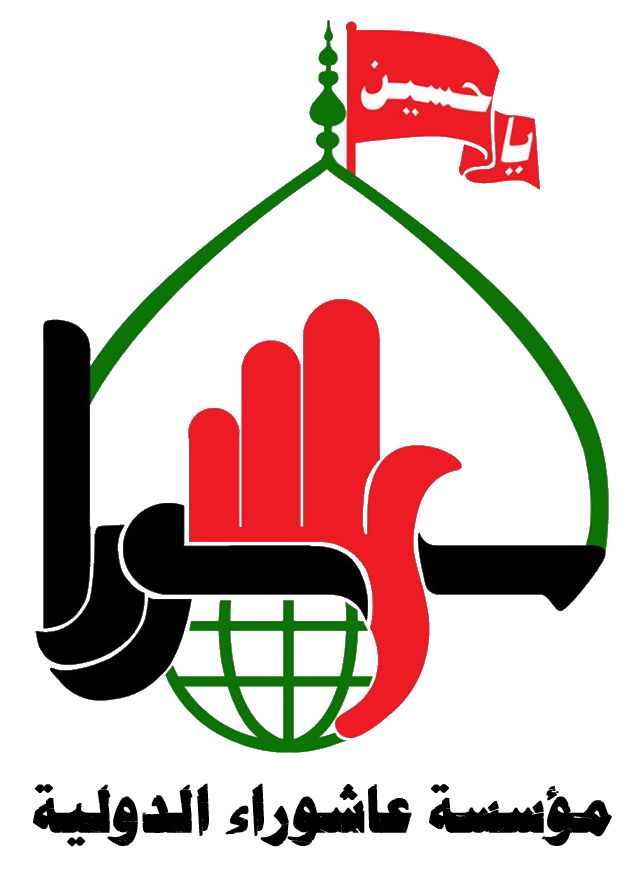
سوالات و نظرات