رؤية الآخر لرحلة الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية إلى العراق.. ابن كثير اختياراً
{ أ. د. علي صالح رسن المحمداوي/ أ. م . د. شيماء هاتو فعل البهادلي }
مقدّمة[1]
وضع أعداء الإسلام عقبات كثيرة تمكنوا من خلالها من إيقاف مدّه، وتسببت في توجيه الخطاب الإسلامي للمسلمين بعضهم بعضاً، مبررين ذلك بغطاء ما يُسمّى نشوء علم الكلام، من دون الانتباه إلى مخاطر ذلك، ومنها: عقد المناظرات الكلامية، والجدل والجدال الدائر حول أحقيّة فلان من فلان، متناسين خطاب الله سبحانه للنبي محمد عليها السلام: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)[2] ، فالمفروض أن تكون صيغة الخطاب كونية، ومَن ينأى بنفسه عكس ذلك يكون من الذين (لَا يَعْلَمُونَ) بناءً على ظاهر الآية، والمحزن حقاً هناك مَن يُلقي في خطاباته تُهماً وتسويفاً يكون المرء مضطراً للردّ عليها، وبهذا أصبحنا ندور في حلقة حول أنفسنا، بل نتناحر فيما بيننا، تاركين كونية الرسالة المحمدية، من دون توجيه الخطاب لأهل الشرك، لعلّ الله يهديهم.
المراد من هذا الطرح، هو الخطاب المقلوب الذي توجه به ابن كثير (ت774هـ)، وهو أحد تلامذة ابن تيمية، بل من أخصّهم، وأكثرهم تأثراً به، حتى أنّه عند وفاته، دُفن في تربته، وهناك مَن أثنى عليه فذكر أنّ هذا المؤرخ كان لا يألو جهداً في الرد على أهل البدع، شافعي المذهب، بعيداً عن التعصّب الديني، له إسهامات علمية كثيرة، منها في علم التاريخ، ولم يكن حاطب ليل، اعتمد القرآن والسنّة، وميّز بين الصحيح والسقيم، ولا سيّما في كتابه البداية والنهاية[3].
هذا الثناء الجميل والكلام المنمّق جعلنا نعرف موقف الرجل من النهضة الحسينية الإصلاحية، فـإذا كان بهذه الصفات يكون حكمه عادلاً، ويعكس الوقائع اعتماداً على مصادر التشريع، وبعد أن خضنا غمار البحث وجدنا الحقيقة عكس ذلك، وفوجئنا بمذهب الرجل، وأنّه ليس بشافعي، بل هو من أتباع الوهابية، لا يُحسن أن يملك غير التكفير والقتل والسب والشتم، ولا سيّما مع الشيعة، واصفاً إيّاهم أهل بدع، وقد وصل به الحال تبرئة يزيد من قتل الإمام الحسين عليه السلام.
وبعد أن جمعنا المادة العلمية أصبحت كثيرة جداً، فقسّمناها إلى فصول أربعة، كلٌ منها أخذ مسلكه العلمي، فكانت حصّة المؤتمر هذا العنوان، الذي ضمّ بين صفحاته مباحث شتّى، الأوّل: ركّز على نهي الناس عامتهم الإمام الحسين عليه السلام بعدم التوجّه إلى العراق، ولهذا النهي أسباب، منها: الخطب المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذمّ أهل الكوفة. وأما المبحث الثاني: فجاء خصيصاً لأسباب اختيار الإمام عليه السلام العراق، وفي مقدّمتها كثرة كُتب أهل الكوفة له، وتشجيع ابن الزبير، وصدور أمر قتله من قِبل يزيد لوالي المدينة.
وكان لزاماً على الإمام عليه السلام أن يُرسل الرسل لمعرفة موقف أهل الكوفة، فكاتبهم وأرسل إليهم مسلم بن عقيل عليه السلام وغيره، ونحن في هذا المقام نقرّ بعدم علمنا بوجود رسل آخرين غير مسلم، ولا ندري ما حلّ بهم، وهذا ما تناوله البحث الثالث. وكان مسيره إلى الكوفة وأشهر المحطات التي حطّ بها رحاله حصة المبحث الرابع.
وما تجدر الإشارة إليه أنّ عِينة البحث، ما ورد عند ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وقد اعتمدنا تحليل النصّ ومراجعة مصادره ومعرفة أسانيده، وهذا ما كلّفنا وقتاً وجهداً مضاعفيَن، عسى أن نحظى بشفاعة سيّدنا ومولانا يوم الورد المورود، وهذا هو هدفنا من المشاركة وما يترتب عليها من الزيارة والدعاء، والفوز العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على رسوله الأمين وآله الطاهرين.
المبحث الأوّل: نهيه بعدم التوجه للعراق
تجلّت القيادة العسكرية الناجحة في شخصية الإمام الحسين عليه السلام بشكلها العلني في واقعة الطفّ، ومن أبرز سماتها: المنهج الواضح، وعزيمته اللامتناهية في مقارعة الظلم، على الرغم من إشارة الكثيرين عليه بالعدول عن مناهضة القوم الظالمين، ومن الأدلّة على ذلك: نهي أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام[4]، فقال له: «قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك، وأنت تُريد أن تسير إليهم، وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك مَن قد وعدك أن ينصرك، ويخذلك مَن أنت أحبّ إليه ممَّن ينصره، فأذكّرك الله في نفسك، فقال: جزاك الله خيراً، مهما يقضي الله من أمر يكن. فقال أبو بكر: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، نحتسبك»[5].
وفي رواية قال: «إنّ الرحم تظأرني عليك، وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك؟ قال: ما أنت ممَّن يُستغش ولا يُتهم، وساق الخبر»[6].
وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن، ربيبة عائشة[7] تعظّم عليه ما يُريد صنعه، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة، وتُخبره: إن لم يفعل إنمّا يُساق إلى مصرعه، وتقول: «أشهد أنّ عائشة سمعت النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: يُقتل الحسين بأرض بابل، فلمّا قرأ كتابها، قال: فلا بدّ لي إذاً من مصرعي ومضى»[8].
المعروف أنّ الإمام عليه السلام صاحب هدف خرج لأجله على الرغم من علمه أنّه مقتول، ومن هنا نُدرك أنّه خارج للشهادة لا للسلطة وطلب الحكم، وبما أنّ مصـرعه هناك لا بدّ أن يطلبه لا العكس كما يفعله كثيرون، أي: طالباً الموت، وهذه السمة قلّما تتوافر في القيادات الذين يختفون خلف الأسوار، ويلوذون بين أحضان الحمايات، ناسين قوله تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ)[9]، فإذا تدبّر المسؤول هذه الآية ما تحصّن في الحصون.
والسؤال الذي بحاجة إلى إجابة هو: إن كان قدر الإمام عليه السلام أنّه يُقتل هناك، فما ذنب عائلته وصحبه زجّ بهم في معركة خاسرة؟
وفي رواية أبي مخنف عن لوذان، عن عكرمة أنّ أحد عمومته سأل الإمام الحسين عليه السلام: أين تُريد؟ فحدّثه. فقال له: «أنشدك الله لما انصرفت راجعاً، فـوالله ما بين يديك من القوم أحد يذبّ عنك، ولا يُقاتل معك، وإنّما والله، أنت قادم على الأسنّة والسيوف، فإنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال، ووطأوا لك الأشياء، ثمّ قدمت عليهم بعد ذلك، كان ذلك رأياً، فأمّا على هذه الصفة، فإنّي لا أرى لك أن تفعل. فقال له الإمام عليه السلام: إنّه ليس بخفيّ عليَّ ما قلت وما رأيت، ولكنّ الله لا يُغلب على أمره»[10].
سند الرواية فيه أبو مخنف، ومن الأخطاء العلمية القاتلة ـ التي سار عليها رجالات البحث العلمي ـ الاعتماد عليه بشكل مطلق في تاريخ النهضة الحسينية، بِعَدّه المصدر الأوّل والأخير، ولم يراعوا التدقيق والتحقيق في رواياته، وما يهمّنا في هذا الموضوع معرفة سيرته، فقد ارتبط اسمه بـاسم جدّه مخنف بن سليم بن الحارث صاحب النبي (صلّى الله عليه وسلّم)[11]، أمّا هو فاسمه: لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي الغامدي، شيخ من أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، يُسكن إلى ما يرويه، روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وقيل: عن الباقر عليه السلام ولم يصحّ[12]. وذكره الشيخ الطوسي بقوله: صاحب المغازي[13]، ولم يشر إلى تجريحه أو توثيقه.
وفي موضع آخر قال: من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ومن أصحاب الحسن والحسين عليهما السلام على ما زعم الكشّي، والصحيح أنّ أباه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو لم يلقه[14]، وقد ظنّ العلّامة الحلي أنّ الطوسي من القائلين: إنّ لوطاً من أصحاب الإمام عليه السلام، فقال: «لعلّ قول الشيخ الطوسي والكشّي إشارة إلى الأب [يعني أباه] والله أعلم»[15]. وقال ابن داوود: إنّ لوطاً لم يلقَ أمير المؤمنين عليه السلام، وإنّما كان أبوه يحيى من أصحابه[16]، بدليل رواية لوط خُطب أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام بواسطتين[17].
وقيل: من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ومحدّثي الإمامية وثقاتهم، ومن العلماء، وشيخ المؤرخين، مختلف في وفاته بين سنة (170هـ) و(175هـ)[18]، وهذا لم يصـرّح به كبار علماء الإمامية، مثل: الطوسي والنجاشي وغيرهما، وإنّما أشاروا إلى صحبته الإمام الصادق عليه السلام، وإلى مؤلفاته في تاريخ الإمامية، ولم يذكروا أنّه إمامي.
ونفى ابن أبي الحديد إماميته، فقال: «من المحدّثين، وممَّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار وليس من الشيعة، ولا معدود من رجالها»[19].
وبعد أن عرضنا موقف علماء الإمامية، وقد كان خالياً من الطعن، حري بنا التعرف على موقف الفريق الثاني الذي انهال عليه تجريحاً لا لذنب ارتكبه؛ وإنّما ظنّاً منهم أنّه شيعيّ، فقد أشار الألباني إلى حديث مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، فوثّق كلّ رواته باستثناء لوط؛ مشيراً إلى أنّه إخباري هالك[20]، من دون أن يُظهر العوامل التي جعلته يقول ذلك.
وأشار ابن أبي حاتم إلى ضعفه، فـقال: إنّه ليس بثقة، متروك الحديث[21]. ونقل ابن عدي عن ابن معين أنّه ليس بشيء، حدّث بأخبار المتقدّمين الصالحين من السلف، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعي[22] محترق صاحب أخبارهم، وإنّما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه، له من الأخبار المكروه الذي لا أستحبّ ذكره[23].
أمّا الذهبي فكان متحاملاً عليه، ووصفه بأنّه أخباري تالف في الحديث، لا يوثق به، تركه أبو حاتم وضعّفه الدارقطني[24]، وروى عن طائفة من المجهولين[25].
ولوذان لم أعرفه، كما لم أعرف عكرمة، هل أنّه مولى ابن عباس، وهو مطعون فيه[26]، وكان اتهامه أنّه من المارقين، وقد فرض عليه الاختفاء عن أنظار الناس.
وهناك اختلاف في سنة وفاته، قيل: سنة (105هـ)، وقيل: سنة (106هـ)، وقال جماعة: سنة (107هـ)[27].
وإذا كان عكرمة هو ابن عمّار(ت159هـ)، وقيل: (160هـ)، فمختلف في الاحتجاج به[28]، وإذا كنّا لم نعرف عكرمة، فكيف نعرف عمّه الذي دلّست عنه الرواية؟
أمّا متنها فهو عبارة عن تهمة موجهة للإمام عليه السلام، واعتباره طالب سلطة؛ لذلك قال له عمّ عكرمة ـ الذي لم نعرفه ـ إنّك قادم على الأسنّة والسيوف.
ونحن نقول: هو عارف تماماً بذلك، ومَنْ قال: إنّه قادم على عرش وكرسي، وسجادة حمراء، وقصر منيف؟! هذا حطام دنيا لم يعبأ الإمام به، ولم تكن هذه الحادثة وحسب، بل حاول عليه السلام معرفة موقف الناس من نهضته، فـأراد جس نبض الشارع بحسب التعبير المعاصر، وهذا ما رواه أبو مخنف، قال: «إنّ الفرزدق لقاه في الطريق فسلّم عليه، وقال له: أعطاك الله سؤلك، وأمّلك فيما تُحب. فسأله الحسين عليه السلام عن أمر الناس وما وراءه. فقال له: قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أُميّة، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء. فقال له: صدقت، لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ، يفعل ما يشاء، وكلّ يوم ربنا في شأن، إن نزل القضاء بما نُحب فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يتعدّ مَن كان الحق نيته، والتقوى سريرته»[29].
وعلى رواية، قال الفرزدق: «حججتُ فمررت بذات عرق، فإذا بها قباب منصوبة، فقلت: لـمَن هذه؟ قالوا للإمام الحسين عليه السلام، فدخلت عليه…»[30]. وكأنّ التوبيخ موجّه لأهل الكوفة على أنّهم غدرة مكرة، والمعروف أنّ الإمام في طريقه إلى الكوفة، ولقاه الفرزدق البصري في الطريق.
ممّا يلحظ على الرواية أنّها خلطة غير متجانسة، وفيما يخصّ الفرزدق أنّهم فسّقوه، فقد قيل في ترجمته: «الشاعر التميمي من أهل البصرة، كنيته أبو فراس، واسمه همام بن غالب، والفرزدق لقب، روى عن ابن عمر، وأبى هريرة… وكان ظاهر الفسق، هتّاكاً للحُرم، قذّافاً للمحصنات، ومَن كان فيه خصلة من هذه الخصال استحق مجانبة روايته على الأحوال، ومات وعكرمة في يوم واحد سنة (110هـ)»[31].
نُسبت له أبيات قالها في مهر قطام الذي دفعه ابن ملجم فقال:[32]
وَلَم أَرَ مَهراً ساقَهُ ذو سَماحَةٍ كَمَهرِ قَطامٍ من فَصيحٍ وَأَعجَمِ
ثَلاثَةُ آلافٍ وَعَبدٌ وَقَينَةٌ وَضَـربُ عَليٍّ بِالحُسامِ المُصَمِّمِ
فَلا مَهرَ أَغلى مِن عَليٍّ وَإِن غَلا وَلا فَتكَ إلّا دونَ فَتكِ اِبنِ مُلجَمِ(2).
وقد بحثنا في ديوانه ولم نجد الأبيات فيه، وهناك مَن نسبها إلى مجهول فقال: قال الشاعر، ولم يسمِّ قائل الأبيات[33].
وروى معمر بن المثنى، قال: «حدّث عوانة بن الحكم، قال: اجتمع في ضيافة سكينة، ـ وهي تحت مصعب بن الزبيرـ الفرزدق بن غالب، وجرير بن الخطفي، وكثير عزة، ونصيب، وجميل بن معمر، فمكثوا ثلاثاً، فأذنت لهم، فجلسوا حيث تراهم ولا يرونها، وتسمع كلامهم، فخرجت إليهم وصيفة قد روت الأحاديث والأشعار، فقالت: أيّكم الفرزدق؟ فقال: ها أنا ذا. قالت: أنت القائل:
أُحاذِرُ بَوّابَينِ قَد وُكِّلا بِها
وَأَسمَرَ من ساجٍ تَئطُّ مَسامِرُه
فَلَمّا اِستَوَت رِجلايَ في الأَرضِ نادَتا
أَحَيٌّ يُرَجّى أَم قَتيلٍ نُحاذِرُ
فَقُلتُ اِرفَعا الأَسبابَ لا يَشعُروا بِنا
وَوَلَّيتُ في أَعجازِ لَيلٍ أُبادِرُه
هُما دَلَّتاني من ثَمانينَ قامَةً
كَما اِنقَضَّ بازٍ أَقتَمُ الريشِ كاسِرُه
فَأَصبَحتُ في القَومِ الجُلوسِ وَأَصبَحَت مُغَلَّقَةً دوني عَلَيها دَساكِرُه
وَيَحسَبُها باتَت حَصاناً وَقَد جَرَت
لَنا بُرَتاها بالَّذي أَنا شاكِرُه(1).
[34]قال: نعم، أنا قائله. قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرّكما، أَلا سترت على نفسك وعليها، خذ هذه الألف والحق بأهلك»[35].
عن حمّاد الرواية، حدّثني بعض أهل الكوفة، قال: «خرجت حاجّاً، فأتيت منزل سكينة ابنة الحسين مُسلّماً عليها، مُعظماً لحقّها، فألفيت ببابها الفرزدق، وجريراً، وكثير عزة، وجميلاً، والناس مجتمعون ما بين مقتبس من علمهم، وناظر إليهم، فلم ألبث إلّا يسيراً حتى خرجت جارية لها، عليها قميص كأنّ شعاع الشمس فيما بين جلدها وقميصها، وإذا هي بيضاء عطبول، لم يشنها قصر ولا طول، فقالت: سيّدتي تقرأ عليكم السلام، وتقول لكم: أين الفرزدق؟ فقال: ها أنا ذا. قالت: تقول لك سيّدتي: أنت القائل:[36]
إنَّ الَّذي سَمَكَ السَماءَ بَنى لَنا
بَيتاً دَعائـمُهُ أَعَزُّ وَأَطوَلُ
بَيتاً بَناهُ لَنا المَليكُ وَما بَنى
حَكَمُ السَماءُ فَإِنَّهُ لا يُنقَلُ»(3).
لقاه أبو هريرة، فقال له: «كم من محصنة قذفتها»[37].
له قصيدة مدح فيها الإمام الحسين عليه السلام، رواها ابن كثير، عن الطبراني، عن أبي حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي، عن يزيد بن البراء بن عمرو بن البراء الغنوي، عن سليمان بن الهيثم، قال: «كان الإمام الحسين عليه السلام يطوف بالبيت، فأراد أن يستلم فيما وسع له الناس، فقال رجل للفرزدق: مَنْ هذا؟ فأجاب بقوله: [38]
هَذا الَّذي تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأَتَهُ
وَالبَيتُ يَعرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ
هَذا اِبنُ خَيرِ عِبادِ اللَهِ كُلِّهِمُ
هَذا التَقِيُّ النَقِيُّ الطاهِرُ العَلَمُ»(1).
إلى نهاية القصيدة، ثمّ قال ابن كثير: «هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في معجمه الكبير، وهو غريب»[39]، وقد راجعنا المصدر الذي نقل عنه للتأكد من صحة الرواية، فوجدناها عنده[40].
يُضعِف الرواية محمد بن حنيفة الواسطي، «وهو ضعيف ليس بالقوي»[41]. وقال الدارقطني: «غير قوي»[42]. وبقيّة السند مجهولون.
ولكن ما يقوّيها منزلة الخيرية التي تمتّع بها أمير المؤمنين عليه السلام، وهي إحدى فضائله، فقد ورد فيها أحاديث نبوية محمدية كثيرة، منها: «خير الناس مَن نفع الناس». وقد ناقشها أحد الباحثين، فمَن شاء الاطلاع عليها فليراجع[43]، وكذلك ما أُنشد للإمام الحسين عليه السلام في العاشر من المحرّم قوله: «خيرة الله من الخلق أبي»[44].
وهذا ليس قدحاً في شخص الإمام السجاد عليه السلام، وإنّما لكلّ استحقاقه الشرعي، وكأنّ القضية ـ في حرف القصيدة عن الإمام الحسين عليه السلام ـ مقصودة أُريد منها صرف أذهان الناس عن النهضة الحسينية، ولا سيّما الإجابة عن سؤال مهم، مفاده: إذا كان الإمام الحسين عليه السلام بهذه الهيئة، فلماذا قتلتموه؟ فسحبوا البساط، وقالوا: إن المقصود بالقصيدة هو الإمام السجاد عليه السلام؛ لذلك احترمناه ولم نقتله.
وهناك مَن حاول حرف مسار القصيدة، فقال: «المشهور أنّها من قيل الفرزدق في علي بن الحسين عليه السلام لا في أبيه، وهو أشبه، فإنّ الفرزدق لم يرَ الحسين عليه السلام إلّا وهو مقبل إلى الحجّ، والحسين ذاهب إلى العراق، ثمّ إنّ الحسين قُتل بعد مفارقته له بأيام يسيرة، فمتى رآه يطوف بالبيت»[45].
وقد انسحب ذلك على الموروث العلمي لأتباع مذهب آل البيت عليهم السلام، وذهبوا إلى أنّ الفرزدق مدح فيها الإمام زين العابدين عليه السلام في حضرة الملك هشام بن عبد الملك الأُموي الذي حبسه على أثرها، وقبال ذلك أعطاه الإمام مبلغاً من المال، وقال له: «فقد رأى الله مكانك وعلم نيتك»[46]. وعلى الرغم من ذلك فإنّه يبقى أحد المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام بسيفه، لكنّه دافع عنه بلسانه، فيكون موقفه موقف رجال الإعلام، لا يؤمن من خوف ولا يشبع من جوع.
«وقال هشام بن الكلبي، عن عوانة بن الحكم، عن ليطة بن غالب بن الفرزدق، عن أبيه: حججت بأُمّي فبينما أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في أيام الحجّ، وذلك سنة (60هـ)، إذ لقيت الإمام الحسين عليه السلام خارجاً من مكّة معه أسيافه وأتراسه، فقلت له: ما أعجلك عن الحجّ؟ فقال: لو لم أعجل لأُخذت، ثمّ سألني: ممَّن أنت؟ فقلت: امرؤ من العراق. فسألني عن الناس، وساق الخبر، قال الفرزدق: وسألته عن أشياء، وعن المناسك، فأخبرني بها، وإذا هو ثقيل اللسان من برسام[47] كان أصابه بمن بالعراق[48]، ثمّ مضيت، فإذا فسطاط مضروب في الحرم، وهيأة حسنة، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، سألني فأخبرته بما لقيت، قال: فهلّا اتّبعته؟ فإنّه لا يحيك فيه السلاح، ولا يجوز فيه وفي أصحابه، فندم الفرزدق وهمّ أن يلحق به، ووقع في قلبه مقالة ابن عمرو، ثمّ ذكرت الأنبياء وقتلهم؛ فصدّني ذلك عن اللحاق به، فلمّا بلغه أنّه قُتل لعن ابن عمرو، وكان ابن عمرو يقول: والله لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغير حتى يبلغ هذا الأمر ويظهر، وإنّما أراد بقوله: لا يحيك فيه السلاح، أي: السلاح الذي لم يُقدّر أن يُقتل به، وقيل: غير ذلك. وقيل: أراد الهزل بالفرزدق»[49].
السؤال الذي يُضعِف الرواية هو أنّ الفرزدق بصريّ، كيف علم أخبار الكوفة؟ ومن الرواية نُدرك سبب سرعة خروج الإمام عليه السلام، وعدم إدراكه الحجّ، وقد أفصح عنه، فقال: «لو لم أعجل لأُخذت»، ويرد هنا سؤال وهو: إذا كان الأمر هكذا، فلماذا اعترض المعترضون على خروجه، ويضعون افتراضات لا صحة لها؟ إذاً الأمر محسوم لا بدّ من الخروج.
ولم نجد أحداً نقل الرواية عن أبي مخنف إلّا الطبري، نقلها بالسند المتقدّم، سأله الفرزدق عن أشياء، فأخبره بها، من نذور ومناسك، ثمّ لقيّ الفرزدق عبد الله بن عمرو بن العاص، فأخبره الأمر، فقال له: «ويلك! فهلّا اتبعته ـ فو الله ـ ليملكن ولا يجوز السلاح فيه ولا في أصحابه. فقدم الفرزدق على أهله في عسفان، قال: فو الله، إنّي لعندهم إذ أقبلت عِير قد امتازت من الكوفة، فلمّا سمعت بهم خرجت في آثارهم حتى إذا أسمعتهم الصوت وعجلت عن إتيانهم، صرخت بهم: أَلا ما فعل الإمام الحسين عليه السلام؟ قال: فردّوا عليَّ: أَلا قد قُتل. وكان أهل ذلك الزمان يقولون ذلك الأمر وينتظرونه في كلّ يوم وليلة، فقلت له: فما يمنعك أن تبيع الوهط؟ [50] قال: فقال لي: لعنة الله على فلان ـ يعنى معاوية ـ وعليك. فقلت: لا، بل عليك لعنة الله. فزادني من اللعن، ولم يكن عنده من حشمه أحد، فألقى منهم شرّاً، فخرجت وهو لا يعرفني»[51].
السند فيه هشام الكلبي الذي طعن فيه العامّة، ولديه أُغلوطات معروفة أشرنا إلى كثير منها، توفّي سنة (204هـ)[52]، وعوانة بن الحكم، عثماني أمويّ مطعون فيه، توفّي سنة (147هـ)[53].
أمّا «لبطة بن الفرزدق بن غالب التميمي المجاشعي… روى عنه القاسم بن الفضل الحداني، وسفيان بن عيينة»[54]. «الشاعر روى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة»[55]. كان شيخاً كبيراً جليلاً، روى الحديث، «له أخوان خبطة وحنظلة»[56].
وما زلنا في ذكر الفرزدق نذكر له هذا الموقف في موضع الإنكار لا الإقرار، رواه أبو سلمة المنقري، عن معاوية بن عبد الكريم، عن مروان الأصفر، عن الفرزدق، قال: «لمّا خرج الإمام عليه السلام لقيت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنّ هذا قد خرج، فما ترى؟ قال: أرى أن تخرج معه، فإنّك إن أردت دنيا أصبتها، وإن أردت آخرة أصبتها، فرحلت نحوه، فلمّا كنت في بعض الطريق، بلغني قتله، فرجعت إلى عبد الله، فقلت: أين ما ذكرت؟ قال: كان رأياً رأيته. قلت: هذا يدلّ على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره، وهو رأي ابن الزبير، وجماعة من الصحابة شهدوا الحرة»[57].
السند فيه موسى بن إسماعيل التبوذكي، «يكنى أبا سلمة»[58]، «مولى منقر بن عبيد، وهو رجل من أهل رامهرمز، من قرية يقال لها: تبوذك، فنُسب إليها»[59]، «وسُمّي تبوذكياً؛ لأنّه اشترى بتبوذك داراً»[60]، قال: «لا جُزيَ خيراً مَن سمّاني تبوذكي، أنا مولى بني منقر، إنّما نزل داري قوم من أهل تبوذك فسمّوني تبوذكي»[61]، «ويقال له: المنقري نسبةً إلى سيّده منقر»[62]، «ولد في بداية إمارة المنصور العباسي»[63]، «كان أحمر الرأس واللحية، يخضّب بالحناء»[64].
وقد وثّقه ابن سعد، فقال: «ثقة كثير الحديث»[65]، والعجلي[66]، وابن حبّان، وأضاف أنّه من المتقنين[67]، ثقة أيقظ من حجاج الأنماطي، ولا أحداً بالبصرة أحسن حديثاً منه، «قال أبو عاصم النبيل: ما بالبصـرة أعقل منه»[68].
وقال يحيى بن معين: «ما جلست إلى شيخ إلّا هابني، أو عرف لي ما خلاه، ثقةً مأموناً كيّساً، وثّقه الطيالسـي، وأضاف أنّه صدوق، قال علي بن المديني: قديماً مَن لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه، قدِم ابن معين البصـرة، فكُتب عنه»[69].
«الحافظ الإمام الحجة، شيخ الإسلام… وروى عن أعين الخوارزمي من صغار التابعين، وجرير بن حازم، وشعبة حديثاً واحداً، وجويرية بن أسماء، وحمّاد بن سلمة، والقاسم بن الفضل، وهمام بن يحيى، ومبارك بن فضالة، وأبي هلال، ويزيد بن إبراهيم التستري، ومحمد بن راشد المكحولي، وسليمان بن المغيرة، والضحّاك بن نبراس، وعبد العزيز بن الماجشون، وعبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن مسلم، ومهدي بن ميمون، ووهيب، وابن المبارك، وحمّاد بن زيد حديثاً واحداً، وخلق كثير، وكان من بحور العلم، أوّل سماعاته عام (160هـ)، حدّث عنه: البخاري، وأبو داوود، والباقون عن رجل عنه، والحسن بن علي الخلال، ويحيى بن معين، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن الحسن الترمذي، وأبو زرعة، ويعقوب الفسوي، وإبراهيم بن ديزيل، وإبراهيم الحربي، وإسماعيل سمويه، وأبو حاتم، ومحمد بن غالب تمتام، وأبو الأحوص العكبري، ومحمد ابن أيوب بن الضريس، والعباس بن الفضل الأسفاطي، وسبطه أبو بكر بن أبي عاصم، وأحمد بن داوود المكي، وخلق كثير»[70].
«مات بالبصرة ليلة الثلاثاء 13رجب سنة (223هـ)»[71]. «وقيل: سنة (226هـ)»[72].
والغريب أننا لم نعرف مذهب الرجل، ولماذا التوثيق الشديد؟ كما لم نجد أيّ رابطة تربطه مع ابن سعد الذي نقل عنه الرواية، ولا مع شيخه سليمان الضبعي، ولا نعرف كيفية وضع السند بهذه الطريقة، ومَن المسؤول عنها، وكأنّي قد وضعت الرجل في غير محلّه، وربّما يكون المراد بموسى بن إسماعيل غير هذا.
و«معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنّما سمّي بذلك؛ لأنّه ضلّ في طريق مكّة»[73]. «وليس.. من الضلالة في الدين، بل اشتُهر بهذه الصفة أبو عبد الرحمن الثقفي من آل أبي بكرة… من عقلاء أهل البصـرة ومتقنيهم وثقاتهم»[74].
ترجم له البخاري في الضعفاء الصغير، فقال: «أصله ثقفي، وما أعلم رجلاً أعقل منه»[75]. وقيل: كان معه رجل يسمّى معاوية، فربما نادوا معاوية، فيجيب الآخر، فقالوا: معاوية الضال، فيميّز بينهما، وقيل: ثقة ما أثبت حديثه، وما أصح حديثه، بعض ما روى عن عطاء لم يسمعه، فأنكره، وقال: هو يروي بعضها عن قيس وبعضها يقول: سمعت عطاء ـ أي: فلا يدلّس ـ وهو أحبّ من إسماعيل بن مسلم، وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث محلّه الصدق، ولا يحتج به، يحول منه[76]. وترجم له ابن حبّان في الثقات[77]. وقال ابن شاهين: «ليس به بأس ثقة»[78]. «وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عبد الغني بن سعيد المصـري الحافظ: رجلان نبيلان لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم الضال، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنّما كان ضعيفاً في جسمه لا في حديثه»[79]. وقال الذهبي:«كان مسنداً معمراً، وليس بالمكثر»[80].
وفي تهذيب الكمال: «روى عن إياس بن معاوية بن قرّة المزني، وبكر بن عبد الله المزني، وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، والحسن البصري، وعامر بن عبيدة الباهلي، وعبّاد بن منصور، وعبد الله بن بريدة، وأبيه عبد الكريم الثقفي، وعبد الملك بن يعلى الليثي قاضي البصرة، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وقيس بن سعد المكي، ومحمد بن سيرين، ومروان الأصفر، وأبي جمرة الضبعي، روى عنه إبراهيم بن بشير المكي، وإبراهيم بن موسى الرازي، وأحمد بن إبراهيم الموصلي، وأحمد بن أسد البجلي ابن بنت مالك بن مغول، وحاتم بن عبيد الله النميري، وحامد بن عمر البكراوي، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن سوار العنبري، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبيد الله بن عمر القواريري، وعلي بن المديني، وعمر بن يحيى بن نافع الأبلي، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، وقتيبة بن سعيد، وليث بن خالد البلخي، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن سليمان لوين، ومحمد بن عبيد بن حساب، ومحمد بن موسى الحرشي، وأبو خداش مخلد بن خداش الكوفي، ومنين بن طالب البصري، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل، ويحيى بن يحيى النيسابوري… مات سنة (180هـ)»[81].
أمّا «مروان الأصفر، أبو خلف البصري، يقال: مروان بن خاقان، وقيل: إنّهما اثنان، روى عن أنس بن مالك، وأبي وائل شقيق بن سلمة، وصعصعة بن معاوية، وعامر الشعبي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومسـروق بن الأجدع، وأبي رافع الصائغ، وأبي هريرة، روى عنه جعفر بن برقان، وحرب بن ثابت، والحسن بن ذكوان، وخالد الحذاء، وسليم بن حيّان، وشعبة بن الحجاج، وعوف الأعرابي، وعيينة بن عبد الرحمان ابن جوشن، ومبارك بن فضالة، ومعاوية بن عبد الكريم الضال، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داوود، والترمذي»[82].
ذكره ابن أبي حاتم ولم يشر إلى مدحه أو قدحه[83]، وابن حبّان في الثقات[84]، ووثّقه أبو داوود[85]، وابن حجر[86].
من مروياته، أنّه قال: «رأيت ابن عمر أبرك بعيراً بينه وبين القبلة، ثمّ بال، فقلت يا أبا عبد الرحمن، ألستم تكرهون هذا؟ قال: إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترها فلا بأس»[87]، هذا كلّ ما وجدناه عن الرجل، ولم نعرف له تاريخ وفاة، وعليه نعدّه شخصية وهميّة، لم تحصل له رؤية الفرزدق.
روى ابن كثير، عن يحيى بن معين، عن أبي عبيدة، عن سليم بن حيّان، عن سعيد ابن مينا، عن عبد الله بن عمرو، قال: «عجّل الإمام الحسين عليه السلام قدره، والله لو أدركته ما تركته يخرج إلّا أن يغلبني، ببني هاشم فُتح هذا الأمر، وببني هاشم يُختم، فإذا رأيت الهاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان»[88]. للتحقق من صحة الرواية، نقول: هي أُحادية، أقدم مَن نقلها ابن عساكر، وقد نسب هذا القول إلى عبد الله بن عمر[89].
قال ابن كثير: «وهذا يدلّ على أنّ الفاطميين أدعياء كذبة، لم يكونوا من سلالة فاطمة كما نصّ عليه غير واحد من الأئمّة»[90]. وهذا ذكرناه في معرض الإنكار ولسنا في محلّ الردّ عليه، ولم نعرف عبد الله بن عمرو، لعلّه ابن العاص، والعياذ بالله، وحرصه هذا غريب، ألم يكن هو ابن مستشار معاوية، وأحد ولاته؟!
أمّا السند ففيه «يحيى بن معين بن عون بن زياد بن عون أبو زكريا البغدادي أصله من سرخس»[91]، «أكثر من كتابة الحديث وعُرف به»[92]، «إمام الجرح والتعديل»[93].
«روى عن هشيم، ومعتمر بن سليمان وابن علية، وجرير، روى عنه أبو زرعة، وأحمد ابن منصور الرمادي، وعباس الدوري، ومحمد بن هارون الفلاس المخرمى… قيل عنه: إمام»[94]. من أهل الدين والفضل وممَّن رفض الدنيا في جمع السنن، وكثرت عنايته بها، وجمعه لها، وحفظه إيّاها حتى صار علماً يُقتدى به في الأخبار، وإماماً يُرجع إليه في الآثار، مات سنة (233هـ)بالمدينة وهو حاجّ، وحمل على نعش ومناد ينادى بين يدي جنازته: معشر المسلمين، هذا ذبّ الكذب عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) كذا وكذا عاماً[95].
و«عبد الواحد بن واصل السدوسي، مولاهم، أبو عبيدة الحداد البصري، سكن بغداد»[96]. ذكره ابن حبّان في الثقات[97]، ووثّقه أبو داوود[98]، وابن معين[99]، والعجلي[100].لم يُحدّث إلّا ببغداد[101]، ثقة من المتثبتين ما أُخذ عليه خطأ البتة، جيّد القراءة لكتابه[102].
أخرج له البخاري في الصلاة[103]، «روى عن أبان بن صمعة، والأخضر بن عجلان، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وإسماعيل بن سليمان الكحال، وبهز بن حكيم، وثابت بن عمارة الحنفي، والحكم بن فروخ، وحميد بن مهران، والخزرج بن عثمان، وخلف بن مهران، وسعد بن أوس البصـري، وسعيد بن عبيد الله الثقفي، وسعيد بن أبي عروبة، وسكين بن عبد العزيز، وسليم بن حيّان، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن عبيد مؤذّن مسجد جراذان، وعبد الله بن عون، وعبد الجليل بن عطيّة، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وعبد الواحد بن زيد الزاهد، وعبيد الله بن الأخنس، وعتاب بن عبد العزيز، وعثمان بن أبي رواد، وعثمان بن سعد الكاتب، وعمارة بن زاذان الصيدلاني، وعمر بن أبي زائدة، وعمر بن سليط الهذلي والد إسحاق بن عمر بن سليط، وعوف الأعرابي، وعيسى بن حميد الراسبي، وعيينة بن عبد الرحمان بن جوشن، وفروة بن يونس البصري، وليث بن كيسان العبدي، ومحمد بن ثابت البناني، ومرزوق أبي عبد الله الشامي، ومعاذ ابن العلاء المازني أخي أبي عمرو بن العلاء، والمعلى بن جابر اللقيطي، والمغيرة بن عبيد الله الثقفي، وهشام بن حسان، والوليد بن ثعلبة، ويونس بن أبي إسحاق، روى عنه ابن حنبل، وأبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي السفر الهمداني، وأبو معمّر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي القطيعي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وزياد بن أيوب الطوسي، وسعيد ابن محمد الجرمي، وعبد الله بن عون الخراز، وعمرو بن زرارة النيسابوري، وعمرو ابن محمد الناقد، والفضل بن الصباح البغدادي، ومحمد بن إبراهيم الأسباطي، ومحمد ابن شجاع المروزي، ومحمد بن صالح الخياط، ومحمد بن الصباح الدولابي، ومحمد بن قدامة بن أعين المصيصي، ويحيى بن أيوب المقابري العابد، ويحيى بن معين… صاحب شيوخ، لم يكن صاحب حفظ إلّا أنّ كتابه صحيحاً، وثّقه يعقوب بن شيبة، ويعقوب بن
سفيان زاد ابن شيبة: صالح الحديث… روى له البخاري، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي»[104].
«لم يكن صاحب حفظ، وكان كتابه صحيحاً»[105]، «قال ابن حنبل: أخشى أن يكون ضعيفاً»[106]، مات سنة (190هـ)[107].
و«سليم بن حيّان البصري، روى عن سعيد بن ميناء، وأبيه، وعكرمة بن خالد، وأبي غالب، وأبي المهزم، ومروان الأصفر، روى عنه عبد الرحمن بن مهدى، وأبو عبيدة الحداد، وأبو داوود، ويزيد بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعفان، ومسلم ابن إبراهيم، وعمرو بن مرزرق، وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ما به بأس»[108]، «صدوق»[109]، وثّقه ابن حنبل[110]، وابن حبّان[111]، ولم نعرف سنة وفاته ولا مذهبه.
و«سعيد بن مينا المكي، ويقال: المدني، أبو الوليد، مولى البختري بن أبي ذباب، أخو سليمان بن ميناء، روى عن الأصبغ بن نباتة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبي هريرة، روى عنه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وأيوب السختياني، وحمّاد بن يحيى الأبح، وحنظلة بن أبي سفيان، وزيد بن أبي أنيسة، وسليم بن حيّان، وعبد الملك بن جريج، وعمرو بن قيس المكّي، ومحمد بن إسحاق بن يسار، والمعلّى بن هلال، وثّقه ابن معين، وأبو حاتم… روى له الجماعة سوى النسائي»[112]، «الإمام الثقة أبو الوليد الحجازي، حديثه في الصحاح»[113]، وثّقه ابن حجر[114]، وأخرج البخاري في الجنائز والسير والبيوع والجهاد وغيرها، قال أبو زرعة: «هو مدني ثقة»[115] «مكي، روى عنه سليم بن حيّان، وحمّاد الأبح»[116]، وثّقه ابن حنبل[117].
وذكر ابن أبي حاتم أنّه مديني، ولم يشـر إلى مدحه أو قدحه[118]، كما ذكره ابن حبّان[119]، ووثّقه النسائي[120]، هذا كلّ ما وجدناه عنه، ولم نعرف مذهبه ولا سنة وفاته، ولا مدينته، قيل: مكي، وقيل: مدني، وأُخرى مديني، وغيرها حجازي.
ممّا تقدّم اتّضح أنّ كلّ الذين عارضوا خروج الإمام الحسين عليه السلام نهوه عن التوجّه إلى العراق، مستندين في ذلك إلى خطب أمير المؤمنين عليه السلام في ذمِّ أهل الكوفة وهو يستنهضهم لقتال القاسطين معرباً إيّاهم أنّ ما يُريده منهم الدفاع عن بلادهم، والقتال تحت راية إمامهم، وقد كلّمهم بهكذا كلام، وكأنّهم أموات لا يجيبون، مصوراً ذلك المشهد أدقّ تصوير بقوله: «أيّها الناس، المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم كلامكم يوهي الصمّ الصلاب، وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء، تقولون في المجالس: كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد ما عزّت دعوة مَن دعاكم، ولا استراح قلب مَن قاساكم، أعاليل بأضاليل، دفاع ذي الدين المطول لا يمنع الضيم الذليل، ولا يُدرك الحق إلّا بالجد، أيّ دار بعد داركم تمنعون، ومع أيّ إمام بعدي تقاتلون، المغرور والله مَن غررتموه، ومَن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومَن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أصبحت والله، لا أُصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم، أقولاً بغير عمل، وغفلة من غير ورع، وطمعاً في غير حق؟!»[121].
وعندما تواترت عليه الأخبار باستيلاء قوم معاوية على أجزاء من دولته، قام إلى المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد، ومخالفتهم له في الرأي، فقال: «ما هي إلّا الكوفة أقبضها وأبسطها، إن لم تكوني إلّا أنتِ تهب أعاصيركِ، فقبحكِ الله، ثمّ قال: إنّي والله، لأظنّ أنّ هؤلاء القوم سينالون منكم باجتماعهم على باطلهم، وتفرقكم عن حقّكم، وبمعصيتكم إمامكم في الحقّ، وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم، فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته، اللهمّ إنّي قد مللتهم وملّوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شرّاً منّي، اللهمّ مث قلوبهم كما يُماث الملح في الماء، أَما والله، لوددت أنّ لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم هنالك لو دعوت أتاك منهم، فوارس مثل أرمية الحميم»[122].
وذكر الكوفة فقال: «كأنّي بكِ يا كوفة، تمدين مدّ الأديم العكاظي، تعركين بالنوازل وتركبين بالزلازل، وإنّي لأعلم أنّه ما أراد بك جبار سوءاً إلّا ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل»[123].
وفي موضع آخر مخاطباً قومه ومحذّرهم خطر قوم معاوية، فقال: «أَما والذي نفسـي بيده، ليظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنّهم أولى بالحق منكم؛ ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقّي، ولقد أصبحت الأُمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي، استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرّاً وجهراً فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا، أشهود كغياب وعبيد كأرباب؟! أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرّقون عنها، وأحثّكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر القول حتى أراكم متفرّقين أيادي سبا، ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم، أُقوّمكم غدوة وترجعون إليّ عشية كظهر الحيّة، عجز المقوّم وأعضل المقوّم، أيّها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يُطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه، لوددت والله أنّ معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ منّي عشرة منكم وأعطاني رجلاً منهم، يا أهل الكوفة، مُنيت بكم بثلاث واثنتين، صُمٌ ذوو أسماع، وبُكمٌ ذوو كلام، وعُميٌ ذوو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم، يا أشباه الإبل، غاب عنها رعاتها كلّما جُمعت من جانب تفرّقت من جانب آخر، والله لكأني بكم فيما أخال أن لو حمس الوغى وحمي الضـراب، وقد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها، وإنّي لعلى بينة من ربي، ومنهاج من نبيي، وإنّي لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً، اُنظروا أهل بيت نبيّكم فألزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يُعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا»[124].
وكيف لا يذم أهل الكوفة، وقد همّ قوم من جندهم اللحاق بالمارقين، وكانوا على خوف منه، فقال له: «أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟… بُعداً لهم كما بعُدت ثمود، أَما لو أُشرعت الأسنّة إليهم، وصُبت السيوف على هاماتهم، لقد ندموا على ما كان منهم، إنّ الشيطان اليوم قد استفلهم، وهو غداً مُتبرئ منهم ومُتخل عنهم، فحسبهم بخروجهم من الهدى، وارتكاسهم في الضلال والعمى، وصدهم عن الحق، وجماحهم في التيه»[125].
المبحث الثاني: أسباب ذهابه إلى العراق
عزم الإمام الحسين عليه السلام على المسير فخرج من مكّة أيام التروية، قبل مقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام بيوم واحد؛ إذ قُتل يوم عرفة[126]، ولا بدّ من اختياره العراق؛ لأسباب، منها:
الأوّل:كُتب أهل العراق على رأس الأسباب التي وضعها بعض البشر، فقد كثر ورود الكتب عليه من أهل الكوفة يعدونه بالقدوم إليهم، حين بلغهم موت معاوية وولاية يزيد، فكان أوّل مَن قدِم عليه عبد الله بن سبع الهمداني، وعبد الله بن وال، ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية، فقدما عليه يوم (10) رمضان سنة (60هـ)، ثمّ جاء نفر، منهم: قيس بن مسهّر الضدائي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكوا الأرحبي، وعمارة بن عبد الله السلولي، ومعهم حوالي (150) كتاباً، ثمّ بعثوا هانئ بن السبيعي، وسعيد بن عبد الله الحنفي، ومعهما كتاب يحثه عليه السلام على الاستعجال في السير إليهم، وكتب إليه شبث بن ربعي، وحجار بن أبجر، ويزيد بن الحارث، ويزيد بن رويم، وعمرو بن الحجاج الزبيدي، ومحمد بن عمر بن يحيى التميمي: أمّا بعدُ فقد اخضرّت الجنان، وأينعت الثمار، ولطمت الجمام، فإذا شئت فأقدم على جندٍ لك مجنّدة، والسلام عليك. فاجتمعت الرسل كلّها بكُتبها عنده، وجعلوا يستحثونه ويستقدمونه عليهم؛ ليبايعوه عوضاً عن يزيد، ويذكرون في كتبهم أنّهم فرحوا بموت معاوية، وينالون منه ويتكلّمون في دولته، وأنّهم لم يبايعوا أحداً إلى الآن، وينتظرون قدومه إليهم ليقدّموه عليهم[127].
وقد تمت مراجعة أصل الرواية، فوجدناها من روايات الطبري، رواها عن أبي مخنف، عن الحجاج بن علي، عن محمد بن بشر الهمداني، قال: «اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد، فذكرنا هلاك معاوية، فحمدنا الله عليه، فقال سليمان بن صرد: إنّ معاوية قد هلك، وإنّ حسيناً قد تقبّض على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكّة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهل والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه. قالوا: لا، بل نقاتل عدوه، ونقتل أنفسنا دونه. فكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان بن صرد، والمسيّب بن نجبة، ورفاعة بن شداد، وحبيب بن مظاهر، وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، سلام عليك، فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلّا هو، أمّا بعدُ، فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد، الذي انتزى على هذه الأُمّة، فابتزها أمرها، وغصبها فيأها وتأمر عليها بغير رضى منها، ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبُعداً له كما بعُدت ثمود، إنّه ليس علينا إمام فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحق، والنعمان بن بشير[128] في قصـر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله، والسلام ورحمة الله عليك، ثمّ سرّحنا الكتاب مع عبد الله بن سبع الهمداني، وعبد الله بن وال، وأمرناهما بالنجاء، فخرج الرجلان مسرعين حتى قدما عليه لعشر مضين من رمضان بمكة، ثمّ لبثنا يومين، ثمّ سرّحنا إليه قيس بن مسهر الصيداوي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي، وعمارة بن عبيد السلولى، فحملوا معهم نحواً من ثلاثة وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة، ثمّ لبثنا يومين آخرين، ثمّ سرّحنا إليه هانئ بن هانئ السبيعي، وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكتبنا معهما: بسم الله الرحمن الرحيم، لحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين، أمّا بعدُ، فحيهلا فإنّ الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك، فالعجل العجل والسلام عليك. وكتب شبث بن ربعي، وحجار بن أبجر، ويزيد بن الحارث، ويزيد بن رويم، وعزرة بن قيس، وعمرو بن الحجاج الزبيدي، ومحمد بن عمير التميمي، أمّا بعدُ فقد اخضـرّ الجناب، وأينعت الثمار، وطمت الجمام، فإذا شئت فأقدم على جندٍ لك مجندة، والسلام عليك. وتلاقت الرسل كلّها عنده، فقرأ الكتب وسأل الرسل عن أمر الناس، ثمّ كتب مع هانئ بن هانئ السبيعي، وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل: بسم الله الرحمن الرحيم، من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أمّا بعدُ، فإنّ هانئاً وسعيداً قدما عليَّ بكتبكم، وكانا آخر مَن قدِم عليَّ من رسلكم، وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم»[129].
وحتى نتحقّق من صحة الرواية لا بدّ من معرفة سندها الذي فيه الحجاج بن علي الهمداني، الذي روى عنه أبو مخنف، عن محمد بن بشير الهمداني، قال: «لمّا ضرب عبيد الله هانئاً وحبسه، خشي أن يثب الناس به، فخرج فصعد المنبر، ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعدُ، أيّها الناس، فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمّتكم، ولا تختلفوا ولا تفرّقوا، فتهلكوا وتذلّوا، وتجفوا وتحرموا، إنّ أخاك مَن صدقك، وقد أُعذر مَن أُنذر. قال: ثمّ ذهب لينزل، فما نزل عن المنبر حتى دخلت النظارة المسجد من قِبل التمّارين، يشتدون ويقولون: قد جاء ابن عقيل، فدخل ابن زياد القصـر مسـرعاً وأغلق أبوابه»[130].
اتضّح من الرواية أنّ الهمداني هذا كان حاضراً الوقعة سنة (60هـ)، ومعاصراً لأبي مخنف المتوفّى (170هـ) أو (175هـ)؛ بحيث نقل الرواية له، وهذا أوّل عوامل الضعف في الرواية؛ لبعد الفارق الزمني بينهما، ومن الثوابت التي يجب تثبيتها أنّ أبا مخنف نقل عنه من دون واسطة في هذه الرواية.
هذا كلّ ما وجدناه عن الرجل، ولم نعرف أيّ تفصيلات عن حياته، ولا شيء عن وفاته، ولم نطمئن لوجوده، ونعدّه شخصية وهمية.
والحال نفسها مع محمد بن بشـر الهمداني الذي سمع محمد بن الحنفيّة، يقول: «حدّثني أمير المؤمنين عليه السلام، أنّ النبي عليها السلام يوم القيامة آخذ بحجزة الله، ونحن آخذون بحجزة نبيّنا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا. قلت: وما الحجزة؟ قال: الله أعظم من أن يوصف بالحجزة أو غير ذلك، ولكن النبي عليها السلام آخذ بأمر الله، ونحن آل محمد آخذون بأمر نبيّنا، وشيعتنا آخذون بأمرنا»[131]، وكذلك روى عن ابن الحنفيّة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «لأن أجمع ناساً من إخواني على صاع من طعام، أحبّ إليّ من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فاعتقها»[132].
وروى أبو مخنف عن عبد الله بن عاصم، عن محمد بن بشر الهمداني، قال: «ورد كتاب أمير المؤمنين عليه السلام مع عمرو بن سلمة الأرحبي إلى أهل الكوفة، فكبّر الناس تكبيرةً سمعها عامّة الناس، واجتمعوا لها في المسجد ونودي: الصلاة جمعاً، فلم يتخلّف أحد وقُرئ الكتاب»[133].
هذا كلّ تاريخ الرجل، وقد حاولنا إسقاط لقبه (الهمداني)، والبحث عنه من دون لقب، فوجدنا أسماء عدّة لم يكن هو من بينهم، نذكر منهم:
أولاً: «محمد بن بشر بن بشير بن معبد الأسلمي، كوفي، أسند عنه، مات سنة (163هـ)، وهو ابن (67) سنة»[134]، «روى عن أبيه، وإياس بن سلمة، وزياد بن علاقة، وعبد العزيز بن حكيم الحضـرمي، روى عنه عبد الله بن المبارك، وأبو أحمد الزبيري، وطلق بن غنام، وأبو عاصم النبيل، وأبو نعيم»[135].
ثانياً: «محمد بن بشر اللفافي، كوفي»[136].
ثالثاً: «محمد بن بشر السوسنجردي، من غلمان أبي سهل النوبختي، ويُعرف بالحمدوني، يُنسب إلى آل حمدون، وله كُتب، منها: كتاب الإنقاذ في الإمامة»[137].
رابعاً: «محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي، ويكنى أبا عبد الله توفّي بالكوفة في جمادى الأُولى سنة (203هـ) في أمارة المأمون، ثقة كثير الحديث»[138]، وقد وثّقه العجلي[139]، وذكر ابن أبي حاتم أنّه: «من عبد القيس من أصحاب الحسن بن صالح، روى عن إسماعيل ابن أبي خالد، والأعمش، وزكريا بن أبى زائدة، ومسعر، ومحمد بن عمرو، روى عنه جعفر بن عون، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وابنا أبي شيبة، وثّقه ابن معين»[140].
خامساً: «محمد بن بشر الأنصاري، روى عن النبي عليها السلام، روى عنه ابنه يحيى بن محمد ابن بشـر».
سادساً: «محمد بن بشر، روى عن أبى سعيد عقيصا، روى عنه هشيم».
سابعاً: «محمد بن بشر الحمصى السكوني، ثمّ الكندى، أبو عبد الله روى عن إسماعيل ابن عيّاش كتاب الفتن».
ثامناً: «محمد بن بشر أبو عبد الله الرازي الأرنبوي، روى عن أبي داوود الطيالسـي، والأصمعي».
تاسعاً: «محمد بن بشر الحريري الأسدي الكوفي، روى عن سعيد بن بشير، ومعروف الدمشقي».
عاشراً: «محمد بن بشر بن سفيان الجرجرائي، روى عن إسحاق بن سليمان الرازي، وأبي بدر شجاع بن الوليد، وزيد بن حباب، وشبابة، وموسى بن داوود سمعت منه بجرجرايا وهو صدوق»[141]. وأخيراً لم يطمئن الباحث لصحة السند، ويعدّه وهميّاً.
حتى قيل: أتته بيعة أربعين ألفاً يحلفون بالطلاق والعتاق[142]. وهذا العدد يدعونا إلى التساؤل عن عدد سكّان الكوفة حينها حتى بايع هذا العدد منهم.
ومع ذلك إن صحّ هذا، فالعدد لا يُستهان به، بل يمكن مقارعة دولة بني أُميّة برمّتها، والتغلّب عليها إن توافرت النيّة عندهم، وهذه الرواية سالبة بانتفاء الموضوع؛ لأنّ الإمام عاش في الكوفة حيناً من الزمن، وعرف موقف أهلها من خلافة أبيه وأخيه عليهما السلام، وسمع ووعى ما قاله أبوه عنهم، وهو أمر لا يمكن تجاهله، ولهذا من المستحيل أن يغترّ بوعودهم الكاذبة؛ لأنّ «المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين»، هكذا قال النبي عليها السلام[143].
ويُضعِف الرواية، عدم وجود شخصية عمارة بن عبد الله السلولي، فهو غير معروف إلّا في هذا المورد، وقيل: هو عمارة بن عبيد، وهذا مجهول أيضاً، والحال نفسها مع عبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي، فقد ذكره الطوسي في رجاله على أنّه من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام[144]، وقُتل معه في واقعة الطفّ، ووقع التسليم عليه في زيارة الناحية، وأنّه من المقتولين في الحملة الأُولى [145]، لكن الباحث لا يركن لذلك ويعتبره شخصية وهمية، بلا تاريخ.
وعلى رواية قالوا: «وبعث أهل العراق إليه الرسل والكتب يدعونه إليهم، فخرج متوجّهاً إليهم في أهل بيته، وستين شخصاً من أهل الكوفة صحبته، وذلك يوم الإثنين في عشر ذي الحجة»[146]، ولم نعرف مَنْ هم الذين قالوا، والفعل دالّ على الجماعة، وكذلك لم نعرف الستين شخصاً الذين رافقوه، ولا نعرف موقفهم يوم الواقعة، هل إنّهم تفرّقوا عنه أم لقوا حتفهم معه؟
وبعد ذلك لا بدّ من معرفة القيادات الشيعية التي كاتبت الإمام عليه السلام، ولماذا لم تنصـره حين الواقعة؟ ومنهم: «سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون، وهو عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو، يكنى أبا مطرف… كان اسمه يسار، فغيّره النبي عليها السلام»[147]، «وخزاعة هم ولد حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماء… خيّراً فاضلاً، له دين وعبادة»[148].
وقد اختلفت الألفاظ حول صحبته النبي عليها السلام، فقيل: إنّه أسلم وصحب النبي عليها السلام، وكانت له سنّ عالية، وشرف في قومه[149]، وقيل: «كوفي له رؤية»[150]، و«له صحبة»[151]، وأنّه «الصحابي، له رواية يسيرة»[152]، وأنّه «أدرك النبي عليها السلام»[153].
وقبال ذلك هناك مَن عدّه تابعياً، إذ نقل الخوئي عن الكشـي قوله: «هو من التابعين الكبار، ورؤسائهم، وزهادهم»[154]، وقال الخوئي: «ما ذكره الشيخ ـ لعله الطوسي ـ من كون سليمان بن صرد من أصحاب رسول الله عليها السلام لعلّه مأخوذ من بعض كتب العامّة، وإلّا فقد صرّح الفضل بن شاذان بأنّه من التابعين»[155].
وحتى نخلص إلى نتيجة علمية مقبولة تحسم الأمر إن كان صحابياً أم تابعياً، لا بدّ أن نتعكز على تقدير عمره يوم استشهاده، فقيل: قتل وهو ابن (93) سنة[156]، فإذا حسبنا ذلك رياضياً من تاريخ استشهاده سنة (65هـ)، ورجعنا للوراء (93) سنة تكون ولادته سنة (28) قبل الهجرة، وبهذا يكون صحابياً، له ما للصحابة من الحصانة والتقديس أُسوة بغيره.
وبعد استشهاد النبي عليها السلام تحوّل إلى الكوفة حين نزلها المسلمون، وابتنى بها داراً في خزاعة[157] وشهد مع أمير المؤمنين عليه السلام الناكثين والقاسطين[158]، والصحيح أنّه لم يحضر معركة الناكثين، وإنّما تخلّف عنها[159]؛ إذ التقى وأمير المؤمنين عليه السلام وراء نجران الكوفة، فصرف وجهه عنه، ولمّا دخلها عاتبه، وقال له: كنتَ من أوثق الناس في نفسي، فاعتذر، وقال: يا أمير المؤمنين استبق مودّتي تخلص لك نصيحتي[160].
وعلى رواية قال له أمير المؤمنين عليه السلام: «تربّصت وتنأنأت فكيف ترى صنع الله؟ فأجاب: الشوط بطين وقد بقيَ من الأُمور ما تعرف به صديقك من عدوك»، وعلى رواية قال أمير المؤمنين له: «تأخرت فقد أغنى الله عنك»، وقد حاول استمالة الإمام الحسن عليه السلام، فقال له: «ما أراك عذرتني عنده، وقد كنت حريصاً على أن أشهد معه، فقال: يلومك وقد قال يوم الناكثين: يا حسن هبلتك أُمّك، ما ظنّك بأمر قد جمع بين هذين الغارين ما أرى أن بعد هذا»[161]، وعلى رواية قال للإمام الحسن عليه السلام: «أعذرني عند أمير المؤمنين، فإنّما منعني من الجمل كذا وكذا. فقال الحسن: لقد رأيته ـ يعني أباه حين اشتدّ القتال ـ يقول: لوددت أنّي متّ قبل هذا بعشرين سنة»[162].
وقد دافع الخوئي عنه بحيث وصل به الأمر إلى حدّ التشكيك في نسبة كتاب وقعة صفّين لمؤلفه نصر بن مزاحم المنقري، بقوله: «لا ينبغي الإشكال في جلالة سليمان بن صرد، وعظمته، لشهادة الفضل بن شاذان بذلك، وأمّا تخلّفه عن أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة الناكثين فهو ثابت، ولعلّ ذلك كان لعذر أو بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام، فإنّ ما روي عن كتاب وقعة صفّين لنصر بن مزاحم، من عتاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعذله سليمان بن صرد في قعوده عن نصـرته بعد رجوعه عليه السلام من المعركة لا يمكن تصديقه؛ لأنّ عدّة من رواته لم تثبت وثاقتهم، على أنّه لم يثبت كون هذا الكتاب عن نصـر بن مزاحم بطريق معتبر، فلعلّ القصة مكذوبة عليه كما احتمله الطوسي»[163].
ونحن في هذا المقام نحترم هذا الرأي ونقدّس صاحبه، ولكن التبريرات التي قدّمها بخصوص تخلّف الرجل غير مقبولة؛ بدلالة توبيخ أمير المؤمنين عليه السلام إيّاه، وقد كانت الميول إلى هذا الرأي واضحة وأنّه من أجل تفنيد رواية هَدَمَ دراية فإنّ سماحة السيّد من أجل الدفاع عن سليمان هدم هذا التراث الضخم، وعليه فإنّنا نعتقد بضرورة إعادة النظر في الموضوع؛ لأنّ الأمر خطير لا يمكن قبوله بهذه السهولة، وفي الوقت نفسه، لو اطّلع بعض الجهلة على هذا الرأي، لأقاموا الدنيا، وقد قدّم الباحث أدلة قرآنية على عدم صحة رواية في أحد كتب الشـريف الرضي، فأُقيمت الدنيا عليه ولم تقعد، وإلى اليوم ينظرون إليه نظرة دونية، علماً أنّ الباحث مع سماحة السيّد جملةً وتفصيلاً، وحبذا أن نغربل التراث الشيعي ونمايز بين الجيّد والرديء، وأن نجري ذلك على كتاب سليم، وغيره كثير، حيث وضع عليها الباحث علامات استفهام.
بعد كلّ هذا نقول: مثلما تخاذل الرجل في معركة الناكثين، تخاذل في معركة كربلاء، وألتمس العذر لسماحة أستاذ المحققين لعلّ هذا الرأي ليس له وإنّما حُشر عند الطباعة، أو هو من عمل شخص آخر.
وشارك مع أمير المؤمنين عليه السلام في معركة القاسطين، وهو الذي قتل حوشباً ذا ظليم الألهاني مبارزةً، ثمّ اختلط الناس يومئذٍ[164].
كل ما يعنينا في هذا المورد موقفه من النهضة الحسينية، فقد كان فيمَن كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم الكوفة، فلمّا قدِمها أمسك عنه ولم يقاتل معه، وكان كثير الشك والوقوف، فلمّا قُتل الحسين عليه السلام، ندم هو والمسيّب بن نجية الفزاري، وجميع مَن خذله ولم يقاتل معه، فقالوا: ما المخرج والتوبة ممّا صنعنا؟ فخرجوا فعسكروا بالنخيلة[165]، لمستهل شهر ربيع الآخر سنة (65هـ)، وولّوا أمرهم سليمان بن صرد، وقالوا: نخرج إلى الشام، فنطلب بدم الحسين عليه السلام، فسُمّوا التوابين، وكانوا أربعة آلاف، فخرجوا فأتوا عين الوردة، وهي ناحية قرقيسياء[166]، «فلقيهم جمع من أهل الشام، وهم عشرون ألفاً، عليهم الحصين بن نمير، فقاتلوهم فترجّل سليمان بن صرد، فقاتل فرماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله، وقال: فزت وربّ الكعبة، وقُتل عامّة أصحابه، ورجع مَن بقيَ منهم إلى الكوفة، وحمل رأس سليمان بن صرد، والمسيّب بن نجبة، إلى مروان بن الحكم، أدهم بن محرز الباهلي»[167].
وقيل: «قام سليمان بن صرد الخزاعي، والمسيّب بن نجبة الفزاري، وخرجا في جماعة معهما من شيعة العراق، بموضع يقال له: عين الوردة، يطلبون بدم الحسين عليه السلام، ويعملون بما أمر الله به بني إسرائيل، إذ قال: (فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)[168]، واتّبعهم خلق من الناس، فوجّه إليهم مروان، ابنَ زياد، وقال: إن غلبت على العراق فأنت أميرها، فلقيَ سليمان بن صرد، فلم يزل يحاربه حتى قتله، وقيل: لم يُقتل سليمان في أيام مروان، ولكنّه قُتل في أيام عبد الملك»[169].
وعلى رواية «كان مع الإمام الحسين عليه السلام، فلمّا قُتل انفرد من عسكره تسعة آلاف نفس فيهم سليمان بن صرد، فلمّا خرج المختار لحق به فقُتل مع المختار بعين الوردة في رمضان سنة (67هـ )»[170]، وقالوا: «نحن التوابون. قتلهم كلّهم عبيد الله بن زياد»[171]، وهذا هراء أنّى للحسين عليه السلام أن يكون له هذا الجيش؟!
وقيل: «كان ممَّن كاتب الحسين ليبايعه، فلمّا عجر عن نصره ندم… فخرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد، وساروا للطلب بدمه، وسُمّوا جيش التوابين، وسار في أُلوف لحرب ابن زياد، وقال: إن قُتلت فأميركم المسيّب بن نجبة، والتقى الجمعان، وكان عبيد الله في جيش عظيم، فالتحم القتال ثلاثة أيام، وقُتل خلق من الفريقين، واستحرّ القتل بالتوابين شيعة الحسين عليه السلام، وقُتل أمراؤهم الأربعة، سليمان، والمسيّب، وعبد الله بن سعد، وعبد الله بن والي، وذلك بعين الوردة التي تُدعى رأس العين سنة (65هـ)، وتحيّز بمَن بقيَ منهم رفاعة بن شداد إلى الكوفة»[172].
أمّا «المسيّب بن نجبة، من صحابة أمير المؤمنين عليه السلام، استُشهد مع التوابين في معركة عين الوردة»[173]، ويبدو أنّه أحد الذين أُلقيَ عليهم القبض، وأُودعوا في السجن، هو والمختار وغيره من قادة الإمام الحسين عليه السلام، ونعتذر عن دراسة الشخصيات التي راسلت الإمام عليه السلام؛ لأنّه يبعدنا كثيراً عن أصل الموضوع.
وروى ابن كثير، عن ابن سعد، عن موسى بن إسماعيل، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، قال: «حدّثني مَن شافه الإمام الحسين عليه السلام، قال: رأيت أخبية مضروبة بفلاة من الأرض، فقلت: لـمَن هذه؟ قالوا: هذه لحسين. قال: فأتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديّه ولحيته. قال: قلت: بأبي وأُمّي يا بن بنت رسول الله، ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ فقال: هذه كُتب أهل الكوفة إليَّ، ولا أراهم إلّا قاتلي، فإذا فعلوا ذلك لم يَدَعوا لله حرمة إلّا انتهكوها، فيسلّط الله عليهم مَن يذلهّم حتى يكونوا أذلّ من قرم الأَمة ـ يعني مقنعتها ـ »[174]. وقد بحثنا عن الرواية فلم نجدها عند ابن سعد، الذي هو مقل الرواية عن يزيد الرشك، وكلّ الذي وجدناه، أنّها من روايات ابن عساكر [175]، وفيها تدليس عن الشخص الذي شافه الإمام عليه السلام.
والسؤال الذي لم يسمح الوقت بالإجابة عنه، هو: ما موقف هؤلاء البشر من النهضة الحسينية؟ هل كلّهم تخاذلوا؟ وماذا عن رؤوس القوم؟ ما مصيرهم؟ هل كلّهم شخصيات حقيقيّة، أم جلّها وهميّة؟ وهل لهم أثر الآن، كأن يكون مرقداً أو داراً؟ وهذا ما سيقوم الباحث ـ إن مكنّه الله ـ بتتبعه حول تلك الشخصيات فرداً فرداً.
أمّا السند، ففيه أبو سلمة البصري، موسى بن إسماعيل، وقد درسناه سابقاً[176]، و«جعفر بن سليمان الضبعي الجرشي من أهل البصرة، كنيته أبو سليمان، نزل في بنى ضبيعة فنُسب إليها»[177]، وثّقة الطوسي[178]، وابن معين[179]، والعجلي[180]، وقال ابن حنبل: «لا بأس به، وقال حمّاد بن زيد: لم يكن ينهى عنه»[181].
قال العجلي: «يتشيّع»[182]، وقال آخر: «يُنسب إلى الرفض»[183]، وقيل: «رافضي مثل الحمار… ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه»[184]، وقيل: «كان من العلماء الزهاد على تشيعه»[185]، وكان يتشيّع، ويحدّث بأحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، وأهل البصرة يغلون في أمير المؤمنين عليه السلام[186]، وقال الذهبي: «من ثقات الشيعة وزهّادهم… وعنه أخذ بدعة التشيّع»[187]. ويبدو أنّ الرجل لم تكن فيه مشكله، سوى تشيعه، ولهذا عندما ترجموا له أشاروا إلى هذا الموضوع.
وقيل: «من الثقات المتقنين في الروايات غير أنّه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمّتنا خلاف، أنّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها، أنّ الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره؛ ولهذه العلّة ما تركوا حديث جماعة ممَّن كانوا ينتحلون البدع، ويدعون إليها، وإن كانوا ثقات، واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم وكانتحالهم سواء، غير أنّهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربّه إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات»[188].
وقيل: «يخالف في بعض حديثه»[189]، وقيل: «لا يُكتب حديثه»[190]، وضعّفه العقيلي بقوله: نهى يزيد بن زريع إتيان مجلسه، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدّث عنه، ولا يروى عنه، وكان يستضعفه حتى قيل له: «إنّك تشتم أبا بكر وعمر. فقال: أمّا أشتم فلا، ولكن البغض ما شئت»[191]، وقيل: «يبغض الشيخين»[192]، وهذا هو السبب الآخر الذي جعل القوم يطعنون فيه.
وكان عبد الرحمن بن مهدي لا ينشط لحديثه، واستثقله ابن سنان، وسليمان بن حرب لا يكتب حديثه، وعامّة حديثه رقائق، قال ابن المديني: «أكثر جعفر عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي(صلّى الله عليه وسلّم)»[193]، ولعلّ هذه الأحاديث مروية في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.
قدِم اليمن وحدّث بصنعاء كثيراً، وكان عبد الصمد بن معقل يجلس إليه[194]، ثقة فيه ضعف، وقد روى له الجماعة سوى البخاري[195]. لماذا؟ فإذا روى فضائل الشيخين أيكون موقف البخاري هكذا؟!
قال ابن سعد: «ثقة فيه ضعف»، وقيل: «فاضلاً حسن الهدى»، «روى أحاديث من مناقب الشيخين، وهو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عُدّت ممَّا يُنكر، واختلف الاحتجاج بها» غالبيتها في صحيح مسلم، وأدخله النسائي في صحيحه، وروى «عن أبى هارون، عن أبى سعيد، قال: مات رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ولم يستخلف أحداً. رواه سفيان، عن جعفر، فما حدّث به إلّا وعنده أنّ علياً ليس بوصي»[196] مات سنة (178هـ)[197]، وقيل: سنة (177هـ)[198]. وأخيراً لم يصحّ عنه نقل فضائل الشيخين.
أمّا يزيد الرشك الضبعي[199]، وهو «يزيد بن أبي يزيد الرشك، أبو الأزهر… يُعدّ في البصـريين»[200]، «ولا يُسمّى أبو يزيد، وكان غيوراً ويُسمّى بالفارسية أرشك، فعُرّب فقيل: الرشك، ويقال له: القسّام يقسم الدور، مسح مكّة… روى عن سعيد بن المسيّب، وعن مطرف، ومعاذة العدوية، وخالد الأثبج، روى عنه شعبة، ومعمر، وعبد الوارث، وحمّاد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وجعفر بن سليمان الضبعي، وعبد الله بن شوذب»[201].
وثقة ابن سعد[202]، وابن معين [203]، وابن حبّان[204]، والترمذي[205]، وقال ابن شاهين: «ليس به بأس»[206]، صالح الحديث، وثّقه أبو حاتم، وأبو زرعة[207].
وقبال ذلك هناك مَن تكلّم فيه، إذ انفرد أبو أحمد الحاكم بقوله: «ليس بالقوى عندهم، فأخطأ بذلك»[208]، وقيل: «ضعيف»[209]. «كان قساماً بالبصـرة… عظيم اللحية كثها»[210]؛ ولهذا سميَّ بالرشك، ويعني «بالفارسية كبير اللحية، وبذلك لقب لكبر لحيته، قالوا: دخلت عقرب في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام ولم يعلم بها»[211]. وهذا الأمر مدعاة للسخرية، لا يصحّ.
بلغ من العمر مائة سنة ولم يمت[212]، مات سنة (130هـ) بالبصرة[213]. كلّ ما تقدّم ما يهمّ، وبودّنا أن نحسب ولادته رياضياً، فإذا فرضنا وفاته عن عمر مائة سنة، وتوفّي سنة (130هـ)، تكون ولادته سنة (30هـ)، بمعنى أنّه أدرك من حياة الإمام الحسين عليه السلام (26) سنة، ولكن من سوء عاقبته أنّه لم يلتقيه، ولم يسمع منه شيئاً، مكتفياً بوضع شبهة، قال: حدّثني مَن شافه الإمام، وقد دلّس عنه، وفي واقع الحال لم يحدّثه أحد، وهناك نقطة بقيت مبهمة وهي أنّنا لم نعرف مذهبه.
الثاني: موقف ابن الزبير، الذي أراد إبعاد الإمام عن الساحة في مكّة لتخلو له، فكان يغدو ويروح إليه، ويشير عليه بالذهاب إلى العراق، ويقول: «هم شيعتك وشيعة أبيك»[214].
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن[215]: كان ينبغي للإمام الحسين عليه السلام أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم، ولكن شجّعه على ذلك ابن الزبير، وكتب إليه المسور ابن مخرمة[216]، إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق، وبقول ابن الزبير: «الحق بهم فإنّهم ناصروك»[217]، وقد تجاهل ابن كثير المصدر الذي نقل منه، وهو ابن عساكر، وحذف جزء من قول المسور، ونسبه إلى ابن عباس، وهو: «إيّاك أن تبرح الحرم فإنّهم إن كانت لهم بك حاجة فسيضربون آباط الإبل حتى يوافوك، فتخرج في قوة وعدّة. فجزاه خيراً وقال: أستخير الله في ذلك»[218].
وقد أراد صاحب الرواية الطعن في الإمام على أنّه آله يحرّكها ابن الزبير، وهذا كلام يتنافى وسيرته، ومشورة الرجل غير مقبولة؛ لأنّها صدرت من عامل وصهر البيت الأُموي؛ إذ زوّج ابنته أُمّ كلثوم الكبرى من بشر بن مروان بن الحكم، وعيّنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أُميّة لمّا ولي المدينة لمعاوية في المرة الأُولى قاضياً على المدينة، فلمّا عُزل سعيد بن العاص، وولي مروان المدينة المرّة الثانية عزله[219].
أمّا المسور فمن سوء عاقبته والعياذ بالله، لم يخرج مع إمام زمانه خشية الموت، لكنّه مات بمكة سنة (74هـ) أصابه حجر المنجنيق، وهو يصلّى في الحجر[220]، وعليه تكون حجته باطلة، ولا يقول قائل: إنّ الرجل كان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية[221]، فنقول: ذلك الزمان غير الزمان الذي تخاذل فيه.
«وقال أبو مخنف: قال أبو جناب يحيى بن أبي خيثمة: عن عدي بن حرملة الأسدي، عن عبد الله بن سليم، والمنذر بن المشمعل الأسديين، قالا: خرجنا حاجّين من الكوفة فقدِمنا مكّة، فدخلنا يوم التروية، فإذا الحسين وابن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى بين الحجر والباب، فسمعنا ابن الزبير يقول له: إن شئت أن تُقيم أقمت، فوليت هذا الأمر آزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك؟ فقال الحسين: إنّ أبي حدّثني أنّ لها كبشاً يستحل حرمتها يُقتل، فما أحبّ أن أكون أنا ذلك الكبش. فقال له ابن الزبير: فأقم إن شئت وولّني أنا الأمر، فتُطاع ولا تُعصى. فقال: وما أُريد هذا أيضاً، ثمّ إنّهما أخفيا كلامهما دوننا، فما زالا يتناجيان حتى سمعنا دعاة الناس متوجّهين إلى منى عند الظهيرة، فطاف الإمام عليه السلام بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصّر من شعره، وحلّ من عمرته، ثمّ توجه نحو الكوفة وتوجهنا نحن مع الناس إلى منى»[222].
الثالث: صدور أمر قتل الإمام قبل مغادرته الحجاز من قِبل يزيد، ولمّا علم الإمام بذلك همّ بالذهاب العراق، فدخل مسجد النبي عليها السلام «ليودع القبر، فلمّا وصل، سطع له نور من القبر، فعاد إلى موضعه، فلمّا كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر، فقام يصلّي فأطال، فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي عليها السلام وهو في منامه، فأخذه وضمّه إلى صدره، وجعل يُقبّل بين عينيه، ويقول: بأبي أنت، كأنّي أراك مرمّلاً بدمك بين عصابة من هذه الأُمّة، يرجون شفاعتي، ما لهم عند الله من خلاق، يا بني إنّك قادم على أبيك وأُمّك وأخيك، وهم مشتاقون إليك، وإنّ لك في الجنّة درجات لا تنالها إلّا بالشهادة. فانتبه من نومه باكياً، فأتى أهل بيته، فأخبرهم بالرؤيا وودّعهم، وحمل أخواته على المحامل وابنته، وابن أخيه القاسم بن الحسن بن علي عليهم السلام، ثمّ سار في أحد وعشرين رجلاً من أصحابه وأهل بيته، منهم أبو بكر بن علي، ومحمد بن علي، وعثمان بن علي، والعباس بن علي، وعبد الله بن مسلم بن عقيل، وعلي بن الحسين الأكبر، وعلي بن الحسين الأصغر… فسار الحسين عليه السلام وأصحابه، فلمّا نزلوا الثعلبية[223] ورد عليه رجل يقال له: بشـر بن غالب[224]، فقال: يا بن النبي، أخبرني عن قول الله عز وجل: (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)[225]، قال: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها، هؤلاء في الجنّة، وهؤلاء في النار، وهو قوله عز وجل: (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)[226]»[227].
وهذه خرافة واضحة، بل فرية على المعصوم، وما يتمنّاه الباحث، أن يكون الحديث بما يليق بالمعصوم، والابتعاد عن لهجة المنامات التي رافقت الإمام عليه السلام على طول الطريق بين مسافة وأُخرى، وأنّه عليه السلام قد هوّمت عيناه في النوم، ورأى رؤيا، حتى صيّروه وكأنّه عليه السلام نائم في أغلب الوقت أثناء الطريق وأنّه غير جاد في قضيته، مع أنّه عليه السلام سائر بأهله وقومه، ومتصدٍّ لقيادة الركب، وراكب على ظهر دابة، وهذا الموقف لا يسمح له بالنوم.
هذه الخطابات جعلت الآخر يسخر منّا، والمفروض توجيه الخطاب بما يتحمله عقله وما يفهمه، ولا يحصل ذلك إلّا عن طريق الابتعاد عن الغيبيات التي شوّهت النهضة الحسينية المقدّسة، والتعامل مع نصوصها بالتحليل العلمي الدقيق بعيداً عن العاطفة التي نحتاجها في المجالس، ولا سيّما في قضية البكاء لمأساة كربلاء، وأن يكون الخطاب فيها للعقل، وأخيراً فإنّ الباحث يرفض هذه الرواية بما فيها.
الرابع: خرج الإمام عليه السلام ناقماً من ولاية يزيد، وهذا ما رواه الزبير بن بكار، عن محمد بن الضحّاك بن عثمان الحزامي، عن أبيه، قال: «خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة ساخطاً لولاية يزيد الذي كتب إلى واليه ابن زياد على العراق: إنّه قد بلغني أنّ حسيناً سار إلى الكوفة، وقد ابتُليَ به زمانك من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتُليت به من بين العمال، وعندها يعتق أو يعود عبداً كما يعتبد العبيد»[228].
الخامس: قد يتصوّر بعض الناس ممَّن لا يمتلكون ثقافة في العلاقات الهاشمية الأُموية، أنّ خروجه عليه السلام جاء نتيجة طلبه السلطة، وهذا ما كان يدور في خَلَد ابن عمر، عندما قال له: «والله لا يليها أحد منكم أبداً، وما صرفها عنكم إلى الذي هو خير منكم، فارجعوا». وعلّق أحدهم على ذلك بقوله: «وقد وقع ما فهمه ابن عمر من ذلك سواء، من أنّه لم يلِ أحد من أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتمّ له الأمر، وقد قال ذلك عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين عليه السلام إنّه لا يلي أحد من أهل البيت أبداً»[229].
وعلى رواية قال له ابن عمر: «إنّي محدّثك حديثاً، إنّ جبريل أتى النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فخيّره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، ولم يرد الدنيا، وإنّك بضعة من النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، والله ما يليها أحد منكم أبداً، وما صرفها الله عنكم إلّا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع»[230]. وهذه أحد ركائز القراءات الخاطئة للنهضة الحسينية المقدّسة، وعلى شاكلتها كثير من الشواهد.
وقال ابن كثير: «سبب قتل الإمام الحسين عليه السلام أنّه كتب إليه أهل العراق يطلبون منه أن يقدِم إليهم ليبايعوه بالخلافة، وكثر تواتر الكتب عليه من العامّة ومن ابن عمّه مسلم ابن عقيل، فلمّا ظهر على ذلك ابن زياد والي يزيد بن معاوية، بعث إلى مسلم فضرب عنقه ورماه من القصر إلى العامّة، فتفرّق ملؤهم وتبددت كلمتهم، هذا وقد تجهّز الحسين من الحجاز إلى العراق، ولم يشعر بما وقع، فتحمل بأهله ومَن أطاعه وكانوا قريباً من ثلاثمائة»[231]. وهذه الفكرة راسخة في عقل ابن كثير، وهو يترجم حياة الإمام عليه السلام، قال: «سبب خروجه من مكّة في طلب الأمارة»[232].
المبحث الثالث: رسل الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة
أوّلاً: مسلم بن عقيل
بعد أن كثرت على الإمام عليه السلام كُتب أهل العراق، يحثّونه على القدوم، وأنّهم ليس عليهم إمام، ويطلبون منه أن يُقدم عليهم، لعلّ الله أن يجمعهم به على الهدى والحق، أجابهم بقوله: «وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إليَّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إليَّ أنّه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدِمت عليَّ به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدِم عليكم وشيكاً إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلّا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله، والسلام… دعا مسلم بن عقيل فسـّرحه مع قيس بن مسهّر الصيداوي، وعمارة بن عبيد السلولي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي، فأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف، فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجّل إليه بذلك، فأقبل مسلم حتى أتى المدينة، فصلّى في مسجد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وودّع مَن أحبّ من أهله، ثمّ استأجر دليلين من قيس»[233].
يُضعِف الرواية عدم وجود السلولي والأرحبي، وأنّهما شخصيتان وهميتان، وهذا ما نريد قوله: إنّ الإمام أرسل مسلماً فقط، والدليل أنّ حديثه كان بالمفرد ولم يكن بالجمع، قال: «أخي وابن عمّي وثقتي، ومن أهل بيتي»، وهذه صفات تستوجب التوقّف عندها لولا كبر حجم البحث، وهذه نقطة مهمّة لا بدّ من الالتزام بها على مستوى المراسلات المحلية والدولية، وأن الموفَد أو الممثِّل لا بدّ أن يكون بهذه الصفات ولا سيّما صفة الوثاقة، وعندما حدّد هوية رسوله وأنّه من أهل بيته؛ وأنّه على الخط لا يخون ولا يُهادن، وأنّ الهدف واحد، والدماء واحدة، والرسول واحد، فلا يصحّ وجود آخرين معه، وهذه الصفات هي كلمة السّر في الموضوع.
الهدف من هذه المهمّة الكشف «عن حقيقة الأمر والاتّفاق، فإن كان متحتماً وأمراً حازماً محكماً بعث إليه ليركب في أهله وذويه»[234]، وهذه نقطة مهمّة في الفكر العسكري، وهي مهمّة استطلاعيّة لمعرفة نوايا القوم، «أقبل مسلم حتى دخل الكوفة، فنزل دار المختار بن أبي عبيد، وهي التي تدعى اليوم دار مسلم بن المسيّب[235]، وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فلمّا اجتمعت جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الإمام الحسين عليه السلام، فأخذوا يبكون، فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:
أمّا بعدُ، فانّي لا أُخبرك عن الناس، ولا أعلم ما في أنفسهم، وما أغرّك منهم، والله أُحدّثك عمّا أنا موطّن نفسـي عليه، والله لأجيبنّكم إذا دعوتم، ولا قاتلن معكم عدوّكم، ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أُريد بذلك إلّا ما عند الله، فقام حبيب بن مظاهر الفقعسي ـ لعلّه الأسدي ـ فقال: رحمك الله، قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك، ثمّ قال: وأنا والله الذي لا إله إلّا هو، على مثل ما هذا عليه، ثمّ قال الحنفي ـ سعيد بن عبد الله ـ مثل ذلك، فقال الحجاج بن علي: فقلت لمحمد بن بشر فهل كان منك أنت قول؟ فقال: إن كنت لأحبّ أن يعزّ الله أصحابي بالظفر وما كنت لأحبّ أن أُقتل وكرهت أن أكذب»[236].
يُضعِف الرواية عدم وجود شخصيّة عابس بن أبي شبيب الشاكري، على الرغم من ذكر الطوسي له[237]، فضلاً عن ورود اسمه في زيارة الشهداء (رضوان الله عليهم) يوم عاشوراء، «السلام على عابس بن شبيب الشاكري»[238]، ذكر السيد الخوئي أنّه: «من أصحاب الحسين عليه السلام، وقع التسليم عليه في زيارتي الناحية، والرجبية، ولكنّ المذكور فيهما: عابس بن شبيب، والظاهر أنّه هو الصحيح وفاقاً لما ذكر في كلمات غير واحد ممَّن تعرّض له»[239].
وبعد وصوله كَتَبَ للإمام عليه السلام كتاباً مضمونه: أمّا بعدُ، فإنّ الرائد لا يكذب أهله، وإنّ جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تقرأ كتابي هذا والسلام عليكم، وقد وصل إليه قبل أن يُقتل مسلم بـ(27) ليلة[240]، وقد راجعنا الرواية فوجدنا مصدرها هو أبو مخنف[241].
وبناءً على ذلك خرج الإمام عليه السلام وفي الطريق التقى رجلاً من بني أسد، وأراد أن يسأله فمال عنه الرجل ولم يتمكّن الإمام من مسألته، ولكن سأله رجلان أسديان عن أحوال الكوفة، فقال: «ما خرجت من الكوفة حتى قُتل مسلم بن عقيل، وهاني ابن عروة، فرأيتهما يجران بأرجلهما في السوق، فأخبر الرجلان الإمام بما جرى هناك»[242]، «وقد جرى كلّ ذلك والإمام الحسين عليه السلام لا يعلم بشيء»[243].
ثانياً: قيس بن مسهّر الضدائي، وقيل: الصيداوي
أحد الذين راسلوا الإمام الحسين عليه السلام، وطلبوا منه قدوم العراق، بل أحد بعوث أهل الكوفة إلى مكّة[244]، وهو الذي سار إلى الكوفة بكتاب الإمام الحسين عليه السلام «حتى إذا انتهى إلى القادسية، أخذه الحصين بن نمير[245]، فأنفذه إلى عبيد الله بن زياد، فقال له: اصعد فسبّ الكذّاب الحسين عليه السلام. فصعد، وحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّ الحسين خير خلق الله أُمّه فاطمة بنت النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، وأنا رسوله إليكم فأجيبوه، ثمّ لعن عبيد الله بن زياد وأباه، واستغفر لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وصلّى عليه، فأمر به ابن زياد أن يُرمى به من فوق القصر، فرموه وتقطّع»[246]، والغريب أنّنا، لم نجد له موضع قبر في الكوفة، ثمّ إنّ وجهته الكوفة فما الذي دفعه إلى القادسية؟ علماً أنّه كوفي، ثمّ كيف علم به الحصين أنّه معادياً؟ إذاً، الأمر فيه لبس يحتاج إلى دراسة خارج ما نحن ملتزمون فيه عند ابن كثير.
وروى أبو مخنف، عن محمد بن قيس قوله: « إنّ الإمام الحسين عليه السلام أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمة[247]، بعث قيس بن مسهّر الصيداوي إلى أهل الكوفة، وكتب معه إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من الإمام الحسين عليه السلام إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلّا هو، أمّا بعدُ، فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يُخبرني فيه بحسن رأيكم، واجتماع ملئكم على نصـرنا، والطلب بحقنا، فنسأل الله أن يحسن لنا الصنيع، وأن يُثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء 8/ذي الحجة، يوم التروية، فإذا قدِم عليكم رسولي، فاكتموا أمركم، وجدوا فإنّي قادم عليكم في أيّامي هذه إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقبل قيس بن مسهّر الصيداوي بالكتاب فأُلقي عليه القبض، فأمر به ابن زياد، فأُلقي من رأس القصـر فتقطّع، ويقال: بل تكسّـرت عظامه، وبقيَ فيه بقيّة رمق، فقام إليه عبد الملك بن عمير البجلي فذبحه، وقال: إنّما أردت إراحته من الألم، وقيل: ليس هو مَن فعلها، وإنّما رجل يشبهه»[248].
وللتعليق على ذلك راجعنا الرواية، فوجدناها في كتاب أبي مخنف[249]، وما نريد قوله هو: أنّنا لم نطمئن لوجود قيس بن مسهّر الصيداوي، على الرغم من ذكره في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام[250].
والدليل: ورد في رواية أنّ الذي قدِم بكتاب الإمام الحسين عليه السلام هو عبد الله بن بقطر ـ قيل: يقطر ـ فألقي من أعلى القصر[251]، وقد استُشهد ولم يعرف الإمام حاله، ولم يصل خبره إلّا عندما وصل الإمام زبالة[252]، فأتاه خبر مقتله[253].
والقاتل شخص واحد هو عبد الملك بن عمير[254]، من أبناء الشام، وأجلاف محاربي أمير المؤمنين عليه السلام، المشتهرين بالتعصّب والعداوة له ولعترته، ولم يزل يتقرّب إلى بني أُميّة بتوليد الأخبار الكاذبة، والطعن في أمير المؤمنين حتى قلّدوه القضاء، وكان يقبل الرشوة، ويحكم بالجور والعدوان، متجاهراً بالفجور والعبث بالنساء، فمن ذلك أنّ الوليد بن سريع خاصم أُخته كلثم في أموال، وكانت من أحسن نساء وقتها وأجملهن، فأعجبته، فوجّه القضاء على أخيها تقرباً إليها وطمعاً فيها، فظهر ذلك عليه واستفاض عنه، وفيه قال هذيل الأشجعي[255]: [256]
أتاه وليد بالشهود يقودهم
على ما ادّعى من صامت المال والخول
يسوق إليه كلثماً وكلامها
شفاء من الدّاء المخامر والخبل
فما برحت تومي إليه بطرفها
وتومض أحياناً إذا خصمها غفل»(2).
وهو الذي احتز رأس عبد الله بن يقطر[257] بالكوفة بعد أن رُمي به من فوق القصر[258]، وفوق ذلك كلّه أنّه من أشياع بني أُميّة، يجهز على أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وهم جرحى[259]، وهو من المقرّبين إلى ابن زياد، رمى رأس الحسين عليه السلام في مجلس ابن زياد[260]، وبعد كلّ هذه المساوئ وثّقه بعضهم[261].
المبحث الرابع: مسير الإمام عليه السلام إلى العراق
كثير هم الناس الذين لم يعرفوا مقام الإمام الحسين عليه السلام، وخير مثال على ذلك الرأي القائل: إنّه أقام على ما هو عليه من الهموم، مرّة يريد أن يسير إلى العراق، ومرّة يجمع الإقامة في مكّة[262]، والحقيقة عكس ذلك، حيث لم يكن له خيارات غير شدّ الرحيل، للقاء ربّه في بقعة شرّفها دمه، ودم الشهداء، اسمها كربلاء.
ولما أراد الخروج من مكّة إلى الكوفة مرّ بباب المسجد الحرام، فقال:[263]
لا ذَعَرتُ السَوامَ في غَلَسِ الصُبـ ـحِ مُغيراً وَلا دَعَوتُ يَزيدا
يَومَ أُعطي مَخافَةَ المَوتِ ضَيماً وَالمَنايا يَرصُدنَني أَن أَحيدا»(2).
وقد نسبت البيتان للشاعر يزيد بن مفزع الحميري البصـري المتوفّى (69هـ)[264]، والشاعر البصـري العبّاسي، عبد الصمد بن المعذل بن غيلان، المتوفّى (240هـ)[265].
وسند هذا الرأي فيه الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن الزبير بن العوّام وهو مقدوح فيه[266]، أمّا «محمد بن الضحّاك بن عثمان الحزامي، روى عن أبيه، روى عنه يعقوب بن حميد»[267]، «من أهل المدينة»[268]، فلم أطمئن لوجوده على الرغم من ذكره في الروايات، ثمّ إنّه لم يدرك الحادثة، فروايته مرسله.
وبعدها سار نحو الكوفة ولا يعلم شيئاً ممَّا وقع من الأخبار. قال أبو مخنف: عن أبي علي الأنصاري، عن بكر بن مصعب المزني: «وكان لا يمرّ بماء من مياه العرب إلّا اتّبعوه»[269]، وهذه رواية أبي مخنف[270]، وطريقها غير صحيح، رواها الأنصاري والمزني وهما غير معروفَين ومجهولَين تماماً، ولم نعرف الذين اتّبعوه كم عددهم؟ وبالأحرى لم نجدهم، فالموجود هو: أنّه عليه السلام أينما حلّ نهوه من وجهته التي قصدها.
وروى أبو مخنف عن أبي جناب الكلبي، عن عدى بن حرملة الأسدي، عن عبد الله بن سليم، والمذري بن المشمعل الأسديين، قالا: «لمّا قضينا حجّنا لم يكن لنا همّة إلّا اللحاق بالحسين في الطريق؛ لننظر ما يكون من أمره وشأنه، فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود[271]، فلمّا دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين، فوقف كأنّه يريده، ثمّ تركه ومضـى، ومضينا نحوه، فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا نسأله، فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه، فمضينا حتى انتهينا إليه، فقلنا: السلام عليك. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. ثمّ قلنا: فمَن الرجل؟ قال: أسدي. فقلنا: فنحن أسديان، فمَن أنت؟ قال: أنا بكير بن المثعبة. فانتسبنا له، ثمّ قلنا: أخبرنا عن الناس وراءك؟ قال: نعم، لم أخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، فرأيتهما يُجرّان بأرجلهما في السوق، فأقبلنا حتى لحقناه، فسايرناه حتى نزل الثعلبية[272] ممسياً، فجئناه حين نزل، فسلّمنا عليه، فردّ علينا فقلنا له: رحمك الله إنّ عندنا خبراً، فإن شئت حدّثنا علانيةً، وإن شئت سرّاً. فنظر إلى أصحابه، وقال: ما دون هؤلاء سرّ. فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاءً أمس؟ قال: نعم، وقد أردت مسألته. فقلنا: قد استبرأنا لك خبره، وكفيناك مسألته، وهو ابن امرئ من أسد منّا، ذو رأي وصدق، وفضل وعقل، وأنّه حدّثنا أنّه لم يخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم ابن عقيل، وهانئ بن عروة. فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، رحمة الله عليهما، فردّد ذلك مراراً، فقلنا: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلّا انصرفت من مكانك هذا؛ فإنّه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوّف أن تكون عليك، فوثب عند ذلك بنو عقيل بن أبي طالب»[273]، «وقالوا: لا والله، لا ترجع حتى ندرك ثأرنا، أو نذوق ما ذاق أخونا»[274]. وعلى رواية، كثر تردّده بعد أن سمع نهي الأسديين له، ولا سيمّا قولهما: «ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلّا انصـرفت من مكانك هذا، فإنّه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوّف أن يكونوا عليك، فنظر إلى بني عقيل، فقال: ما ترون؟ فقد قُتل مسلم. فقالوا: والله، لا نرجع حتى نصيب ثأرنا، أو نذوق ما ذاق»[275].
أُريد من ذلك وكأنّه عليه السلام تراجع عن موقفه، وفضّل العودة من حيث أتى، لولا امتناع آل عقيل، وهذه لها ما يؤيّدها في مواقف لاحقة سندمجها ونردّ عليها.
وعليه لا بدّ من دراسة سند الرواية؛ لمعرفة رتبته من الصحة، والذي فيه أبو جناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي، وقد قيل فيه: «واسم أبي حيّة حي»[276]، «ضعيف الحديث»[277]، «ضعّفه يحيى القطان»[278]، «كوفي فيه ضعف»[279]، ضعّفه النسائي[280]، «أحاديثه مناكير»[281]، «لم يحدّث عنه يحيى، ولا عبد الرحمن شيئاً قطُّ»[282]، «مُدلّس»[283]، «صاحب تدليس، أفسد حديثه بالتّدليس، كان يحدّث بما لم يسمع، وقال يزيد بن هارون: كان يحدّثنا عن عطاء، والضحّاك، وابن بريدة، فإذا وقفناه نقول: سمعت من فلان هذا الحديث، فيقول: لم اسمعه منه، إنّما أخذت من أصحابنا، لم يحبّه أبو حاتم، وأوصى بعدم الكتابة عنه، ليس بالقوي»[284].
وكان ممَّن يُدلّس على الثقات ما سمع من الضّعفاء، فالتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهير، وحمل عليه أحمد بن حنبل حملاً شديداً، وضعّفه ابن معين[285]. قال يحيى القطّان: «لو استحللت أن أروي عنه حديثاً لرويت في تكبير العيد، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث، من أحاديثه عن أبي سليمان، عن عمّه، عن علي، عن النبي (صلّى الله عيه وسلّم)، قال: أنت وشيعتك في الجنّة، وأنّ قوماً يقال لهم الرّافضة، فإن لقيتهم فاقتلهم؛ فإنّهم مشركون»[286].
كان يحيى القطان، يتكلّم فيه وفي أبيه، قال عثمان بن سعيد: «هو ضعيف، وضعّف حديثه الجوزجاني، وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف، وقال أبو داوود: ليس بذاك»[287]، وقبال ذلك هناك مَن قال: «ليس به بأس»[288]، «ثقة»[289]، «صدوق»[290]، «يكتب حديثه»[291].
روى «عن عمير بن سعيد، والشعبي، وأبي حازم، وأبيه، ويزيد بن البراء، وإسماعيل ابن رجاء الزبيدي، وعطاء بن أبي رباح، والضحّاك، وأبي إسحاق الهمداني، وعون بن عبد الله»[292]، «وإياد بن لقيط، وأبي صخرة جامع بن شداد، والجلاس بن عمرو، والحسن البصري، وخيثمة بن عبد الرحمان، وسلمان أبي حازم الأشجعي، وشهر بن حوشب، والضحّاك بن مزاحم، وطاووس بن كيسان، وأبي تميمة طريف بن مجالد الهجيمي، وطلحة بن مصـرف، وعامر الشعبي، وعبد الله بن بريدة، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، وعبد الرحمان بن زيد بن الخطاب، وعبد الرحمان بن أبي ليلى، وعثمان بن الأسود المكّي، وعدي بن ثابت، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وعمير بن سعيد النخعي، وعون بن عبد الله بن عتبة بن
مسعود، ومعاوية بن قرّة المزني، ومغراء العبدي، والمنهال بن عمرو، وهلال أبي ظلال القسملي، والوليد بن سريع، ويزيد بن البراء بن عازب، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبي جميلة الطهوي، وأبيه أبي حية الكلبي، وأبي سليمان غير مُسمّى، روى عنه: إسحاق بن يوسف الأزرق، وجرير بن عبد الحميد، وجعفر بن عون، والحسن بن حبيب بن ندبة، والحسن بن صالح بن حي، وزكريا بن الحارث بن أبي مسرة المكي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وسليمان بن قرم، وسيف بن عمر التميمي، وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني، وشريك بن عبد الله النخعي، وشعيب بن ميمون، وعبد الحميد بن عبد الرحمان الحماني، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وعبدة بن
سليمان الكلابي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن فضيل بن غزوان، ومحمد بن مسروق الكندي، والنضر بن زرارة، وهشيم بن بشير، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية، ويزيد بن هارون»[293]توفّي سنة (147هـ) بالكوفة[294]، وقيل: سنة (150هـ)[295].
وعدي بن حرملة، ورد في جملة روايات عند أبي مخنف[296]، ونقلها الطبري[297] وغيره، وعلى الرغم من ذلك لم يصح وجوده لدى الباحث ويعدّه شخصية وهمية، والسند معلول من جهته.
وعبد الله بن سليم الأسدي هو الآخر مجهول، والموجود عبد الله بن سليم العامري، «من صحابة الإمام الصادق عليه السلام»[298]، «روى عن بقيّة، روى عنه عمرو الناقد… شيخ ليس بالمشهور»[299]، ولم يكن من بني أسد، وعبد الله بن سليم من أهل الجزيرة مولى امرأة من حمير، كنيته أبو عبد الرحمن، وروى عن أهل الجزيرة، روى عنه أهلها مات سنة (213هـ )[300].
وكذلك المذري بن المشمعل، هو الآخر مجهول. ومن اللّياقة العلمية الإشارة إلى ما قاله المفيد الذي سمّاهما «عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعل الأسديان»[301]، وعبد الله
ابن سليمان بهذه التسمية «عدّه الشيخ الطوسي تارةً في أصحاب الحسين، وأُخرى في أصحاب الباقر، وعدّه البرقي في أصحاب الباقر عليه السلام»[302]، ولم يثبت وجوده في هذا السند، وكذلك المنذر.
وعندما علم بمقتل رسله في الكوفة، قال: «لا خير في العيش بعد هؤلاء»، فعلم أصحابه أنّه قد عزم رأيه على المسير، فقلنا له: خار الله لك. فقال: «رحمكما الله ». فقال له أصحابه: إنّك والله، ما أنت مثل مسلم بن عقيل، ولو قدِمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع. فسكت، ثمّ انتظر حتى إذا كان السحر، قال لفتيانه وغلمانه: « أكثروا من الماء». فاستقوا وأكثروا، ثمّ ارتحلوا، ولمّا وصل إلى حاجر[303]، قال: «خذلتنا شيعتنا، فمَن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج عليه، وليس عليه منّا ذمام، فتفرّق الناس عنه يميناً وشمالاً، فما بقيَ إلّا أصحابه الذين جاؤوا معه من مكّة، وإنّما فعل ذلك؛ لأنّه ظنّ أنّ مَن اتّبعه من الأعراب، إنّما اتّبعوه، لأنّه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهلها، فكره أن يسيروا معه إلّا وهم يعلمون على مَن يقدمون، وقد علم أنّه إذا بيّن لهم الأمر لم يصحبه إلّا مَن يُريد مواساته في الموت معه»[304].
وكالعادة تحقّقنا من مصدر الرواية، فلم نجد لها إلّا مصدراً واحداً وهو الطبري، الذي ساقه بسنده عن أبي مخنف، عن أبي على الأنصاري، عن بكر بن مصعب المزني، قال: «لمّا وصل الإمام الحسين إلى زبالة، أخرج للناس كتاباً، فقرأ عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعدُ، فإنّه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، وعبد الله بن بقطر، وساق الخبر حتى بقيَ في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة»[305].
ما نريد قوله هو: الاختلاف في اسم الموضع الجغرافي، فقد سمّاه ابن كثير حاجر، وقلنا: إنّه غير معروف، والصحيح ما ذهب إليه الطبري الذي سمّاه زبالة، وكذلك القوم الذين بقوا معه، فقال ابن كثير: هم من أهل مكّة. وهذا غير صحيح، بل هم أهل المدينة كما في رواية الطبري، بدليل أنّهم هم الذين رافقوا عائلة الإمام عليه السلام في المسير من المدينة، ولا سيمّا أنّ تاريخ أهل مكّة مليء بالشرك، وقد استسلموا يوم فتحها مكرهين، وكأنّ الحادثة أُعيدت للأذهان، واستحضروا صورة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يكسر أصنامهم، ولم يمضِ وقت طويل على الحادثة، فهل ينصروا ابنه أو يدافعوا عنه؟
أمّا مصدرها الطبري صاحب المجلدات الضّخمة التي حوت من كلّ حوش حائش، وفيها أخبار الغثّ والسمين، فهل كلّ ما أورد الطبري صحيحاً؟ وليس عيب عليه أن ينقل هكذا رواية، فقد نقلها من دون التحقّق منها.
وتجدر الإشارة هنا إلى بيان نفاق ابن كثير الذي عمل بصحة الرواية، وكأنّها حقيقة مطلقة، وقبال ذلك طعنه في الطبري؛ لأنّه نقل حديث الولاية، فقال: واعتنى بهذا الحديث الطبري صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طرقه وألفاظه، وساق الغثّ والسمين، والصحيح والسقيم، على ما جرت به عادة كثير من المحدّثين، يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه، وهذا طعن مبطّن للطبري، وفيه إشارة إلى أخباره، وأنّ فيها الصحيح وغيره، وبهذا فليس كلّ ما أورده حجّة، وإنّما كُتبه مثل بقيّة الكُتب.
وقد أقذع السليماني في وصف الطبري: «مَن قال: إنّ أبا بكر، وعمر، ليسا بإمامي هدى أيش هو؟ قال: مبتدع. فقال له الطبري إنكاراً: مبتدع مبتدع، هذا يقتل، مَن قال: إنّ أبا بكر وعمر ليس إمامي هدى يُقتل يُقتل»[306]. «وهو قريب المذاق في تنقيص أمير المؤمنين عليه السلام»[307]، ويُضعِف الرواية أحاديتها فليس لها إلّا أصل واحد هو ذا، وقد وقفنا عنده وبيّنا زيفه، فما هي حجّة مَن أحتجّ بصحة الرواية؟
أمّا متنها فليس صحيحاً إطلاقاً، ومحال أن يصدر عن المعصوم، الذي عبّأ جيشه في رحلة طويلة، وأصبحت المجابهة واقعة لا محال، فكيف يُفكّك جيشه بدلاً من أن يشدّ عزيمته، فيقرأ عليهم ما سلف ذكره، بدلاً عمّا يرّغب في الجهاد، كأن يتلو عليهم قوله تعالى: (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)[308]، وقوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ)[309]، وقوله: (. . . وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[310]، وآيات كثيرة حثّت المؤمنين على الجهاد، وكذلك أحاديث الحبيب المصطفى عليها السلام.
إذن؛ هذا الموقف خطأ قاتل، والمعصوم لا يجوز عليه الخطأ، فالرواية موضوعة، أُريد منها تبرير عمل الذين تخاذلوا عن نصرة الإمام عليه السلام، وعلى رجال التّحقيق أن ينظروا أيّهما أفضل، قول الله تعالى، أو ما نُسب للمعصوم قوله؟ ولأوّل مرّة أجد في روايات القوم ما يبرّرون به فعل المعصوم، وأنّه فعل كذا؛ لأنّه كذا، فما هي غايتهم من ذلك؟
«فلمّا كان من السحر، أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه، ثمّ سار حتى مرّ ببطن العقبة[311]، فنزل بها»[312]، وهذه رواية أبي مخنف، ولم يكن ابن كثير أميناً في نقلها، وقد حذف جلّها؛ لأنّها لا تنسجم مع هواه، قال أبو مخنف: «حدّثني لوذان أحد بني عكرمة: إنّ أحد عمومته سأل الحسين عليه السلام أين تريد؟ فحدّثه، فقال له: إنّي أنشدك الله، لمّا انصرفت، فو الله لا تقدم إلّا على الأسنّة وحدّ السيوف، فإنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك، لو كانوا كفوك مؤنة القتال، ووطئوا لك الأشياء، فقدِمت عليهم كان ذلك رأياً، فأمّا على هذه الحال التي تذكرها، فإنّي لا أرى لك أن تفعل. فقال له: يا عبد الله، إنّه ليس يخفى عليّ، الرأي ما رأيت، ولكن الله لا يُغلب على أمره، ثمّ ارتحل منها»[313].
الخاتمة
الحمد لله الذي بتوفيقه تمّ إنهاء هذا العمل، الذي نعتقد ـ في أغلب صفحاته ـ أنّه عمل جديد، ونحن مطالبين في كتابة هذا الجديد تحت عنوان اسمه الخاتمة، الذي ذكرها رسول الله عليها السلام بقوله: «إنّما الأعمال بخواتيمها»[314] «ويقرأ (خاتمه مسك)، أي: ختامه، يعني عاقبته ريح المسك، وخاتمة السورة: آخرها، وخاتم العمل وكلّ شيء: آخره»[315].
وبناءً على هذه الضابطة، نورد شيء قليل عن هذا المعنى:
1ـ اعتماد الباحثين على أبي مخنف في تدوين النهضة الحسينية، وهو مصدر غير موثوق، وصاحبه غير معروف الحال، فقد نُسب إلى لوط بن يحيى من دون دليل، وحتى هذا الرجل مختلف عليه، لم تثبت صحبته للإمام الحسين عليه السلام.
2ـ لقاء الفرزدق ـ الشاعر البصري ـ بالإمام الحسين عليه السلام غير ثابت، ولكن الثابت لدينا إنّ قصيدته المشهورة كانت بحق الإمام الحسين عليه السلام، ولم تكن للإمام السجاد عليه السلام.
3ـ ورد في أحد الروايات أنّ الإمام حمل معه ابنته إلى العراق، وهذا دليل يدعم رأينا بعدم وجود بنتاً له اسمها سكينة.
4ـ كثرة المنامات المنسوبة للإمام الحسين عليه السلام، وهي كلّها واهية لا صحة لها.
5ـ أُجبر الإمام الحسين عليه السلام على الخروج إلى الكوفة، ولم يكن بمحض إرادته؛ بل بسبب مضايقة القوم له، فإمّا أن يبايع يزيد وإمّا أن يُقتل، وهذا يُبطل القراءات الخاطئة من أنّه عليه السلام خارج لطلب السلطة.
6ـ أرسل الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة رسولاً واحداً، هو مسلم بن عقيل عليه السلام، ولم يرسل غيره.
فهرست المصادر
* القرآن الكريم
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الألباني، تحقيق: زهير الشاويش، ط2، 1985م، بيروت.
أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت279هـ)، تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط1، 1394هـ، بيروت.
الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر (ت852هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط1، 1415هـ، بيروت.
الأعلام، خير الدين الزركلي (ت1410هـ)، ط5، بيروت، (د ت).
الأنساب، أبو سعيد عبد الكريم السمعاني (ت562هـ )، تعليق: عبد الله عمر البارودي، ط1، 1408هـ، بيروت.
أبو طالب بن عبد المطلب، دراسة في سيرته الشخصية وموقفه من الدعوة الإسلامية، علي صالح رسن المحمداوي، 2012م، بيروت.
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد (ت413هـ)، قم، (د ت).
الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد (ت413هـ)، ط1، 1412هـ، قم.
الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي الصدوق (ت381 هـ)، 1404هـ، قم.
اختيار معرفة الرجال، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: مير داماد وآخرون، 1404هـ، قم.
البداية والنهاية، عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت774هـ)، ط2، 1974م، بيروت.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم المصري (ت970م)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، ط1، 1418هـ، بيروت.
التعديل والتجريح لـمَن خرج عنه البخاري، سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ)، تحقيق: أحمد البزار، (د ت).
التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، بيروت، (د ت).
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أحمد بن علي بن حجر (ت852 هـ)، تحقيق عاصم القربوني، ط1، عمان، (د ت).
تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر (ت852 هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر، ط2، 1995م، بيروت.
تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر (ت852 هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر،ط2، 1415هـ، بيروت.
تاريخ بغداد، الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر، ط1، بيروت، 1417هـ.
تذكرة الحفّاظ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748 هـ)، مكتبة الحرم المكي، (د ت).
التبيين لأسماء المدلسين، إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الشافعي (ت841هـ)، تحقيق: يحيى شفيق، 1406هـ، بيروت.
تاريخ أسماء الثقات ممَّن نقل عنهم العلم، عمرو بن أحمد بن شاهين (ت385هـ)، تحقيق: صبحي السامرائي، ط1، الدار السلفية، 1404هـ.
التوحيد، محمد بن علي الصدوق (ت381 هـ)، تحقيق: هاشم الحسيني، 1387هـ، قم.
ترجمة الإمام الحسن عليه السلام، علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي(ت571هـ)، تحقيق: محمد باقر المحمدي، 1980م، بيروت.
تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي(ت571هـ)، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، 1415هـ.
تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310 هـ)، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، 1968م، مصر.
تاريخ ابن معين، يحيى بن معين (ت233هـ)، تحقيق: عبد الواحد حسين، بيروت، (د ت).
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين يوسف المزي (ت742هـ)، تحقيق:
د. بشار عواد معروف، ط4، مؤسسة الرسالة، 1406هـ.
تاريخ اليعقوبي، أحمد بن يعقوب اليعقوبي (ت292هـ)، بيروت، (د ت).
الثقات، محمد بن حبّان (ت354هـ)، ط1، 1393هـ، الهند.
الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت327 هـ)، ط1، 1371هـ، بيروت.
جمهرة أنساب العرب، أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم (ت456هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط3، 1971م، مصر.
خلاصة الأقوال، الحسن بن يوسف الحلي (ت726هـ)، ط2، 1381هـ، النجف.
رجال ابن داوود، تقي الدين ابن داوود الحلي (ت707هـ)، 1392هـ، النجف.
روضة الواعظين، محمد بن الحسن بن الفتّال (ت 508هـ)، قم، (د ت).
سؤالات أبي داوود، أبو عبيد الآجري، تحقيق: عبد الحليم عبد العظيم، ط1، مؤسسة الريان، 1997م.
سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748 هـ)، تحقيق: صلاح الدين المنجد، مصر، (د ت).
شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد (ت656هـ)، 1404هـ، قم.
الضعفاء الصغير، محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط1، 1406هـ، بيروت.
الضعفاء الكبير، محمد بن عمر بن موسى العقيلي (ت322هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين، ط2، 1418هـ، بيروت.
الطبقات الكبرى، محمد بن سعد (ت230هـ)، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، (د ت).
طبقات المحدّثين بأصفهان والواردين عليها، محمد بن حبّان (ت354هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق، ط2، 1412هـ، بيروت.
الطبقات، خليفة بن خياط (ت240هـ)، تحقيق سهيل زكار، 1993م، بيروت.
العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت241هـ )، تحقيق: وصي الله بن محمود عباس، ط1، 1408هـ، الرياض.
عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة، علي صالح رسن المحمداوي، مركز الأبحاث العقائدية (الجمهورية الإسلامية، 2011م).
عكرمة مولى ابن عباس مفسراً، علي صالح رسن المحمداوي، بحث غير منشور.
الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عبد الحسين الشبستري، ط1، 1418هـ، قم.
الفهرست، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، النجف.
فهرست أسماء مصنفي الشيعة، أحمد بن علي النجاشي (ت450هـ)، 1407هـ، قم.
فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد بن عبد الرؤوف المناوي (ت1031هـ)، ط1، 1415هـ، بيروت.
الكرم والجود وسخاء النفوس، محمد بن الحسين البرجلاني (ت238هـ)، تحقيق: عامر حسن صبري، ط2، 1412هـ، بيروت.
الكاشف في معرفة مَن له رواية في الكتب الستة، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748 هـ)، ط1، مؤسسة علوم القرآن، 1413هـ.
الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365هـ)، تحقيق: سهيل بكار، ط3، 1409هـ، بيروت.
الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت329 هـ)، 1365هـ، طهران.
الكافئة في أبطال توبة الخاطئة، أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد (ت413هـ)، تحقيق: علي أكبر زماني، 1993م، بيروت.
معجم البلدان، ياقوت الحموي (ت626هـ)، بيروت، (د ت).
مجمع الزوائد ومعجم الفوائد، نور الدين علي الهيثمي (ت807 هـ)، بيروت، (د ت).
مقتل الإمام الحسين عليه السلام، أبو مخنف لوط بن يحيى (ت157هـ)، تحقيق: ميرزا حسن الغفاري، 1298هـ، قم.
معرفة الثقات، حمد بن عبدان العجلي (ت261هـ)، ط1، 1405هـ، المدينة المنورة.
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق: حمدي عبد الحميد، ط2، القاهرة.
ميزان الاعتدال، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط1، 1382هـ، بيروت.
مسند ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ت238هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الخالق، ط1، 1991م المدينة المنورة.
معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيّد أبو القاسم الخوئي (ت1413هـ)، تحقيق: لجنة التحقيق، ط5، 1413هـ.
المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبّان (ت354هـ)، تحقيق :محمود إبراهيم زايد، (د ت).
مشاهير علماء الأمصار أعلام فقهاء الأقطار، محمد بن حبّان (ت354هـ)، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، ط1، دار الوفاء، 1411هـ.
مقاتل الطالبيين، علي بن الحسين الإصفهاني (ت356هـ)، تحقيق: كاظم المظفر، ط2، 1965م، قم.
نقد الرجال، مصطفى بن الحسين التفرشي (ت ق11)، تحقيق: ونشر مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، ط1، 1418هـ، قم.
نهج البلاغة، أبو الحسن محمد بن الحسين الملقب بالشريف الرضي (ت406 هـ)، تحقيق: محمد عبده، بيروت، (د ت).
________________________________________
[1] جامعة البصرة/كلية التربية/العلوم الإنسانية.
جامعة البصرة/كلية التربية/العلوم الإنسانية.
[2] سبأ: آية28.
[3] اُنظر: من إشكاليات التاريخ: .Altareekh.com/article/view/8334/
[4] «أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المتوفّى سنة (94هـ) بالمدينة». ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص207.
[5] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص17.
[6] ابن عساكر، علي بن الحسن، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: ص295.
[7] «عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أُمّها سالمة بنت حكيم بن هاشم بن قوالة، تزوجها عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان، كانت عالمة». ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج8، ص480.
[8] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص176.
[9] النساء: آية78.
[10] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص185.
[11] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص35.
[12] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص319.
[13] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص275.
[14] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص204.
[15] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوال: ص234.
[16] اُنظر: ابن داوود، الحسن بن علي، رجال ابن داوود: ص15. التفرشي، مصطفى بن الحسين، نقد الرجال: ج4، ص75.
[17] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج15، ص142.
[18] اُنظر: الشبستري، عبد الحسين، الفائق في رواة الإمام الصادق عليه السلام: ج2، ص625.
[19] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: ج1، ص147.
[20] اُنظر: الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل: ج8، ص117.
[21] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج7، ص72.
[22] في المصدر: (وهو شاعي) والظاهر أنّه خطأ مطبعي.
[23] اُنظر: الجرجاني، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال: ج6، ص92.
[24] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص419.
[25] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج7، ص301.
[26] اُنظر: المحمداوي: عكرمة مولى ابن عباس مفسراً، بحث غير منشور.
[27] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص96.
[28] اُنظر: المحمداوي، علي صالح، عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة: ص231.
[29] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص180.
[30] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص372.
[31] ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج2، ص204.
[32] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج3، ص143.
[33] الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص213.
[34] الفرزدق، همام بن غالب، ديوان الفرزدق: ص32، ص43ـ46.
[35] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص213.
[36] المصدر السابق: ج69، ص209.
[37] المصدر السابق: ج50، ص284.
[38] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص226ـ227.
[39] المصدر السابق: ص227.
[40] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص101.
[41] اُنظر: الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج5، ص121.
[42] المناوي، محمد بن عبد الرؤوف، فيض القدير: ج1، ص601.
[43] اُنظر: المحمداوي، علي صالح، الخلافة الراشدة: ص207ـ223.
[44] الفتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص155.
[45] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص227.
[46] الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ج1، ص343ـ345.
[47] «ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعاثم، يتصل بالدماغ، وهو معرب». ابن نجيم المصـري، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق: ج3، ص435.
[48] هكذا في المصدر.
[49] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص180.
[50] الوهط: «حائط لعبد الله بن عمرو بالطائف، وكان معاوية قد ساوم به عبد الله وأعطاه به مالاً كثيراً، فأبى أن يبيعه بشيء». الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص290.
[51] المصدر السابق: ج4، ص290.
[52] اُنظر: المحمداوي، علي صالح، أبو طالب: ص36.
[53] المحمداوي، علي صالح، عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة: ص291.
[54] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج7، ص183.
[55] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص361.
[56] أبو الفرج الإصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص245.
[57] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص293.
[58] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص306.
[59] العصفري، خليفة بن خياط، الطبقات: ص398.
[60] الباجي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج2، ص775.
[61] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج29، ص24.
[62] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص60.
[63] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج10، ص361.
[64] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج29، ص26.
[65] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص306.
[66] اُنظر: العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص303.
[67] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص160.
[68] الباجي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج2، ص775.
[69] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج29، ص24.
[70] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج10، ص360.
[71] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص306.
[72] العصفري، خليفة بن خياط، الطبقات: ص398.
[73] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص285.
[74] السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج4، ص5.
[75] البخاري، محمد بن إسماعيل، الضعفاء الصغير: ص113.
[76] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج8، ص381ـ382.
[77] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص470.
[78] أبو حفص، عمر بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: ص220.
[79] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج28، ص199.
[80] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص136.
[81] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج28، ص199.
[82] المصدر السابق: ج27، ص410.
[83] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج8، ص273.
[84] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص483.
[85] اُنظر: الشيباني، أحمد بن محمد، سؤالات أبي داوود للإمام أحمد: ج2، ص161.
[86] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص172.
[87] ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم، مسند إسحاق بن راهويه: ج2، ص510.
[88] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص173.
[89] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص203.
[90] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص173.
[91] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص262.
[92] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص354.
[93] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج1، ص41.
[94] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج9، ص192.
[95] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص263.
[96] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج18، ص473.
[97] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج8، ص426.
[98] اُنظر: الشيباني، أحمد بن محمد، سؤالات أبي داوود للإمام أحمد: ج1، ص375.
[99] اُنظر: ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج2، ص.62
[100] اُنظر: العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص415.
[101] اُنظر: الشيباني، أحمد بن محمد، سؤالات أبي داوود للإمام أحمد: ج2، ص13.
[102] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص4.
[103] اُنظر: الباجي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج2، ص1016.
[104] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج18، ص474.
[105] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج6، ص24.
[106] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج2، ص677.
[107] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج18، ص474.
[108] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج4، ص314.
[109] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف في معرفة مَن له رواية في كتب الستة: ج1، ص456.
[110] اُنظر: ابن حنبل، أحمد، العلل ومعرفة الرجال: ج2، ص496.
[111] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص435.
[112] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج11، ص84.
[113] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج5، ص245.
[114] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص365.
[115] الباجي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج3، ص1227.
[116] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج1، ص65.
[117] اُنظر: ابن حنبل، أحمد، العلل ومعرفة الرجال: ج2، ص496.
[118] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج4، ص61.
[119] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص291.
[120] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج4، ص81.
[121] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، خطب نهج البلاغة: ج1، ص73.
[122] المصدر السابق: ج1، ص63.
[123] المصدر السابق: ج1، ص97.
[124] المصدر السابق: ج1، ص187.
[125] المصدر السابق: ج2، ص102.
[126] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص163.
[127] اُنظر: المصدر السابق: ج8، ص162.
[128] ابن سعد من بني الحارث بن الخزرج، ولي الكوفة لمعاوية وأقام بها، وكان عثمانياً، ثمّ عزله فصار إلى الشام، فلمّا مات يزيد بن معاوية دعا النعمان لابن الزبير، وكان عاملاً على حمص، فلما قُتل الضحّاك بن قيس بمرج راهط سنة (64هـ )، هرب النعمان بن بشير من حمص، فطلبه أهل حمص فأدركوه فقتلوه واحتزوا رأسه، ووضعوه في حجر امرأته الكلبية. ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص53.
[129] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص261.
[130] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص40. أبو الفرج الإصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص70.
[131] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص165.
[132] البرجلاني، محمد بن الحسين، الكرم والجود: ص49.
[133] المفيد، محمد بن محمد، الكافئة: ص27.
[134] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص278.
[135] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج7، ص210.
[136] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص278.
[137] الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص208.
[138] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص394.
[139] اُنظر: العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص233.
[140] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج7، ص210.
[141] المصدر السابق: ج7، ص211.
[142] اُنظر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: ج20، ص117.
[143] البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج9، ص65.
[144] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص103.
[145] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج10، ص365.
[146] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص178.
[147] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص292. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج3، ص144.
[148] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج11، ص455، ص456.
[149] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص292.
[150] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج4، ص123
[151] ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص81. المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج11، ص455.
[152] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص394.
[153] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص94.
[154] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص283.
[155] المصدر السابق.
[156] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص293.
[157] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج11، ص456.
[158] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص292.
[159] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص66.
[160] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص271.
[161] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص272.
[162] المصدر السابق: ج2، ص273.
[163] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص283.
[164] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج11، ص456.
[165] «تصغير نخلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام، وهو الموضع الذي خرج إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وخطب خطبةً مشهورة، ذم فيها أهل الكوفة، وبه قتلت الخوارج لمّا ورد معاوية إلى الكوفة». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص278.
[166] «بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصب الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات، وقيل: سُمّيت بقرقيسيا بن طهمورث الملك». المصدر السابق: ج4، ص328.
[167] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص292.
[168] البقرة: آية54.
[169] اليعقوبي، أحمد، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص257.
[170] ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص81.
[171] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج3، ص160.
[172] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص395.
[173] المحمداوي، علي صالح، عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة: ص213.
[174] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص183.
[175] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: ص307.
[176] اُنظر: المبحث الأوّل: نهيه بعدم التوجه للعراق.
[177] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص140.
[178] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص176.
[179] اُنظر: ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج2، ص104.
[180] اُنظر: العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج1، ص269.
[181] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج2، ص481.
[182] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج1، ص269.
[183] اُنظر: العقيلي، محمد بن عمر، ضعفاء العقيلي: ج1، ص189.
[184] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص140.
[185] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص408.
[186] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج2، ص481.
[187] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص241.
[188] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص140.
[189] البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج2، ص192.
[190] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج2، ص104.
[191] اُنظر: العقيلي، محمد بن عمر، ضعفاء العقيلي: ج1، ص188.
[192] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص140.
[193] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج2، ص481.
[194] اُنظر: ابن عدي، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال: ج2، ص144.
[195] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ: ج1، ص241.
[196] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص408.
[197] اُنظر: العصفري، خليفة بن خياط، الطبقات: ص386.
[198] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج2، ص192.
[199] اُنظر: الباجي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج3، ص1407.
[200] البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج8، ص370.
[201] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج9، ص297.
[202] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص245.
[203] اُنظر: ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ص215.
[204] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص631.
[205] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج32، ص281.
[206] أبو حفص، عمر بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: ص255.
[207] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج9، ص298.
[208] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص444.
[209] أبو حفص، عمر بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: ص255.
[210] ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص241.
[211] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج32، ص281.
[212] اُنظر: المصدر السابق: ج32، ص283.
[213] اُنظر: ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص241. ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص631.
[214] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص175.
[215] «ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب، قدِم البصرة والكوفة، توفّي بالمدينة سنة (94هـ)، وهو ابن (72) سنة. وهذا أثبت من قول مَن قال: إنّه توفّي سنة (104هـ)». ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص157.
[216] «ابن نوفل ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، مولده بمكة السنة الثانية من الهجرة، وقدِم به المدينة في النصف من ذي الحجة سنة(8هـ)، وحجّ مع النبي (صلّى الله عليه وسلّم) حجةً، وحفظ جوامع أحكام الحجّ، واستوطن المدينة». ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص43.
[217] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص176.
[218] ابن عساكر، علي بن الحسن، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: ص294.
[219] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص155.
[220] اُنظر: ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص43.
[221] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص47.
[222] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ص8، ص179.
[223] «من منازل طريق مكّة من الكوفة، بعد الشقوق وقبل الخزيمية، وهي ثلثا الطريق، سُمّيت بثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء لمّا تفرّقت أزد مأرب، لحق ثعلبة بهذا الموضع، فأقام به فسُمّي به، فلمّا كثر ولده وقوي أمره رجع إلى نواحي يثرب، فأجلى اليهود عنها، فولده هم الأنصار، قيل: سُمّيت الثعلبية بثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وهو أوّل مَن حفرها ونزلها. وقيل: سُمّيت برجل من بني دودان بن أسد يقال له ثعلبة، أدركه النوم بها، فسمع خرير الماء بها في نومه، فانتبه، وقال: أقسم بالله إنّه لموضع ماء! واستنبطه وابتناه». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص78.
[224] الباحث لم يقر وجوده.
[225] الإسراء: آية71.
[226] الشورى: آية7.
[227] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص216.
[228] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص115.
[229] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج6، ص258.
[230] المصدر السابق: ج8، ص172.
[231] المصدر السابق: ج6، ص258.
[232] المصدر السابق: ج8، ص160.
[233] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص261. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص17.
[234] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص163.
[235] الباحث لم يعرفها ولا صاحبها، كلّ الذي وجده هو مسلم بن المسيّب بشيراز، عامل لابن عمر، فقتله سنة (128هـ). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج6، ص39.
[236] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص20. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص264.
[237] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص103.
[238] المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص485ـ ص495.
[239] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج10، ص193.
[240] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص181.
[241] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص71. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص297.
[242] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182. أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص75. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص299.
[243] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص163.
[244] اُنظر: المصدر السابق.
[245] ذُكر في روايات أنّه حمصي سكوني، له دور سيّء في أحداث كربلاء، الباحث لم يطمئن له.
[246] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص71. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص297. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص71.
[247] «وادٍ معروف بعالية نجد، وقيل: قاع عظيم بنجد، تنصب إليه أودية». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج1، ص449.
[248] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182.
[249] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص71. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص297.
[250] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص104.
[251] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8،182.
[252] «منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة، وهى قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية، وهي بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق، فيها حصن وجامع لبنى غاضرة من بنى أسد، سُمّيت زبالة باسم زبالة بنت مسعر امرأة من العمالقة نزلتها». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج3، ص129.
[253] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص75.
[254] ابن حبّان، محمد، الثقات:ج5، ص116. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عمر، طبقات المدلسين: ص41. سبط ابن العجمي، إبراهيم بن محمد، التبيين لأسماء المدلسين: ص39.
[255] ابن عبد الله بن سالم، شاعر كوفي معروف بالهجاء. ابن حزم الأندلسـي، محمد علي بن أحمد، جمهرة أنساب العرب: ص249. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج9، ص72.
[256] المفيد، محمد بن محمد، الإفصاح: ص220. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: ج17، ص62.
[257] «رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن زياد، الذي أمر به فرُميَ من فوق القصر مكشوفاً فوقع على الأرض وبه رمق فذبحه». الفتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص177.
[258] اُنظر: المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج27، ص163. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص71. الأردبيلي، محمد بن علي، جامع الرواة: ج1، ص518.
[259] اُنظر: القمي، محمد طاهر، كتاب الأربعين: ج1، ص275. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص37.
[260] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص105. الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص220.
[261] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج1، ص200. العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص104. الخزار القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص328.
[262] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص205.
[263] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص179. اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص204.
[264] اُنظر: الحميري، يزيد بن مفزع، ديوان الحميري، الدالية، البيتان التاسع والعاشر.
[265] اُنظر: البصري، عبد الصمد بن المعذل، ديوان عبد الصمد، الدالية، البيت الخامس.
[266] اُنظر: المحمداوي، علي صالح، عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة: ص106.
[267] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج7، ص290.
[268] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص59.
[269] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182.
[270] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص78. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص300.
[271] «رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاجّ من الكوفة، ولعلّها سُمّيت بذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها السحائب؛ لأنّ معنى الزرد هو البلع». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج3، ص139.
[272] «من منازل طريق مكّة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية، وهي ثلثا الطريق». المصدر السابق: ج2، ص78.
[273] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص75. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص299.
[274] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182.
[275] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص75.
[276] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص58.
[277] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص360.
[278] البخاري، محمد بن إسماعيل، الضّعفاء الصغير: ص124.
[279] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص393.
[280] اُنظر: النسائي، أحمد بن علي، الضّعفاء والمتروكين: ص250.
[281] ابن حنبل، أحمد، العلل ومعرفة الرجال: ج3، ص114.
[282] العقيلي، محمد بن عمر، ضعفاء العقيلي: ج4، ص399.
[283] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج1، ص257.
[284] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج9، ص138.
[285] اُنظر: ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج3، ص111.
[286] ابن عدي، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال: ج7، ص212.
[287] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج86، ص312.
[288] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج1، ص257.
[289] ابن حنبل، أحمد، العلل ومعرفة الرجال: ج3، ص114.
[290] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج9، ص138. المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج86، ص312.
[291] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص393.
[292] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج9، ص138.
[293] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج31، ص284.
[294] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص360. ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص597.
[295] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، الضعفاء الصغير: ص124. ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج3، ص111.
[296] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص66، ص78، ص81، ص120.
[297] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص288. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص179، ص182، ص186.
[298] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص260.
[299] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج5، ص77.
[300] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج8، ص352.
[301] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص73.
[302] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج11، ص214.
[303] لم أعرفه سوى ما قيل: «إنّه موضع في ديار بني تميم». البكري الأندلسي، عبد الله بن عبد العزيز، معجم ما استعجم: ج2، ص416.
[304] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182.
[305] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص300. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص75.
[306] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج52، ص201.
[307] المحمداوي، علي صالح، الخلافة الراشدة: ص92ـ93.
[308] النساء: آية95.
[309] البقرة: آية154.
[310] المائدة: آية35.
[311] «منزل في طريق مكّة بعد واقصة وقبل القاع لـمَن يريد مكّة، وهو ماء لبني عكرمة من بكر بن وائل». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص134.
[312] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص183.
[313] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص79. اُنظر الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص301. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص76.
[314] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج7، ص188.
[315] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج4، ص242.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبياء
http://warithanbia.com/?id=1306
لینک کوتاه
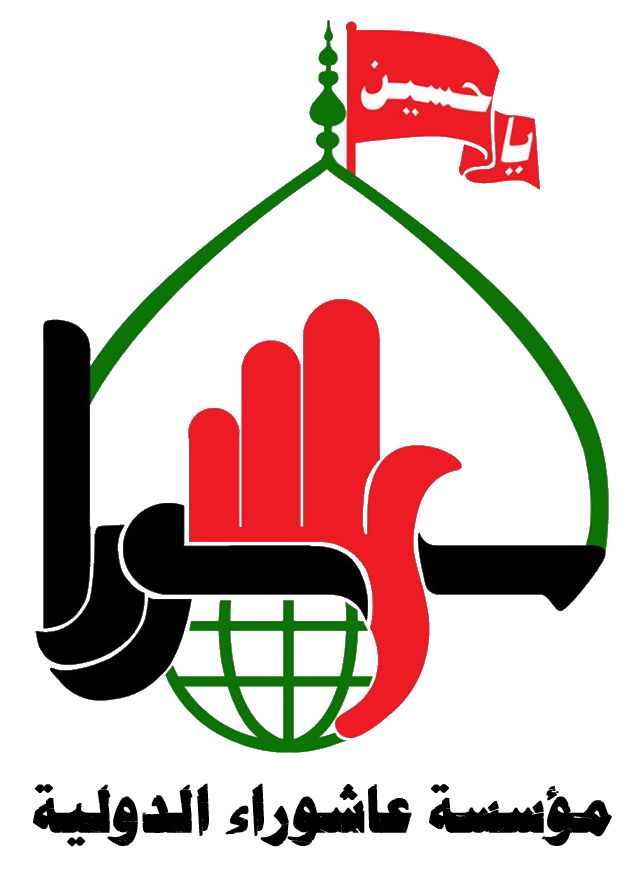
سوالات و نظرات