توظيف آية التطهير بلسان الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) في النهضة الحسينية
{ الشيخ وسيم راقم الوائلي – ماجستير في الشريعة والعلوم الإسلامية، قسم علوم القرآن والحديث، كلية الفقه ـ جامعة الكوفة، من العراق }
المقدّمة
إنّ البحوث كثيرة في آية التطهير، إلّا أنّ منهج البحث يختلف من باحثٍ لآخر؛ لذا فقد يُتصور للوهلة الأُولى أنّ البحث سيتناول الآية الكريمة بالكيفية المتعارفة في بحث النصّ القرآني نفسها، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك؛ فالبحث لا يُسلِّط الضوء على تفسير النصّ الكريم فحسب، بل يبحث ما وراءه من الدقائق التي لا يمكن اكتشافها إلّا عِبر الآليات الدقيقة المتمثلة بطريقة التفسير التحليلي[1]، الذي يعطي أجزاء النصّ اللغوي بعامّة والقرآني بخاصّة حقّه من البحث، ابتداءً بأصغر جزءٍ من النصّ وانتهاءً بالمنظومة السياقية المترامية الأطراف.
وتبرز أهمّية الموضوع في كونه يتعلّق بأبرز نصٍّ في القرآن الكريم، ولأنّه جاء على لسان الإمام عليّ بن الحسين(عليهما السلام) في مقام التوظيف، ولأهمّية النتائج المترتبة على دلالة هذه الآية الكريمة، وعدم الاكتفاء بالنظرة السطحية لهذا النصّ ولغيره من النصوص الكريمة؛ لأنّ منها ما يؤسّس لسننٍ وقوانين تاريخية تفسّر الظواهر البشرية على امتداد الزمان.
وقد تمّ تقسيم البحث على أربعة مباحثٍ يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة بأهم النتائج.
التمهيد: أنواع توظيف النصّ والمناسبة التاريخية لتوظيف آية التطهير
أنواع توظيف النصّ
لكلّ نصٍّ لغوي وظيفةٌ ما[2]، تسمّى بـ(الوظيفة الإبلاغية) أو (التواصلية)، وهي تتنوّع بتنوّع الأغراض التي يستهدفها الموظِّف للنصّ، وقد ذكر العلماء الوظيفيون جملةً من هذه الأقسام، كأقسام هاليداي[3]، وأقسام جاكبسون[4]، وأقسام بوهلر[5]، وهنالك مَن أرجع كلّ الأقسام الوظيفية إلى أصلٍ واحد[6]، وهو (الوظيفة التواصلية)، إلّا أنّها تكون بدرجات متفاوتة، ومنهم[7] مَن أرجعها إلى (الوظيفة الإفهامية).
وفي الحديث عن توظيف النصّ القرآني ينبغي التمييز بين وظيفة النصّ القرآني القصدية من قِبل السماء، وبين عملية توظيف النصّ القرآني من قِبل البشر في تواصلهم؛ لأنّ وظيفة النصّ القرآني الأُولى، هداية البشرية بعامتها[8]، لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة على أكمل الوجوه، وهذه الوظيفة واضحة الدلالة في عبارة القرآن العظيم، كما في قوله تعالى: (إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)[9]، فالهداية وظيفة تواصلية إفهامية قصدية من قِبل القرآن الكريم، ويقعُ في طولها وظائف لا متناهية من حيث مستوى المُرسِل والمتلقي؛ «فإنّ القرآن الكريم يُمكنُ أن يُفهَمَ من كلّ مستوى من المستويات العقلية والروحية بشكلٍ يختلف عن الآخر، فإذا وصل المستوى إلى أعلى المستويات ـ كما عند المعصومين(عليهم السلام) ـ أصبح فهمهم للقرآن الكريم لا يشبهه فهمٌ آخر»[10].
لذا؛ فقد يتّسع البحث أو يضيق تبعاً لمستوى المُرسِل للنصّ أو المُتلقي؛ وتأكيد ذلك بقول الإمام الحسين(عليه السلام): «كتاب الله(عز وجل) على أربعة أشياء: على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء»[11]، وهذا القول الكريم يختصر المطوّلات ويحلّ الإشكالات في سرّ تعدّد وظائف هذا السفر العظيم؛ لأنّ الله تعالى يخاطب به كلّ مستويات البشر من العامّة إلى الأنبياء(عليهم السلام)؛ وكلّما كانت مرتبة المتلقي للنصّ أعلى، كانت الوظائف التي يفهمُها من النصّ أكثر وأعمق؛ من هذا يُفهم أنّ القرآن الكريم فيه تبيان كلّ شيء في واقعه وفي الأمر نفسه، ومن حيث مجموع مستويات المتلقي المتفاوتة، وليس لكلِّ فردٍ إدراك كلّ شيء من القرآن الكريم، لأنّ ذلك يختلف من حيث قابلية الأفراد واستحقاقهم، فالمطهّرون، والراسخون في العلم، وأهل الذكر، مطّلعون على تلك الحقائق القرآنية وتفاصيلها[12]، إلّا أنّ المتلقّي لا يمكنه استيعاب جميع دلالات النصّ الكريم، بل له من ذلك القدر المتيقّن من الوظيفة العامّة (وظيفة الهداية)، فإن اتّسعت مداركه استطاع التعرّف على وظائف أُخرى تقع في طول الوظيفة العامّة؛ إذ إنّ توظيف النصّ القرآني من قِبل بني البشر يهبُ النصّ وظيفةً تواصليةً خاصّةً، تختلف باختلاف مستوياتهم، يُشترط فيها أن تكون في طول الوظيفة العامّة للنصّ الكريم (وظيفة الهداية)، وإلّا كان التوظيف سقيماً، وعلى هذا تفرّع ـ إجرائياً ـ نوعين من توظيف النصّ القرآني، وهما (التوظيف السقيم)، و(التوظيف السليم) .
ومن أجل استنطاق النصوص الموظّفة في النهضة الحسينية فلا بدّ من تحليلها في ضمن أُطرها التداولية (Pragmatics) التي تعني: «دراسة المعنى الذي يقصده المتكلّم»[13]؛ لأنّ النصّ القرآني الموظّف ينبغي أن يُفهم من زاوية ما هو موجود من الوقائع[14]، وفي طول الوظيفة العامّة للنصّ القرآني الكريم.
المناسبة التاريخية لتوظيف آية التطهير بلسان الإمام عليّ بن الحسين(عليهما السلام)
وظَّفَ الإمام زين العابدين(عليه السلام) هذا النصّ الكريم في حواره مع شيخٍ شامي، فقد نُقل أنّ السبايا «أُتي بهم باب دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي… وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين(عليه السلام) وهم في ذلك الموضع، فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم، وأراح البلاد من رجالكم، وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له عليّ بن الحسين(عليه السلام): يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت هذه الآية: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)[15]؟ قال الشيخ: نعم، قد قرأت ذلك. فقال عليّ(عليه السلام) له: فنحن القربى يا شيخ… فهل قرأت هذه الآية: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[16]. قال الشيخ: قد قرأت ذلك. فقال عليّ(عليه السلام): فنحن أهل البيت الذي خصّصنا الله بآية الطهارة… فبقيَ الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلّم به، وقال: بالله إنّكم هم؟ فقال عليّ بن الحسين(عليهما السلام): تالله إنّا لنحن هم من غير شك… فبكى الشيخ ورمى عمامته، ثمَّ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهم إنّا نبرأ إليك من عدوّ آل محمد(صلى الله عليه واله) من جنّ وإنس. ثمّ قال: هل لي توبة. فقال له: نعم، إن تبت تاب الله عليك، وأنت معنا. فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ، فأمر به فقتل»[17].
وممّا تقدّم اتّضح أنّ الإمام عليّ بن الحسين(عليهما السلام) وظّف آية التطهير في الحوار مع الشيخ الشامي، وهذا التوظيف يقع في طول الوظيفة العامّة للقرآن الكريم (وظيفة الهداية).
المبحث الأول: التفسير التحليلي للحرف في آية التطهير
تتكون آية التطهير من خمسين صوتاً؛ إلّا أنّ الباحث اختار واحداً من هذه الأصوات ليبحث دلالته الصوتية في النصّ الكريم؛ لضيق مقام البحث عن تناول جميع الحروف.
اختار الباحث حرف الميم ـ هنا ـ لما لهذا الحرف من مزايا[18]، فهو المرتبط تاريخياً مع الماء سرّ الحياة، وكذلك لملاحظة التحوّل الدلالي[19] لدلالة الحرف في المفردات المختلفة.
وقد جاء حرف الميم في آية التطهير ثلاث مرات في ثلاث مفرداتٍ قرآنية، وهي: (إنَّما)، (عنكم)، (يطهّركم)، ولصفاته الثلاث: (الجهر)، (الاستفال)، (التوسط) تناسبٌ دلالي مع الأحداث التي دلّ عليها النصّ الكريم لفظاً ونزولاً وتوظيفاً على نحو «المحاكاة الصوتية (Onomatopoeia): [و] هي عملية تجسيد الصوت للمعنى»[20]، وهو أحد أنواع المحاكات الثلاثة[21].
أمّا صفة الجهر في الميم[22] فتتناسب مع ما دلّت عليه أخبار الفريقين[23] من جهر النبيّ(صلى الله عليه واله) وتبليغه للقرآن الكريم بعامّة وآية التطهير بخاصّةٍ، فقد قام بتبليغها بأُسلوبٍ مميّزٍ من حيث الجهر بها على باب الإمام عليّ وفاطمة الزهراء(عليهما السلام)، وخلال مُدّةٍ طويلة وبشكلٍ يومي، بل إنّ بعض الأخبار دلّت على جهره(صلى الله عليه واله) بالنصّ على أسماء تسعةٍ من ولد الإمام الحسين(عليه السلام)[24]، وهذا ما يتعلّق بتوظيف الإمام زين العابدين(عليه السلام)؛ بصفته أحد أهل البيت الذين جهر النبي(صلى الله عليه واله) بأسمائهم(عليهم السلام).
وبهذا تتبيّن علاقة صفة الجهر بالحدث الذي دلّت عليه آية التطهير؛ إذ إنّه كان من أبرز الحوادث في تاريخ المسلمين وأبينها؛ لكثرة التأكيد من قِبل النبي(صلى الله عليه واله) على هذه الحقيقة الكبيرة التي يدلّ عليها النصّ الكريم.
وتوظيف الإمام زين العابدين(عليه السلام) لهذا النصّ الكريم في حواره مع الشيخ الشامي جاء مناسباً لصفة الجهر في حرف الميم؛ وذلك أنّ الإمام(عليه السلام) قد جهر بتلك الحقيقة التي كانت خافيةً على الشيخ الشامي، ممّا أدّى إلى هدايته.
أمّا صفة الاستفال في الميم[25] فتتناسب مع حدث الإزالة الذي يتناسب عكسياً مع التطهير؛ حيث «يقرنُ العقلُ بين إحساس الصوت وإحساس الصورة، وبينه وبين أيّ إحساسٍ من نوعٍ آخر»[26]، فالرجس وأهله في الأسفل، والطهارة وأهلها في الأعلى، وأهل البيت(عليهم السلام) وإن لم يكُن قد أصابهم الرجس إلّا أنّه أُبعِدَ (عنهم) لا (منهم)، لِيُزال عنهم البتة؛ فهم في تكاملٍ وارتفاعٍ وعلوٍ مستمرٍ ودائمٍ، وهذا يقتضي الابتعاد عن الرجس وأهله؛ ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: (إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)[27]، فعبارة (رافعك إليَّ) دلّت على العلو ويقابله السفل، وحيث إنّ الطهارة جاءت ملازمة للرفع إلى الله تعالى فهي تُناسب الفوقية والارتفاع، والرجس يُناسب التحتية والاستفال، وقد أشار الإمام زين العابدين(عليه السلام) إلى هذا المعنى في توظيفه للنصّ الكريم ببيان أنّه منزّهٌ عمّا أُلصق به من دعوى الشاميين وغيرهم، بل هو من هذا البيت الذي نصّ عليه القرآن الكريم.
وأمّا صفة (التوسط) في الميم فتتناسب مع دعوة النبي(صلى الله عليه واله) وذريته من أهل البيت(عليهم السلام) إلى الوسطية التي نصّ عليها القرآن الكريم[28]، وما نصّت عليه بعض التفاسير[29] من أنّ الأمّة الوسط متمثّلةٌ بأهل البيت(عليهم السلام)، وقد جاء خبر توظيف الإمام زين العابدين(عليه السلام) متّسماً بأركان الحوار الموضوعي من (شخصية المُحاوِر والمُحاوَر)[30] حيث لم يتّسم الشيخ بالعناد، وإلّا تحوّل الحوار إلى جدالٍ باطل[31].
المبحث الثاني: تحليل دلالة الكلمة القرآنية في آية التطهير
وردت في آية التطهير أكثر من كلمة، إلّا أنّ تناول جميع تلك الكلمات مما لا يسَعُ البحث؛ لضيق مقامه عن ذلك وكونه مقيداً بسقفٍ كميٍّ محدّد؛ لذا يحسن التركيز على أبرز الكلمات؛ لبيان أهمّية (التفسير التحليلي) في بيان دلالة النصّ القرآني الموظّف.
والكلمة التي سيدرسها البحث ـ هنا ـ هي: (البيت)؛ وذلك لما لها من أثرٍ بليغٍ في استدلال العُلماء[32] في تحديد مصداق المعنيين بـ(أهل البيت)، وخصوصية ذلك البيت.
أولاً: التحليل المعجمي لكلمة (البيت) في آية التطهير
ذكر علماء اللغة[33] أنّ البيت أصله ثلاثي (بَيْتٌ)، وأصل معناه (الخباء)، وهو بيت صغير مصنوع من الصوف أو الشعر، ولكنّه استعمل استعمالاتٍ عديدة، منها: بيتُ الرجُل (دارُهُ وقصرُهُ)، ومنها: بيوتُ الله (المساجد)، ومنها: البيت الحرام (الكعبة الشريفة)، ومنها: بيت المقدس، ومنها: بيت العنكبوت، ومنها: (بيتُ الشعرِ) تشبيهاً له بالخباء، ومنها: بيتُ العرب (شرفها)، ومنها: بيت النبي(صلى الله عليه واله)، وأهل البيت هم أهل بيت النبي(صلى الله عليه واله)، وغيرها.
ثانياً: التحليل الصرفي لكلمة (البيت) في آية التطهير
البيت اسم ثلاثي مجرّد على وزن (فَعْل)[34] بفتح الفاء وسكون العين، ويعطي هذا البناء المعنى الأصل الطبيعي للاسم الثلاثي، وهو الوزن الأول من أوزان الاسم العشرة، و(بيت) من أسماء الأجناس المحسوسة الجامدة[35]؛ لأنّه لم يؤخذ من غيره.
ويتّصف الاسم الجامد بأنّه، اسم يدلّ على معنىً من غير ملاحظة صفةٍ ما، فالبيت يدلّ على المعنى المعجمي المتقدّم من دون صفةٍ ما كـ(كبير، صغير) وما شابه ذلك، وهو ما يتلاءم مع تفسير البيت بأنّه بيت الله المعنوي[36]؛ لأنّه لا يمكن أن يقيد بوصفٍ.
ثالثاً: التحليل النحوي لكلمة (البيت) في آية التطهير
أُعرِبَت كلمة البيت في آية التطهير مضافاً إليه مجروراً[37]، وقد عُرِّف المضاف إليه بأنَه: «كلّ اسمٍ أُضيف إلى شيءٍ بواسطة حرف الجر لفظاً… أو تقديراً»[38]، والشيءُ الذي أُضيف له هو كلمة (أهل) وإعرابها أنّها «نصبٌ على النداء وإن شئت على المدح، ويجوزُ في الكلام الخفضُ على البدل من الكاف والميم في (عنكم) عند الكوفيين، ولا يجوز ذلك عند البصريين؛ لأنّ الغائب يُبدل من المُخاطب لاختلافهما. وقيل: لم يجُز؛ لأنّ البدل بيانٌ، والمُخاطِبُ والمُخاطَبُ لا يحتاجان إلى بيان»[39]، أمّا التقدير فـ(أهلٌ في البيت)[40]، «وقد يكتسب المضاف إليه من المضاف»[41] قيمه الدلالية؛ ومن هذا يتضح أنّ الدلالة النحوية لكلمة (البيت) متأتيةٌ من أمرين:
الأوّل: ارتباطها بالمضاف (أهل)، فإن أُعربت بدلاً كان أهل البيت كلّهم من الرجال أو أغلبهم من الرجال على (التغليب)، وإن أُعربت بالأنحاء الأُخرى فهي شاملةٌ لكلا الجنسين وبغضّ النظر عن نسبة الرجال والنساء فيهم.
الثاني: وجود تقديرٍ معنويٍ لحرف الجر بين المضاف والمضاف إليه، فأهلُ البيت هم الكائنون فيه حقيقةً أو مجازاً.
رابعاً: التحليل الإيحائي لكلمة (البيت) في آية التطهير
اكتسبت كلمة (البيت) في آية التطهير إيحائِيَتها من أمرين مهمين:
الأول: (ال) التعريف[42]، فأفادت معاني عديدة.
الثاني: حذف طرف البيت؛ لأنّ «معنى البيت، في قوله تعالى: (أَهْلَ الْبَيْتِ)[43]… معنىً إضافي حُذف طرفه في الآية الكريمة، فهو لم يقل: أهل بيت مَن»[44].
أمّا الأمر الأول فتؤدي اللام وظائف إيحائية عديدة[45]، منها الدلالة على العموم والشمول، ومنها: استغراق كلّ أفراد الجنس، ومنها: العهدية، ومنها: دلالة الكمال والتعظيم، ومنها: دلالة القصر حقيقة أو تجوزاً للمُبالغة، ومنها: الوظيفة التوضيحية والتحديدية.
فإن كانت (ال) ـ الداخلة على كلمة (بيت) في آية التطهير ـ عهديةً[46]، فالبيت ينبغي أن يكون معروفاً لدى المسلمين بعامّة فضلاً عمّن عاصر النبي(صلى الله عليه واله)، وأبرزُ مصداقٍ له في القرآن الكريم (البيت الحرام)، وإن كانت (للشمول) فهي تعني (عموم البيت)، أي: سواءٌ أكانت الكعبة الشريفة فهم أهلُها، أم أنّ البيت شيءٌ آخر فهم أهلُهُ من دون استغراق، وإن كانت لاستغراق الجنس فالمقصود كلّ بيتٍ على وجه الكون وفي كلّ زمن، وهذا المعنى غير مقبولٍ في دلالة النصّ، إلّا إذا أُخذت الأهلية بمعنى الولاية والتصرّف، وإن كانت (ال) لدلالة التعظيم والكمال فهذا ممكنٌ أيضاً بقرينة التطهير وإذهاب الرجس، وإن كانت لدلالة القصر فيكون هذا البيت هو البيت الوحيد على وجه الأرض يستحقُّ الصفات التي تطرّقت لها آية التطهير، وإن كانت للوظيفة التوضيحية والتحديدية فهي التي تفيد «دلالة العهدية والجنسية معاً»[47]، فتدلّ على أنّ ثمّة أكثر من بيتٍ داخلٌ في جنس البيت كالكعبة الشريفة، وبيت الإمام عليّ(عليه السلام)، والمساجد.
وفي هذه المعاني الإيحائية المنبثقة من دلالة (ال) التعريف مناقشاتٌ كثيرة في ظلِّ السياق الذي جاءت فيه كلمة البيت.
وأمّا الأمر الثاني الذي تفرّعت عليه الدلالة الإيحائية فهو حذفُ طرفِ البيت ممّا أوحى إلى معنيين رئيسين للبيت[48]:
أحدهما: بيت النبي(صلى الله عليه واله).
الآخر: بيت الله سبحانه وتعالى.
أمّا بيت الله تعالى فله معنيان: أحدهما مادي وهو الكعبة الشريفة[49]، والآخر واقعي وهو البيت المعنوي، وفيه تسكن أنوار أهل البيت لا أجسادهم، وهذان المعنيان متلازمان ولا تنافي بينهما، فالأول رمز والآخر مرموز إليه.
أمّا بيت النبي(صلى الله عليه واله) فله معنيان: أحدهما حقيقي والآخر مجازي، فأمّا الحقيقي فلم يثبت أنّ للنبي(صلى الله عليه واله) بيتاً حين نزول آية التطهير ولا بعدها[50]، وأمّا المجازي فعلى معانٍ عديدة، منها: «بيوت زوجاته وهي إنّما بيوتهنّ، وليست خاصّة به»[51]، ومنها: «الدار مجموعاً، وهي لا تسمّى بيتاً بضرورة اللغة»[52]، ومنها: أنّه(صلى الله عليه واله) بيت على أهله؛ إذ إنّه بمنزلة الخيمة[53]، ومنها:[54] بيت الإمام عليّ(عليه السلام)؛ لأنّه نفس النبي(صلى الله عليه واله) بنصّ القرآن الكريم.
ومما تقدّم يتلخّص أنّ البيت المعنوي لله تعالى هو الأقرب لمعنى البيت، وذلك لوجوهٍ عديدة:
الوجه الأول: إنّ البيت بيت الله تعالى لا يُحَدّ بزمانٍ ولا مكان، وأنوار أهل البيت ساكنةٌ فيه ولا تخرج منه، وهذا المعنى يناسب سياق آية التطهير من الشمول لكلّ الأزمنة.
الوجه الثاني: إنّ البيت بمعنى بيت الإمام عليّ(عليه السلام) أو الكعبة الشريفة لا تتعارض مع البيت المعنوي؛ لأنّها رمز والبيت المعنوي مرموز إليه.
الوجه الثالث: إنّ أهل البيت(عليهم السلام) يمكن أن يُنسبوا لأكثر من بيتٍ في عالم الدنيا؛ فالكساء بيتهم(عليهم السلام)، وبيت الإمام عليّ(عليه السلام) بيتهم، ولكلّ نسبةٍ ما يدلّ عليها.
وخلاصة الدلالة الإيحائية أنّ للبيت معاني عديدة، وإن كان أهله مشخّصين ومعروفين، وهم ـ باتفاق المسلمين[55] ـ: (فاطمة، وأبوها، وبعلها، وبنوها)، وأمّا غيرهم فقد استُثني الكثير منهم برواية الفريقين[56]، ومن الجدير ذكره أنّ «بيت الحسين(عليه السلام) في المدينة هو بيت عليّ وفاطمة حيث كان يتنزّل الوحي»[57].
المبحث الثالث: تحليل دلالة المركّب للنصوص الموظّفة في الحوار
تضمّنت آية التطهير أكثر من مركّب، مما لا يسعُ البحث تناولها؛ لذا فقد اختار الباحث المركّبَ (إنّما يريد الله)؛ لما له من أهمّيةٍ في مجال البحوث القرآنية، ويمكن تحليله بأكثر من كيفية:
أولاً: التحليل الصرفي للمركّب (إنّما يريد اللّه) في آية التطهير
تتعلّق الدلالة الصرفية لهذا المركّب بالفعل (يُريد) على وزن (يُفعِل)[58]، ولفظ الجلالة (الله)، وفي وزنه كلامٌ يحتاج إلى تفصيل.
وللمسند (يُرِيْدُ) في النصّ الكريم دلالة صرفية مهمّة اكتسبها من صيغته في النصّ الكريم على وزن (يُفِعْل)، وأُخرى ممّا طرأ على صيغة (يُريدُ) من زيادة حرف (الياء) في أوله.
أمّا زيادة الياء في أوله فدلّت على ثلاثة أُمور، وهي:
الأوّل: (تغيير زمن الفعل من الماضي إلى المضارع)، وياء المضارعة تدلّ على الغائب لولا مجيء لفظ الجلالة.
الثاني: (دلالتها على الفاعل)، فياء المضارعة في أول الفعل (يريد) تدلُّ على الفاعل[59] للإرادة وهو الله سبحانه، وليس فوق إرادته (جلّ جلاله) إرادة كما قال تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)[60].
الثالث: دلالتها «على حال الفاعل»[61] وكونه (المريد) لإذهاب الرجس ولطهارة أهل البيت(عليهم السلام).
وأمّا صيغة الفعل (يُريد) وإن كانت تدلّ على «الحال والاستقبال»[62]، إلّا أنّ هذه الدلالة إن صحّت في (الزمن الصيغي)[63] فهي تتغيّر في (الزمن السياقي)[64]، وبما أنّ الفعل اقترن باسم الله تعالى فهو مسلوب الدلالة على الزمن مع دلالته على التجدد من حيث المفعول للإرادة؛ «ونقل الزركشي (794هـ) أنّ اللفظة حيث وقعت في صفات الله فهي مسلوبة الدلالة على الزمن»[65]، فالحوادث لا تعرض على الذات الإلهية؛ فـ« إنّ الله تعالى خاطبنا بصفتنا عرفيّين وبصفته عرفيّاً، أي: نزّل نفسه إنساناً وتحدّث معنا كأحدنا، فحصلت من ذلك التنزيل شخصيّة وهميّة، وتلك الشخصيّة تكون محطّاً للعواطف المذكورة في القرآن، كالحبّ والبغض والرضا والغضب»[66] والإرادة وغيرها، والقرآن الكريم «إنّما نزّل نفسه منزلة شخص عرفي من أجل مصلحتنا وإفادتنا، فإن فهمناه فهماً عرفياً أو فهمنا لغته كذلك، فقد فهمناه من الزاوية التي أقرّها وأمضاها وتحدّث بها؛ ولذا كانت ظواهره حجّة، ولو كان قد تحدّث بالدقّة؛ لمَا فهمه إلّا أقل القليل، ولو تحدّث بالدقّة التي هو يعرفها؛ إذن لم يفهمه أحد إطلاقاً. إذن، فلا بدّ له من التنزّل عن مستواه الحقيقي الدقّي، قليلاً أو كثيراً، وقد فعل»[67]، فالفعلُ (يريد) بحسب الدلالة الصرفية وإن دلّ على التجدد والحدوث إلّا أنّ نسبته إلى الذات الإلهية يغيِّر من هذه الدلالة وقيودها بما يتناسب مع الذات الإلهية ممّا هو في علمه (جلّ جلاله).
وتقريب ذلك يعني أنّ العبد يحتاج إلى استمرار فيض الإرادة؛ لبقاء الاستحقاقات التي دلّت عليها آيةُ التطهير.
وأمّا لفظ الجلالة (الله) ففي وزنه الصرفي أقوالٌ[68]، أبرزها:
1ـ إنّه مأخوذٌ من أَلَهَ يألَه بمعنى عبدَ، ووزن لفظ الجلالة (الْعَال).
2ـ إنّه مأخوذٌ من لاهَ يليهُ بمعنى التستر، ووزن لفظ الجلالة (الفَعَل).
3ـ إنّه مأخوذٌ من وَلِهَ يولَهُ بمعنى التحير، ووزن لفظ الجلالة (العَفَل).
4ـ إنّه اسم علمٍ جامدٍ ليس مشتقاً، وهو جامعٌ لكلّ صفات الجمال والجلال ووزنه (فَعَّال)[69].
وهذا الاختلافُ في الاشتقاق دليل عظمة اللفظ ومدلوله، فإن كان الوزن (العَال) فهو يشير إلى علو الخالق (جلّ جلاله)، فلا شيء فوقه، وهو يتناسب مع استحقاق العبودية له تعالى، وإن كان الوزن (الفَعَل) فإنّه المستور بحقيقته عن جميع الخلق (جلّ جلاله)، وإن كان الوزن (العَفَل) فإنّ الخلق متحيرون في ذاته (جلّ جلاله) وإن اتفقوا على عظمته وجلاله وسائر صفاته، وإن كان الوزن (فعَّال) فهو مناسبٌ لـ(الإرادة) بحسب السياق القرآني كما قال تعالى: (فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ)[70].
ويرى البحث أن لا تعارض بين هذه الأقوال، فيمكن أن تكون مقصودةً من قبل المولى بأسرها فضلاً عن غيرها[71] ولو على نحو الإيهام الإثباتي[72].
وتوظيف الإمام زين العابدين(عليه السلام) لهذا النصّ الكريم في حواره مع الشيخ الشامي مناسبٌ لهذه الدلالات والمضامين المُختزلة في آية التطهير؛ لذا فقد أحدث التوظيف تأثيراً كبيراً في شخصية الشيخ الشامي من خلال «آلية إثارة الذهن»[73].
ثانياً: التحليل النحوي للمركّب (إنَّما يُريدُ الله) في النصّ الكريم
أُعرب المركّب (إنَّما يُريدُ اللهُ) على نحوين[74]:
النحو الأول: (إنّ) حرف مشبّه بالفعل، و(ما) اسمٌ موصولٌ في محلّ نصب اسم إنّ، و(يريدُ اللهُ) صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب.
النحوُ الثاني: (إنَّما) كافةٌ ومكفوفة، و(يريدُ اللهُ) فاعلٌ ومفعول.
وأبرز ما يترتب على الإعرابين هو أنّ (ليُذهِبَ) ـ التي تأتي بعد (إنَّما يُريدُ الله) ـ تُعرب في محلّ نصب خبرٍ لـ(إنّ) في الإعراب الأول[75].
وتعرب (لِيُذهِبَ) مفعولاً به ليريد في الإعراب الثاني[76]، وهذا الإعراب يوجّه الدلالة إلى تأثير الإرادة الإلهية في ذهاب الرجس عن أهل البيت(عليهم السلام)، ممّا يتلاءم مع (الإرادة التكوينية)[77].
والإعراب الثاني هو الأصحّ[78] بلا شك؛ لأنّه الأنسب للسياق اللفظيّ للنصّ الكريم؛ بقرينة وحدة السياق في (يريد) و(يطهّركم)؛ إذ إنّ فاعلها واحدٌ تمّ التصريح به مع فعل الإرادة؛ وجاء مضمراً مع فعل الإذهاب والتطهير، ويؤكده أنّ (يريد) فعلٌ متعدٍ وليس لازماً[79].
ثالثاً: التحليل الإيحائي للمركّب (إنّما يُريدُ اللّه) في آية التطهير
إنّ الدلالة الإيحائية للمركّب (إنّما يريدُ الله) تنبثق من مجموع المركّب تارةً، ومن مفرداته أُخرى، فللمركب (إنّما يريدُ الله) دلالةٌ إيحائيةٌ مميزةٌ في القرآن الكريم؛ وذلك لأنّ هذا المركب القرآني ورد في أربعة مواطنٍ من القرآن الكريم، ثلاثة منها جاء مقترناً بالعذاب، وذلك قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ)[80]، وقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ)[81]، وقوله تعالى: (أَنَّمَا يُرِيدُ الله أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ)[82]، ومرّةً واحدةً في آية التطهير في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[83]؛ لذا تكون آية التطهير هي المورد الوحيد في القرآن الكريم الذي جاء بصيغة الـمَنّ والعطاء الإلهي المقترن بإرادته العظمى، وهذا ممّا أضفى إلى آية التطهير خصوصيةً وميّزةً أُخرى في مجال البحث الإيحائي لدلالة المركب؛ فالمورد الوحيد في القرآن الكريم الذي اختصّت به الإرادة الإلهية في مقام الامتنان وعلى نحو التأكيد والتشديد، هو ما جاء في آية التطهير فحسب دون كلّ القرآن الكريم.
أمّا مُفردات المركّب فـ(إنّما) وهبت النصّ الكريم دلالةً مميّزة لما للحصر من دلالةٍ على الاختصاص وهو اختصاص إلهي لاقترانه بالإرادة الإلهية.
وأمّا (يريدُ اللهُ) فقد وسّع البحث في معنى هذه الإرادة؛ بسبب نسبة الإرادة إلى الله تعالى، فامتلأت المصادر الدينية في معنى (إرادةُ الله) وتفرّعت عليها المذاهب والنظريات، وخلاصّةُ ما تمّ التوصل إليه هي: أنّ الإرادة إذا جاءت مقترنةً بلفظ الجلالة أفادت أحد معنيين[84]:
المعنى الأول: الإرادة التكوينية.
المعنى الثاني: الإرادة التشريعية.
وهذا التّقسيم للإرادة في كلام العلماء مأخوذٌ مما جاء في الروايات من تقسيم الإرادة الإلهية إلى (إرادةِ عزمٍ) و(إرادة حتمٍ)، والفرق بينهما كما ورد عن الإمام الرضا(عليه السلام): «إنّ لله إرادتين ومشيتين: إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء، ويأمر وهو لا يشاء، أَوَ ما رأيت أنّه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك، ولو لم يشأ لم يأكلا، ولو أكلا لغلبت مشيتهما مشية الله، وأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل(عليهما السلام)، وشاء أن لا يذبحه، ولو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشية إبراهيم مشيئة الله(عز وجل)»[85].
وقد ذهب رأي أبرز المفسرين[86] إلى أنّ الإرادة الإلهية في آية التطهير (تكوينية)؛ بشرط أن لا يُفهمَ منها سلبُ إرادة أهل البيت(عليهم السلام)؛ لكي لا يُعتقدُ أنّهم مجبورون على الطهارة؛ فالإرادة على نحو «(المقتضي) لا العلّة التامّة لتكون موجبة للجبر وسلب الاختيار»[87]؛ فأهل البيت(عليهم السلام) قادرون على ارتكاب الذنب، إلّا أنّهم منزّهون عن الذنوب؛ لأنّهم «يعفّون أنفسهم ويجلّونها عن التلوّث بها باختيارهم»[88]، والذي حصل في تطهيرهم قطع معلولات السوء ونتائجه؛ فهم معصومون «بإرادة الله سبحانه وتعالى»[89] المساوقة لاختيارهم، وتفصيل الحديث عن الإرادة من المطولات في بحوث المفسرين[90].
المبحث الرابع: دلالة السياق لآية التطهير بلسان الإمام عليّ بن الحسين(عليهما السلام)
لهذه الآية التي وظّفهما الإمام زين العابدين(عليه السلام) في حواره مع الشيخ الشاميّ سياقان (لفظيٌ ومعنويٌ)، يشتركان معاً في إبراز سبب توظيف هذا النصّ من قِبل الإمام(عليه السلام) في حواره مع ذلك الرجل الشامي.
السياق اللفظي
أمّا (السياق اللفظي) لقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[91]، فقد جاء ليركّز على مقام أهل البيت(عليهم السلام) بكلّ أساليب الدلالة ابتداءً بالصوت وانتهاءً بالجمل التركيبية بكلّ ما تضمّه من دلالات، وأولها افتتاح آية التطهير (بالهمزة)، و«هذا الصامت، بانفجاره القوي، وخروجه من أول المخارج الصوتية يُهيئ جهازك النُّطقيّ للقراءة، وذهنك للتفكّر، كما ويُهيئ السامع بفجأته الخاطفة ووضوحه السمعي العالي، لسماع السورة وتدبرها»[92].
السياق المعنوي
وأمّا (السياق المعنوي) للآية فيحسن دراسته في ضوء (السياق العاطفي)؛ وذلك لغلبة هذا النوع من السياق على صفة النصّ في مقام التوظيف، وقد عُرِّف السياق العاطفي بأنّه: «السياق الذي يتولّى الكشف عن المعنى الوجداني (emotive meaning)، والذي قد يختلف من شخصٍ إلى آخر»[93]، وعُرِّف بأنّه: «السياقُ الذي يحدّد درجة القوّة والضعف والانفعال، وما يستتبعها من دلالات التأكد والمبالغة والاعتدال»[94].
وفي ضوء هذين التعريفين للسياق العاطفي يمكن الوقوف على جملة من الدلالات المهمّة في السياق العاطفي لحوار الإمام زين العابدين(عليه السلام) مع الشيخ الشامي، وفي ضمن حدود فهم البحث؛ لأنّ المعنى الوجداني الذي هو للإمام المعصوم(عليه السلام) لا يُمكن إدراكه إلّا ممّن هو في مستواه أو أعلى منه مرتبة[95]. فالبحث في ذلك بالمقدار المتعارف للاستدلال من ظواهر النصوص الموظّفة في ذلك الحوار، وهذا المقدار ممكن من حيث كلام الإمام زين العابدين(عليه السلام)، فضلاً عن الشيخ الشامي.
أمّا السياق العاطفي المتعلّق بالشيخ الشامي، فيتبيّن من خلال كلماته التي وجهها للإمام السجاد(عليه السلام)، الدالة على كون الشيخ الشامي من عامة المسلمين المُضللين؛ وذلك أنّه نسَبَ جريمة القتل لله تعالى، بل هو يحمد الله على ذلك؛ ظناً منه أنّ هؤلاء السبايا هم ممّن يظلمون العباد ويسببون لهم الأسى والاضطهاد، ثمّ إنّه يعتقد أنّ يزيد بن معاوية هو أمير المؤمنين! فهو يعيش في أجواءٍ مليئةٍ بالضلال، وبما أنّه من المُضللين بادر الإمام إلى تنبيهه وتوعيته وإرشاده من خلال توظيف النصّ القرآني، مستعيناً بأسباب النزول التي تُساهم في بيان مصاديق النصوص القرآنية الحقيقية، ممّا يبيّن أهمية أسباب النزول في فهم النصّ القرآني؛ لأنّ تلك النصوص الكريمة تذكر الصفات في أغلب الأحيان دون ذكر الموصوف[96]؛ لأنّ الكناية أبلغ من الإفصاح[97]، ولعلّ من أغراض ذلك تعميق الاختبار، وإعمال الفكر؛ لذا فإنّ القرآن الكريم يحثّ على التدبر، كما ومن أغراض ذلك ضرورة الرجوع لأهل الذكر، ثمّ إنّ التصريح قد يكون سبباً للتشكيك بالكتاب من قِبل المرجفين، كما أنّ التصريح بالأسماء يكون مثاراً للجدل من قِبل أعداء أهل البيت(عليهم السلام)، ولعلّ عدم التصريح يهدف إلى التركيز على الصفات التي يتصف بها أهل البيت(عليهم السلام) أكثر من الأسماء؛ فإنّ الله تعالى إنّما اختارهم لتلك الصفات التي اتصفوا بها، ولعلّ عدم ذكرهم بصريح الاسم لأجل أن يعثر الناس على مصاديق تلك الآيات بأنفسهم؛ لتكون الحجة عليهم أكبر، وفي الوقت نفسه يكونوا قد وصلوا إلى القناعة التامة بذلك، هذا وأنّ ذكر الأسماء يجعل النصّ مقيداً، فلا يستفاد من عموم لفظه[98].
هذه الأسباب وغيرها تشترك بمجموعها لتكون سبباً في عدم ذكر أسماء أهل البيت(عليهم السلام) بصراحة، ولا يقصد البحث في خصوص آية التطهير؛ بل ثمّة مئات الآيات مما نزل في أهل البيت(عليهم السلام)، بإجماع أهل القبلة[99] وهي تنصّ على صفاتهم دون ذكر أسمائهم؛ ولذا فقد كان ذلك الشيخ الشامي جاهلاً بمصاديق تلك الآيات لعدم معرفته بأسباب نزول الآيات التي وظّفها الإمام زين العابدين(عليه السلام)، بدليل أنّ الإمام قد سأله عن سبب نزولها، فلم يعرف ذلك الشيخ، وهذا ينفعُ في مقام المناظرة والحوار؛ في أنّ الخطوة الأُولى التي ينبغي الانتهاء منها في كلّ آية تحديد سبب نزولها بشكلٍ صريحٍ وقطعي، وهذا ما قام به الإمام زين العابدين(عليه السلام) مع ذلك الشيخ، بعد أن قدّم سؤاله بشكلٍ منطقي؛ حيث سأل الشيخ: «يا شيخ، هل قرأت القرآن؟»[100]. وهذه الخطوة مهمّة، فالإمام لم يقل: هل قرأت هذه الآية؟ وإنّما قال: هل قرأت القرآن؟ فقد يكون هذا الشيخ لم يصل إلى كتاب الله قطُّ، كما أنّ الإمام كلّمه ضمن السياق المتعارف في الحوار، وبشكلٍ تدريجي، وهو لا يعني أنّ الإمام لا يعلمُ كونه قد قرأ القرآن أم لم يقرأ؛ وإنّما التدرج في الحوار الطبيعي يحتاجُ إلى هذا النوع من تبادُل أطراف الحديث؛ لأنّ النفس البشرية تميل إلى هذا النوع من التبادل في طرف الحديث، وفي مقام طرح السؤال بخاصّةٍ؛ لأنّه يُحدث الإثارة لدى المسؤول؛ ومن هنا فقد سأل الإمام(عليه السلام) ذلك الشيخ سؤالاً يكادُ أن تكون إجابته بديهية، ثمّ دخل معه في صلب الموضوع وسأله(عليه السلام) قائلاً: «فهل عرفت هذه الآية: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)[101]، قال الشيخ: نعم، قد قرأت ذلك»[102]، وهذا النوع من التساؤل أحدث عند الشيخ حالة من الذهول؛ بدليل أنّه كان مسترسلاً في الإجابة، ولا سيّما أنّه يتكلّم مع حجّة الله في أرضه بخاصّة، حتّى وإن كان غافلاً عن ذلك، إلّا أنّ حُسن ردّ الإمام، حيث لم يُقابل ذلك الشيخ بالأسلوب نفسه، بل قابله بأسلوبٍ في غاية الخُلُق والسماحة مما أدهش ذلك الشيخ، وقد حصلت الصدمة حين قال الإمام(عليه السلام): «فنحن القربى يا شيخ»[103]. هنا كيف يمكن تصور حال الشيخ الشامي وهو يتلقى هذا الكلام الذي لم يسمعهُ على مدى حياته؟
من هنا، يأتي دور السياق العاطفي في جانبه التأكيدي الذي نصّ عليه تعريف السياق العاطفي، وهو (دلالات التأكّد)؛ إذ إنّ الإمام زين العابدين(عليه السلام) قد أردف السؤال الأوّل بسؤالٍ آخر من الأُسلوب نفسه، ولكنّه تضمّن الحديث عن آية التطهير، فقد قال الإمام: «فهل قرأت هذه الآية: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[104]. قال الشيخ: قد قرأت ذلك»[105]، وقول الشيخ: نعم، من دون الردِّ على قول الإمام في نصّ آية المودّة، يدلُّ على حالة الذهول التي اعترته، فكان يرسل الكلام على ما يرومه الإمام(عليه السلام)، وكان ذلك الشيخ أُذناً صاغية لما يقوله الإمام؛ فاستعمل الإمام «آلية التدرُّج في السلّم الحجاجي»[106]، وهنا حصلت المفاجئة الثانية، حينما أجاب الإمام عن أنّ آية التطهير خاصّةٌ بهم؛ وذلك بقوله(عليه السلام): «فنحن أهل البيت الذي خصصنا اللهُ بآية الطهارة»[107]؛ عندها ذُهل الشيخ بما يلقيه عليه من معاني القرآن الكريم التي غيَّرت موقفه بسبب معرفة مصاديقها.
ومن ذلك يتّضح أنّ السياق العاطفي يبيِّن أنّ الشيخ الشامي لم يكن معانداً، بل كان مُضَلّلاً بسبب الإعلام الأُموي الذي نُشر بين المجتمع الشامي بأنّ هؤلاء من الخوارج على الإسلام، في حين أنّ الإمام قد أخبر بحقيقةٍ عظيمة ومهمّة وهي أنّهم القربى الذين أمر الله تعالى بمودّتهم، وأنَّهم أهل البيت الذين طهّرهم الله تطهيراً؛ لذا فقد كان الشيخ الشامي نقياً في نيّته ولا يريد السوء بالقربى وبأهل البيت(عليهم السلام)، بدليل أنّه سارع إلى التوبة بمجرّد أن سمع كلام الإمام وعرف مصاديق هذه الآيات الكريمة، بل جاء في الخبر: «فبكى الشيخ ورمى عمامته، ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهمّ، إنّا نبرأ إليك من عدوّ آل محمد(صلى الله عليه واله) من جنّ وإنس»[108]، وبهذا القول أعلن الشيخ الشامي براءته من يزيد بن معاوية وأمثاله من الأولين والآخرين، وقال للإمام: «هل لي توبة؟ فقال له: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال: أنا تائب»[109].
وهذه التوبة هزّت أركان الحكومة بدليل ما نقله التاريخ من قتل ذلك الشيخ، فقد جاء فيه: «بلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقُتل»[110]، وسببُ قتله هو محاولة إبقاء المجتمع الشامي على الضلال الذي اعتادوا عليه في زمن معاوية، وتبعه على ذلك ابنه يزيد، فضلاً عن كون الإعلام كان محكماً عليه من قِبل السلطات الحاكمة، ثمّ إنّ وصول الأخبار بشكل متأخر يسبب بروداً بالموقف، وعلى سبيل المثال: لو مات حاكمٌ فإنّ نبأ ذلك يصل بعد مدّة من الزمن لحين وصول المراسيل، في حين أنّه يكون قد نُصِّب حاكم غيره؛ ومن هنا فقد كان دخول آل الرسول إلى الشام أعظم حدثٍ إعلامي رأته الشام في تاريخ الإسلام؛ لما أحدثه من ضجةٍ قلبت الأُمور على رأس السلطة الأُموية، بشكلٍ لم يُشهَد له نظير في التاريخ، فقد كانت كلّ خطوةٍ يخطوها الإمام الحسين وأهل بيته(عليهم السلام) تؤتي ثمارها في كلّ حين.
نتائج البحث
من أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث:
أولاً: إنّ آية التطهير تتميّز عن كلّ آيات القرآن الكريم من حيث أهمية مضامينها تركيباً ودلالةً، وأنّ التفسير التحليلي لمفردات آية التطهير يعالج مشكلاتٍ كثيرة على المستوى الفكري وغيره.
ثانياً: إنّ لكلّ جزءٍ تحليلي في آية التطهير علاقة بدلالة النصّ في مقام نزول الآية وتوظيفها ممّا لم يتطَرّق له المفسرون، وقد كشف البحث عنه بواسطة التفسير التحليلي.
ثالثاً: إنّ عنوان أهل البيت مختصٌّ بالخمسة من أصحاب الكساء بحسب سياق نزول الآية، إلّا أنّ توظيف النصّ من قِبل الإمام زين العابدين(عليه السلام)، أعطى سعةً لدلالة الآية؛ لتشمل غيرهم(عليهم السلام)، فيكون بقية المعصومين(عليهم السلام) مشمولين أيضاً.
________________________________________
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. أُسلوب الحوار في القرآن الكريم، إدريس أوهنا، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الأُولى، 1426هـ.
2. اشتقاق أسماء الله، عبد الرحمن الزجاجي (ت340هـ)، تحقيق: د. عبد الحسين المبارك، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ.
3. الأصوات اللغوية في كتاب المستوفي في النحو للفرغاني، خميس عبد الله التميمي (ت549هـ)، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة الأُولى، 2013م.
4. أُصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت328هـ)، مؤسّسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأُولى، 1425هـ.
5. أطلس الحسين ـ أو جواب الأين في منازل مسير الحسين(عليه السلام)، عباس الربيعي، هيأة تراث الشهيد الصدر، بغداد، الطبعة الأُولى، 1432هـ.
6. الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم (دراسة نظرية تطبيقية)، د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، الطبعة الأُولى، 1429هـ.
7. إعراب القرآن الكريم، د. محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، الأزراريطة ـ مصر.
8. الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل، بهجت عبد الواحد صالح، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمّان ـ الأردن، الطبعة الثانية، 1998م.
9. الألسنية (رواد وأعلام)، د. هيام كريدية، الجامعة اللبنانية، بيروت، الطبعة الأُولى، 1431هـ.
10. الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، قم، الطبعة الأُولى، 1414هـ.
11. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل، ناصر مكارم الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 1423هـ.
12. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت413هـ)، تحقيق: إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني، الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، مطبعة: مهر، قم، الطبعة الأُولى، 1423هـ.
13. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، مؤسّسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
14. البناء الصوتي في السور المكية، د. إبراهيم الراضي، دار الحصاد، دمشق، الطبعة الأُولى، 1435هـ.
15. بين يدي القرآن، محمد الصدر(ت1419هـ)، دار ومكتبة البصائر، بيروت، الطبعة الأُولى، 1432هـ.
16. تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة (سورة التوبة أنموذجاً)، فخرية غريب قادر، عالم الكتب الحديث، إربد ـ الأردن، الطبعة الأُولى، 1432هـ.
17. التحليل الصوتي للّغة العربية عند المستشرقين (مايكل بريم أُنموذجاً)، د. موسى صالح الزعبي، عالم الكتب الحديثة، إربد، الطبعة الأُولى، 2012م.
18. التحليل الصوتي للنص، مهدي عناد قبها، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأُولى، 2013م.
19. تخريج الشواهد ووضع الفهارس، أحمد بن محمد الحملاوي (ت1315هـ)، تقديم: د. محمد ابن عبد المعطر، وأبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض.
20. التداولية (PRAGMATICS)، جورج يول، ترجمة: د. قصي العتابي. الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأُولى، 1431هـ.
21. التعريفات، الشريف علىّ بن محمد الجرجاني (ت816هـ)، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأُولى، 1424هـ.
22. تعليقات على كتاب الشيعة والسنّة لإحسان إلهي ظهير، محمد الصدر (ت1419هـ)، تحقيق: مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر، الناشر: المحبين، الطبعة الأُولى، 1440هـ.
23. تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشى (ت320هـ)، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأُولى، 1411هـ.
24. تفسير القرآن بالقرآن (دراسة دلالية)، أحمد رسن، دار السياب، لندن، الطبعة الأُولى، 2010م.
25. تفسير نور الثقلين، عبد علي بن جمعة الحويزي (ت1112هـ)، تحقيق: السيّد علي عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 1422هـ.
26. التوحيد، محمد بن عليّ الصدوق (ت381هـ)، صححه وعلّق عليه: السيّد هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدّسة.
27. جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم، د. أسامة جاب الله، دار ومكتبة الإسراء للطبع والنشر والتوزيع، طنطا ـ مصر، 2008م.
28. جواهر البلاغة، السيّد أحمد الهاشمي (ت1362هـ)، مؤسّسة الصادق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1386هـ.
29. الحوار في القرآن (حوارات الإمام الصادق أُنموذجاً)، شعبة البحوث والدراسات، الناشر: الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدّسة ـ قسم الشؤون الفكرية والثقافية، بغداد، الطبعة الأُولى، 1435هـ.
30. الخصال، محمد بن علي الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: علي أكبر غفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة التاسعة، 1434هـ.
31. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)، تحقيق: محمد علي نجار، الهيأة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة.
32. خطب الجمعة لشهيد صلاة الجمعة، محمد الصدر (ت1419هـ)، هيأة تراث السيّد الشهيد الصدر، بيروت، الطبعة الأُولى، 1434هـ.
33. الدر المنثور في التأويل بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة الثانية، 1424هـ.
34. دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليم اللغات، أحمد حساني، الناشر: ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ـ بت عكنون الجزائر ـ الجزائر، الطبعة الثانية، 2009م.
35. دلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار، د. جلال الدين العيداني، دار الراية للنشر والتوزيع، عمّان ـ الأردن، الطبعة الأُولى، 1431هـ.
36. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأُولى، 1344هـ.
37. السياق اللغوي ودراسةُ الزمن في اللغة العربية، د. محمد رجب الوزير، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأُولى، 2015م.
38. شرح الرضي على الكافية، محمد بن الحسن الأسترآباذي (ت688هـ)، التحقيق: يوسف حسن عُمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الثانية، 1996م.
39. شرح قطر الندى وبل الصدى، جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت761هـ)، التحقيق: محمد جعفر الكرباسي، دار الاعتصام للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، 1426هـ.
40. شواهد التنزيل لمن خُصَّ بالتفضيل، عبيد الله بن عبد الله الحسكاني، الحنفي (ت490هـ)، التحقيق: محمد باقر المحمدي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، الطبعة الثالثة، 1427هـ.
41. صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعي (ت311هـ)، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، 1424هـ.
42. الصرف، حاتم صالح الضامن، مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث، كلية الدراسات الإسلامية، دبي.
43. علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، د. عبد الجليل منقور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010م.
44. علم الدلالة دراسةٌ نظرية وتطبيقية، د. فريد عوض حيدر، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأُولى، 1426هـ.
45. علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة، حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق القاهرة، الطبعة الأُولى، 2009م.
46. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي، محمد حسين فضل الله، دار الملاك للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1418هـ.
47. قاموس الأصوات اللغوية، رحاب كمال الحلو، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأُولى، 2009م.
48. القرآن كتاب الهداية، روح الله الخميني، جمع وتحقيق: أحمد صولي الحسيني، دار الولاء، بيروت، الطبعة الأُولى، 1433هـ.
49. القصص القرآني (دراسة ومعطيات وأهداف)، جعفر السبحاني، مؤسّسة الإمام الصادق(عليه السلام)، قم، الطبعة الأُولى، 1427هـ.
50. قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، د. أحمد المتوكّل، دار الأمان للنشر والتوزيع، زنقة المانوية ـ الرباط.
51. اللسانيات وتعليم اللغة، د. محمود أحمد السيّد، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة ـ تونس.
52. اللهوف في قتلى الطفوف، علىّ بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، الناشر: منشورات السجدة، قم، الطبعة الأُولى، 1424هـ.
53. المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر (ت1400هـ)، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، قم، الطبعة الرابعة، 1434هـ.
54. مسند ابن حنبل، أحمد بن حنبل (ت241هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأُولى، 1421هـ.
55. مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)، تحقيق: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأُولى، 1430هـ.
56. معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي (ت516هـ)، تحقيق: محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1417هـ.
57. معاني الأخبار، محمد بن عليّ الصدوق (ت381هـ)، مؤسّسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 1430هـ.
58. معجم ألفاظ القرآن الكريم، حسّان عبد المنان، مؤسّسة انتشارات دار العلم، قم.
59. المعجم المفهرس للأوزان الصرفية في القرآن الكريم، د. أشواق النجار، دار الكتب العلمية للطباعة والنّشر والتوزيع، بغداد، الطبعة الأُولى، 1435هـ.
60. معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430هـ)، تحقيق: عادل ابن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأُولى، 1419هـ.
61. معرفة أهل البيت في ضوء الكتاب والسنّة (دراسة تحليلية)، راضي الحسيني، دار التعارف للمطبوعات، حارة حريك ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1433هـ.
62. مقتل الحسين(عليه السلام)، الموفّق محمد بن أحمد الخوارزمي المكّي (ت568هـ)، انتشارات أنوار الهدى، الطبعة الرابعة، 1428هـ.
63. منّة المنان في الدفاع عن القرآن، محمد الصدر (ت1419هـ)، هيأة تراث السيّد الشهيد الصدر(قدس سره)، بيروت، الطبعة الأُولى، 1434هـ.
64. المنجد في اللغة، لويس معلوف، دار المشرق، بيروت، الطبعة السادسة والعشرون، 1362هـ.
65. منهج الأصول، محمد الصدر(ت1419هـ)، دار ومكتبة البصائر، بيروت، الطبعة الأُولى، 1430هـ.
66. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي(ت1402هـ)، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات والمنشورات، بيروت، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
67. نحو الصوت ونحو المعنى، نعيم علوية، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 1992م.
المجلّات:
68. مجلّة الإصلاح الحسيني، العدد 30، 1441هـ/ 2020م
________________________________________
[1]قام الباحث بتعريف التفسير التحليلي، وبيان ضوابطه في بحثٍ آخرٍ تمّ تحت عنوان: (توظيف آية التطهير بلسان الإمام الحسين(عليه السلام)..دراسة تفسيرية تحليلية)، وقد جاء هذا البحث متمّماً لذاك.اُنظر: الوائلي، وسيم راقم، توظيف آية التطهير بلسان الإمام الحسين(عليه السلام)..دراسة تفسيرية تحليلية: مجلّة الإصلاح الحسيني، العدد30، 1441هـ/2020م: ص160ـ162.
[2] اُنظر: المتوكّل، أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: ص54.
[3] اُنظر: المصدر السابق: ص55.
[4] اُنظر: كريدية، هيام، الألسنية (رواد وأعلام): ص171.وأيضاً: حساني، أحمد، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات: ص77.وأيضاً: منقور، عبد الجليل، علم الدلالة (أُصوله ومباحثه في التراث العربي): ص67.
[5] اُنظر: حساني، أحمد، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات: ص73 ـ 74.
[6] المتوكّل، أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: ص54.
[7] اُنظر: السيّد، محمود أحمد، اللسانيات وتعليم اللغة: ص18 ـ 19.
[8] اُنظر: الخميني، روح الله، القرآن كتاب الهداية: ص63.وأيضاً: الصدر، محمد، خطب الجمعة لشهيد صلاة الجمعة: ص531.وأيضاً: الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن: ص17.
[9] الإسراء: آية17.
[10] الصدر، محمد، تعليقات على كتاب الشيعة والسنّة لإحسان إلهي ظهير: ص65.
[11] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج89، ص20.
[12] اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي: ج2، ص131.
[13] يول، جورج.التداولية (Pragmatics): ص19.
[14] اُنظر: العيّاشى، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج1، ص9.وأيضاً: الصدر، محمد، خطب الجمعة لشهيد صلاة الجمعة: ص357.
[15] الشورى: آية23.
[16] الأحزاب: آية33.
[17] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.واُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج2، ص69.
[18] حيث «يُعتقد أنّ كلمة ميم تعني الماء، خصوصاً وأننا نجد كلمة ميم في العبرية وتعني ماءً، كما ونجد كلمة مَيْ في العربية العامية وتعني ماء، وكذلك اسمها ميم في السريانية والكلدانية، ونلاحظ أنّ رسم حرف الميم الفينيقي هو كسطح ماء البحر المنمنم، وهو يُشبه هذا الرسم الهيروكليفي».اُنظر: الحلو، رحاب كمال، قاموس الأصوات اللغوية: ص549.
[19] اُنظر: رسن، أحمد، تفسير القرآن بالقرآن (دراسة دلالية): ص76.
[20] الراضي، إبراهيم، البناء الصوتي في السور المكية: ص129.
[21] اُنظر: جاب الله، إسامة، جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم: ص55 ـ 56.
[22] اُنظر: التميمي، خميس عبد الله، الأصوات اللغوية في كتاب المستوفي في النحو للفرغاني: ص158.
[23] ابن حنبل، أحمد، المسند: ج28، ص77.وأيضاً: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج 2، ص150.وأيضاً: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ج1، ص418.
[24] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص517.وأيضاً: الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمّة: ج1، ص99، وص120.
[25] اُنظر: الحلو، رحاب كمال، قاموس الأصوات اللغوية: ص481.
[26] علوية، نعيم، نحو الصوت ونحو المعنى: ص7.
[27] آل عمران: آية55.
[28] اُنظر: الصدر، محمد، تعليقات على كتاب الشيعة والسنّة لإحسان إلهي ظهير: ص15.
[29] اُنظر: الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين: ج1، ص166.وأيضاً: الكاشاني، محسن، تفسير الصافي: ج2، ص197.وأيضاً: الشيرازي، محمد، تقريب القرآن إلى الأذهان: ج2، ص189.وأيضاً: قراءتي، محسن، تفسير النور: ج1، ص211.
[30] اُنظر: فضل الله، محمد حسين، الحوار في القرآن (قواعده، أساليبه، معطياته): ص68 ـ 69.
[31] اُنظر: شعبة البحوث والدراسات، الحوار في القرآن (حوارات الإمام الصادق أُنموذجاً): ص5.
[32] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: ص65.وأيضاً: العاملي، جعفر مرتضى، الصحيح من السيرة: ج9، ص129.وأيضاً: الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص63.
[33] اُنظر: ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص324.وأيضاً: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس: ج3، ص21 ـ 25.وأيضاً: معلوف، لويس، المُنجِد في اللغة: ص55 ـ 56.
[34] اُنظر: الحملاوي، أحمد بن محمد، شذا العرف في فن الصرف: ص41.وأيضاً: النجار، أشواق، المعجم المفهرس للأوزان الصرفية في القرآن الكريم: ج2، ص778.
[35] اُنظر: الحملاوي، أحمد بن محمد، شذا العرف في فن الصرف: ص11.
[36] اُنظر: الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص47.
[37] اُنظر: ياقوت، محمود سليمان، إعراب القرآن الكريم: ج8، ص3736.
[38] الجرجاني، علىّ بن محمد، كتاب التعريفات: ص86.
[39] القيسي، مكي بن أبي طالب، مُشكل إعراب القرآن: ص383.واُنظر: ياقوت، محمود سليمان، إعراب القرآن الكريم: ج8، ص3736.
[40] اُنظر: ابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى: ص347.
[41] قادر، فخرية غريب، تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة (سورة التوبة أُنموذجاً): ص180.
[42] المصدر السابق: ص179.
[43] الأحزاب: آية33.
[44] الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص47.
[45] قادر، فخرية غريب، تجليات الدلالة الإيحائِية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة (سورة التوبة أُنموذجاً): ص179ـ 180.
[46] اُنظر: الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص55.
[47] اُنظر: قادر، فخرية غريب، تجليات الدلالة الإيحائِية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة (سورة التوبة أُنموذجاً): ص180.
[48] اُنظر: الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص47.
[49] جاء ذكر البيت في القرآن الكريم (14) مرّة بمعنى الكعبة الشريفة.اُنظر: عبد المنان، حسّان، معجم ألفاظ القرآن الكريم: ص199.
[50] اُنظر: الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص49.
[51] المصدر السابق ص47.
[52] المصدر السابق.
[53] اُنظر: المصدر السابق.
[54] اُنظر: المصدر السابق: ص62.
[55] اُنظر: ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة: ج5، ص136.وأيضاً: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الأوسط لابن المنذر: ج7، ص487.وأيضاً: البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل: ج1، ص 258.
[56] اُنظر: الصدوق، محمد بن عليّ، الخصال: ص403.وأيضاً: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج22، ص296.وأيضاً: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التأويل بالمأثور: ج 8، ص158.
[57] الربيعي، عباس، أطلس الحسين(عليه السلام): ص35.
[58] النجار، أشواق، المعجم المفهرس للأوزان الصرفية في القرآن الكريم: ج4، ص2895.
[59] اُنظر: ابن جني، عثمان، الخصائص: ج1، ص225.وأيضاً: الزعبي، موسى صالح، التحليل الصوتي للّغة العربية عند المستشرقين (مايكل بريم أُنموذجاً): ص94.
[60] النحل: آية40.
[61] الأسترآبادي، محمد بن الحسن، شرح الرضي على الكافية: ج1، ص25.
[62] ابن جني، عثمان، الخصائص: ج1، ص175.
[63] هنداوي، عبد الحميد، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم (دراسة نظرية تطبيقية): ص50.
[64] اُنظر: الوزير، محمد رجب، السياق اللغوي ودراسة الزمن في اللغة العربية: ص88.
[65] اُنظر: العيداني، جلال الدين، دلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار: ص183ـ 184.
[66] الصدر، محمد، منّة المنان في الدفاع عن القرآن: ج1، ص503.
[67] الصدر، محمد، منهج الأصول: ج2، ص49.
[68] اُنظر: الزجاجي، عبد الرحمن، اشتقاق أسماء الله: ص23 ـ 32.وأيضاً: الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة: ج6، ص222 ـ 223.
[69] الحملاوي، أحمد بن محمد، شذا العرف في فن الصرف: ص53.
[70] هود: آية 107.البروج: آية 16.
[71] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص5.
[72] اُنظر: الصدر، محمد، منّة المنان في الدفاع عن القرآن: ج3، ص363 ـ 364.
[73] أوهنا، إدريس، أسلوب الحوار في القرآن الكريم: ص116.
[74] اُنظر: صالح، بهجت عبد الواحد، الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل: ج9، ص254.
[75] اُنظر: المصدر السابق.
[76] اُنظر: ياقوت، محمود سليمان، إعراب القرآن الكريم: ج8، ص3736.
[77] سيأتي الحديث عنها في مطلب الدلالة الإيحائية للمركّب.
[78] اُنظر: صالح، بهجت عبد الواحد، الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل: ج9، ص254.
[79] اُنظر: الضامن، حاتم صالح، الصرف: ص117.
[80] التوبة: آية55.
[81] التوبة: آية85.
[82] المائِدة: آية49.
[83] الأحزاب: آية33.
[84] اُنظر: السبحاني، جعفر، الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية: ص54.
[85] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص64.
[86] اُنظر: الحسيني، راضي، معرفة أهل البيت في ضوء الكتاب والسنّة (دراسة تحليلية): ج1،
ص67ـ 78.
[87] الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص246.
[88] المصدر السابق: ج13، ص247.
[89] الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(عليه السلام): ص65.
[90] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص127.
[91] الأحزاب: آية33.
[92] قبها، مهدي عناد، التحليل الصوتي للنص: ص87.
[93] حيدر، فريد عوض، علم الدلالة دراسةٌ نظرية وتطبيقية: ص159.
[94] البهنساوي، حسام، علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة: ص70.
[95] اُنظر: الصدر، محمد، خطب الجمعة لشهيد صلاة الجمعة: ص259.
[96] اُنظر: الصدر، محمد، بين يدي القرآن: ص246 ـ 249.
[97] اُنظر: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز: ص70.
[98] اُنظر: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية: ص232.
[99] اُنظر: الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله، شواهد التنزيل لـمَن خُصَّ بالتفضيل: ج1، ص10.
[100] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.
[101] الشورى: آية23.
[102] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.
[103] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج2، ص69.
[104] الأحزاب: آية33.
[105] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.
[106] أوهنا، إدريس، أسلوب الحوار في القرآن الكريم: ص129.
[107] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج2، ص69.
[108] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.
[109] المصدر السابق.
[110] المصدر السابق.
https://warithanbia.com/?id=2756
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة وارث الأنبياء
لینک کوتاه
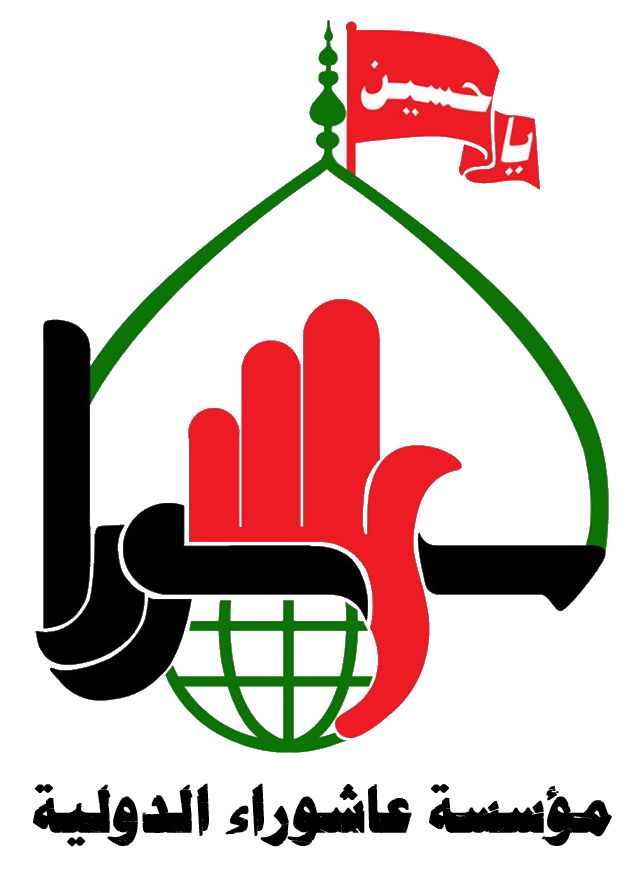
سوالات و نظرات