أثر الخطاب العاشورائي في إصلاح الأُمّة وتوحيدها.. الشباب أُنموذجاً
{ أ. م. د. سلام ناجي باقر الغضبان / م. م. إيثار عبد المحسن المياحي }
المقدّمة[1]
صفحات التاريخ بخيرها وشرّها انطوت، إنّها مسؤولية الماضين، لا نُحاسب على سلبياتهم ولا نُكافئ على إيجابياتهم: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[2].
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف يكون الموقف من التاريخ؟ هل نُدير الظهر لتاريخنا وتراثنا وفيهما من الغنى ما يُثري حاضرنا لمجرّد أنّ التاريخ مضى وانقضى؟
إنّ دروس التاريخ وعِبَره كثيرة، يمكن أن نستلهم منها أفكاراً وخبرات وتجارب جديدة، فقد أثبتت التجربة أنّ الذين أمعنوا النظر في التاريخ وتعمّقوا في دلالات أحداثه كانوا أقوياء في نظرتهم للواقع والمستقبل.
إنّ مسؤوليتنا التاريخية تتطلّب منّا أن نقرأ تاريخنا وتاريخ العالم بنظرة موضوعية غير انحيازية ولا متعصّبة ولا متطرّفة، بين رفضٍ لكلّ ما فيه وبين قبول لكلّ ما فيه؛ لأنّه نتاج بشر مثلنا، وقد يكون فيه الصحيح وفيه السقيم، وقد يكون فيه الموضوع الدخيل الذي ليس منه بشيء، وهذا الأمر يستدعي عدم النظر إلى التاريخ على أنّه قرآن منزل، أو تراث مقدّس ـ وهذا ما وقع فيه غيرنا للأسف ـ وقد يقول بعض الشباب: نحن أبناء اليوم فما لنا وللماضي؟ ونحن هنا لا ندعو إلى الاستغراق في الماضي، ولكنّنا نأخذ من ماضينا لحاضرنا ما ينفع ويغني، وتلك دعوة القرآن إلينا: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ)[3]، و(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)[4]، فهؤلاء الناس قد غادروا مسـرح التاريخ، ولم يبقَ منهم سوى أفكارهم التي هي نتاج بحثٍ وتجربة، وأعمالهم التي يمكن أن نقتني بعضها ونطوّر بعضها الآخر، فكانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام ممّا يمكن أن نقتدي بها وننهل منها الكثير، وكانت حركته نهضة في تاريخ الإنسانية، ومحطّة من محطّات الصراع بين الحق والباطل، وهي حركة متّصلة اتّصالاً وثيقاً بأعظم الرسالات السماوية على الإطلاق، تلك هي رسالة خاتم الأنبياء محمد عليها السلام، فقد قال رسول الله عليها السلام: «حسينٌ منّي وأنا من حسين، أحبّ الله مَن أحبّ حسيناً…»[5].
وقد احتلّت سيرته المباركة عليه السلام وشهادته يوم الطف حيزاً كبيراً في التاريخ، وأخذت أشكالاً مختلفة من الاهتمام، تمثّل أحدها بالمجلس الحسيني، الذي يُعدّ من أهمّ الشعائر التي لا يزال إحياؤها قائماً منذ قرون مديدة.
فإحدى وظائف الخطيب الحسيني هي تعريف الناس بمفاهيم عاشوراء وتاريخ كربلاء، والتذكير بمحطّاتها المضيئة في حياة الإنسانية[6]، وكان موضوع الشباب واحداً من تلك المحطّات المضيئة، والتي ما زالت طريقاً يسلكه أحرار العالم اليوم لينهلوا من نميره العذب؛ لكي يحوّل الضعف إلى قوّة، والصبر على البأساء والضرّاء مسألة يحتاجها أبناء الإسلام كافّة مع موجة المواجهات مع دين الله.
كم هو بليغٌ الأثر حين نسمع زينب الحوراء عليها السلام قدوة البطولة تقول: «…ما رأيت إلّا جميلاً»؛ إذ إنّ كلّ مأساتها ما دامت في عين الله فهي تهون؛ فهي امتحان واختبار جميل؛ لأنّه لله وفي الله ومع الله.
من هنا؛ ندعو الإخوة القائمين على المناسبات الحسينية إلى استثمار ذكرى عاشوراء في توعية الشباب والشابّات بالقيم الأخلاقية العليا التي تحميهم من الانحراف والسقوط في الهاوية، لا سيما أنّ ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واحدة من أهمّ المناسبات؛ لما لها من تأثير روحي واسع، فضلاً عن أنّ استثمارها على هذا النحو يعطي المناسبة بُعداً مضافاً يخدم معانيها العظيمة، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي تمرّ بها أُمّتنا الإسلامية، على أن لا يكون اقتصارنا على البعد العاطفي لتلك الواقعة، بل يجب أن نأخذ حياة الإمام الحسين عليه السلام نبراساً؛ لأنّ حياته عليه السلام كلّها عبرة وعِظة؛ لأنّه رجل الأخلاق والمُثل العليا.
المبحث الأوّل: أثر النهضة الحسينية في توعية الأُمّة
إنّ أخطر ما يُبتلى به شعب هو أن يُقضى على روح النضال فيه، فإنّه حينئذٍ يفقد شخصيته، ويذوب في خِضمّ الفاتحين، كما قُدّر لشعوب كثيرة أن اضمحلّت وذابت وفقدت كيانها؛ لأنّها فقدت روح النضال، واستسلمت، وفقدت شخصيتها ومقوّمات وجودها المعنوي، فأذابها الفاتحون. وإنّ هذه الشعوب التي لم يحفظ لنا التاريخ إلّا أسماءها لم تأتِ من ضعفها العسكري أو الاقتصادي، وإنّما أتت من فلسفة الهزيمة والتواكل والخنوع التي وجدت سبيلها إلى النفوس، بعد أن خَبت روح النضال في هذه النفوس.
ولو أنّها بقيت مؤمنة بشخصيتها وثقافتها ومقوّماتها، واحتفظت بروح النضال حيّة في أعماقها لما استطاع الغزاة إبادتها، ولشقّت لنفسها طريقاً جديداً في التاريخ، وهذا ما حقّقته ثورة الحسين عليه السلام.
لقد أجّجت هذه الثورة تلك الروح التي حاول الأُمويون إخمادها، وبقيت مستترة تُعبّر عن نفسها دائماً في انفجارات ثورية عاصفة ضدّ الحاكمين، مرّة هنا ومرّةً هناك، وكانت الثورات تفشل دائماً ولكنّها لم تخمد؛ لأنّ الروح النضالية كانت باقية تدفع الشعب المسلم إلى الثورة دائماً، وإلى التمرّد والتعبير عن نفسه قائلاً للطغاة: إنّني هنا[7].
إذن؛ أهمّ إنجاز حقّقته الثورة الحسينية هو انبعاث الروح النضالية في الأُمّة؛ إذ لولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام لنامت الأُمّة في سباتٍ عميق؛ لأنّ الأُمويين سلكوا مع الأُمّة مسالك عجيبة من أجل إذلالها وتحطيم شخصيتها المعنوية؛ لغرض السيطرة عليها وتمكين قبضتهم منها، وتصفية كلّ حالات المعارضة والتمرّد ضدّ نظام حكمها، يقول الوليد بن يزيد:[8]
| فدَع عنك ادّكارك آل سعدي | فنحن الأكثرون حصى ومالاً | |
| ونحن المالكون الناس قسراً | نســـومهم المذلّة والنكالا | |
| ونوردهم حياض الخسف ذلاً | وما نألوهم إلّا خـبالاً(2). |
وهذه الأبيات تكشف بدقّة عن توجّه بني أُميّة السياسي في قهر الأُمة وإذلالها، وفرض نفوذهم وسلطانهم عليها.
ولا تحسب أنّ هذا التصوّر المتطرّف يخصّ الوليد بن يزيد من بين حكام بني أُميّة، فقد كان جلّ بني أُميّة وعمّالهم يرون مثل هذا الرأي أو قريباً منه.
هذا بالنسبة للأُمّة بصورة عامّة، أمّا موقفهم من بني هاشم بصورة خاصّة، فقد كانوا منهم في موقف الحاسد؛ لأنّ الأُمّة والمسلمين عامّةً كانوا يرون الفارق الكبير والبون الشاسع بين أهل البيت عليهم السلام وبين بني أُميّة في الماضي والحاضر، وكان على بني أُميّة لكي يستقرّ حكمهم ونفوذهم أن يعملوا على القضاء التامّ على نفوذ أهل البيت عليهم السلام الروحي في المسلمين، وعلى تصفية شيعتهم والقضاء عليهم، وملاحقتهم ومطاردتهم؛ ليصفو لهم الجو السياسي في العالم الإسلامي، وبشكلٍ خاصّ في العراق والحجاز.
فالأُمويون عندما استولوا على الحكم حُرّفت الحقائق، وفقد الإيمان معناه الحقيقي؛ لذا كان من الواجب أن يكون هناك رادعٌ لهؤلاء، على أن لا تنام الأُمّة وتنتظر أن يرسل لها المولى عز وجل ملائكة من السماء تقاتل دونهم، فكانت الثورة الحسينية التي وقفت بوجه الأُمويين لتحوّل مجرى التاريخ؛ لذا قيل: إنّ الإسلام محمديّ الوجود حسينيّ البقاء.
فهذا الدين مَدين للإمام الحسين عليه السلام ببقائه، فلولاه لما بقي من الإسلام إلّا اسمه، فكانت الأهداف الحسينية تتحقّق واحداً تلو الآخر، ونستطيع حصرها بما يأتي:
1ـ تحرير إرادة الأُمّة
فالطواغيت متّفقون على استخدام سلاحَين مؤثِّرَين في وجه تحرك الأُمّة وتمرّدها ورفضها للظلم، «وهما: سلاح (الإرهاب)، و(الإفساد). ومن خصائص هذين السلاحين أنّهما يسلبان الأُمّة الإرادة والقدرة على التحرّك والوعي والإدراك»[9].
وهذه سنّة الطغاة في كلّ عصـرٍ ومصـر ـ من باب التاريخ يُعيد نفسه ـ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)[10]. ففرعون قد سلب الأُمّة إرادتها ووعيها وقيمها بالإرهاب والإفساد، فمسخ الأُمّة بشخصها كاملاً، واستأصل كلّ قدرةٍ لها على التفكير، كذلك فعل بنو أُميّة، وقد وضعوا الأحاديث النبوية لإضلال الأُمّة وتخديرها وإطاعتها للحاكم الظالم إطاعةً عمياء، من ذلك أنّهم نسبوا إلى رسول الله عليها السلام القول: «يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقال السائل: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطِع»[11].
وهذا الفكر قد أعطى الحاكم حصانة حتى لو كان ظالماً؛ بحجّة أنّ الخروج عليه يؤدّي إلى مفسدة أكبر من السكوت على ظلمه، ودور العلماء ينحصر عند انحراف الحاكم بالذهاب إلى المساجد والدعاء له بالهداية.
وربّ سائل يسأل: لماذا اختار الحسين عليه السلام تلك الموتة الفجيعة على يد أُمّة ادّعت الانتماء للإسلام، واختار مشهداً أصبحت الأُمّة كلّها شاهداً عليه، مَدينةً بكسلها واستسلامها وخضوعها لدولة الانحراف؟
الجواب: لأنّ ذلك الأمر الوحيد الذي كان كفيلاً بإيقاظ الأُمّة وتنبيهها إلى خطر الانحراف المستشري، وكان هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يهزّها ويعيدها إلى صوابها، وكان لا بدّ من مشهد مثل ذلك المشهد الذي جرى على أرض كربلاء، وأمام أنظار شريحة كبيرة من الأُمّة التي ادّعت ولاءها وحبّها للرسول عليها السلام وآله عليهم السلام، ثمّ تخلّت عنهم، فهذه الأُمّة لا بدّ أن تنهض، ولا بدّ أن تثور كلّها بوجه النظام المنحرف، وبوجه كلّ نظام منحرف آخر[12] إلى يوم القيامة، ولا تصدّق بحفنةٍ من الأحاديث الموضوعة التي وضعها حكّام الجور لأجل استمرار حكمهم وظلمهم للعباد.
2ـ سلب الشرعية من النظام
أعطى الأُمويون لأنفسهم صبغةً شرعية، وكانوا يوحون للناس بطريقٍ وبآخر أنّ موقع الخلافة أقوى من موقع الرسالة، فيقول قائلهم: «إنّ خليفة أحدكم أفضل من رسوله»[13]، وقد أخذوا من إمارتهم أداةً لتنفيذ طموحاتهم ورغباتهم، فكان هذا الموقع الشـرعي الذي حرصوا عليه أكبر الأخطار التي تلحق أُمّة الإسلام، فقد كانت انحرافات أُمرائهم تنحدر إلى الناس من قصور الخلفاء في أُطر شرعية، وكانت حركته عليه السلام لكسر هذا الإطار الشـرعي، وقد أعلن هذا الموقف علناً أمام الوليد بن عتبة، عندما دعاه لمبايعة يزيد، فقال له: «يزيد رجلٌ فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس، معلنٌ بالفسق، فمثلي لا يبايع مثله»[14].
وكان هذا الموقف، ثمّ بعده الخروج على حكم بني أُميّة وذلك بإعلان الحرب، كلّ هذه الأسباب كان لها الأثر الفاعل في إثارة سخط المسلمين ضدّ سلطان بني أُميّة، وبالتالي الخروج وإعلان التمرّد وذلك بتوسيع دائرة المعارضة إلى قيام ثورات عدّة كردّ فعل على ما حصل في كربلاء، وقد تحقّق هذا الهدف أيضاً.
3ـ استعادة الدور القيادي والريادي للدولة الإسلامية
وقد تمثّل بتحمّل رسالة الإسلام بكلّ ما تتضمّنه كلمة الإسلام من معنى التوحيد الخالص لله تعالى، وجعلها أمينة على تحمّل هذه الرسالة؛ لتكون أُمّةً وسطاً، ويكون أفرادها المؤمنون شهداء على الناس بكلّ ما تتضمّنه هذه التعابير من مضامين عالية وغالية، الأمر الذي لا يتهيّأ لها من دون تمثّلها لكل القيم التشريعية والعقائدية التي تضمّنتها عقيدة الإسلام فكراً وسلوكاً، وعلماً وعملاً، وعقيدةً وتشريعاً.
4 ـ تعريف الإيمان وحقيقة العبودية
أراد الإمام الحسين عليه السلام بثورته الباسلة أن يُثبت للناس أنّ حبّ الله هو ضروري للإيمان، فكان مصداق قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ)[15]، فقد ضحّى عليه السلام بعياله وأصحابه، ثمّ بنفسه الزكية، فهام في الحبّ الإلهي.
هذه أهمّ الأهداف التي يمكن استيفاؤها من الواقعة، ونحن نلقي نظرةً على وصيته لأخيه محمد بن الحنفية قبل الخروج من المدينة متوجّهاً إلى مكّة، والوصية هي كالآتي: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد ابن الحنفية: أنّ الحسين يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، جاء بالحقّ من عنده، وأنّ الجنة حقٌّ والنار حقٌّ، والساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور، وأنّي لم أخرج أشراً ولا بَطِراً ولا مُفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدي عليها السلام، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب، فمَن قبلني بقبول الحق فالله أوْلى بالحقّ، ومَن ردّ عليَّ هذا أصبر حتى يقضـي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين»[16]، ثمّ طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى
أخيه محمد.
فهذه الوصية تحمل معاني كثيرة وأهدافاً عالية للخروج على الحاكم الظالم، فإذا أضفنا إلى هذا رسالتَه إلى وجوه البصرة، والتي كان من ضمن كلماته: «أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه، فإنّ السنّة قد أُميتت والبدعة قد أُحييت، فإن تسمعوا قولي أهدِكم سبيل الرشاد»[17]، أضف إلى ذلك كتابه الذي أرسله مع مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة، والذي حدّد فيه رسالته: «…فلعمري، ما الإمام إلّا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائم بالحقّ، الحابس نفسه على ذات الله»[18]، ومن هذه الوصايا يمكن أن نستلهم أهدافاً أُخرى للثورة:
1ـ إحياء الإسلام.
2ـ إحياء السنّة النبوية والسيرة العلوية، وإماتة البدعة.
3ـ توفير القِسط والعدالة الاجتماعية، وتطبيق حكم الشريعة.
4ـ إزالة البِدع والانحرافات.
5ـ كسر عقدة الخوف من الحكّام الظلمة عند أبناء الأُمّة.
6ـ إنشاء مدرسة تربوية رفيعة، وإعطاء المجتمع دوره وشخصيته.
ففي كلّ هذا وذاك كان هدفه السامي هو التغيير، والتغيير هنا ليس جانباً واحداً، بل تغييرٌ سياسيٌّ واجتماعيٌّ واقتصاديٌّ، فكانت ثورته عليه السلام فريدةً في نوعها، ولا نبالغ إذا قلنا: لا يوجد مثلها حتى في تاريخ الأنبياء وأوصياء الأنبياء، ولا توجد عملية أو حركة اجتماعية تشابه تلك العملية التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، عملية فريدة في نفسها، ومختصّة بخصائص تميّزها عن غيرها؛ لذا صارت رسالة موجّهة إلى كلّ العالم، لا تخصّ طائفةً دون أُخرى، ولا قوميةً دون أُخرى، ولا ديناً دون آخر، بل أصبح جميع البشـر مكلّفين بأن يأخذوا منها الدروس والعبر، ولا نتعجّب إن قال (غاندي) الهندوسي: «تعلّمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر»[19]، وكذلك ما قاله الرئيس الصيني (ماو تسي تونغ) لياسر عرفات ـ عندما طلب منه أن يعلّمه دروساً في التضحية من دروس الثورة الصينية ـ: «عندكم تجربة ثورية قائدها الحسين، وهي تجربة إنسانية فذّة، وتأتون إلينا لتأخذوا التجارب؟!»[20].
وقد حقّقت ثورة الإمام الحسين عليه السلام أهدافها، سواء كان ذلك على المديات القريبة أم البعيدة، فعلى المديات القريبة كانت أوّل ثورة بعد واقعة الطف هي ثورة سليمان ابن صرد الخزاعي، وبعدها ثورة المختار، ثمّ ثورة زيد بن علي عليهما السلام، وهكذا توالت الثورات «إلى أن سقط الحكم الأُموي، وليس المهم أن يسقط الحكم الأُموي أو لا يسقط، بمقدار أنّ المهم هو أنّ الشارع بقيَ محافظاً على القيم الإسلامية الأصيلة بدرجةٍ كبيرة، والعالم اليوم يهتزّ لحضارتنا ولأُمّتنا الحية المتقدّمة، من هنا من الشـرق ومن العراق، ومن هذه المنطقة منطقة أتباع أهل البيت عليهم السلام»[21].
أمّا على المديات البعيدة، فقد حقّقت الكثير الكثير، فما الصحوات في العالم الإسلامي إلّا ومضةٌ من تلك الومضات الربّانية، فالثورة الإسلامية التي قامت في إيران ما هي إلّا من إرهاصات تلك الثورة الحسينية، وما حصل في جنوب لبنان من دفع للعدو الصهيوني بعد ما كان يسرح ويمرح في لبنان إلّا شرارة من شرارات الحسين عليه السلام، وما حصل في العراق ويحصل اليوم من انتفاضة على الظلم والظالمين، وما سيحصل بعد آلاف السنين فهو من كربلاء، وقد صدق الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية الإيرانية عندما قال: «كلّ ما لدينا هو من عاشوراء»[22]، وصدقت المقولة المشهورة القائلة: «كلّ يوم عاشوراء، وكلّ أرض كربلاء»[23]، فعاشوراء ليست واقعة، بل هي ثقافة، ثقافة الملحمة، ثقافة الشهادة، ثقافة الصمود والمقاومة، ثقافة الولاية، ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثقافة الحب، ثقافة الإيثار، ثقافة التحمّل، ثقافة البصيرة والتدبير، ثقافة التسليم لأمر الله، ثقافة الوفاء للقرآن والعترة، ثقافة العزة والرفعة، ثقافة عدم الاهتمام بزخارف الدنيا، وثقافة جميع الخيرات[24]؛ لأنّ عاشوراء عبارة عن مجابهة بين رؤيتين: رؤية الإسلام الأصيل ورؤية الإسلام الأُموي، عبارة عن اصطفاف مَن جذبتهم ملذات الدنيا أمام طلّاب الآخرة، هي ساحة اختبار الخواصّ والعوام، عاشوراء كانت حصيلة ضعف التبعية للقائد الذي اختاره الله، عاشوراء حصيلة انتشار الفساد والذنوب وعدم الالتزام في المجتمع وضعف الإيمان، إلى غير ذلك من حصائل[25].
ولرُبَّ سائلٍ يسأل: ما هو سرّ انشداد الناس لثورة الحسين عليه السلام؟ أي: ما هي أسباب هذا التفاعل الوجداني لجماهير الناس مع نهضة الحسين عليه السلام؟ وإذا كنّا في مقام الإجابة فنقول: إنّ هذا الانشداد والتفاعل جاء من سببين:
الأول: مشيئة الله سبحانه وتعالى.
الثاني: أنّ جماهير الناس قد وجدت في عاشوراء شيئاً يتناغم مع ضمائرها وعقولها وعواطفها، كما وجدوا فيها ذاتهم وزادهم في المسير إلى الله تعالى[26]، وقد وجد الناس في هذه الثورة الأُسوة في حياتهم.
وهكذا ستظلّ هذه الثورة مشعلاً للأحرار في بقاع الأرض إلى يوم القيامة.
المبحث الثاني: أثر المنابر الحسينية في توعية الأُمّة
المنبر الحسيني: هو ما يُطرح من أفكار وأحاديث ومفاهيم إسلامية، وفضائل قادة المسلمين، والبحث في مشاكل المسلمين، والسعي إلى إيجاد حلٍّ لها[27]، وليس المقصود به هو الخشب الذي هُندس بطريقةٍ معيّنة.
إمّا الخطبة الحسينية، فهي: «الخطبة التي يُلقيها الخطيب الحسيني في المجلس الحسيني، وتمتاز بمواصفات خاصّة بها، منها: ذكر الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأنصاره، والإشادة بمواقفهم، ثمّ التخلّص بذكر مأساتهم ومصائبهم، وهي أيضاً الخطبة الكاملة والمحاضرة النافعة التي تبعث الوعي في الأُمّة، وتنشر الثقافة في المجتمع؛ لما تحمله من مضمون علمي في مجالات المعرفة»[28].
يُعدّ الإمام زين العابدين عليه السلام مؤسِّس هذا المنبر، وأوّل مَن اعتلى الأعواد وتكلّم بكلامٍ نال استحسان الحاضرين، بل وتعجّبوا من منطقه الفيّاض، وذلك في مجلس يزيد في عام (61هـ)، أي: بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعدّة أيام، وكانت خطبته في ذلك المجلس هي الخطبة التأسيسية لمنبر الحسين عليه السلام[29]، وقد وضع عليه السلام الحجر الأساس للخطبة الحسينية، وجمع العناصر الأساسية، وقال في خطبته: «الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأوّل الذي لا أوّلية له، والآخر الذي لا آخرية له، والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام، وقسّم في ما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلّام… أيّها الناس، أُعطينا ستّاً وفُضّلنا بسبع، أُعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين، وفُضّلنا بأنّ منّا النبي المختار محمّداً عليها السلام، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله، ومنا أسد الرسول، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا سبطا هذه الأُمّة وسيدا شباب أهل الجنة.
أيّها الناس، مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أيّها الناس أنا ابن مكّة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مَن حمل الركن بأطراف الردا… أنا ابن مَن أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن مَن ضرب بين يدي رسول الله ببدرٍ وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ذاك أبو السبطين الحسن والحسين علي
ابن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء، وسيدة النساء، وابن خديجة الكبرى، أنا ابن المرمّل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن مَن بكى عليه الجن في الظلماء، وناحت عليه الطير في الهواء.
فلمّا بلغ إلى هذا الموضع ضجّ الناس بالبكاء، وخَشـي يزيد الفتنه فأمر المؤذّن أن يؤذّن للصلاة»[30].
وقد جمعت هذه الخطبة العناصر الأساسية للمنبر الحسيني، وهي:
1ـ ركّز الإمام السجاد عليه السلام في بداية خطبته على مسألة التوحيد والمسائل العقائدية، فكأنّما أراد من رواد المنابر أن تكون أحاديثهم في بداية كلّ خطبة هو الخوض في المسائل العقائدية؛ لمِا تعرّضت له من تشوّه بين الفينة والأُخرى.
2ـ أكّد الإمام بعد ذلك على دور أهل البيت عليهم السلام في الحياة الإسلامية، وأنّ الإشارة إلى مزاياهم تعيد ذكراهم في النفوس، وتُحيي أمجادهم في الذاكرة.
3ـ أكّد في نهاية الخطبة على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، حتى أنّه أبكى كلّ مَن كان في المجلس.
ومن هذه الخطبة الخالدة للإمام السجاد عليه السلام نستطيع إن نستلهم أهداف المنبر الحسيني، والتي هي كما فهمناها من الخطبة:
1ـ إنّ المنبر الحسيني له مسؤولية وله رسالة، وهذه الرسالة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وهذا ما فهمناه في قوله عليه السلام: «أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد، فأتكلم بكلامٍ فيه لله تعالى رضىً ولهؤلاء الناس أجرٌ وثواب؟».
2ـ إنّ على الخطيب الحسيني أن لا يستهين بالجالسين أمامه مهما كان مستواهم العلمي، فالإمام السجاد عليه السلام رغم علمه أنّ مَن كان في مجلس يزيد هم من أهل الشام، الذين غُسلت عقولهم من قبل معاوية ثمّ من بعده ابنه يزيد، مع ذلك وجّه الخطاب إليهم.
3ـ على الخطيب أن يكون واعياً لمشاكل المجتمعات التي يخاطبها، فالخطيب الذي يخطب في العراق مثلاً يجب أن يكون خطابه مختلفاً عن خطاب المبلِّغ الذي يمارس دوره في بلدان أُخرى.
4ـ إنّ المنبر الحسيني مؤسّسة إسلامية يُراد من خلالها إحياء الإسلام، وإحياء سيرة أهل البيت عليهم السلام؛ لذا يجب أن يكون بمستوى تلك المسؤولية[31].
5ـ أن يهتمّ الخطيب بمشاكل المجتمع، ويحاول الحديث عنها، لا سيما مشاكل شبابنا اليوم، فنحن نتعرّض إلى هجمةٍ شرسة في ديننا، فيجب على الخطباء الحديث عن كلّ الفئات العمرية، لا سيما هذه الفئة؛ لأنّ الرسول عليها السلام قال: «أُوصيكم بالشباب خيراً، فإنّهم أرقّ أفئدةً وأتقى نفوساً»[32].
وكانت الثورة الحسينية وما زالت مليئةً بالمعطيات، فكان المنبر الحسيني أحد تلك المعطيات؛ لأنّه يشارك الأُمّة الإسلامية في سرّائها وضرّائها، شدّتها ورخائها، وهو مصدر الوعي السياسي والثقافي فيها.
وقد حفل تاريخ المنبر الحسيني بالمواقف الثورية والأعمال البطولية، ففي ثورة العشرين في العراق شارك مجموعة من خطباء المنبر الحسيني في الدفاع عن استقلال العراق، وفي أيّام المدّ الشيوعي في المنطقة الإسلامية وقف المنبر الحسيني أمام الكفر والإلحاد بصلابة، وواصل الدفاع عن الإسلام ببسالة، وأبلى الخطباء بلاءً حسناً في إعلاء كلمة الله، ودحض الإلحاد والكفر، بعد أن انخرط مجموعة من شبابنا المسلم في هذا المدّ الجارف، كذلك ما فعله المنبر في نفوس الشباب ضدّ الكفر العفلقي والظلم الصدامي، وهذا هو الذي دفع النظام المجرم لتعطيل المنابر الحسينية وتصفية الخطباء، فسجن وعذّب الكثير من الخطباء، واستُشهد آخرون في ظروف غامضة، وشُرّد الكثير منهم، ولا ننسى دور المنبر في أحداث الثورة الإسلامية في إيران، فقد ساهم المنبر الحسيني مساهمةً فعّالة في توعية الجماهير لمساندة الثورة وقائدها الخميني رحمه الله[33].
أمّا دور المنبر اليوم في الهجمة الهمجية الداعشية على عراقنا الحبيب، فقد كان له حضور مشهود، فنرى الخطباء قد شدّوا على أيدي الشباب العراقي يحثونهم على الاستجابة لنداء المرجعية، التي أعلنت بضرورة الجهاد ـ وإن كان الجهاد كفائياً ـ ضدّ هؤلاء البرابرة مغول العصر، الذين جاءت بهم دول الاستكبار العالمي لغزو العالم الإسلامي، بعد أن تعبت من قيادة الحروب بنفسها، فسلّطت عملاءها في المنطقة لخوضها نيابةً عنها، وبأموال هذه الشعوب الإسلامية المظلومة، فكان العراق واحداً من تلك الدول التي تعرّضت لهذه الهجمة، بعد أن استطاع الأوباش الذين قَدِموا من دول مختلفة من العالم أن يُدمّروا أجزاءً كثيرة من سورية تحوّلوا إلى العراق، بعد أن جمعوا خريجي السجون المحكومين بالإعدام لتدمير العراق الصامد، سيظلّ العراق صامداً ـ إن شاء الله ـ ما بقي لأبنائه عِرقٌ ينبض، وهذا هو الهدف الأساس الذي من أجله شجّع أئمّة أهل البيت عليهم السلام على ضرورة تأسيس هذه المجالس، بل أشادوا بتلك المجالس وحثّوا عليها؛ لأنّهم عليهم السلام يعلمون أنّ هذه المجالس سوف تكون في يومٍ من الأيام مدارسَ لشيعتهم، فقد رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لفضيل ابن يسار: «يا فضيل، تجلسون وتحدّثون؟ قلت: نعم. قال[ عليه السلام]: تلك المجالس أُحبّها، فأحيوا أمرنا، رحم الله مَن أحيى أمرنا، يا فضيل، مَن ذكرنا أو ذُكرنا عنده، فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»[34].
«والواقع أنّ لرعاية الأئمّة عليهم السلام للمجالس الحسينية، وإقامتهم لها في بيوتهم، دخلاً في تحويلها إلى مؤسّسة ثقافية واسعة، امتدّت على رقعة المسكون، لتنتظم في عقدها الشيعة مواطن ومساكن، وليس هذا التطوّر معزواً إلى العفوية، بل هو خطّة موضوعة، أحكم وضعها أئمّة أهل البيت وتابعهم على ذلك شيعتهم»[35].
وقد آتت هذه الخطوة أُكلها وعلى مرّ الزمان، فلم يؤثر عن مؤسّسة ثقافية ما أُثر عن المنبر الحسيني من الحضور الفعلي في كلّ زمان ومكان في الحياة الإسلامية؛ حيث إنّه ترك أثراً واضحاً على شخصية المسلم ذي الارتياد المستمر للمأتم الحسيني، بل حتى الذي يرتاده لأوّل مرة، فلا يقوم من مقامه إلّا وقد ترك في نفسه أثراً واضحاً، ولا ضير إذا قلنا: إنّ تقويم الشخصية الشيعية مستندٌ إلى ما يفعله المنبر الحسيني من تأثير بيّن فيها؛ لذا صار من واجب أصحاب المنابر ليس فقط التركيز على الجانب المأساوي وحده، وإنّما التركيز على كافّة الجوانب، لأنّ مَن ركّز على الجانب المأساوي ورآه مجرّد تعبير عن أقصـى الحزن والألم، فقد أساء كثيراً للثورة الحسينية؛ لأنّ هذه الثورة إنّما جاءت لتصوغ المرء المسلم صياغةً ملائكية، تتلاشى فيها الصفات المذمومة التي ورثها من حضارته المصنوعة بأيدٍ بشـرية، من قبيل: الطمع، والشح، والخوف، والجبن، والانتهازية، والنفعية، والمحسوبية، والمادية، وغيرها كثير. صحيحٌ أنّ هذه المؤسّسة الاجتماعية ـ أعني المنبر الحسيني ـ لا تقوم وحدها بهذا الواجب، ولا تتعامل بمفردها مع إنسان مجتمعها، بل تتشاطر مع غيرها من المؤسّسات الاجتماعية في إعادة هوية المرء المسلم ـ وإن كان هناك مؤسّسات تحمل طابعاً غير إسلامي وهدفها تدمير المسلم ـ لذا يجب أن تكون واعية لتستوعب تغيرات العصـر، ولكن بحذرٍ شديد، بحيث تستطيع أن تنتصر أو تثبت أمام التحدّيات التي قد تُطرح من مؤسّسات أُخرى، فلا تفقد جمهورها الخاصّ الذي يستجيب لنداءات الواقع وضروراته، هذا مع التأكيد على «صفة الأصالة في حال الاستجابة لضـرورات الحداثة، فلا تطغى ضرورات الحداثة على صفة الأصالة، فتخرج المؤسّسة عن حقيقتها، ويخرج قادتها عن جوهر رسالتهم»[36]، فمثلاً نرى أنّ الثقافة الحسينية في العصر الحديث قد تطوّرت لتستفيد من الوسائل الإعلامية المتطوّرة، كالإعلام المرئي والمسموع، والمسـرح والإنترنت، والصحيفة وغيرها؛ ليشارك في إظهار هذا الأثر الفقيه والمفكّر والأديب والفيلسوف، والرجل والمرأة، لكنها مع ذلك لم تضمحلّ أو تتمحور على العكس؛ لأنّ الحسين عليه السلام وكما قال جدّه المصطفى عليها السلام: «مصباح الهدى وسفينة النجاة»[37]، وأنّه عليه السلام يعطي العلم والثقافة والمعرفة للإنسان، ويدعو إلى نهضة ثقافية وحضارية، ويحارب الجهل والتخلّف الفكري والعلمي، وعليه؛ فإنّ للمنبر الحسيني آثاراً عدّة يمكن عدّها بما يلي:
1ـ الأثر الثقافي: الثقافة التي أسّسها الحسين عليه السلام بثورته، وهي ما نصطلح عليه (الخطابة الحسينية) وما يتعلّق بها من الأدب الحسيني، التي من خلالها يُطرح كلّ ما يهمّ الإنسان، وما يقع عليه من مسؤوليات.
2ـ الأثر الاجتماعي: أصبح الحسين عليه السلام وسيلةً للوئام الاجتماعي؛ لأنّه يحملهم من مكان واحد، وتحت سقف واحد، فإنّك ترى في المجلس الحسيني العالم، والدكتور، والمهندس، والعامل، والفلاح، والرجل، والمرأة، والشاب، والكبير، والصغير، مجتمعين تحت ظلّه عليه السلام، وقد حقّق الإمام عليه السلام ما لم يحقّقه غيره، فجمع الأضداد تحت خيمته، وألغى التفاوت الطبقي والاجتماعي، بحيث يصبح الكلّ جالسين بهيئة واحدة، والكلّ آذان صاغية يستمعون إلى ما يقوله الخطيب والأديب، ودموعهم جارية حسرةً على صاحب المصيبة.
3ـ الأثر السياسي: لقد ترك الإمام الحسين عليه السلام ومنبره والنداء بمظلوميته أثراً واضحاً فيمَن أرادوا الوصول إلى حكم عادل ينعم به الإنسان، ولا يعود يعاني من الاضطهاد الذي يشهده من حكّام العالم الإسلامي اليوم، فهذا المختار الثقفي لمّا رفع شعار: «يا لثارات الحسين»، استطاع أن يؤسّس دولة طويلة عريضة شملت ثلاثة أرباع العراق، ووصلت إلى أرمينيا وإيران وجبال الأكراد، وقد وصل هذا كلّه بفضل رفعه شعار: «يا لثارات الحسين»؛ لذا فقد استجاب له الجماهير وانتصروا بالحسين على خصومهم، لهذا قال غاندي الهندوسي كلمته الشهيرة: «تعلّمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصـر»، إذ جعل الظلامة الحسينية شعاراً ومبدءاً في كفاحه ضدّ المحتلّ البريطاني، حتى أزاح كابوسه عن بلاده، وحرّرها بفضل الحسين عليه السلام.
4ـ الأثر العاطفي: فقد ترك المنبر أثره العاطفي في الناس، فالشفقة الإنسانية تجاه سيد الشهداء عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وعياله ونسائه، والتي تترجم بحسب فهم الناس ووعيهم وجهلهم وسذاجتهم اتّجاه الإسلام عامّة والحسين عليه السلام خاصّة، فهم ورغم اختلافاتهم هذه متّفقون على أشياء كثيرة، كإقامة المآتم، وعقد المجالس الحسينية، وقراءة الرثاء، والبكاء، وإنشاد الشعر الحزين، وإن كان هذا يختلف من بلدٍ إلى بلد.
5ـ الأثر الحركي والثوري: ثورة الحسين عليه السلام أُريد منها أن تكون حركة تغييرية، وثورة ضدّ الظلم وحكّام الجور، فإذا ذُكر اسم الحسين عليه السلام تبادر إلى الأذهان: الثورة، التغيير، التمرّد على الواقع المرّ، ولأنّ هدفه عليه السلام ـ منذ خروجه ـ الإصلاح في أُمة جده، والإصلاح لا يقوم إلّا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما عاملان من عوامل النهوض الحضاري والإصلاح الاجتماعي؛ لذا قال تعالى مادحاً مَن قام بالأمرين معاً: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)[38]. وبما أنّ الظلم موجودٌ في كلّ زمانٍ ومكان، فالحسين عليه السلام سوف يبقى يواجه هذا الظلم في كلّ مكانٍ وزمان، فقد ورث دروس الشجاعة وإباء الضيم ورفضه عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام منذ أن كان طفلاً، فقد روي أنّه عليه السلام عندما كان طفلاً حضر مسجد رسول الله عليها السلام فوجد الخليفة الأوّل يخطب، فأخذ بتلابيبه وجرّه قائلاً: «هذا منبر أبي لا منبر أبيك… [فقال أبو بكر:] صدقت، هذا منبر أبيك لا منبر أبي»[39]؛ لأنّه كان يعلم أنّ الحكم بعد رسول الله عليها السلام لأبيه علي عليه السلام، وليس لأحدٍ غيره.
6ـ الأثر الديني: هذا الأثر قال به القرآن الكريم، فقد قال تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)[40]، فتعظيم هذه الشعائر الحسينية وإقامتها، وعمل المجالس الحسينية والتشجيع عليها، وإنفاق الأموال وبذل الغالي والنفيس هو إحياء الشعائر؛ لأنّ شعائر الحسين هي شعائر الله، وهي معالم تدلّ على دين الله، فالمسجد هو بيت الله، كذلك فإنّ الحسينية هي الأُخرى بيت الله؛ لأنّها بيت الحسين عليه السلام ولا يختلف الاثنان في ذلك[41].
هذه هي أدوار المنبر الحسيني وآثاره، فلنحاول إذاً إلقاء الضوء على تأثيره في فئة مهمّة من فئات المجتمع، ألا وهي فئة الشباب المسلم، ومدى تأثير شباب الطف عليهم.
المبحث الثالث: ما الذي استلهمه الشباب اليوم من دروس كربلاء الحسين وشباب الطف؟
قال تعالى : (اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)[42]. فالآية الكريمة قسّمت العمر الطبيعي للإنسان إلى أدوار ثلاثة، وهنّ عبارة عن دوري ضعف، يتوسّط بينهما دور قوّة، فدوري الضعف هما: دور الطفولة والصبا إلى سنّ البلوغ، ثمّ دور الكهولة والشيخوخة إلى حين الموت، وبين الدورين دور القوة وهو دور الشباب الذي يبدأ من حين البلوغ الجنسـي في الخامسة عشرة عادةً إلى عمر الأربعين سنة، وهي الفرصة الوحيدة للإنسان لكي يستفيد من حياته كلّها، بأن يعتبر فيه بأخطاء الماضي، وينظّم فيه الحاضر ويبني فيه المستقبل، وفي هذا الدور ـ دور الشباب ـ تتفتّح طاقات الإنسان ومشاعره الروحية والجسمية، وتنمو مواهبه ومَلكاته الشخصية، وتنضج قواه وغرائزه، ويمتلئ نشاطاً وحيوية، ويندفع بجد واهتمام في طريق الحياة للأخذ والعطاء والتأثّر والتأثير والسعي والعمل[43]، من هذا وذاك اعتبر الإسلام أنّ الشباب محور الأُمة وقطب المجتمع في كلّ ما يتعرّض له من نجاح أو فشل، وتقدّم أو تخلّف، ونصر أو هزيمة، بل صارت كلّ آمال الأُمّة وأهدافها منوطة بشبابها إن كانوا صالحين.
ومن هذه الأهمّية وجّهت المجتمعات العالمية جلّ اهتمامها لشبابها تربيةً وتعليماً ورعاية، وعنيت الحكومات والقوانين والنظم العالمية عنايةً فائقة بالشباب، فأنشأت لهم وزارة خاصّة، ووضعت لشؤونهم برامج وخطط تستهلك شطراً كبيراً من ميزانية الدولة.
والحقيقة أنّ الإسلام قد سبق جميع المجتمعات والحكومات إلى الكشف عن أهمّية الشباب وعظيم تأثيره في المجتمع، فقد ركّز الرسول عليها السلام وفي بدايات دعوته على جيل الشباب، مُولياً لهم أهمّية فائقة، مستعيناً بالنظرة السليمة التي يتحلّى بها هذا الجيل، بعد أن أطلعهم على الثوابت الأخلاقية والأُصول الدينية، وضرورة أن يوجّه الشباب جميع قدراته وقابلياته باتّجاه الخير والسعادة والإحسان، فاستعمل عليها السلام مجموعة من الشباب في إدارة شؤون المسلمين، فكان علي بن أبي طالب عليه السلام أوّل شاب دعاه الرسول عليها السلام، فأجاب حينما أمره بالمبيت على فراشه، وأوّل فدائي في الإسلام عرض نفسه لسيوف قريش، الذين قرّروا اغتيال شخص النبي الكريم عليها السلام، وكذلك كان مصعب بن عمير ذلك الشاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، الذي كان مترفاً فترك ترفه وهاجر إلى رسول الله عليها السلام[44]، ثمّ الشاب عتاب بن أسيد الذي كان في العشرين من عمره، ولّاه النبي عليها السلام إمارة مكّة بعد فتحها[45].
وآخر شاب اعتمد عليه عليها السلام قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى هو أُسامة بن زيد الشاب البالغ ثمانية عشر عاماً، أمّره على أخطر جيش جهزه في حياته، وكان تحت لوائه الشيوخ وكبار السن من الصحابة[46].
وطالما لاقى عليها السلام معارضة شديدة ولوم كبير ـ رغم أنّه: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)[47] ـ من بعض مَن يعتبر نفسه أوْلى بذلك؛ لكبر سنّه أو قدمه، وكان عليها السلام يرد عليهم ردّاً حاسماً، فمثلاً عندما عيّن أسامة بن زيد قائداً لجيشه تكلّم القوم وقالوا: «يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين؟! فغضب رسول الله عليها السلام غضباً شديداً، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعد، أيّها الناس فما مقالةٌ بلغتني عن بعضكم في تأمير أُسامة، لئن طعنتم في تأميري أُسامة فقد طعنتم في تأميري أباه قبله، وأيم الله، إنّه كان للإمارة خليقاً، وإن ابنه بعده لخليقٌ للإمارة، وإن كان لمن أحبّ الناس إليّ، فاستوصوا به خيراً، فإنّه من خياركم»[48].
وما اهتمامه عليها السلام هذا لهم، وإصراره على حماية الشباب الأكفاء، ودعم مواقفهم إلّا لأنّه عليها السلام كان يريد أن يرسّخ في أذهان عامّة المسلمين أنّ الذين كانوا يخطئون الشباب يحب أن يلتفتوا إلى جهلهم في هذا التقييم.
أمّا الأئمّة المعصومون عليهم السلام، فقد أوصوا بالشباب، ولهم عليهم السلام شواهد قولية وفعلية على اعتمادهم وثقتهم بالشباب المؤمن في إقامة الحق، والدعوة إلى الصـراط المستقيم، فقد سُئل أمير المؤمنين عليه السلام يوماً من أيام معارك صفّين ضدّ المتمرّدين (معاوية وحزبه)، فقيل له: ما الذي أقعدك عن انتزاع حقّك في الخلافة بعد وفاة الرسول عليها السلام، فقال عليه السلام: «هؤلاء…»، وأشار إلى فرقةٍ من جيشه تشتمل على عشـرة آلاف شاب من شباب المدينة وأطرافها، هؤلاء كانوا في أصلاب آبائهم وأرحام أُمّهاتهم في ذلك اليوم[49].
وقد حدّث عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام في وصيّته له عن دور الآباء في تربية الشباب فقال: «وإنّما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما أُلقي فيها قبلته، فبادرتُك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك»[50].
وما هذا إلّا لأنّه عليه السلام يعلم أنّ أيام الشباب تعني بلوغ أعلى القمم، وشروع أجمل مراحل العمر، الشاب في هذه المرحلة يرى الأشياء جميلة، ويرى الأُفق واسعاً مليئاً بكلّ ما يستهويه ويرتضيه، ويصبح غارقاً بالآمال والأُمنيات، وقلبه طافح بالحبّ والأمل .
وهكذا أكّد بقية الأئمّة عليهم السلام على وجوب تربية الشباب، والاعتناء بهم وبنائهم بناءً فكرياً وروحياً وخُلقياً؛ لأنّهم مؤهّلون لنقل التعلّم أكثر من غيرهم، فعن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قالا: «لو اُتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته، قال: وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: تفقهوا، وإلّا فأنتم أعراب»[51].
وما دمنا في الحديث عن الشباب ودورهم في الحياة الاجتماعية لا بدّ من أن نعرّج على شباب الطف؛ لما لدورهم من أهمّية، فقد وقفوا مواقف بقيت آثارها إلى اليوم محرّكةً للتاريخ، ومقوّمة لمسيرته، وهؤلاء الشباب ساروا أكثر من ألفي كيلو متر من مكّة إلى كربلاء، والكوفة، وسنجار، وحلب، ودمشق، ثمّ عادوا في نفس الطريق إلى المدينة، علماً أنّهم لم يتعوّدوا على هذه الرحلات الطويلة والشاقّة المرافقة للخوف والإرهاب والبطش، فكانت رحلتهم ملحمة من التضحية والجهاد، والجود بالنفس في سبيل العدالة والمساواة وإحقاق حكم الله في الأرض، فكانت أمانيهم ومطامحهم صموداً في الأهوال، وصبراً في البأساء، واستشهاداً بحدّ السيوف، فإذا كانت مطامح الشباب عيشاً رغيداً ومستقبلاً سعيداً حافلاً بكلّ ألوان النِّعَم كما نشاهد ونرى، فإنّ شباب كربلاء لم يفكّروا أو يهتمّوا بما أُعدّ لهم من غضارة الدنيا، وما ينتظرهم من صفو الحياة ولهوها ومتعتها، بل كان همّهم التطلّع إلى أي سبيل من سُبل الشهادة يعبرون، وأي موقفٍ من مواقف البطولات يقفون.
نحاول على عجالةأن نذكر بعض أسماء هؤلاء الشباب وبعض مواقفهم التي سطّرها التاريخ بأحرفٍ من نور، فقد سار الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء على رأس قافلة من الشباب الأبطال، متحدّياً أقوى سلطة وأبشع طغيان بسبعين من الرجال والشباب؛ ليحطّم بهذا العدد القليل قوى الشـر والطغيان، ومعاقل البغي والعدوان، وليعلم أبناء آدم كيف يموتون في سبيل العزّة والكرامة[52]، فمن هؤلاء الشباب:
1ـ علي الأكبر: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وُلد في أوّل خلافة عثمان بن عفان، أو بعد جدّه عليه السلام بسنتين كما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد[53]، أُمّه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي[54]، كان يشبه جدّه رسول الله عليها السلام في المنطق والخَلق والخُلق[55]، وروى الحديث عن جدّه علي بن أبي طالب عليه السلام، كما حقّقه ابن إدريس في السـرائر، ونقله عن علماء التاريخ والسير.
علي الأكبر رمز الشباب، علي الأكبر الشاب الكامل، علي الأكبر المؤمن ذو البصيرة النافذة، ذو الإيمان الصلب، يُقال: إنّه لمّا «سار الحسين عليه السلام وهوّمت عيناه بالنوم ساعة انتبه وهو يقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. فأقبل عليه ولده علي الأكبر عليه السلام وقال له: يا أبتِ، لِمَ استرجعت، لا أراك الله سوءاً؟ فقال عليه السلام: يا ولدي، خفقت خفقةً فرأيت فارساً وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. فقال له: يا أبتِ، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، نحن والله على الحق. فقال علي الأكبر عليه السلام: إذاً والله، لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا»[56].
فإنّه عليه السلام لم يُقدم على أيّة صغيرة ولا كبيرة إلّا وسأل إمامه الحسين عليه السلام عنها؛ حرصاً منه على تطبيق الحكم الشرعي، وهو ما يجب أخذه بنظر الاعتبار من جميع الشباب.
كان أوّل مَن قُتل بالطف من بني هاشم بعد أنصار الحسين عليه السلام، فإنّه وبعد أن شاهد أصحاب الحسين عليه السلام يُستشهدون واحداً تِلو الآخر استأذن الإمام الحسين عليه السلام للخروج، فأذن له، وقال عليه السلام: «اللّهمّ اشهد فقد برز إليهم غلامٌ أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك عليها السلام، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إليه». ثمّ صاح بابن سعد: «قطع الله رحمك كما قطعت رحمي»[57].
فشدّ على القوم مرتجزاً:[58]
| أنا علي بن الحسين بن علي | نحن وبيت الله أولى بالنبي | |
| والله لا يحكم فينا ابن الدعي | أضرب بالسيف أحامي عن أبي(3) |
فقاتل قتالاً شديداً، ثمّ عاد إلى أبيه وهو يقول: «يا أبتِ العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني…»، حتى استُشهد على يد مرّة بن منقذ[59].
وبهذا تكون كربلاء قد قدّمت أبهى الصور، وأقدس الأنفس، وأحب الناس إلى الله تعالى من الشباب الذين باعوا أنفسهم لله، وأرخصوها في سبيله، وإذا كان الإنسان بحاجة إلى نبراس وقدوة فلا أفضل من علي الأكبر عليه السلام، فهو خير قدوةٍ وأُسوة لشبابنا، وهو العالم العابد وصاحب العقيدة الثابتة.
2ـ القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: أُمّه أُمّ عبد الله بن الحسن الذي سمّاه البعض تصحيفاً أبا بكر، كان يوم الطف غلاماً لم يبلغ الحلم، وقِيل: إنّه بلغ الحلم.
قال الراوي: «وخرج غلام كأنّ وجهه شقّة قمر، فجعل يقاتل، فضربه ابن فضيل الأزدي على رأسه، ففلقه، فوقع الغلام لوجهه وصاح: يا عمّاه، فجلى الحسين عليه السلام كما يجلي الصقر، ثمّ شدّ شدة ليثٍ أغضب، فضرب ابن فضيل بالسيف، فاتقاها بالساعد، فأطنّه من لدن المرفق، فصاح صيحة سمعه أهل العسكر، وحمل أهل الكوفة ليستنقذوه فوطأته الخيل حتى هلك. قال: وانجلت الغبرة، فرأيت الحسين عليه السلام قائماً على رأس الغلام وهو يفحص برجليه، والحسين عليه السلام يقول له: بُعداً لقومٍ قتلوك، ومَن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك وأبوك…»[60].
ولقد قال له الإمام الحسين عليه السلام أنت العلامة من أخي، أنت الوديعة من أخي، وجمعاً بين الكلمتين الشريفتين ننتهي إلى «أنّ القاسم كان يحمل صفات أبيه الحسن المجتبى عليه السلام، وقد أجمع المؤرِّخون على أنّه كان أشبه ولد الحسن بالحسن»[61].
وكان شباب أهل البيت آنذاك هم «عشـرون شاباً من نسل أبي طالب وأحفاد رسول الله محمد عليها السلام، رفضوا الذل والهوان، ومشوا إلى الموت بأُنوف شامخة ورؤوس مرفوعة عالية؛ لحماية الإسلام من الوثنية والجاهلية الرعناء»[62].
وإذا اقتصرنا على هذين الشابين فإنّه لا يعني أنّه لا يوجد غيرهم، فقد كان قمر بني هاشم العباس وإخوانه في ريعان الشباب، وكذلك بنو عقيل، بل بنو طالب أجمعون الذين قالوا له وبصوتٍ واحد ـ عندما خيّرهم الإمام بين البقاء الذي يعني الموت وبين الرحيل ـ: «يا بن رسول الله، فما يقول الناس لنا وما نقول لهم، إنّا تركنا شيخنا وكبيرنا وابن بنت نبيّنا، لم نرمِ معه بسهم، ولم نطعن معه برمح، ولم نضرب بسيف؟! لا والله، يا بن رسول الله، لا نفارقك أبداً، ولكننا نقيك بأنفسنا حتى نُقتل بين يديك…»[63].
وهكذا أدّى الشباب العلويون مهمّتهم على خير وجه، وقد ضربوا لشبابنا اليوم دروساً في التّضحيات، ولا يقتصر الكلام على الشباب العلوي، بل كان لشباب الأنصار دورٌ آخر في المعركة نأخذ منه نماذج قليلة:
1ـ وهب الكلبي: وهو وهب بن عبد الله، كان نصرانياً فأسلم هو وأُمّه وزوجته على يد الإمام الحسين عليه السلام[64]، وأحسن في الجلاد وبالغ في الجهاد، بعد أن قتل في المبارزة أربعةً وعشرين راجلاً واثني عشر فارساً، ورجع إلى أُمّه وقال: يا أُمّاه أرضيت أم لا؟ فقالت: لا، ما رضيت حتى تُقتل بين يدي الحسين عليه السلام. وقالت امرأته: بالله عليك لا تفجعني في نفسك. فقالت له أُمّه: يا بني أعزِب عن قولها، وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبيك؛ تنال شفاعة جدّه يوم القيامة.
فرجع ولم يزل يقاتل حتى قُطعت يداه، فأخذت أمرأته عموداً فأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأُمّي، قاتِل دون الطيبين حرم رسول الله عليها السلام، فأقبل ليردّها إلى النساء، فأخذت بثوبه وقالت: لن أعود دون أن أموت معك. فقال الحسين: جزيتم من أهل بيتٍ خيراً، ارجعي إلى النساء يرحمك الله. فانصـرفت إليهنّ، ولم يزل يقاتل حتى قُتل (رضوان الله عليه)[65]. فذهبت امرأته تمسح الدم عن وجهه فبصر بها شمر، فأمر غلاماً له فضـربها بعمودٍ كان معه فشجّها وقتلها، وهي أوّل امرأة قُتلت في عسكر الحسين عليه السلام[66].
2ـ عمر بن جنادة الأنصاري: هو شابٌّ جاء مع أُمّه وأبيه، وبعد أن استُشهد أبوه جاء يستأذن الحسين للمبارزة فأبى الحسين عليه السلام وأرجعه، وقال: هذا غلامٌ قُتل أبوه في الحملة الأُولى ولعلّ أُمّه تكره ذلك. فقال الغلام: إنّ أُمّي هي التي أمرتني يا بن رسول الله. فخرج وهو يقول:
| أميري حسينٌ ونعم الأمير | سرور فؤادي البشير النذير | |
| عليٌّ وفاطمة والداه | فهل تعلمون له من نظير |
ثمّ قاتل فقُتل وحُزّ رأسه ورُمي به إلى معسكر الحسين عليه السلام، فأخذت أُمّه رأسه وقالت له: أحسنت يا بني، يا قرّة عيني وسرور قلبي. وأخذت عمود خيمة وحملت على القوم وهي تقول:[67]
| أنا عجوزٌ في النساء ضعيفة | باليةٌ خاويةٌ نحيفة | |
| أضربكم بضربةٍ عنيفة | دون بني فاطمة الشريفة(1). |
والحقيقة لا يدري الإنسان بمَن يُعجب بالأُمّ أم بولدها أم بزوجها، هذا غيضٌ من فيض، هؤلاء الأصحاب الذين لم يعهد التاريخ لنبي ولا وصي من الأوصياء، ولا ملك من الملوك، ولا زعيم من الزعماء كأصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإنّهم (رضي الله عنهم) كانوا ينظرون إلى حركات إمامهم وسكناته، ويعملون ما كان يعمله عليه السلام، ويتركون ما كان يتركه، وكانوا لا يحيدون عن ذلك قيد شعرة[68]، لذلك نراه عليه السلام يخاطب أصحابه وأهل بيته: «أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحاباً أصلح منكم، ولا أهل بيت أبر ولا أفضل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً عنّي خيراً»[69]. وهذا يعني أنّهم أفضل من شهداء بدر وأُحد أصحاب رسول الله عليها السلام، فضلاً عن أصحاب الأنبياء السابقين، وقد قِيل: «إنّ الذين ذهبوا مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء هم خمسمائة وما فوق، إلّا أنّهم تفرّقوا عنه حين أخبرهم بنهايته المؤلمة»[70].
وكان من حقّ الإمام الحسين عليه السلام أن يفتخر بهم جميعاً؛ وذلك لأنّ التاريخ لم يسجّل من عهد آدم إلى اليوم أنّ سبعين رجلاً وقفوا في مقابلة سبعين ألف من الرجال، وبهذا تكون واقعة الطف قد ضمّت جميع الشرائح الاجتماعية، رجالاً ونساءً، عبيداً وأحراراً، شيباً وشباباً… كما شملت جميع الأبعاد الرسالية، وتجسّدت فيها أروع صور التضحية والفداء، والشجاعة والإباء[71]، وما أحرانا اليوم أن نتّعظ ونأخذ العبرة من هؤلاء جميعاً، لا سيما شبابنا الذين يشكّلون اليوم الغالبية العظمى ممَّن ينبغي أن يتوجّه إليهم المنبر الحسيني بالتبليغ، فهم في أمسّ الحاجة للتوعية والإرشاد الديني؛ لأنّه يمكن لنا أن نصلح كلّ ما دمّرته قوى الاستكبار العالمي ـ التي من جملتها إفساد هؤلاء الشباب ـ وفق مخطّطات مدروسة دراسة دقيقة، ومبنية على أُسس علمية ونفسية؛ وعلينا أن نقوم بهذا الواجب لأسباب عدّة:
1ـ لأنّ الشباب اليوم يشكّلون الأغلبية من مجموع نفوس أبناء الشعب.
2ـ إنّ أعداء الإسلام يتربّصون بنا الدوائر منذ فترات طويلة، وإذا كنّا قد غفلنا نحن عن شبابنا، فإنّ العدو غير غافل، بل هو يحاول جذب شبابنا والسيطرة على عقولهم وأفكارهم، عبر الإذاعات والفضائيات والكتب والأساليب المتناسبة مع طبائع الشباب وشهواتهم.
3ـ إنّ شريحة الشباب أكثر قبولاً وأسرع تقبّلاً من غيرهم؛ لأنّهم يحملون قلوباً نيّرة ، كما وصفهم رسول الله عليها السلام، لم تتلوّث بعدُ بقدَر تلوّث قلوب مَن تصرّمت من أعمارهم سنوات طويلة، ويمكنهم بكلّ سهولة أن يُدركوا الحقيقة والاستجابة لها[72].
والحقيقة أنّ شبابنا اليوم يؤمن ويعتقد بالدين الإسلامي، وهذا شـيء مهم، لكنّهم يحتاجون إلى بذل جهد جهيد في هذا المجال، وهذا الجهد يجب أن يكون أكبر من الجهد الذي بذله أعداؤنا لأجل إضلال الشباب؛ لأنّنا اليوم في معركة، لكنّها ليست كالمعارك التي خاضها المسلمون في جبهات القتال؛ لأنّ عدوّنا قد تعب من الحروب، فقرّر أن تكون حروبه عبارة عن إعلام مضلّل ضدّ الشباب، فإذا قضى على هؤلاء فلا يحتاج إلى الحروب الواقعية، ولا إلى خسائر الحرب المادية والروحية، لنأخذ مثلاً ما قاله الإسرائيلي الدكتور مالحوم أخنوف، صاحب فكرة برنامج (ستار أكاديمي): كنّا متأكّدين من نجاح فكرة البرنامج؛ لأنّنا نعلم أنّ المسلمين اليوم ابتعدوا عن دينهم، وفي نفس الوقت العديد من الشباب المسلم بدأوا يميلون إلى الالتزام الديني، الذي لو كبر وتزايد سيقضـي على دولتنا.
وعندما سُئل عن أسباب حرصهم على أن يكون (ستار أكاديمي) وسيلة لتدمير المسلمين قال أخنوف: إنّنا نريدهم أن يبتعدوا عن دينهم. وأضاف: كنّا نخطّط لغزو البنات المسلمات، فإذا انحرفت الفتاة المسلمة سينحرف جيل من المسلمين وراءها؛ ولذا نحن اليوم نحرص على غزو المسلمة وإفسادها عقلياً وفكرياً وجسدياً أكثر من صنع الدبابات والطائرات الحربية. وسُئل عن هذا البرنامج الذي تقدّمه الفضائية اللبنانية (LBC) فأجاب: نحن نتبرّع لهم كلّ يوم بمبلغ كبير من المال، والبرنامج تحت إشرافنا باستمرار. وأخيراً وُجّه له سؤال: ماذا تقول للأُمّة الإسرائيلية؟ فقال: أُوصيهم أن يستغلّوا نوم المسلمين، فإنّهم أُمّة لو صحت تسترجع في سنين قليلة ما سُلب منها في قرون[73].
وبين مطرقة هذه الحرب الجديدة التي شنّها الغرب الكافر علينا وبين إهمال حكوماتنا الوطنية واجبها تجاه شبابنا المسلم، ضاع الشباب وعاشوا أزمة هوية، أو لنَقُل: (تشوّش الهوية) الذي يعني: عجز الناشئة عن تقبّل الدور الذي يطالبهم المجتمع بإيفائه[74]، فعلماء النفس «يرون في مرحلة الشباب أزمة نفسية طويلة، وصراعاً نفسياً محتدماً بين (المؤثرات) و(الاستجابات)، ويتعاملون مع الشباب من منطلق المراهقة التي توصم بالقلق والحيرة والاكتئاب والانفعالات»[75]؛ لذا صار من الواجب علينا جميعاً كمربّين أن نضاعف الجهود لأجل هذه الثروة العظيمة، التي هي المحرّك الرئيس لحياة الأُمّة، والدم الذي يجري في عروقها، علينا جميعاً السعي للحيلولة دون وقوع شبابنا فريسة الانحراف والانحلال والتبعية للغرب، أو أن يضيّعوا أعمارهم في اللهو والعبث والهوايات الفارغة.
هذا العمر الثمين الذي نستطيع أن نكتسب في كلّ ساعة، بل في كلّ دقيقة منه كمالاً بالعودة إلى الله تعالى، ولرُبّ سائلٍ يسأل: ما هي العوامل التي حفّزت الشاب على الانحراف؟
الجواب:
1ـ جهل المربّين وأولياء الأُمور بالأساليب الصحيحة للتربية، وضغطهم على الأبناء ليعيشوا الحياة التي يعيشونها هم، وهذا التصرّف غير لائق، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تقسـروا أولادكم على آدابكم، فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم»[76].
2ـ أن يكون المربّي بمثابة قدوة للشباب، في الجانب الأخلاقي والسلوكي والإيماني، فإذا كانت القدوة سيئة فماذا تتوقّع من المقتدي، فهم ينهونه عن تصـرف ويفعلونه؛ لذا نصحت الأحاديث كلّ مَن يؤدّب غيره ويعظه أن يؤدّب نفسه ويعِظها أوّلاً؛ لذا صار واجب أصحاب المنابر أن يكونوا بالمستوى الذي يكونون فيه قدوةً للناس في كلّ شيء.
3ـ أن يتحلّى المربي بقدرة الصبر؛ ليكون قادراً على حلّ مشاكلهم، فسعة الصدر كفيلة بتذليل كلّ المعوقات.
4ـ أن يُؤمن المربي بأهمّية العمل الموكول إليه، وأن يُؤمن بالثواب الأُخروي جزاءً لعمله هذا.
5ـ الصدق والإخلاص في العمل، والحذر من كلّ تصـرّف يسبّب إيجاد هفوات في شخصية الشاب.
6ـ انتشار وسائل الإفساد وإحاطتها به في مقابل غياب صوت الحقّ أو ضعفه، فأغلب المساجد خالية من أئمّة الجماعات وليس فيها خطب أو محاضرات أو حوارات.
7ـ البيئة الفاسدة التي تحيط بالناشئ، فلخلوّه من التجربة وعدم نضجه يحاول أن ينفتح على أصدقائه؛ ليأخذ منهم الحلول لمشاكله وهمومه في غياب العلاقة الودية المبنية على الصراحة والثقة بين الولد وأبيه[77].
8ـ مراقبة الآباء أبناءهم، دون أن يُشعروهم بالمراقبة، مَن من البشـر يصاحبون؟ فرفقة السوء لها تأثير على الشباب، وصَدَقَ الشاعر حينما قال:[78]
| لا تَربِط الجرباء حول صحيحةٍ | خوفي على تلك الصحيحة تجرَبُ(2). |
و في الحِكَم المأثورة: مَثل قرين السوء مَثل الحية، لينٌ لمسها قاتلٌ سمّها.
وكذلك فإنّ الطيور على أشكالها تقع، حتى لا يندم الشاب يوم القيامة فيقول: (يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا)[79]، فالأخلاق السيئة مرضٌ معدٍ يتسلّل من صاحبه إلى أصحابه وأصدقائه.
نقل الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: «يا بني، مَن يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومَن يدخل مداخل السوء يُتّهم…»[80]، وقد حذر عليه السلام من صحبة الفاجر بقوله: «لا تصحب الفاجر فيعلّمك من فجوره»[81].
إذن؛ ما الشاب الذي يريد الإسلام بناءه؟ هذا النوع من الشباب يجب أن يتّصف بما يلي:
1ـ أن يكون متّزناً منضبطاً، جاداً هادئاً، حكيماً، لا ينصـرف إلى شكله ومظهره وشعره، والحركات المشبوهة والتصرّفات المستنكرة كما هو شائع ومطلوب في عالم اليوم المتخم بوهم التحرّر إلى حدّ الانتحار، حتى غدا التحرّر عبثاً ولهواً ومجوناً وعبودية لكلّ شيء إلّا الله.
2ـ أن يكون ملتزماً متعبّداً ساعياً إلى مرضاة الله، وأن يقضي وقته فيما يفخر به في الآخرة ولا يخجل منه في الدنيا، ففي الأثر عن رسول الله عليها السلام: «ما من شابٍ يدَع لله الدنيا ولهوها، وأهرم شبابه في طاعة الله إلّا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صِدّيقاً»[82].
3ـ أن يكون مُقبلاً على التفقّه المحل للعلم النافع، الذي يحتاجه في سائر مواقع حياته، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر»[83].
4ـ أن يكون مسخّراً لطاقاته وحيويته ونشاطه وقوّته في سبيل الله تعالى، فقد رُوي عن رسول الله عليها السلام في قوله: «إنّ الله يُحبّ الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله»[84].
5ـ أن يكون غيوراً لا يرضى الاعتداء على مقدّسات وحرمات بلده، ثمّ يجلس لا يحرّك ساكناً، فضلاً عن أن يكون راضياً أو مبتسماً، كما يحدث في المجتمع في هذا الزمان، فما تعرّض له العراق في هذا اليوم من هجمة شرسة من قبل ما يُسمى بعصابات (داعش) الإجرامية يجب أن يكون حضور الشباب وغيرتهم فيه كغيرة أصحاب الحسين عليه السلام على دينهم، وكغيرة العباس عليه السلام على أخيه الحسين عليه السلام، وربّما يجهل الكثيرون خاصّةً في هذه الأيّام أنّ الغيرة واجبة على الرجال، وهذا للأسف ناتجٌ عن حالة التفلّت التي نراها عبر وسائل الإعلام، واعتياد المفاسد، وشياع الاختلاط والمفاكهة بين الرجال والنساء.
6ـ أن يتمتّع شبابنا بالحياء الذي هو خير صفات الشاب المسلم، وقد كانت هذه الصفة من أبرز صفات سيدنا رسول الله عليها السلام، لا سيما في كلامه وملبسه، وهما أمران يُستحبّان اليوم بشكلٍ أكيد، فمخالفة الحياء ظاهرة شائعة من خلال السباب والشتائم، والكلمات المحرّمة التي تُطلق علناً في الشوارع والأماكن العامّة وبصوت عالٍ دون خجل، مع أنّ الرواية تصرّح: «لا إيمان لمَن لا حياء له»[85].
7ـ أن يكون الشاب مستعدّاً دوماً للتضحية والجهاد في سبيل الله ونصـرة الدين، فبقدر ما نكون أقوياء بقدر ما نحافظ على وجودنا وكياننا وحقوقنا واستقلالنا. ومرحلة الشباب هي الفرصة الأنسب لإعداد أنفسنا للجهاد والدفاع عن مقدّساتنا، لا سيما بعدما صرّح رؤوس الكفر في دولة داعش أنّ معركتهم لن تكون على أرض الموصل فقط، بل إنّ معركتهم الحقيقية في بغداد والنجف وكربلاء والجنوب أجمع، وما حملة التطوّع التي سارع إليها الشباب بعد فتوى المرجعية بضرورة الجهاد الكفائي إلّا دليل على تفاني هؤلاء الشباب في سبيل الدين والوطن، مستمدّين مبادئهم من إمامهم، الإمام الحسين عليه السلام.
8ـ أن يحبّ الشباب المستحبّات والسنن، ويتقيّدوا بها ويحرصوا عليها، وبهذا يبرهن الشباب مدى حبّهم لرسولهم عليها السلام الذي قال: «مَن أحيى سنّتي فقد أحبّني، ومَن أحبّني كان معي في الجنة»[86]. والسنة والآداب تكون في قيامه وقعوده، وعند نومه، وفور استيقاظه، وعند طعامه، وجلساته ومشيته، وعباداته، وأن يبقى دوماً على وضوء، ويصلّي الصلاة في أوّل وقتها[87].
والخلاصة التي يجب الانتهاء إليها هي: أنّ مرحلة الشباب في حياة الفرد هي مرحلة بناء، وفي حياة الأُمّة والمجتمع هي مرحلة تحوّل، فإن كان الشباب رشيداً ناضجاً واعياً عاقلاً، فإنّه يبني لنفسه مستقبلاً سعيداً ويحوّل أُمّته إلى العزة والقوّة والكرامة وحياة أفضل، وإن كان الشباب لاهياً مائعاً، سادراً في غيّه، وغارقاً في شهواته، فإنّه يبني لنفسه بيتاً ينهار على رأسه، ومستقبلاً يُرثى له ولا يُغبط عليه، وفي نفس الوقت يدفع بأُمّته إلى الانهيار المادي والمعنوي، وإلى هذا المعنى أشار الإمام علي عليه السلام بقوله: «أصناف السكر أربعة: سكر الشباب، وسكر المال، وسكر النوم، وسكر المُلك»[88].
وقد سُئل حكيمٌ: متى يبلغ الإنسان سنّ الرشد؟ فقال: متى صار يعرف مصلحته ويُؤثرها على شهواته.
النتائج
بعد أن أبحرت سفينتنا في بحر الحسين عليه السلام، وفتّشت في داخله عن ألماسه وجواهره وصدفه ولآلئه، استطعنا أن نستخرج منه ما للخطاب العاشورائي من أثر في إصلاح الأُمّة وتوحيدها، فكان الشباب أُنموذجاً لذلك الجوهر الغائص في أعماق ذلك البحر الحسيني، الذي منه نهلنا جميعاً وشربنا من مائه العذب الرقراق، فكانت من تلك النتائج:
1ـ إنّ الحسين ومبادءه يجب أن تعيش في وجدان كلّ مسلم عرف الحسين عليه السلام وثورته المباركة، فالحسين عليه السلام ليس وقفاً على الشيعة وحدهم، بل هو جاء للبشرية جمعاء، لكلّ زمانٍ ومكان.
2ـ إنّ للخطاب الحسيني الهادف أثراً في إصلاح الأُمّة وتوحيد كلمتها، ونحن اليوم أحوج إليه من الأمس؛ بسبب تصدّع الصف الإسلامي الواحد.
3ـ يجب أن يكون لتضحيات الشباب الحسيني ومواقفهم لحظة تأمّل وتفكّر من قبل شبابنا اليوم، بعد الانحرافات الكثيرة والخطيرة التي شهدها المجتمع المسلم، لا سيّما مجتمع الشباب، وهذا ما يقع دوره على خطباء المنابر الحسينية اليوم، فهم المخاطبون بإيصال الكلمة إلى مَن يحتاجها؛ لكيلا يقول قائل: لا أعلم.
4ـ إنّ شبابنا اليوم أمام مسؤولية شرعية كبرى، بعدما تعرّض ديننا لهجمة شرسة من قبل أعداء الإسلام، فيجب أن يهبّوا لنصرة الدين، وإلّا أصبحنا بخبر كان.
5ـ إنّ مرحلة الشباب في حياة الفرد إنّما هي مرحلة بناء، وفي حياة الأُمّة والمجتمع هي مرحلة تحوّل، ففي الحالتين الشاب مسؤول أمام الله والتاريخ عن عزة ورفعة أُمّته، وهو أيضاً مسؤول عن ضياع الأُمّة ورقها وعبوديتها.
فهرست المصادر
* القرآن الكريم.
الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري (ت282هـ)، تحقيق: عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتاب العربي، ط1، 1960م، القاهرة.
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت413هـ)، دار المفيد، ط2، 1414هـ، بيروت.
الأعلام، خير الدين الزركلي، ط3، 1389هـ/1969م، بيروت.
الإمام الحسين عليه السلام (سماته وسيرته)، محمد رضا الحسيني الجلالي، دار المعروف، قم.
أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت179هـ)، تحقيق: محمد حميد الله، دار المعارف، 1959م، مصر.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت1111هـ)، دار إحياء التراث العربي، ط3، 1403هـ/1983م، بيروت ـ لبنان.
تحف العقول عن آل الرسول عليها السلام، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني (ت ق4هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، مؤسّسة النشـر الإسلامي، ط1، 1404هـ، قم.
تربية الشباب بين المعرفة والتوجيه، علي القائمي، مكتبة دار النبلاء فخراوي، ط1، 1996م/1416هـ، المنامة ـ البحرين.
تفصيل وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت1104هـ)، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1، 1411هـ، قم المقدّسة.
ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، محمد مهدي شمس الدين، الدار الإسلامية، ط1، 1400هـ/1980م، بيروت.
الحركة الإصلاحية بين أصحاب الكساء والحسين سيد الشهداء، محمد القبانجي، مؤسّسة إحياء التراث الشيعي، ط1، 1429هـ، النجف الأشرف.
خلفيات ثورة الإمام الحسين عليه السلام، محمد مهدي الآصفي، مركز دراسات نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ط1، قم المقدّسة ـ إيران.
دور المنبر في التوعية الإسلامية، محمد باقر المقدسي، مطبعة سليمان زاده، ط1، 1424هـ، طهران.
دنيا الشباب، محمد حسين فضل الله، دار التعارف للمطبوعات، ط1، 1415هـ/1995م، بيروت ـ لبنان
الرسالية في الثورة الحسينية، حسين الحاج حسن، دار الكرام، ط1، 1993م/1413هـ، بيروت ـ لبنان.
الشباب وأزمة الهوية، الدكتور محمد رضا شرفي، ترجمة: زهراء بكانة، دار الهادي، ط1، 1424هـ/2003م، بيروت ـ لبنان.
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبي الفضل أبراهيم، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1387هـ/1967م، بيروت ـ لبنان.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ)، دار الفكر، بيروت.
عاشوراء في فكر الإمام الخميني، مركز الإمام الخميني الثقافي، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، ط3، 1428هـ /2007م، بيروت ـ لبنان.
عوامل خلود الثورة الحسينية، محمد الهنداوي، دار المحجّة البيضاء، ط1، 1425هـ/2004م، بيروت ـ لبنان.
فن الخطابة الحسينية، إعداد: سيد مرتضـى الحسيني، مؤسّسة الإرشاد والتوجيه الديني في النجف الأشرف، برعاية مكتب السيد السيستاني، دار الاعتصام، ط1، 1427هـ.
في ظلال الطف (بحوث تحليلية ليوم عاشوراء)، محمد مهدي الآصفي، دار الكرام، ط1، 1416هـ/1996م، بيروت ـ لبنان.
قواعد بناء الشباب، محمد اليعقوبي، دار الصادقين للطباعة والنشـر، ط1، 1432هـ/2013م، النجف الأشرف.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين بن حسام الدين (المتقي الهندي) (ت975هـ)، مؤسّسة الرسالة، 1409هـ، بيروت.
اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت664هـ )، تحقيق: فارس الحسون، دار الأُسوة للطباعة والنشر، ط1، 1413هـ، مؤسّسة الميلاد، إيران.
مجالس عاشوراء، محمد الهنداوي، دار المحجّة البيضاء، ط1، 1425هـ/2004م، بيروت ـ لبنان.
مدينة معاجز الأئمّة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشـر، هاشم بن سليمان البحراني (ت1107هـ)، تحقيق: عزة الله المولائي، مؤسّسة المعارف الإسلامية، ط1، 1413هـ، قم.
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت1320هـ)، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1 ،1408هـ، بيروت.
مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت241هـ)، دار صادر، بيروت.
مصعب بن عمير، محمد دشبيلي، دار الجيل، ط2، 1416هـ/1996م، بيروت ـ لبنان.
مقالات الشباب، الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، ط2، 1435هـ.
مقتل الإمام الحسين عليه السلام، أبو المؤيد الموفق بن أحمد مكي المعروف بـ(الخوارزمي) (ت568هـ)، مطبعة الزهراء، النجف الأشرف، بدون تاريخ.
مقتل الحسين عليه السلام أو حديث كربلاء، عبد الرزاق المقرم الموسوي، مطبعة النجف الأشرف، ط2، 1376هـ/1956م.
مقتل الحسين ومصرع أهل بيته عليهم السلام وأصحابه في كربلاء، أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي، منشورات الرضي، ط2، 1411هـ، قم.
من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام، عبد العظيم المهتدي البحراني، مؤسّسة الإمام الجواد عليه السلام، ط1 ،1421هـ، قم.
من وحي الثورة الحسينية، هاشم معروف الحسيني، دار التعارف للمطبوعات، ط1، 1994م/1414هـ، بيروت ـ لبنان.
منية الخطيب، أحمد شعاع فاخر، منشورات الشـريف الرضي، ط1، 1421هـ، قم المقدّسة.
ميزان الحكمة، محمد الريشهري، دار الحديث، ط1، 1416هـ، قم.
[1] جامعة الكوفة/كلّية التربية المختلطة/قسم علوم القرآن.
.
[2] البقرة: آية 134
[3] محمد: آية10.
[4] العنكبوت: آية20.
[5] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص261.
[6] معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسيني، تاريخ النهضة الحسينية: ص5ـ6.
[7] شمس الدين، محمد مهدي، ثورة الحسين عليه السلام (ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية): ج1، ص220ـ221.
[8] الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص348.
[9] الآصفي، محمد مهدي، خلفيات ثورة الإمام الحسين عليه السلام: ص210.
[10] الزخرف: آية54.
[11] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج6، ص20.
[12] اُنظر: .http://sarallah.valiasr
[13] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص98.
[14] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج11، ص386.
[15] البقرة: آية165.
[16] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329ـ330
[17] المصدر السابق: ص340.
[18] المصدر السابق: ص335.
[19] البحراني، عبد العظيم المهتدي، من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام: ص248.
[20] منتدى درر العراق: .www.dorar-aliraq.net
[21] القبانجي، صدر الدين، الحركة الإصلاحية بين أصحاب الكساء والحسين سيّد الشهداء: ص128.
[22] مركز الإمام الخميني الثقافي، عاشوراء في فكر الإمام الخميني: ص5.
[23] الجلالي، محمد رضا، الإمام الحسين عليه السلام (سماته وسيرته): ص199.
[24] مقتطفات من خطب الإمام الخميني وآية الله الخامنئي (عِبَر من عاشوراء): ص1.
[25] اُنظر: المصدر السابق.
[26] اُنظر: الآصفي، محمد مهدي، في ظلال الطف: ص19: .http://alsarh.info/showthread.php
[27] اُنظر: الهنداوي، محمد، عوامل خلود الثورة الحسينية: ص275.
[28] مؤسّسة الإرشاد والتوجيه الديني، فن الخطابة الحسينية: ص119ـ120.
[29] اُنظر: الهنداوي، محمد، عوامل خلود الثورة الحسينية: ص275.
[30] الخوارزمي، الموفق، مقتل الحسين عليه السلام: ج2، ص77. واُنظر:المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين عليه السلام: ص352ـ353.
[31] اُنظر: الهنداوي، محمد، عوامل خلود الثور الحسينية: ص289ـ291.
[32] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص235.
[33] اُنظر: المقدسي، محمد باقر، دور المنبر الحسيني في التوعية الإسلامية: ص21ـ22.
[34] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج12، ص20.
[35] فاخر، محمد شعاع، منية الخطيب: ص14.
[36] شمس الدين، محمد مهدي، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي: ص307.
[37] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص52.
[38] آل عمران: آية110.
[39] النوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج15، ص165.
[40] الحج: آية 32.
[41] اُنظر: الهنداوي، محمد، مجالس عاشوراء: ص685ـ692.
[42] الروم: آية54.
[43] اُنظر: القائمي، علي، تربية الشباب بين المعرفة والتوجيه: ص18ـ22.
[44] اُنظر: دشبيلي، محمد، مصعب بن عمير.
[45] اُنظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص358.
[46] اُنظر: المصدر السابق: ج1، ص281ـ282.
[47] النجم: آية3ـ 4.
[48] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج21، ص410.
[49] اُنظر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج3، ص127.
[50] المصدر السابق: ج16، ص66.
[51] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1، ص214.
[52] اُنظر: .http://arabic.irib.ir/Monasebat/Moharam/Shabab.htm
[53] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص159.
[54] وأبوها هذا كان العرب يعتبرونه واحداً من شخصيتين عظيمتين، وهما: الوليد بن المغيرة الرجل الثري الذي كانت له زعامة مكّة، وآخر عروة بن مسعود الثقفي ، وكان العرب في جاهليتهم يعتقدون بأنّ النبوة يجب أن لا تتعدّى واحداً من هذين.
[55] اُنظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص86.
[56] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص74.
[57] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص166.
[58] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص106.
[59] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص166.
[60] اُنظر: المصدر السابق: ص 168.
[61] الهنداوي، محمد، مجالس عاشوراء: ص519.
[62] الحسني، هاشم معروف، من وحي الثورة الحسينية: ص59.
[63] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص152.
[64] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الإمام الحسين عليه السلام: ج2، ص13.
[65] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص161.
[66] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص16.
[67] المصدر السابق: ص27ـ28
[68] اُنظر: النقدي، جعفر، أصحاب الحسين عليه السلام يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل بلبن أُمه، موقع العتبة الحسينية المقدسة:
.http://imamhussain-lib.blogspot.com/2014/08/blog-post_26.html
[69] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص55.
[70] اُنظر: حسين الحاج حسن، الرسالية في الثورة الحسينية: ص97.
[71] اُنظر: الربيعي، جميل، الصراط المستقيم نهج السعادة والتقدم (موقع إلكتروني):
http://al-serat.com/content.php?article=942 رحمه اللهpart=maintable.
[72] اُنظر: المركز الإسلامي للتبليغ، إضاءات من فكر الإمام الخامنئي (الذين يبلّغون): ص101ـ102.
[73] اُنظر: مجلة (عفاف)، مجلةٌ شهريّةٌ ثقافيةٌ تصدر عن مؤسّسة المعصومين الأربعة عشر الإنسانية: ص11.
[74] اُنظر: شرفي، محمد رضا، الشباب وأزمة الهوية: ص25.
[75] فضل الله، محمد حسين، دنيا الشباب: ص5.
[76] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج20، ص267.
[77] اُنظر: اليعقوبي، محمد، قواعد بناء الشباب: ص10ـ11. وكذلك: القائمي، علي، تربية الشباب بين المعرفة والتوجيه: ص30ـ31.
[78] البغدادي، عبد اللطيف، الشفاء الروحي: ص209.
[79] الفرقان: آية 28ـ 29.
[80] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج68، ص278.
[81] المصدر السابق: ج71، ص191.
[82] المصدر السابق: ج74، ص84.
[83] المصدر السابق: ج1، ص224.
[84] الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج2، ص1402.
[85] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص106.
[86] المتقي الهندي، علي، كنز العمال: ج1، ص184.
[87] اُنظر: الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدّسة، مقالات للشباب: ص19ـ22.
[88] الحرّاني، ابن شعبة، تُحف العقول: ص124.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبیاء
http://warithanbia.com/?id=1310
لینک کوتاه
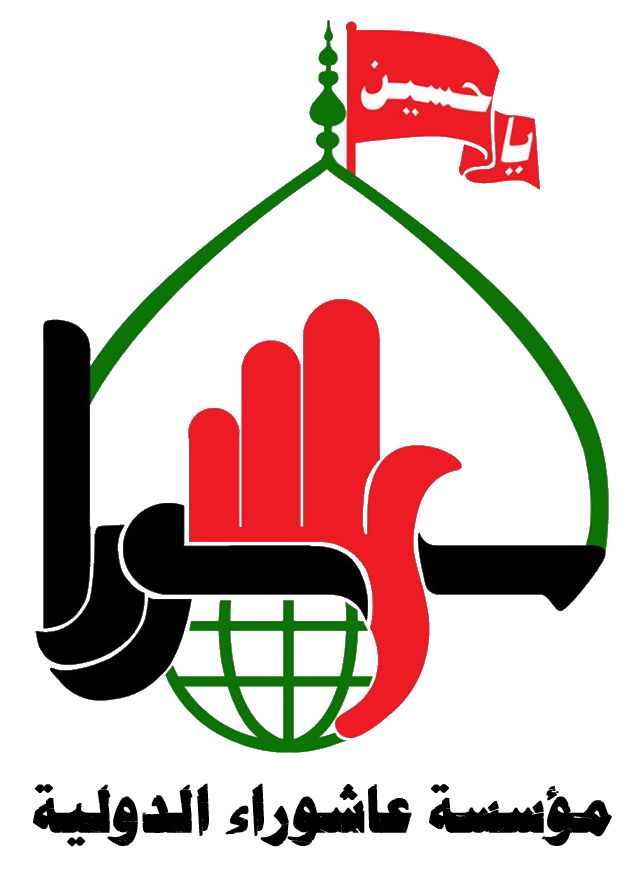
سوالات و نظرات