أثر الإمام الحسين (عليه السلام) في تفسير القرآن … عرض وتحليل
{ د. الشيخ حيدر خماس الساعدي – دكتوراه في الاستشراق والدراسات القرآنية، من العراق }
المقدّمة
يُمثِّل هذا المقال محاولة لترسيخ البحث في أحد أدوار التفسير في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وذلك من خلال التركيز على أثر الإمام الحسين(عليه السلام) في هذا الحقل الديني المعرفي، ذلك الأثر الذي تجلّى في الروايات التفسيرية الواردة عنه(عليه السلام) في هذا المجال، فيبدأ المقال بالتأكيد على أهمّية دراسة الروايات التفسيرية وبيان الأثر الذي يتركه اهتمام كهذا، ثمّ يبيّن الأساس المتّبع في التعامل مع الروايات التفسيرية، وينتهي إلى بيان دور سيّد الشهداء(عليه السلام) في تفسير كتاب الله العزيز بوصفه جزءاً من حلقة أدوار التفسير عند أهل البيت(عليهم السلام)، وذلك من خلال القيام بعرضٍ وتحليلٍ لمجموعة من الروايات الواردة عنه(عليه السلام) في مجال تفسير القرآن الكريم.
ما هو سبب اهتمامنا بالتفسير في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)؟
شهدت عملية تفسير النصّ القرآني المقدّس تطوّرات عديدة ساهمت في رسم صورة معاصرة خاصّة نعيشها أو نمارسها في بعض الأحيان، وقد ساهم في تكوين هذه الصورة بعض التوجّهات الفكرية والسياسية التي تسلطت على رقاب المسلمين في الحقب التاريخية؛ وبسبب ذلك فقد أصبحنا أمام واقع في تاريخ التفسير لا يضع للروايات التفسيرية لأهل البيت(عليهم السلام) حساباً في معادلاته، فلم تلقَ مسألة التفسير في ضوء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) العناية اللائقة بها؛ مع أننا نعتقد بأنّ الاهتمام بالتفسير في ضوء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) يلعب دوراً مهماً، وذلك نظراً لما يلي:
1ـ معرفة أدوار الأئمة(عليهم السلام) في حركة التفسير
على الرغم من اهتمام علمائنا وباحثينا بالدراسات القرآنية، لكنّ مسألة تاريخ التفسير وتطوّره في ضوء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) بقيت شاغرة، بمعنى أنّه لم يُلحظ أهل البيت(عليهم السلام) بصفتهم محور تطوّر حركة التفسير، وإنّما تمّ التعامل مع هذا الحقل المعرفي على أساس التقسيم الشائع، وهو التفسير في عصر النبي الأعظم(صلى الله عليه واله)، والتفسير في عصر الصحابة، والتفسير في عصر التابعين، في حين يمكننا أن نُغيّر بوصلة البحث من الأساس، ونتعامل مع حركة التفسير في ضوء سيرة الأئمّة(عليهم السلام) وأدوارهم، فنُقسِّم أدوار التفسير حسب عصر كلّ إمام أو أكثر تبعاً للظروف التي عاشوها والروايات التي صدرت منهم في هذا المجال. وهذا لا يعني تبعّضاً في التعامل مع روايات المعصومين(عليهم السلام)، ولا يخدش هذا النوع من التقسيم بأصل حجّية قولهم(عليهم السلام)، وإنّما يعود السبب في هذه التعدّدية إلى أنّ هناك تطوّرات شهدتها الفترات التي عاش فيها الأئمّة، وكانت تقتضي بطبيعة الحال تعاملاً خاصاً وتفسيراً يتناسب معها، أو استراتيجية جديدة على أقلّ تقدير.
ويمكن أن تُقسّم أدوار التفسير في ضوء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) في عصر المعصوم كالآتي:
أـ التفسير في عصر النبي الأعظم(صلى الله عليه واله).
ب ـ التفسير في عصر الإمام عليّ والإمامين الحسنين(عليهم السلام).
ج ـ التفسير في عصر الإمام السجاد(عليه السلام).
د ـ التفسير في عصر الإمامين الصادقين(عليهما السلام).
هـ التفسير من عصر الإمام الكاظم(عليه السلام) وحتّى نهاية الغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر(عجل الله فرجه الشريف).
فتكون المراحل التي مرّ بها التفسير في عصر حضور المعصوم خمس مراحل، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف كلّ مرحلة ونمط الروايات التفسيرية في التقسيم. ولا نقصد بهذا التقسيم الفصل الرياضي التامّ بين المراحل، بل هي أدوار تقريبية.
2ـ معرفة منهج أهل البيت(عليهم السلام) في فهم القرآن
من خلال التركيز في روايات أهل البيت(عليهم السلام) التفسيرية نستطيع التعرّف على آفاق جديدة في فهم آيات القرآن الكريم وسبر أغواره، فالروايات التفسيرية الواردة عنهم(عليهم السلام) ذات جانبين: جانب تعليمي، وجانب تلقيني؛ إذ يساعدنا الجانب الأوّل في اكتشاف أدواتٍ ومعرفة طرقٍ تساعدنا على فهمٍ أعمق وأشمل للنصّ القرآني المقدّس، ويساعدنا الجانب الثاني في أخذ أجوبة جاهزة عن بعض الأسئلة ذات الارتباط بمعاني الآيات القرآنية ومدلولاتها.
وربما تعامل واقعنا العلمي في الدراسات القرآنية ـ في كثير من الأحيان ـ مع الروايات التفسيرية على النحو الثاني؛ الأمر الذي أفقدنا التركيز على اكتشاف مناهج وآلياتِ تعاملٍ ناجعة مع كتاب الله العزيز؛ وهنا نستثني ثلاث محاولات في عالمنا الشيعي اتّخذت من الجانب الأوّل محوراً في عملها:
المحاولة الأُولى: محاولة العلّامة محمد حسين الطباطبائي(رحمه الله)
سار العلّامة الطباطبائي(رحمه الله) في تفسيره الموسوم بـ(الميزان في تفسير القرآن) على وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن ذاته، أي: استنطاق هذا الكتاب العظيم ليُفسِّر نفسه. وهذا المنهج قد استخلصه(رحمه الله) من الروايات الشريفة، فقد قال في هذا المجال: «أن نفسّر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبّر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخّص المصاديق ونتعرّفها بالخواصّ التي تُعطيها الآيات، كما قال تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)[1]… ثمّ إنّ النبي(صلى الله عليه واله) الذي علّمه [أي: الله تعالى] القرآن وجعله معلِّماً لكتابه، كما يقول تعالى: ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ…) [2]، ويقول: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)[3]… وعترته وأهل بيته الذين أقامهم النبي(صلى الله عليه واله) هذا المقام في الحديث المتّفق عليه بين الفريقين: إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض… كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما وصل إلينا من أخبارهم في التفسير»[4].
المحاولة الثانية: محاولة الشهيد محمد باقر الصدر(رحمه الله)
من أهمّ مرتكزات التفسير الموضوعي بالطريقة التي دشّنها الشهيد الصدر(رحمه الله)، هي مسألة استنطاق النصّ القرآني من خلال عرض أسئلة الإنسان المعاصر عليه، ومحاولة أخذ الأجوبة القرآنية وفق طريقة يُفصّلها لا مجال لذكرها، وفي مقام الاستناد يعرض الشهيد الصدر(رحمه الله) النصّ الروائي الذي استوحى منه تلك النكتة فيقول: «ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائماً بتيار التجربة البشرية؛ لأنّها تمثّل المعالم والاتّجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن موضوع من مواضيع الحياة؛ ومن هنا أيضاً كانت عملية التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له، وليست مجرّد استجابة سلبية، بل استجابة فعّالة وتوظيفاً هادفاً للنصّ القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. قال أمير المؤمنين(عليه السلام) وهو يتحدّث عن القرآن الكريم: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أُخبركم عنه، أَلا إنّ فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم ونظم ما بينكم.
التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن(عليه السلام) أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكريم، وطرحاً للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها»[5].
المحاولة الثالثة: محاولة الشيخ محمد هادي معرفة(رحمه الله)
ذهب الشيخ معرفة(رحمه الله) إلى تفسير خاصّ لمعنى بطون القرآن، وبيّن نظريته في هذا المجال مستنداً إلى بيان النبي(صلى الله عليه واله) وما جاء عنه من روايات في هذا المجال، وهنا ننقل نصّ كلامه(رحمه الله): «والمصطلح الآخر للتأويل هو تبيين المفهوم العامّ الخابئ وراء ستار اللفظ الذي يبدو خاصّاً حسب التنزيل، فإنّ غالبية الآيات النازلة حسب المناسبات تبدو خاصّة بها لا تتعدّاها ظاهرياً، فهذا يجعل من رسالة القرآن عقيمة مدى الأيام، غير أنّ النبي(صلى الله عليه واله) أكّد على ضرورة استخلاص الآية من ملابساتها، ولتكون ذات مفهوم عامّ وشامل لجميع الأقوام والأعصار»[6]. ثمّ يستمرّ الشيخ بذكر الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى.
ومن هنا؛ فإنّه مع ملاحظة المحاولات الثلاث المتقدّمة نفهم أنّ التدقيق في الروايات التفسيرية بحثاً عن مناهج وآليات لفهم القرآن تنفعنا كثيراً في هذا المجال، بل يُعدّ ذلك أمراً ضرورياً لا يمكن التخلّي عنه؛ وعلى هذا الأساس لا بدّ لنا من التدقيق في روايات كلّ زمن واستكشاف أدوار الأئمّة(عليهم السلام) في التفسير؛ كي نصل إلى منهج دقيق لتفسير القرآن الكريم.
3ـ اختلاف بيئة التفسير في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) عن غيرها
تختلف بيئة التفسير في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) عن بيئة التفسير عند بقيّة المذاهب الإسلامية الأُخرى، وحال التفسير في هذا المجال حال كثير من فروع العلوم الإسلامية الأُخرى: كالفقه، والأُصول، والحديث، والرجال. ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ علم التفسير هو الأكثر اختلافاً من بين هذه العلوم، فالروايات التفسيرية بقيت تُدوّن في أوقات متسلسلة من عصر النبي الأعظم(صلى الله عليه واله) وحتّى الغيبة الصغرى في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، ولم تخضع للقوانين الصارمة المتّبعة من قِبل القائلين بمنع الحديث. يضاف إلى ذلك ارتباط تلك الروايات بالمنبع الصافي المتّصل بالنبي الأكرم(صلى الله عليه واله)، ولم تتدخّل فيها الاجتهادات أو الأُمور الظنّية، وأكثر من ذلك اشتمالها على مستويات عديدة لمدلول النصّ القرآني المقدّس.
وعليه؛ فالاهتمام بالروايات التفسيرية الواردة عن أهل البيت(عليهم السلام)، هو بسبب كونها تحكي واقعاً خاصّاً في التفسير، ولها قيمة معرفية خاصّة؛ ومن هنا فلا بدّ لنا من الوقوف عندها وتحليلها وتمييز المعتبر من غيره بما يتناسب وروح القرآن الكريم.
منهج التعامل مع الروايات التفسيرية
هناك منهجان للتعامل مع الأحاديث في مختلف الأبواب الشرعية: أحدهما يأخذ القرائن وسيلة للاعتماد على الرواية الواردة عن المعصوم(عليه السلام)، والآخر يأخذ السند كمبدأ أساسي، وقد اختار الجيل السابق من علمائنا الأبرار الطريق الأوّل، في حين اعتمد الجيل اللاحق منهم على الطريق الثاني.
وأمّا القرائن التي اعتمد عليها القدماء من علمائنا في مقام تصحيح الحديث، فهي عبارة عن كون الحديث موافقاً لنصّ الكتاب، أو موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر، أو موافقاً لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة، أو كونه مأخوذاً من أصل أو مصنَّف معتبر أو كتاب عُرض على الإمام، إلى غير ذلك من القرائن الخارجية التي تُثبت صدور الحديث؛ هذا هو الصحيح عند القدماء. وأمّا الخبر الصحيح عند المتأخّرين فهو عبارة عن كون السند متّصلاً بالمعصوم(عليه السلام) من خلال نقل الإمامي العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات[7].
ويبدو أنّ حال اعتبار الروايات التفسيرية أقرب إلى منهج القدماء منه إلى منهج المتأخّرين، بل إنّ الحجّية في هذا الباب غير الحجّية المبحوث عنها في الأبحاث الفقهية، فالحجّية هنا ليست بمعنى المنجّزية والمعذّرية التي يبحث عنها الفقيه، فالمفسِّر لا يستند إلى الرواية لتنجّز فهمه للنص القرآني المقدّس أو تعذّره؛ لأنّه أمام نص بلسان عربي مبين يحتاج فيه إلى قوّة كشف وإزالة للغموض الذي يكتنف فهمه للنصّ، فقوّة الرواية بمقدار كشفها وتوضيحها للنصّ بما ينسجم وروحه. فإذا جاز لنا استخدام الحجّية هنا فهي بمعنى قوّة الكشف عن معاني القرآن واكتشاف كنوزه.
ولا بدّ للرواية التفسيرية من عدم مخالفة روح القرآن الكريم ومحتواه، وإذا خرجت عن هذا الإطار فتدخل في إطار معارضتها لكتاب الله العزيز، وقد ثبت في محلّه طرح هذا النوع من الروايات.
دور الإمام الحسين(عليه السلام) في التفسير
تنتمي الروايات الواردة عن الإمام الحسين(عليه السلام) إلى المرحلة الثانية، وفقاً للتقسيم الذي قدّمناه لمراحل التفسير، ومن الطبيعي أن نجد روايات متقاربة في النصّ والمضمون عن الأئمّة(عليهم السلام) في هذه المدّة، وهذا لا يمنع من نسبتها إلى إمام معيّن
ما دامت قد رويت في مصادر مهمّة باسمه. وما نستخلصه من بعض الروايات التي سنوردها أدناه عنه(عليه السلام) يُعدّ جزءاً من دور أهل البيت(عليهم السلام) في هذه الحقبة.
1ـ توضيح أبعاد فهم القرآن
جاء عن سيّد الشهداء الحسين بن عليّ(عليهما السلام): «كتاب الله(عز وجل) على أربعة أشياء: على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواصّ، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء»[8]. وروي هذا النصّ عن النبيّ الأعظم(صلى الله عليه واله) والإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) أيضاً.
يضع الإمام(عليه السلام) في هذه الرواية مراتب لفهم كتاب الله العزيز، وأنّ كلّ فرد ينهل منه حسب درجته، والظاهر أنّ المقصود من تفاوت الدرجات هو قرب الإنسان إلى الله تعالى وعلو درجته في مقام السير إليه.
وفي نصّ آخر يُبيّن الإمام(عليه السلام) ثنائية فهم القرآن الكريم، وأنّ الفهم الدقيق لا يقتصر على الفهم الظاهري للنصّ القرآني، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى لم يضع(عليه السلام) التعبير القرآني بجانب اللفظ على حساب قوّة المعنى، ولا بجانب المعنى على حساب قوّة اللفظ، فالتعابير القرآنية متناسقة منتظمة بشكل دقيق جدّاً، وفي الوقت نفسه تحمل معاني عميقة ودلالات متعدّدة، تُماشي العصور المختلفة؛ وهذا ما يمكن فهمه من قوله(عليه السلام): «القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق»[9].
2ـ بيان الطريق الصحيح في التفسير
بما أنّ القرآن الكريم هو المحور الأساسي في الإسلام، فلا بدّ أن يرتكز فهمه على أُسس صحيحة، وأن يستند إلى أركان وثيقة تمنع وقوع الأجيال المسلمة في متاهة الانحراف والتذبذب. وهنا يأتي دور الإمام ليُبيّن الخطوط العامّة للتعامل مع ثقل الله الأكبر، قال وهب بن وهب القرشي: «وحدّثني الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه(عليهم السلام): أنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن عليّ(عليهما السلام)، يسألونه عن الصمد، فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعدُ، فلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه، ولا تتكلّموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدّي رسول الله(صلى الله عليه واله) يقول: مَن قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار»[10].
وهنا يوضِّح الإمام(عليه السلام) أنّ تفسير القرآن الكريم ليس صنعة العاجز، وليس مرتعاً لحديث مَن لا أهلية له في هذا المجال، فلا بدّ أن يكون المتصدّي لهذا الأمر قد توفّرت فيه شروط المفسِّر، وعلى رأسها وأساسها أن يكون بيانه للقرآن على أساس البيان العلمي والدليل والبرهان؛ ومن هنا بيّن(عليه السلام) في كلام آخر له أنّ تفسيرهم(عليهم السلام) للقرآن لا يعتمد على الظنّ وإنّما يستند إلى الحقيقة والدليل، ففي خطبة للإمام الحسين(عليه السلام)، قال فيها: «نحن… أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله(صلى الله عليه واله) ثاني كتاب الله، فيه تفصيل لكلّ شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعوّل علينا في تفسيره، لا نتظنّى تأويله، بل نتّبع حقائقه»[11].
وبناءً على ما تقدّم؛ فعلى المفسِّر ـ الذي يبتغي الوصول إلى حقائق القرآن ـ استبعاد الطرق الظنّية والأساليب الاستحسانية: كالقياس، والاستحسان، وقول غير المعصوم، فلا يمكن التعامل مع هذه الطرق على أنّها طرق علمية مؤدّية إلى نتائج مثمرة في التفسير.
3ـ تفسير الآيات وتوضيحها
تحتوي روايات أهل البيت(عليهم السلام) التفسيرية على جانبين مهمّين، جانب توضيح وشرح مفردات ونصوص قرآنية، والجانب الآخر هو الجانب التطبيقي والتوسعة الدلالية. ويجب الأخذ بنظر الاعتبار ظروف تلك الروايات والزاوية التي يُفسّر من خلالها النصّ القرآني.
أـ التفسير التوضيحي للمفردات
بيّن الإمام الحسين(عليه السلام) في بعض الروايات التفسيرية الواردة عنه معاني بعض المفردات القرآنية، وهذا ما نلاحظه في الرواية الآتية: «قال الباقر(عليه السلام): حدّثني أبي زين العابدين، عن أبيه الحسين بن عليّ(عليهم السلام) أنّه قال: الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي قد انتهى سؤدده، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي لا ينام، والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال»[12].
ب ـ التفسير التطبيقي للقرآن الكريم
يلاحظ في روايات متعدّدة واردة عن الإمام الحسين(عليه السلام) في التفسير تفسيره للآيات من خلال المثال، وهذه الظاهرة لا تقتصر على روايات الإمام الحسين(عليه السلام) التفسيرية، بل نشاهدها أيضاً في روايات سائر المعصومين(عليهم السلام)، كما أنّها لا تقتصر على روايات أهل البيت(عليهم السلام)، بل منتشرة في روايات المسلمين عامّة.
ومن تلك الروايات الواردة عن الإمام الحسين(عليه السلام) في هذا المجال: «قلت للحسين بن عليّ بن أبي طالب(عليهما السلام): يا أبا عبد الله، حدّثني عن قول الله(عز وجل): ( هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ)[13]. قال: نحن وبنو أُميّة اختصمنا في الله(عز وجل)، قلنا: صدق الله، وقالوا: كذب الله. فنحن وإيّاهم الخصمان يوم القيامة»[14].
وهذا النوع من الانطباق يمكن أن تكون له مصاديق أُخرى، ويمكن أن تتجدّد مصاديقه في كلّ عصر، فالصراع في هذه الأرض بين الصالحين والمفسدين لا ينتهي إلى يوم الدين، وهناك مَن يرفع راية الصلاح والخير، وستبقى هذه الراية خفّاقة ما دام هناك صالحون، وقد رفعها الإمام الحسين(عليه السلام) في عصره، بصفته الإمام وصاحب الحقّ الشرعي والقانوني، غير أنّ بني أُميّة حاربوها فكانوا مثال الكافر بالله تعالى.
وتمارس هنا عملية التوسعة الدلالية للنصوص القرآنية، ولكن هذه التوسعة ليست اعتباطية، بل لا بدّ أن يتمّ ذلك في ضوء الأُطر التفسيرية ودلالات النصّ القرآني؛ وعلى هذا الأساس فبإمكاننا استخراج قواعد عامّة في مجالات مختلفة من حياتنا المعاصرة.
ويمثّل هذا النوع من التفسير ديناميكية القرآن في الحياة البشرية، ويجعل المفاهيم القرآنية أكثر تطبيقاً وعملاً في المجتمع، وتحتاج هذه المرحلة من التعامل مع القرآن الكريم إلى حذاقة ودقّة وابتعاد عن الآراء الشخصية؛ كي لا يقع المفسِّر في متاهات التفسير بالرأي.
وقد شهدت واقعة عاشوراء حركة واضحة في مقام تفسير القرآن الكريم من خلال تطبيق المفاهيم القرآنية على مصاديقها، وهذا ما نلمسه من خلال الشاهدين الآتيين:
الشاهد الأوّل: ما ذكره الطبري في حادثة مقتل مسلم بن عوسجة فقد قال: «ثمّ إنّ عمرو بن الحجّاج حمل على الحسين في ميمنة عمر بن سعد من نحو الفرات، فاضربوا ساعةً؛ فصرع مسلم بن عوسجة الأسدي أوّل أصحاب الحسين، ثمّ انصرف عمرو بن الحجّاج وأصحابه، وارتفعت الغبرة، فإذا هم به صريع، فمشى إليه الحسين فإذا به رمق فقال: رحمك ربُّك يا مسلم بن عوسجة، (منهم مَن قضى نحبه ومنهم مَن ينتظر وما بدّلوا تبديلاً)[15]»[16].
الشاهد الثاني: ما نقله العلّامة المجلسي في كتابه (بحار الأنوار): «ثمّ أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد يقال له: محمد بن أشعث بن قيس الكندي، فقال: يا حسين ابن فاطمة، أيّة حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلا الحسين هذه الآية: ( إِنَّ الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )[17].
ثم قال: والله إنّ محمداً لمن آل إبراهيم، وإنّ العترة الهادية لمن آل محمد»[18].
هذا، ويوجد نوع آخر من التطبيق الذي تكون مصاديقه منحصرة غير قابلة للتكرار والتوسعة، وهو ما نراه في الرواية الآتية:
«عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه(عليهم السلام) قال: كان رسول الله(صلى الله عليه واله) في بيت أُمّ سلمة، فأُتي بحريرة، فدعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام) فأكلوا منها، ثمّ جلّل عليهم كساءً خيبرياً، ثمّ قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا )[19]، فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: أنتِ إلى خير»[20].
ففي هذه الرواية يبيّن لنا الإمام(عليه السلام) انحصار مفهوم أهل البيت بهؤلاء الأفراد، ولا يمكننا ـ من ناحية تفسيرية ـ إشراك غير هؤلاء في هذا المفهوم.
4 ـ التفسير العملي
نقصد بالتفسير العملي استخدام الآيات القرآنية في مواقف عملية معيّنة تكون تلك المواقف مبيّنة لمعاني النصّ ودلالاته، فالواقع الذي يصدر فيه النصّ يكون كالكاشف عن المراد. وبعبارة أُخرى: تُذكر الآيات القرآنية في مواضع محدّدة ليس من أجل تطبيقها على أمثلة أو مصاديق معيّنة كما في الحالة السابقة، وإنّما تُذكر بنحو يفسّرها الواقع العملي الذي تصدر فيه.
وهذا النوع من التفسير لا يُتقنه إلّا مَن عاش حلاوة القرآن ودراية معانيه، ولا يخرج من خطورته إلّا مَن عاشت المفاهيم القرآنية في حياته وأدرك محتواها. ومن هنا يعلِّمنا الإمام الحسين(عليه السلام) طريقاً عملياً لتفسير القرآن؛ كي نعيش أُفقاً عملياً في الحياة البشرية.
ويمكننا أن نلتمس واحداً من الأمثلة كشاهد لهذا النوع من التفسير في كلمات الإمام الحسين(عليه السلام)، فقد جاء في كتاب (تاريخ الأُمم والملوك): «فلمّا دنا منه القوم عاد[21] براحلته فركبها، ثمّ نادى بأعلى صوته ـ بصوت عالٍ ـ دعاءً يسمع جلّ الناس: أيّها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتّى أعظكم بما لحقّ لكم عليّ، وحتّى أعتذر إليكم من مَقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدّقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم عليّ سبيل، وإن لم تقبلوا منّى العذر ولم تُعطوا النصف من أنفسكم (فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ )[22]، ( إِنَّ وَلِيِّـيَ الله الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)[23]»[24].
فهنا جمع الإمام(عليه السلام) بين مقطعين من سورتين مختلفتين، يتعلّق المقطع الأوّل منهما بسياق خطاب نبي الله نوح(عليه السلام) مع قومه، إذ قال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ)[25]. وهنا يريد الإمام(عليه السلام) أن يقول لهم بلسان القرآن: من جانبي أنا متوكّل على الله تعالى، فلا أخاف غيره رغم كثرة عدّتكم وعددكم، وأوضحت لكم ما الذي جاء بي إلى هذه الأرض، بقيَ الجانب الآخر من القضية وهو قراركم، فكّروا بالأمر وقرّروا ما ترونه.
والنصّ الآخر الذي جاء في كلام الإمام(عليه السلام) هو في الواقع جاء في سياق آيات على لسان النبيّ الأعظم(صلى الله عليه واله)، بيّن فيه استغناءه عن الخلق في حديثه مع المشركين، فالإمام يُبيّن هنا أنّ الله تعالى هو ولي وناصر الصالحين، كما أنّه تعالى هو المتكفّل بأُمورهم؛ ومن هنا فإنّ وضع الإمام(عليه السلام) الآيات في سياق مشابه لسياقها الذي نزلت فيه هو من أجل إفهام المتلقّي والتأثير فيه، فالحرب في كربلاء حرب بين الإيمان والشرك كما كان سياق نزول الآيات، غاية الأمر هنا حرب بين الإيمان المتمثّل بالإمام القائم مقام النبيّ(صلى الله عليه واله) من جهة، وبين الذين قاموا بوجهه من جهة أُخرى، وأمّا هناك فقد كانت حرب بين النبي(صلى الله عليه واله) والمشركين.
وهذا النوع من إلقاء النصّ القرآني على المستمع فيه جوانب فنّية وبلاغية ووقع خاصّ عليه، إضافة إلى قناعته بالتفسير الناتج من هذا النصّ بسبب الظروف التي كان الإمام(عليه السلام) يعيشها أثناء تلاوته؛ وعليه فما علينا إلّا فهم ظروف صدور الخطاب المتضمّن لآيات كتاب الله العزيز.
ويمكن أن يُشكِّل هذا النوع من التفسير مدخلاً مهمّاً لنشر المعارف القرآنية، وتوضيح دلالات النصّ القرآني في العصر الحاضر.
وربما تُعدّ مسألة الاهتمام بتلاوة كتاب الله العزيز والعلاقة الدائمة به شرطاً مهمّاً للمفسّر الذي يريد أن يسلك هذا الطريق، ولعلّ التأكيدات الواردة عن الإمام الحسين(عليه السلام) في مجال تلاوة القرآن الكريم والتأمّل في آياته يصبّ في هذا السياق، وفيما يلي نقرأ بعضها:
ففي كتاب الكافي عن بِشر بن غالب الأسدي عن الحسين بن عليّ(عليهما السلام)، قال: «مَن قرأ آية من كتاب الله(عز وجل) في صلاته قائماً يُكتب له بكلّ حرف مائة حسنة، فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكلّ حرف حسنة، وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يُصبح، وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتّى يُمسي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خيراً له ممّا بين السماء إلى الأرض. قلت: هذا لـمَن قرأ القرآن، فمَن لم يقرأ؟ قال: يا أخا بني أسد، إنّ الله جواد ماجد كريم، إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك»[26].
ومن الواضح أنّ تلاوة كتاب الله العزيز طريق إلى التأمّل في آفاقه، ونافذة للعمل به في الحياة، وبداية لمسيرة العشق الإلهي التي لا يقف أمامها شيء. وقد جسّد الإمام الحسين(عليه السلام) ذلك الاهتمام في سيرته العملية، وظهر ذلك بوضوح في أكثر من مورد، ففي طريقه(عليه السلام) إلى كربلاء لم يقطع سفرُه علاقتَه مع القرآن الكريم، بل وكان في أشدّ الظروف يُردّد الآيات القرآنية، وقضى ليلته هو وأصحابه بين تلاوة آيات الكتاب العزيز والتأمّل فيها والعبادة، وهذا ما نجده في النصّين الآتيين:
النصّ الأوّل: «حدّثني مَن شافه الحسين[(عليه السلام)]، قال: رأيت أخبية مضروبة بفلاة من الأرض، فقلت: لـمَن هذه؟ قالوا: هذه لحسين. قال: فأتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خدّيه ولحيته»[27].
النصّ الثاني: «فجاء العباس إلى الحسين(عليه السلام) وأخبره بما قال القوم، فقال: ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غد، وتدفعهم عنّا العشية لعلّنا نصلّي لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنّي كنت قد أُحبّ الصلاة له، وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء، والاستغفار»[28].
وهذه السيرة القولية والعملية للإمام(عليه السلام) تبيّن لنا أهمية تلاوة القرآن والعلاقة الدائمة معه؛ كي يستطيع المرء الولوج إلى آفاق الكتاب العزيز والتدبّر في معانيه.
5ـ المحيط التاريخي للنصّ القرآني
يلعب الإلمام بالظروف التاريخية للنصّ القرآني المقدّس دوراً مهمّاً في فهمه والوقوف على معانيه، وفي هذا المضمار تقدّم لنا الروايات الواردة عن أهل البيت(عليهم السلام) عموماً والإمام الحسين(عليه السلام) خصوصاً في هذا المجال مساعدة كبيرة للوقوف على هذا الجانب، والروايات الواردة في هذا المجال تارة تبيّن ظرف نزول الآية أو السورة، وأُخرى تبيّن الفضاء التاريخي الذي تتحدّث فيه الآية المباركة، فالنحو الأوّل نسمّيه سبب النزول، والثاني شأن النزول، والمحور في الحالة الأُولى فيمَن نزلت الآية أو السورة، وفي الحالة الثانية بشأن مَن تتحدّث الآية أو السورة.
ونستخلص من ذلك تسلسلاً واضحاً لتاريخ نزول الآيات والسور، وفهماً دقيقاً للأحداث التاريخية، وتصوّراً واضحاً عن علاقة القرآن الكريم مع الكتب والشرائع التي سبقته، والانتماءات الدينية التي عاصرته.
ومن هنا؛ فنحن بحاجة ماسّة إلى فهم تاريخي في مجال الدراسات القرآنية، وهو ما أولته روايات أهل البيت(عليهم السلام) أهمّية خاصّة. وهنا نحتاج إلى عمل منهجي مهمّ، تُمحّص فيه تلك الروايات على أساس علمي رصين.
ويمكننا رصد بعض جوانب هذا الموضوع من خلال الروايات التفسيرية الآتية الواردة عن الإمام الحسين(عليه السلام).
الرواية الأُولى: عن زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه(عليهم السلام)، قال: «كان النبي(صلى الله عليه واله) يأتي كلّ يوم باب فاطمة عند صلاة الفجر، فيقول: الصلاة، يا أهل بيت النبوة، (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[29] تسعة أشهر بعدما نزلت ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)[30]»[31].
فهذه الرواية تتحدّث عن ثقافة تاريخية كان لها دور كبير في مقام توضيح النصّ القرآني المقدّس، فمن خلال هذه السيرة العملية لنبي الرحمة(صلى الله عليه واله) فهمنا المعنى الحقيقي لـ(أهل البيت)، وأنّهم عبارة عن: النبيّ الأعظم، وأمير المؤمنين، والزهراء، والحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين).
الرواية الثانية: عن الحسين بن عليّ(عليهما السلام) «في قول الله(عز وجل): (لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)[32]، قال: إنّ القرابة التي أمر الله بصلتها، وعظّم حقّها، وجعل الخير فيها، قرابتنا أهل البيت، الذين أوجب حقّنا على كلّ مسلم»[33].
ويمكن تصنيف هذا البيان ضمن النوع الثاني (شأن النزول)، فالإمام(عليه السلام) يبيّن هنا المورد الذي تتحدّث عنه الآية المباركة، وهو أمر المسلمين بمودّة أهل البيت(عليهم السلام)، وفي الوقت نفسه يمكن تصنيفه ضمن النوع الأوّل (بيان سبب النزول)، ولا مانع من أن يقوم المعصوم(عليه السلام) في رواية واحدة ببيان سبب النزول وشأنه.
6ـ الترابط الدلالي والتناسق في النصّ القرآني
واحدة من الأدوار المهمّة في سيرة أهل البيت(عليهم السلام) في مقام بيان المراد الإلهي من القرآن الكريم هي مسألة التأكيد على الترابط النصّي والدلالي بين الآيات القرآنية، بمعنى انسجام النصّ القرآني على مستوى التعبير والمعاني، فمعانيه ليست متعارضة فيما بينها وحسب، بل يشهد بعضها على بعض، ويفسِّر بعضها بعضاً، وهكذا تعابيره، فإنّها مترابطة وذات سبك خاصّ؛ وهذا معناه ظهور كتاب الله العزيز بكتلة واحدة من الألفاظ والمعاني؛ وبذلك يكون النصّ القرآني محوراً أساسياً في فهم المراد من آيات وسور هذا الكتاب العظيم أوّلاً، وفي فهم معارف الإسلام ومنظومة الفكر الإسلامي برمّتها ثانياً.
ويمكننا مشاهدة ذلك بوضوح في بعض الروايات التفسيرية الواردة عن الإمام الحسين(عليه السلام)، فعلى مستوى الترابط والاتّساق في التعبير ورد عن سيّد الشهداء(عليه السلام) في سورة التوحيد أنّه قال: «… إنّ الله سبحانه قد فسّر الصمد، فقال: ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ )[34]، ثمّ فسّره، فقال: ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ )[35]»[36]، فما بيّنه(عليه السلام) في هذه الرواية هو الجانب الاتّساقي ونظم النص، فبعد بيانه(عليه السلام) لهذا الجانب الفنّي في النصّ القرآني المشار إليه، قام(عليه السلام) في الرواية أعلاه ببيان المفردات التي حوتها السورة وتوضيحها بأُسلوب فني.
وفي جانب الترابط الدلالي نلاحظ ما ورد عنه(عليه السلام): «في قوله تعالى: ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ). قال [(عليه السلام)]: الشاهد جدّي رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، والمشهود يوم القيامة، ثمّ تلا هذه الآية: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)[37]، وتلا (يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ )[38]»[39]. وهذا يكشف لنا عن الوحدة البيانية في التفسير في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام).
الخاتمة
من خلال ما تقدّم يمكننا تسجيل النقاط الآتية:
أوّلاً: تحتوي روايات أهل البيت(عليهم السلام) التفسيرية على مداخل مهمّة في عملية فهم النصّ القرآني المقدّس.
ثانياً: لحركة التفسير في ضوء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) تاريخ خاصّ ومراحل تطوّر تختلف عمّا هو متداول في الدراسات القرآنية.
ثالثاً: ما ورد عن الإمام الحسين(عليه السلام) من روايات تفسيرية يرتبط بالمرحلة الثانية من تاريخ حركة التفسير، وهي بدورها تُشكِّل جزءاً من دور أهل البيت(عليهم السلام) في عملية تفسير القرآن الكريم.
رابعاً: تؤكِّد هذه المرحلة التاريخية على تعدّد مراتب فهم القرآن وعدم انحصاره بمستوى معيّن، كما أنّها تعتبر أنّ عملية فهم القرآن تكون صحيحة إذا ارتكزت على أساس علمي، فيظهر من رواياتها ضرورة توفّر الثقافة التاريخية في فهم كتاب الله العزيز، والأخذ بنظر الاعتبار ترابط النصوص القرآنية على المستوى اللفظي والدلالي.
________________________________________
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، مؤسّسة والوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية المصحّحة، 1403ه/1983م.
2. البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت774هـ)، حقّقه ودقّق أُصوله وعلّق حواشيه: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1408هـ/١٩٨٨م.
3. تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، راجعه وصحّحه وضبطه: نخبة من العلماء، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 1403هـ/1983م.
4. التفسير الأثري الجامع، محمد هادي معرفة (ت1427هـ)، مؤسّسة التمهيد، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1429هـ/2008م.
5. التوحيد، محمد بن عليّ بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تصحيح وتعليق: السيّد هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قمّ المقدّسة.
6. الخصال، محمد بن عليّ بن بابويه الصدوق (ت381هـ)، صحّحه وعلّق عليه: عليّ أكبر الغفّاري، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، قمّ المشرّفة، الطبعة الأُولى، 1403هـ.
7. دروس موجزة في علمي الرجال والدراية، جعفر السبحاني، المركز العالمي للدراسات الإسلامية.
8. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت329هـ)، صحّحه وعلّق عليه: عليّ أكبر الغفّاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الرابعة، 1406هـ/1986م.
9. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عليّ بن أبي بكر الهيثمي (ت708هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1408هـ/1988م.
10. المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر (ت1400هـ)، المؤتمر العالمي للشهيد الصدر(قدس سره).
11. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي (ت1402هـ)، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قمّ المقدّسة.
12. وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت1104هـ)، مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، قم المشرّفة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1414ه.
13. ينابيع المودّة لذوي القربي، سليمان بن إبراهيم القندوزي (ت1294هـ)، تحقيق: السيّد علي جمال أشرف الحسيني، دار الأُسوة للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، 1416هـ.
________________________________________
[1] النحل: آية89.
[2] الشعراء: آية193ـ194.
[3] النحل: آية44.
[4] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص11ـ12.
[5] الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية: ص11.
[6] معرفة، محمد هادي، التفسير الأثري الجامع: ج1، ص30.
[7] اُنظر: السبحاني، جعفر، دروس موجزة في علمي الرجال والدراية: ص68.
[8] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج89، ص20.
[9] المصدر السابق.
[10] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91.
[11] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج27، ص195.
[12] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص90.
[13] الحج: آية19.
[14] الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص43.
[15] هذا المقطع إشارة إلى قوله تعالى: (فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) (الأحزاب: آية23).
[16] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص331.
[17] آل عمران: آية33ـ34.
[18] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص 317.
[19] الأحزاب: آية33.
[20] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج25، ص 213.
[21] ورد في بقية المصادر: دعا براحلته.
[22] يونس: آية71.
[23] الأعراف: آية 196.
[24] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص322.
[25] يونس: آية٧١.
[26] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص611.
[27] الدمشقي، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص183.
[28] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص392.واُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص316ـ317.
[29] الأحزاب: آية33.
[30] طه: آية132.
[31] القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج2، ص59.
[32] الشورى: آية23.
[33] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج23، ص25.
[34] الإخلاص: آية1ـ2.
[35] الإخلاص: آية3ـ4.
[36] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91.
[37] الأحزاب: آية45.
[38] هود: آية103.
[39] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج٧، ص١٣٥ـ 136.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة وارث الأنبياء
https://warithanbia.com/?id=2752
لینک کوتاه
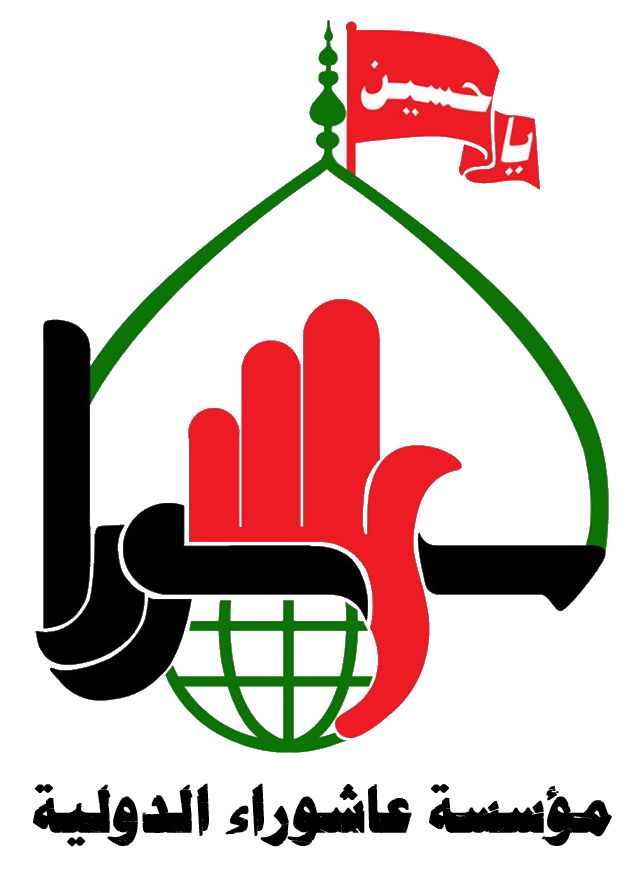
سوالات و نظرات