أساليب الإقناع في خطبة السيدة زينب (عليها السلام) في الشام ….دراسة تداولية
{ أ. م. د. سناء هادي عباس/الجامعة المستنصرية/كلّية التربية الأساسية/العراق }
توطئة
يعدّ التداول ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية في وقت واحد، والقاسم المشترك بين التداول والدلالات هو مضمون النصّ، فالتداولية تدرس كلّ شيء إنساني في العملية التواصلية، سواء أكان نفسياً، أو بايلوجياً، أو اجتماعياً، كما عبّر عنه (فيرشون)[1]، فالنصّ في مقتضـى الحال فعل منزاح عن اللسان، وذلك يحيل إلى التأويل بوصفه حركة فعلية لسانية.
وتعتمد السيّدة زينب(عليها السلام) في خطابها على الحجاج اللغوي بوصفه ظاهرة لُغوية، نجدها في كتابات (ديكرو) الذي يعوّل على وجودها في كلّ قول وخطاب، فهو من أبرز اللسانيين الذين نجد عندهم الطرح اللساني للحجاج داخل اللغة، فالقيمة هي أن تشتمل الجملة على عناصر صوتية وبلاغية من تعابير وصيغ، فضلاً عن محتواها الإخباري، إذ تعطي توجيهاً حجاجياً للقول[2] حسب حاله.
وقد حققت خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) في الشام قيماً اجتماعية وثورية كبيرة في الدفاع عن المظلومين، والصبر، والسمو الإنساني على مصاعب الحياة، فهي تُقدّم الأُسس والمنطلقات الإسلامية في تربية الأجيال، وتعليم اللباقة في قول الحقّ، والجلادة والوقوف بوجه الظالم من غير خوف من سطوته وطغيانه، والاتّكال على الله والثقة به، والإباء والرفعة في مواطن ظاهرها الذلة والخضوع، والرؤية الإيجابية لما يبدو سلبياً، وتوخّي نقاط القوّة والنصـر فيما يظهر أنّه خسارة، وغيرها من الأُمور.
فكانت خطاباً حوارياً طرفاه (مرسِل ومُتلَقٍّ)، مع وجود مقصدية التأثير والإقناع، وقد احتوى جوّ الخطبة على الرفض والتمرّد، وقد تآلفت صياغتها في حركة متناسقة يؤازر بعضها بعضاً، لتكتمل الصورة الإقناعية المؤثّرة في الخطبة برمّتها، مع وجود للتصعيد في الخطاب، وهناك سلّم في التدرّج للتأثير.
(إنّ التداولية تنطلق من هدف أساسي، هو استثمار الممكن والمتاح من الآليات لتوصيل رسالة لُغوية معيّنة، وجعل المعنيّ بها يعيها، ويتحرّك في إطار إنجازها، ولعل هذا ما يدفع بعض التداوليين المعاصرين إلى تعريف البلاغة بأنّها: فنّ الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ؛ لأنّ البلاغة في نظر هؤلاء نظام له بنية من الأشكال التصويرية واللغوية، يصلح لإحداث التأثير الذي ينشده المتكلّم في موقف محدّد)[3]، ومن ثمّ هي ممارسة اتّصال بين المتكلِّم وهو السيّدة زينب(عليها السلام)، والسامع المُتمثِّل في المسلمين في ذلك العصر.
أساليب الإقناع
فتحت الدراسات اللسانية الحديثة الأُفق واسعاً أمام عمليات الاتّصال الإنساني والخطاب، أو الحوار الفكري بين المتكلّم والمخاطب عِبرَ الرسالة الإبداعية، ومنها النصّ القرآني الإعجازي، إذ تستلزم دراسة سورة لقمان مثلاً، مسوّغات شخصية تتبع طبيعة النص المقدّس وإعجازه البلاغي، فهو الهوية العميقة للإنسان المؤمن.
وأمّا المسوّغ الموضوعي، فهو يهتمّ بخصوصية السورة القرآنية، وتجلية معالمها التداولية الوعظية والإرشادية والحثِّية، من خلال التحليل البلاغي الجديد للسورة على وفق معطيات الدرس اللساني الحديث، ووصف الأيقونات التي يتّسم بها النصّ وتحليلها، وإبراز الخصائص والسمات التي يطرحها البحث المعاصر.
وقد حظيت خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) في الشام بأبعاد تداولية ووظائفية مهمة؛ لقدرتها على الاستمالة والتأثير والإقناع، مما يمكن رصده باستعمال ما تنجزه اللغة من أفعال كلامية في إحداث التأثير الذهني أو السلوكي في متلقّي الخطاب، ومن ثمّ تحقيق الإنجاز.
وكان لتحديد العناصر السياقية التي تشتمل على: المتكلّم، والمخاطب، والزمان، والمكان، ونوع الرسالة، دور كبير؛ إذ إنّ للسياق أثره في عملية التخاطب، لارتباطه بالتأثير في المواقف المستلزمة من التعديل أو التبديل.
ويعدّ الحجاج رافداً من روافد البحث التداولي، فنصّ الخطبة المباركة نصّ حجاجي؛ لكونه يطرح تراكيب وملفوظات لها الأثر الدلالي في الإقناع والتأثير، تتعلّق بالحياة الاجتماعية، ورسم الطرائق المؤدّية إلى القبول والتسليم عن طريق الأفعال الكلامية، أو التصوير أو الحجاج، فكان الدرس التداولي أنجع الإجراءات التي تكشف وتُبرز مقاصد المتكلّم وأثرها في متلقّي الخطاب.
الاستهلال: وهو ابتداء الخطاب بالوعظ والإرشاد والتحذير، واستدراج المعاندين أو الخصوم، حيث يضع الخطيب النصّ وموضوعه أمام المُتلقّي؛ ليزيل عنه الغموض، فيتابع باهتمام، وفائدته أن يدلّ على الغرض الذي يستهدفه الخطاب، أو استمالة المُتلقِّي واستدراجه لقبول الخطاب والموضوع باهتمام.
فالخطبة الزينبية تُقبل على المُتلقِّي بموضوع إثبات الحقّ، وحججها آيات الله سبحانه وتعالى، بتفخيم وتعظيم للآيات، وتشويق إليها، من خلال حثّ المُتلقِّي على إنجاز فعل المواصلة للإقناع بقوّة الدليل وظهور الحجّة، ومن ثمّ كان الاهتمام بالافتتاح؛ لأنّه أوّل ما يقرع السمع، وبه يستدلّ على ما في الرسالة، فيدفع المُتلقِّي إلى التنبّه والإصغاء، فالعتبة النصّية أوّل ما يلتقي فيها قارئ النص بصاحبه، والبداية هي المُحرِّك الفاعل الأوّل لعجلة النص[4].
فالهيكلية التي جاءت بها الخطبة كانت متصاعدة، متمردّة، متسائلة، ومنكرة؛ لأنّ النفوس تنشدّ إلى هذه البدايات، وللاستهلال أثره في بناء النصّ، بل هو من مكوّنات الخطاب الإقناعي؛ لأنّه لحظة الانتباه والاستمالة، فبدأت بتناصّ قرآنيّ يدلّل بالحجج الناصعة (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)[5].
العرض: وهو الجزء المنتصف بين المقدّمة في الخطبة وخاتمتها، فهناك وحدة موضوعية ونفسية تتناسب مع أجزاء الموضوع الواحد، والانسجام هو التواصل مع المُتلقِّي للخطاب. وقد تنوّعت الأساليب في العرض بين الصور والأدوات الفنّية، والتوظيف للأفعال الكلامية التي حقّقت بلاغة رائدة وفائدة للقارئ، فقد وردت فيها الموضوعات متحدة، وتفرّعت الجزئيات، وذُكرت التفاصيل بالبحث عن المسببات، والربط بين المقدّمات والنتائج.
الاختتام: وهو يعلق غالباً في الذهن؛ وذلك لقرب عهده بالقراءة، ويوحي بالنهاية، تقول(عليها السلام): (فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنّه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل)[6].
فقد احتوت الخاتمة على الوظيفة الحجاجية في قضية الاعتراف بالقوّة الإلهية، والرضا بالقضاء، وعظمة الخالق، وعلمه بكلّ شيء، وبدايات الأُمور وخواتيمها بيده، فهو الخبير، وقد أُكِّد الخبر بالجملة الطلبية الدعائية التي حوت الفعل الكلامي (نسأل الله)، ورفد بالجمل المؤكّدة بـ(إنّ) التي تحمل طاقة حجاجية كامنة في ردّ التردد أو الشك في ذلك (إنّه رحيم ودود)، فتُثير انفعالات نفسية، وتضع المستمع على هيئة حسنة، وتثبيت صحّة الأقوال الموجّهة إليه؛ ليميل إلى المتكلّم، فهي إصدار حكم نهائي وملخّص وافٍ للحجج.
وقد عُني البحث بدراسة المحاور الأساسية في الخطبة، وهي:
1. الأفعال الكلامية.
2. الملفوظ والعامل.
3. الصورة الحجاجية.
4. الاستلزام الحواري.
فضلاً عن المرور بالسياق والإشارة إليه، والروابط اللغوية وما تؤدّيه في اتّساق النصّ وانسجامه شكلاً ومضموناً، لتحقيق أهدافه في استمالة المُتلقِّي وتوجيهه نحو الغايات التي تريدها الخطبة.
والتداولية منهج (يقوم على الاهتمام بكشف الدوافع النفسية للمتكلّمين، وردود أفعال المتلقّين، ويبيّن الطابع الاجتماعي للكلام)[7].
الأفعال الكلامية
قامت نظرية الأفعال الكلامية على مبادئ فلسفية ومنطقية، تبنّاها (جون أُوستن) الذي يعدّ مؤسس النظرية، وعمّقها (جون سورل)، وهي إحدى محاور الدرس التداولي الحديث، وهي مجال أساسي لدراسة مقاصد المتكلّم ونواياه، فالمقصد يحدّد هدف المُرسِل، من وراء سلسلة الأفعال اللغوية التي يتلفّظ بها، وهذا ما يساعد على فهم الخطاب، ومن ثمّ يصبح توفّر القصد وآليته مطلباً أساسياً، وشرطاً من شروط نجاح الفعل اللغوي، الذي يجب أن يكون متحققاً ودالاً على معنى[8].
وقد رسم (أُوستن) منهجاً للأفعال الكلامية منطلقاً من (إنشاء جملة لسانية، وهي في حدّ ذاتها فعل لُغوي تنتهي إلى نظرية اللغة، التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من نظرية الفعل، حيث يحقق فعل القول في إطارها أفعالاً اعتقادية من قبيل: التأكيد، أو الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو التعجّب)[9].
الأمر
لا تهتم التداولية والدرس التداولي بالبنية اللغوية النحوية للأمر بقدر ما تهتم بالتوظيف الدلالي البلاغي التداولي للأمر وصيغه، ويُعدّ الأمر من أكثر الآليات التي يستخدمها المُرسل الموجّه؛ لما له من دور كبير في تبليغ مقتضـى الأفعال التوجيهية.
والمطّلع على الخطبة الكريمة يجد أنّها تضمّنت أفعال الأمر التي جاءت على سبيل المجاز، والهدف من ذلك تعجيز الخصم، وإفهامه أنّه الخاسر مهما سعى ودبّر، (فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله، لا تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلّا فند، وأيامك إلّا عدد، وجمعك إلّا بدد، يوم يناد المناد: ألا لعنة الله على الظالمين)[10].
لقد جسّد الأمر ودلالاته مقاصد الخطبة الزينبية إلى حدّ كبير، على تنوّع واختلاف في الدلالة، وفي علاقة المُرسِل بالمُرسَل إليه.
إنّ الأفعال (كد، ناصب، اسع) هي أفعال أمر موجّهة من مُرسِل ـ يملك الحقّ والفصاحة والبيان والثقة العليا القادرة على الإنجاز ـ إلى مُرسَل إليه في مرتبة دنيا، لا يملك القوّة ولا الإنجاز ويدّعيهما؛ ولذلك فإنّ بين المرسِل المتمثّل في (زينب الحوراء(عليها السلام) مدعومة بثقة الله وقوّته وقدرته) والمرسَل إليه المتمثّل في (يزيد الطاغي) تباعداً كبيراً.
إنّ المُرسِل لجأ إلى استراتيجية الأمر لعدد من الدواعي في الخطبة، فلا يوجد تشابه في السمات بين المُرسِل والمُرسَل إليه، ولأنّ المُرسَل إليه في المرتبة الدنيا فقد تجاوز حدوده في النقاش والحذر، وتحدّى المُرسِل بالفعل؛ وذلك بسبب التفاوت الكبير في الفعل الإنجازي بين المُرسِل والمُرسَل إليه.
ولهذا؛ فإنّ الأفعال (كد كيدك) و (اسع سعيك) و(ناصب جهدك) المتوجّهة نحو يزيد، فيها معنى التعجيز، ورميه بالوهن والضعف؛ لأنّه في ضلال مبين واضح.
الاستفهام
للاستفهام فاعلية من حيث الإنجاز والتأثير، لمحها سيبويه، حيث يشير إلى أنّ غاية السؤال أنّه يطلب (من المخاطب أمراً لم يستقرّ عند السائل)[11].
إلّا أنّ الاستفهام يخرج عن معناه المعهود إلى معانٍ مجازية لها قوّة إنجازية وفاعلية في التأثير، وتتراكم الاستفهامات في خطبة زينب(عليها السلام) صريحة مرّة وضمنية أُخرى لغاية الإنكار وإقامة البرهان على بطلان أفعال يزيد وحزبه الطلقاء، وذلك في قولها: (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نُساق كما تُساق الأُسارى، أنّ بنا على الله هواناً، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده؟!)[12]، ومن تلك الاستفهامات قولها(عليها السلام): (أمن العدل يابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا؟!)[13].
وتُجيب زينب(عليها السلام) بتداخل نصّي قرآني، فتُفحم يزيد وتُقيم الحجج على بطلان ادّعائه، فتقول: (أنسيت قول الله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)[14]؟!)[15].
إنّ هذا التناصّ القرآني مُفحِم، وحجّة باهرة، ودليل قاطع على أنّ ما يراه المبطلون من تُحقق النصـر لهم سيلقمونه وشيكاً ناراً في بطونهم، وينقلب عليهم إلى أسوء مردّ، حيث عذاب الله المهين لكرامتهم، بعدما ابتغوا إهانة آل رسول الله(صلى الله عليه واله) وأهل بيته(عليهم السلام)، ومرّة أُخرى يخفق يزيد بفعله.
إنّ يزيد يعلم يقيناً مَن تكون زينب(عليها السلام)، وما هو موقعها من رسول الله(صلى الله عليه واله)، ورغم ذلك تجاوز الحد، وأبدى كلّ رعونة، وخفّة عقل، واستهانة بحرم الرسول(صلى الله عليه واله)؛ إذ هتك سترهنّ، وأبدى وجوههنّ، وخدّر حرائره ونساءه.
وقد أثّر ذلك في زينب(عليها السلام) تأثيراً بالغاً، فأطالت وصف قبح أفعال يزيد في هتك ستر أهل بيته، فاستخدمت أُسلوب الإطناب، شارحة مقدار الألم الذي حلّ بها، لسخف فعل يزيد، (فمهلاً مهلاً، لا تطش جهلاً، أنسيتَ قول الله: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؟! أمن العدل يابن الطّلقاء تخديرك حرائرك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههنّ، يحدو بهنّ الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهنّ أهل المناقل، و يبرزن لأهل المناهل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والغائب والشهيد، والشـريف والوضيع، والدنيّ والرفيع، ليس معهنّ من رجالهنّ وليّ، ولا من حماتهنّ حميم، عتوّاً منك على الله، وجحوداً لرسول الله، ودفعاً لما جاء به من عند الله،، ولا غرو منك، ولا عجب من فعلك؟!)[16]، فحذّرت يزيد بعذاب الله له ولأعوانه، وذلك بأُسلوب اسم فعل الأمر (مهلاً مهلاً)، مواساة لقلبها المجروح.
ومن تلك الاستفهامات المنكرة لهذا الفعل الشنيع ليزيد: (وأنّى يُرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الشهداء، ونبت لحمه بدماء السعداء، ونصب الحرب لسيّد الأنبياء، وجمع الأحزاب، وشهر الحراب، وهزّ السيوف في وجه رسول الله أشدّ العرب لله جحوداً، وأنكرهم له رسولاً، وأظهرهم له عدواناً، وأعتاهم على الربّ كفراً وطغياناً؟!)[17]، (وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن، والإحن والأضغان؟! ثمّ تقول غير متأثّم ولا مستعظم:[18]
وأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل
النفي
للنفي أثرٌ فاعل في النص التداولي؛ لأنّ غرضه إبطال آراء الخصم وردّها، فللنفي وظيفة إقناعية، (تُفتّت أُسس الرأي المضاد، وتنزع عنه المصداقية)[19]، وتغلب اعتقاد المتلقّي، وتقطع ادّعاءاته، وله وظيفة تتمثّل في إبطال معلومة الخصم، وإمداده بمعلومة أُخرى يعتبرها الآخر صحيحة[20]، أي: إنّها وظيفة التعويض.
فالمستكبر (يزيد) هو المخاطب، سماعه وعدم سماعه واحد؛ لأنّ الخطبة تتوخّى النتيجة، فالمستكبر (يزيد) سمع الحجج ووعاها، لكنّه لاستكباره لم يعترف، والخطبة قطعت ادّعاءه بإظهار النتيجة: (فوالله، لا تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض عنك عارها)[21].
كلّ ذلك جاء في سياق متناسق، يشدّ بعضه بعضاً بالحجج الدامغة، فأوّل النفي قسم، وآخره كان أساليب نفي مجازي بـ(أداة الحصـر وإلّا)، أو (الاستفهام الإنكاري): (وهل رأيك إلّا فند، وأيامك إلّا عدد، وجمعك إلّا بدد؟!)[22]، كلّ تلك أساليب نفي مؤكّدة، وأدلّة مقنعة، أظهرت النتيجة الحاسمة، والحقائق التي لا مراء فيها، فالحياة إلى زوال، وكلٌّ سينال ما قدّمت يداه.
الروابط الحجاجية
(الرابط…: كلّ لفظ يُمكّن من ربط قضيتين، أو جملتين، أو أكثر؛ لتكوين قضايا وجمل مركبة)[23]، فالبنية النصّية للخطاب تُركِّز على الأدوات اللغوية؛ ليتمّ الربط بين الحجّة والنتيجة، أو المقدّمات والنتائج بروابط حجاجية.
التوكيد
هو من الروابط الحجاجية الإقناعية التي تفيد دفع الشك وإزالة الشبهات عمّا أنت بصدده، تقول زينب(عليها السلام): (إنّي لأستصغر قدرك)[24]، إذ استخدمت مؤكّدَين في معرض استصغار يزيد واحتقاره، وهما: (إنّ) الحرف المشبّه بالفعل، و(لام الابتداء) التي تسمّى هنا باللام المزحلقة.
ومن المؤكّدات الإقناعية أُسلوب الحصر الذي تكرّر مع القسم الذي هو أيضاً يفيد التوكيد، (والله، ما فريت إلّا جلدك، ولا جززت إلّا لحمك)[25]، إنّها عبارات تقولها زينب(عليها السلام) محاطة بمُؤكِّدات، رغم أنّها تُعبِّر عن مستقبل يزيد في يوم الحساب، وهي ترى ذلك بعين الحقّ الذي عرفته من جدّها وأبيها، فلا مجال للشك.
ومنه التوكيد اللفظي: وهو رابط حجاجي، وحجّة تعليلية مُؤكِّدة في الكلام، وخطبة زينب(عليها السلام) من البلاغة بمكان بحيث تنوّعت فيها المُؤكِّدات بتناسق في الكلام وتصعيد؛ لإنكار فعل يزيد، إذ تقول: (ألا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء!) [26].
والحجّة تعجبية هنا لأنّ طرفي الميزان غير متكافئين، فكيف يُقتَل حزب الله والمؤمنون أصحاب الحقّ، بشراذمة الشيطان؟! وتحتجّ زينب(عليها السلام)، فتجد الأدلّة التي تفكّ شفرات التعجّب، ففي الحياة الدنيا الذاهبة غنم يزيد بمقتل الحسين(عليه السلام) وأهله وأصحابه، لكن يوم القيامة سيكون ديناً يُقتص منه، حيث لا اقتصاص إلّا جهنم، تقول زينب(عليها السلام) مُؤكِّدة قولها بالقسم: (ولئن اتّخذتنا مغنماً، لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)، وإلى الله المشتكى، وعليه المعوّل)[27].
إنّ زينب(عليها السلام) مؤمنة آل علي(عليهم السلام)، تعلم يقيناً أنّ الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولهذا قُتِل الأشراف بيد الأدعياء، لكن بالمقابل فإنّ الله ليس بظلّام للعبيد، فكلّ ذي حقّ سينال حقّه شاء الطغاة أم أبوا.
الاستلزام الحواري
لكلّ فعل ردّة فعل لدى المُتلقِّي، تكون ردّة معاكسة، تتبنّاها سمات مكوّنة لنسيج النص، ومتفاعلة مع حركته الجوهرية، والردّة تلك هي من تأثيرات أفعال الكلام الحوارية التي تدعو إلى الاستنتاج المباشر ضمن نسق مختلف، فالمفهوم القصدي من الفعل الكلامي يقوم على أُسس تداولية، وتلك المفاهيم لها قيمتها النصّية والحوارية الكامنة في أبرز المفاتيح الممنهجة للنصوص التي تنطوي على أفعال القوّة المتضمّنة في القول، والتي تُشكّل هرماً توافقياً مع عوامل الإقناع في ظل مجتمع يمتلك الوعي، ولكنه يحيد عن جادة الحقّ، والغاية التواصلية التي يريدها المتكلّم تتحقق من الخطاب وقصديّته[28].
فمن الاستراتيجيات الحجاجية التي استُخدمت في حجاجية أُسلوب الشـرط اشتماله على ألفاظ ذات معانٍ تُلزِم الخصم على اقتراح جواب، فتكون أكثر فاعلية في إقناعه واستمالته، ومن خلال هذا الأُسلوب ظهر لنا ما يسمّى بمبدأ (الاستلزام الحواري) في النصّ، إذ يعدّ واحداً من أهم الجوانب التي تبحث في الدرس التداولي، وهو ألصقها، ففي الحوار نجد المتكلّم والمستمع يستطيعان المناقشة والاتّصال لأنّهما يمتلكان معلومات أو خلفية عن الموضوع.
وقد تطوّر ذلك حتّى انتهى إلى مبدأ التعاون الذي جاء به الأمريكي (جرايس) في تناوله كيفيّة اشتغال اللغة الطبيعية في التواصل، أي: كيف يكون ممكناً أن يقول المتكلّم شيئاً ويعني شيئاً آخر، والمخاطب يسمع شيئاً ويفهم شيئاً آخر؟ و(مقتضاها أنّ المتخاطبين لا يندفعون إلى التبادلات الكلامية إلّا وهم يسلّمون بالتعاون فيما بينهم)[29]، ولا بدّ لنا من جدولة للمقاطع التي تشتمل على الاستلزام الحواري، وهي مقطعان، ذُكرا داخل التركيب اللغوي للجملة الشرطية:
ت الاستلزام الحواري الحوار
1 ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك. الجواب: إنّي لأستصغر قدرك واستعظم تقريعك…
ويستلزم معاني السخرية.
2 لئن اتخذتنا مغنماً الجواب: لتجدنا وشيكاً مغرماً.
وتستلزم الإجابة هنا التهكم والتبكيت.
للاستلزام الحواري أهمّ إسهام في تطوّر التداولية، إذ (إنّ آيات الاستلزام قائمة على مبدأ التعاون، بافتراض فهم السامع وإدراكه المعنى المستلزم، فضلاً عن قدرته على الاستنتاج انطلاقاً من فرضية الملائمة)[30].
حجاج الصورة
عُدّ الدرس البلاغي فنّاً من فنون التعبير والإقناع، تميّز بالخصوصية الشعرية (التخيّل)، والخصوصية الخطابية (الإقناع)، وما بينهما من تداخل، (فقد درس عبد القاهر الجرجاني الخطاب في أبعاده الاستدلالية والمنطقية، وقدّم نظريته في (النظم) التي أقامها على أُسس تداولية باستحضار المُتلقِّي في تحديد القيمة البلاغية للنظم، كما أبرز الوظيفة التداولية والإقناعية للاستعارة من خلال مفهوم الادّعاء)[31]، ومن ثمّ أصبحت وظيفة البلاغة الإمتاع والإقناع كخصيصتين أساسيتين.
(فالبلاغة اهتمّت بالبعد التداولي في مفهومها للخطاب، واعتنت بمناسبة المقال للمقام، واستحضـرت المخاطب في تحديدها للنص البليغ)[32]، فالمجاز أعلى رتبة من الحقيقة في سلّم المعاني المسترسلة المؤوّلة للمعنى الأصلي، ويأتي قولها(عليها السلام): (ولترِدنّ على رسول الله بما تحمّلت من سفك دماء ذرّيته)، مسنداً بتناصٍّ تشبيهي من آي الذكر الحكيم: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)[33] في غاية البلاغة، فالصورة تشبيهية حجاجية، فضلاً عن التوكيد الذي زادها قوّة في جعل الحجّة عليهم، (وحسبك بالله ولياً وحاكماً، وبمحمد(صلى الله عليه واله) خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً)[34].
الخبر
هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، مع مراعاة قصد المُخبِر واعتقاده، فإذا كانت نسبة الخبر الكلامية مطابقة لنسبته الخارجية مع اعتقاد المُخبر بمطابقتها، فالكلام صادق، وإذا كانت نسبته الكلامية غير مطابقة لنسبته الخارجية، مع عدم اعتقاد المخبر بمطابقتها، فالكلام كاذب، ومن هنا فالخبر يقبل الحكم عليه بالثبوت والنفي.
والخطبة في كثير من جملها إخبارية تنبئ عمّا حدث في واقعة الطف، وهي جمل إخبارية مؤكّدة بصنوف التوكيد وأنواعه كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وزينب(عليها السلام) بخطبتها تلك تُخبر عمّا جرى في كربلاء ببلاغة عالية، وشجاعة أدبية، وبمصداقية كبيرة، فليس ذلك شيئاً خفياً، وقد اعترف به كلّ مَن كتب في واقعة كربلاء، ومَن أصدق من بنت علي(عليه السلام) قيلاً؟! والكلام مطابق للواقع، فعندما يلجأ المُتلقِّي إلى قراءة الخطبة أو سماعها، يجد وصفاً حقيقياً للواقعة، ووصفاً لفعل يزيد، ولمصيره الذي سيلقاه.
المصادر والمراجع
*القرآن الكريم.
1. الاستلزام الحواري في التداول اللساني، العياشي أدراوي، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأُولى، 2011م.
2. الاستلزام الحواري في سورة البقرة .. دراسة وصفية تحليلية تداولية (مشروع بحث)، حجر نورما وحيدة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانج، 2010م.
3. الاستهلال فنّ البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية، بغداد، الطبعة الأُولى، 1993م.
4. بحار الأنوار، العلّامة محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1403هـ/1983م.
5. بلاغة الإقناع في المناظرة، عادل عبد اللطيف، منشورات ضفاف، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1434هـ /2013م.
6. بلاغة الإقناع.. دراسة نظرية وتطبيقية، د. عبد العالي قادا، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأُولى، 1437هـ/2016م.
7. البلاغة والنقد، محمد كريم الكواز، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 2006م.
8. التداولية اليوم، آن روبول وجاك موشلار، ترجمة: سيف الدين دغفوس ومـحمد الشيباني، إصدارات: المنظمة العربية للترجمة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2003م.
9. التداولية عند العلماء العرب.. دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، د. مسعود صحراوي، بيروت، الطبعة الأُولى، 2005م.
10. الحجاج في البلاغة المعاصرة، د. محمد سالم محمد الأمين الطلبة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الأُولى، 2008م.
11. الحوار ومنهجية التفكير النقدي، حسن الباهي، مطبعة أفريقيا الشرق، المغرب، 2004م.
12. شجرة طوبى، الشيخ محمد مهدي الحائري (ت1369هـ)، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف، الطبعة الخامسة، 1385هـ.
13. شظايا لسانية، أ.د. مجيد الماشطة، مطبعة السلام، البصرة، الطبعة الأُولى، 2007م.
14. الكتاب، عمرو بن عثمان المشهور بـ(سيبويه)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأُولى.
15. المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة الأُولى، 1997م.
________________________________________
[1] اُنظر: الماشطة، مجيد، شظايا لسانية: ص59.
[2] اُنظر: الطلبة، محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة: ص193.
[3] المصدر السابق: ص175.
[4] اُنظر: النصير، ياسين، الاستهلال فنّ البدايات في النص الأدبي: ص14.
[5] الروم: آية10.
[6] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص135.
[7] الكواز، محمد كريم، البلاغة والنقد: ص279.
[8] اُنظر: فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية: ص38.
[9] الباهي، حسن، الحوار ومنهجية التفكير النقدي: ص123.
[10] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص135.
[11] سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب: ص8.
[12] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص133.
[13] المصدر السابق: ج45، ص134.
[14] آل عمران: آية178.
[15] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص133.
[16] المصدر السابق: ص158.
[17] المصدر السابق.
[18] المصدر السابق: ص134.
[19] عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة: ص223.
[20] المصدر السابق:ص225.
[21] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص135.
[22] المصدر السابق.
[23] آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم: ص265.
[24] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[25] المصدر السابق.
[26] المصدر السابق.
[27] المصدر السابق: ص135.
[28] اُنظر: صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب..دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي: ص200.
[29] اُنظر: وحيدة، حجر نورما، الاستلزام الحواري في سورة البقرة..دراسة وصفية تحليلية تداولية: ص41.
[30] أدراوي، العياشي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص17ـ 18.
[31] قادا، عبد العالي، بلاغة الإقناع..دراسة نظرية وتطبيقية: ص41.
[32] المصدر السابق: ص40.
[33] آل عمران: آية169.
[34] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص159.
المصدر: مؤسسة وارث الأنبياء
https://warithanbia.com/?id=2229
لینک کوتاه
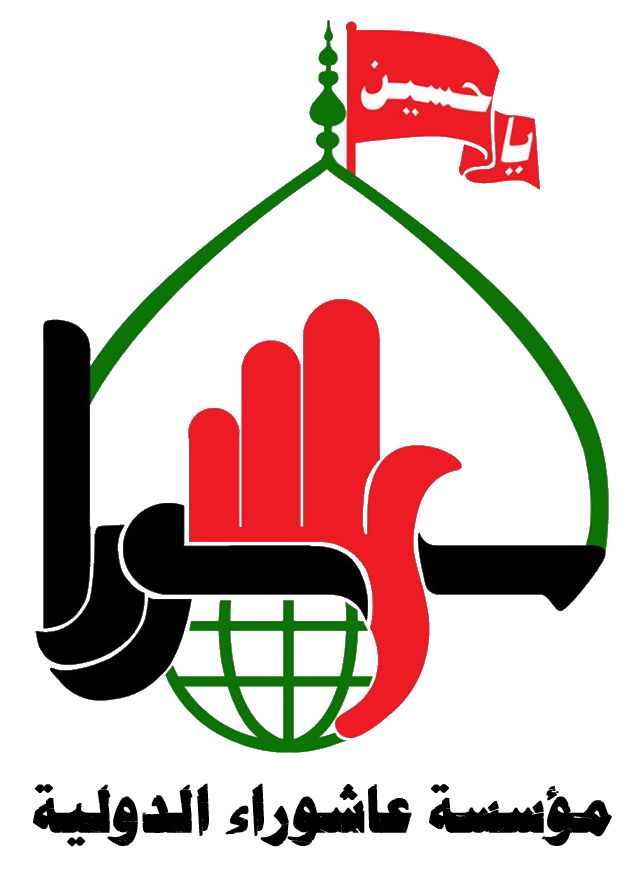
سوالات و نظرات